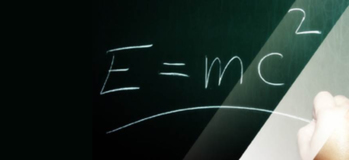القوة والنظام العالمي الجديد( )
فئة : ترجمات

القوة والنظام العالمي الجديد([1])
لقد اقترب عام آخر من النضال السياسي العالمي لإعادة تعريف مجموعة القوى من نهايته. وحتى لو كان كل يوم من الناحية الفلسفية هو يوم للتأمل -وليس فقط التاريخ الرمزي الذي يتم تحديده بوحدة العد سواء سنة أو عقد أو قرن-، فإنني أغتنم هذه اللحظة، هنا والآن hic et nunc، كفرصة لتتبع الخلفية والأفكار المهيمنة للأفعال التي يسترشد بها «منطق القوة». لن أقتبس -بمعنى مراجع ذات صلة relata refero- بشكل انتقائي من المؤلفات الواسعة حول هذا الموضوع، بل من خلال ما تعلمته من «فينومينولوجية القوة Phänomenologie der Macht» التي اشتغلت عليها -بروح منهج هوسرل بالكامل- على امتداد نصف قرن، كوصف وتحليل «للسياسة الواقعية» العالمية([2]).
ما يهمني في المقام الأول ليس هو وصفة طبية Präskription، لكن الوصف Deskription. إذا أراد المرء تعزيز فكرته الخاصة عما يجب أن يكون عليه العالم، فيجب عليه أولاً، أن يعرف كيف هو العالم. إن التمني يحجب الواقع ويجعل العمل الفعال مستحيلاً. في الوصف الفينومينولوجي لمنطق القوة، يكون للتحليل النفسي([3]) بطبيعة الحال أهمية خاصة. ويتعلق الأمر بإعادة بناء دوافع الأفعال الفردية (للسياسي) والأفعال الجماعية (للدولة).
أعتبر أن ما استمر عبر كل العصور التاريخية المتغير الأنثروبولوجي للقوة، يتعلق الأمر برغبة الفرد في تأكيد الذات (بما في ذلك الرغبة في الاعتراف)، ونتيجة لذلك، تأكيد الجماعة -الدولة-، بوصفها رابطة من الأفراد لضمان البقاء، في المقام الأول، ولكن بعد ذلك أيضاً ضمان «الحياة الرغيدة» لمن ينتمي إليها. والمثال الكلاسيكي على ذلك هو دولة الرفاهية الحديثة. وبالإشارة إلى الدولة كشكل قانوني للتنظيم، فإن السلطة هي وسيلة تهيئة الظروف لتحقيق هذا الهدف لكل فرد ينتمي إلى هذه الجماعة.
يتطلب هذا أولاً، احتكار العنف في يد الدولة داخلياً (من أجل تجنب قتال الجميع ضد الجميع؛ أي لتجنب الفوضى)، وثانياً قدرة الدولة على تأمين مصالح الحياة والبقاء للمجتمع الذي تجسده خارجياً. ولا تكمن ها هنا أهمية الجيش فقط، بل أهمية السياسة الخارجية والدبلوماسية بشكل عام. في شكلها الملموس، هذه القدرة هي القوة (القدرة، الإمكانية) للتعبير عن مصلحتها الخاصة («المصلحة الوطنية») على نطاق عالمي بطريقة تمكنك من عدم الاستيلاء على المجتمع المعني بالأمر من قبل مجتمعات أخرى، ولكن قبل كل شيء لا يصبح بيدقاً في الصراع على السلطة بين أطراف ثلاثة. يتعلق الأمر بالسلطة بوصفها تعبيراً عن السيادة، وقدرة الدولة على التصرف بطريقة تحدد مصيرها. وهذا هو جوهر (غير مفهوم بشكل جوهري) للسلطة في المجال الحكومي الدولي -على افتراض أن المرء يعرف السلطة بشكل عقلاني، يعني، الأخذ في الاعتبار أن الدولة لا تسعى بمفردها لتحقيق ذاتها، لكن جميع التجمعات الأخرى التي تنظمها الدولة تريد نفس الشيء، إذا جاز التعبير. ولذلك لا يمكن ممارسة السلطة بشكل عقلاني، إلا على أساس فهم غير مطلق للسيادة.
يجب علينا أن نقارن فكرة القوة في موقعها العقلاني -كوسيلة لتحقيق الدولة لذاتها في إطار مجتمع (دولي) من دول متساوية- بواقع السياسة، حتى لا يصبح تحليلنا غير ذي معنى/أهمية. وفي الواقع، حتى في الوقت الحاضر، لا يتم استخدام القوة بهذا المعنى شبه المستنير، ولكنها تُمارس وفقاً للآليات التقليدية لـ «سياسة القوة» -بغض النظر عن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الرسمية العديدة بالعلاقات السلمية والتعاونية بين الدول («علاقات الصداقة والتعاون بين الدول») («friendly relations and cooperation among States» في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة)([4]). إن «منطق القوة» في السياسة العالمية اليومية موجه نحو تأمين المصالح الوطنية، بالمعنى الذي وصفه الرئيس ترامب منذ وقت ليس ببعيد، بالقول: «أمريكا أولا America first» -كتأكيد على أولوية الدولة القومية منذ البداية- قبل أن يبدأ التفكير الاستراتيجي، ودون مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل([5]).
على هذه الخلفية، تنطلق الدولة، بوصفها فاعلاً دولياً، من «فرضية العمل» القائلة إن أمن المجتمع يجب أن يرتكز على عدم الثقة الاستراتيجية. لا يفترض المرء منذ البداية أن جميع الأطراف الفاعلة الأخرى تتصرف وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. لذا، ما يُطبق ليس هو مبدأ الثقة، بل مبدأ عدم الثقة. وهذا ما يفسر أيضاً الدور البارز الذي تلعبه الأجهزة السرية، خاصة في الدول المتوسطة والكبرى. ويعلم العديد من الدبلوماسيين من دولة صغرى أيضاً، بأنهم يكونون في حالات معينة موضع تقدير من طرف مركز سلطة بلدهم، إذا كانوا يعرفون كيفية «استخدام» حصانتهم الدبلوماسية لأغراض استخباراتية. وفي الصورة الذاتية غير المعلنة للدولة عن نفسها -في اللاوعي الجماعي، إذا جاز التعبير-، فإن الأمر يدور دائماً حول صراع من أجل البقاء عندما تسعى الدولة إلى موضعة نفسها في المنافسة العالمية. في نهاية المطاف، فإن إدلاء المسؤولين باليمين يكون يميناً/قسماً على رفاهية مجتمعهم، وعلى دستورهم، وليس على رفاهية المجتمع العالمي أو حتى الدول المجاورة. وفي هذا السياق، فإن الكذب -بوصفه خداعاً للمنافسين في الصراع من أجل تأكيد مصالحهم- يشكل تقليدياً جزءاً من مخزون السياسة، ولا ينطبق هذا فقط في أوقات الحرب. وهنا يكمن أيضاً رأس اليانوس في ممارسة الخدمة السرية: داخلياً -في مسائل الحصول على المعلومات لمجتمعه، يكون المرء ملتزماً بالحقيقة. أما خارجياً، فيكون ملزماً بالخداع أو التمويه، عندما يتعلق الأمر بإعطاء دولته ميزة على الآخرين أو تجنب الضرر. وتتجلى هذه الازدواجية بشكل خاص في السياسة الدفاعية للقوى العظمى بالطبع.
في هذا الصدد، فإن منطق القوة، إذا جاز التعبير، يتنافس مع سياسة موجهة نحو مثال التعاون المتساوي والمرتكزة على مبدأ الثقة، لكن وكما يظهر التاريخ، فإن الأمر لن يكون منطقياً إلا إذا تصرف الجميع وفقاً لذلك. لقد كانت هشاشة الثقة واضحة في عدد لا يحصى من التجمعات الاستراتيجية منذ العصور القديمة. ولتوضيح ذلك، يمكن للمرء، على سبيل المثال، أن ينظر إلى سياسة التحالف غير المنتظمة في زمن هنري الثامن أو، في التاريخ الحديث، الإحالة على ظروف الاتفاق بين هتلر وستالين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. إن السذاجة وحسن النية ليستا عملتان شائعتان في السياسة العالمية.
يعني منطق القوة -المبني على عدم الثقة- أيضاً في سلوك القوى العظمى، أنها مهتمة دائماً بإدامة الوضع الراهن الذي يعود عليها بالنفع (نعم، يجب أن يُؤخذ هذا في الحسبان في حساباتهم)؛ لأن هذا المنطق ينتج في كثير من الأحيان عن الحرب، وليس عنها فقط. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر «بالسلام الأبدي» بالمعنى الكانطي، بل بغياب الحرب الذي تضمنه الهيمنة الدائمة للدولة. والشعار هو: السلام الأبدي من خلال السيادة الأبدية!
وقد تم التعبير عن ذلك بإيجاز شديد في بداية قرننا في «استراتيجية الأمن القومي» التي أعلنها الرئيس بوش الابن عام 2002، والتي بموجبها توجه الولايات المتحدة كل جهودها لضمان عدم تحقيق أي دولة أخرى للتكافؤ الاستراتيجي على الإطلاق، حتى تصبح قوية مثل الولايات المتحدة. ويعني هذا بلغة واضحة: «يجب علينا أن نبني دفاعاتنا ونحافظ عليه بما يتجاوز التحدي We must build and maintain our defenses beyond challenge»([6]). ومن ثم، فإن منطق القوة هذا يشمل جعل موقف الفرد مطلقاً، أي -في حالة الكوكبة الأحادية القطب- توجه السياسة الخارجية والدفاعية والاقتصادية نحو هدف واحد، واستبعاد ظهور توازن جديد للقوى إلى الأبد، سواء كان توازناً ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب -بطريقة فاوستية([7])- للحديث عن «اللحظة الإستراتيجية»: «ابق، إنك جميل!». ومع ذلك، لا يمكن أبداً إيقاف الزمن، حتى من طرف أقوى لاعب في الوقت الحالي. ليس هناك «نهاية للقصة». إن إنكار الواقع -فقدان مبدأ الواقع- في سياسات القوة الجشعة، كان يؤدي دائماً إلى صحوة مفاجئة وواقعية في كل العصور، وتختلف الفترة الزمنية التي تتم خلالها هذه العملية.
ويتعلق الأمر هنا بخسران الواقع من ناحيتين:
أولا بشكل فردي: إن قادة الدولة الذين وصلوا إلى موقع قوة بلا منازع في منطقتهم (المحلية) يتعرضون عاجلاً أم آجلاً لتغيير في شخصيتهم؛ يعزلون عن بيئة خاضعة ويميلون إلى التفكير في عدم استطاعة المرء الاستغناء عنهم. وهذه نتيجة تجريبية أكدتها ملاحظاتي على مدى عدة عقود. إن تصحيح فقدان مبدأ الواقع هذا لا يكون في كثير من الأحيان تطوراً داخلياً، بل يأتي من الخارج. إنه ديناميكيات العلاقات الدولية التي لا يمكن لسياسي ما التحكم فيها. ومن خلال سوء التقدير الاستراتيجي -لأن الهوس بالسلطة يتجاهل الحقائق أو يزيفها-، فإن الدولة التي يمثلها مثل هؤلاء الأشخاص يمكن فجأة، وبشكل غير متوقع بالنسبة للحاكم، أن تستسلم للقوى الدولية، وهذا ما يؤدي عادة أيضاً إلى عواقب سياسية داخلية -تمشياً مع القول المأثور القديم: «تأتي الكبرياء دائماً قبل السقوط»([8])-.
ثانياً: يتوافق الجنون الجماعي للسلطة مع الفرد. إن الدولة التي تسعى إلى إدامة تفوقها بالطريقة التي سبق وصفها، تميل إلى رؤية موقفها -بشكل غير صحيح- على أنه موقف لا غنى عنه، ويتماشى هذا تماماً مع التقييم الذاتي للولايات المتحدة بصفتها «أمة لا غنى عنها indispensable nation» (مادلين أولبرايت، إن بي سي، The Today Show""، 19 فبراير/شباط 1998)([9]). ويضفي الفرد الشرعية على تصرفاته من خلال مهمة أخلاقية شبه أخروية، نصبت نفسها بنفسها، كما أظهرت خطابات الساسة الأمريكيين حول «النظام العالمي الجديد» بعد نهاية الحرب الباردة([10]). إن المدافعين عن مثل هذه الإستراتيجية، مدفوعين بالتمني، يصلون إلى هذا دائماً بسرعة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك -قبل ثلاثة عقود- كان هناك فرانسيس فوكوياما بأطروحته حول «نهاية التاريخ». لقد أثبت من خلال نبوته بأنه أحد تلاميذ هيغل -وإن كان تلميذاً ضعيفاً -، الذي كان يرى في زمانه الدولة البروسية تجسيداً لــ «روح العالم».
في إنكار مبدأ الواقع، أثبت الصراع على السلطة والهيمنة أنه جنون جماعي في السياسة العالمية، كان سبباً للحروب والصراعات على مر القرون. إن السياسة التي تسترشد بــ «منطق القوة»، والتي تهدف إلى تحقيق هدف الهيمنة الدائمة، الذي لا يمكن تحقيقه في نهاية المطاف، تؤدي أيضاً إلى نتائج عكسية؛ لأنها تولد باستمرار مقاومة تؤدي في النهاية إلى إسقاط الهيمنة المعنية؛ لأنه -بسبب ادعائه بالمطلق- عليه أن يدافع عن نفسه في كل مكان، ويحمي نفسه من كل جانب. وقد صاغ الاستراتيجيون الأمريكيون المقربون من وكالة المخابرات المركزية مصطلح «التأثير العكسي وقد صاغ الاستراتيجيون الأمريكيون المقربون من وكالة المخابرات المركزية مصطلح "التأثير العكسي" لهذا الغرض» لهذا الغرض([11]). وقد وصف بول كينيدي («صعود وسقوط القوى العظمى The Rise and Fall of the Great Powers»، 1988) المشكلة بشكل مناسب بمصطلح «التمدد الإمبراطوري المفرط imperial overstretch». ويستخدم هذا المصطلح لوصف الظروف التي تصبح فيها القوة عاجزة -بسبب ادعائها بالشمولية-.
بسبب منطق القوة، الذي -بوصفه جنون القوة- يهدف دائماً بشكل غير عقلاني إلى الحد الأقصى (من حيث الشدة والمدة) ويكبت الفشل الحتمي، وفي المواقف التي تتغير فيها مجموعة القوى فجأة، تفقد الدول الفرصة لبداية جديدة، وهي فرصة يمكن من خلالها كسر دائرة المنافسة على السلطة المدمرة للذات في نهاية المطاف.
هناك عدد من الأمثلة على هذا الأمر. يكفي أن ننظر إلى التطورات بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولكن أيضاً بعد الحرب الباردة؛ فبدلاً من دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي أُعلن رسمياً بعد الحرب العالمية الأولى، استفاد المنتصرون من إفلاس بعض الدول، أو تصرفوا بطريقة مكيافيلية كلاسيكية وفقاً لمبدأ فرّق تسد. ويكفي أن نشير إلى مصير التيرول([12]) أو المجر، ولكن بشكل خاص إلى نتائج الحرب العالمية الأولى على العالم العربي (الكلمة المفتاحية: اتفاقية سايكس بيكو). حاولت القوتان العظميان اللتان انبثقتا عن الحرب العالمية الثانية تقسيم العالم فيما بينهما. والحروب بالوكالة التي شُنت لتأمين مناطق النفوذ (كوريا وفيتنام) تسببت في خسائر فادحة في الأرواح. وحتى بعد «الحرب الباردة»، لم يتعلم من هم في السلطة أي شيء من التاريخ. فعوض السعي إلى تحقيق التوازن القائم على الشراكة بين المنطقتين الأوروبية الأطلسية والأوراسية، ركز الجانب المتفوق، بعد نهاية الاتحاد السوفييتي، على توسيع هيمنته، بمعنى تأمين موقعه الـمُمَيّز بشكل دائم من خلال تطويق روسيا. وكان منطق القوة هنا يعني أنه بعد انتهاء القطبية الثنائية، ومع انهيار الدولة السوفييتية وتفكك حلف وارسو، لم يتفكك نظيره الغربي، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم فقدانه حقه في الوجود، كحلف جماعي للدفاع عن النفس، بل أعاد تعريف نفسه، بوصفه أداة تَدَخُّل عالمية للطرف الذي أعلن نفسه منتصراً في الحرب الباردة. ومن أجل إخفاء التحول من المفهوم الدفاعي والإقليمي لمعاهدة شمال الأطلسي (1949) إلى تحالف هجومي بمهمة عالمية، تم إطلاق العبارة الـمُلَطِّفة «عمليات الاستجابة للأزمات غير المنصوص عليها في المادة 5»([13]).
في مثل هذه مجموعات التحالف، يهدد الجشع في السعي إلى السلطة بإثارة صراعات جديدة في المستقبل. وكما سبق أن أشرنا، فإن ما يثبت هذا هو مجرى التاريخ بعد الحربين العالميتين، ولكن أيضاً بعد أحداث الثمانينيات. إن المطالبة العالمية المفرطة بالقوة، من طرف القوة العظمى الوحيدة التي نشأت من الحرب الباردة، لم تؤد إلى زعزعة استقرار مناطق كبيرة بالكامل على مدى العقود الثلاثة الماضية فحسب، بل أدت أيضاً إلى نوع من الفوضى العالمية، حيث تجد منظمة الأمم المتحدة، التي أنشئت لضمان السلام، نفسها في دور متفرج عاجز، غير قادر على أكثر من نداءات التحذير، لأن الأمم المتحدة، بسبب إرادة القوة لدى القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، تم بناؤها بطريقة لا يمكنها أن تقف في طريق خطط القوى الأقوى.
هنا أيضاً يصبح من الواضح كيف أُهدرت الفرصة لبداية جديدة في السياسة العالمية بسبب قصر النظر. وبدلاً من إنشاء منظمة لتأمين السلام العالمي على أساس الشراكة المتساوية للجميع، قامت القوى المنتصرة بصياغة نظام أساسي لتأمين حكمها بشكل دائم، الأمر الذي -في وقت لاحق- أدى إلى زعزعة استقرار النظام العالمي بشكل دائم، ونزع الشرعية عن هذه المنظمة العالمية منذ البداية. ويوضح هذا المثال أيضاً عدم جدوى مثل هذه الإستراتيجية وعدم عقلانيتها في نهاية المطاف. إن الوضع المميز الذي يتمتع به مؤسسو الأمم المتحدة، والذين أرادوا تكريسه في الميثاق إلى الأبد([14])، لم يكن من الممكن أن يوقف مجرى التاريخ. ولا يمكن أن يمنع النظام الأساسي الخاص للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (P5)؛ ذلك أن مجموعة القوى في عام 1945 قد تغيرت الآن بشكل جذري، وتجد بعض القوى المنتصرة في ذلك الوقت نفسها الآن في موقع التبعية الإستراتيجية.
استناداً إلى التجربة التاريخية، يمكن القول إن «منطق القوة» في السياق العسكري العالمي يعني في نهاية المطاف: أولا أن الدولة توسع احتكارها الداخلي للقوة (وهذا أمر لا جدال فيه؛ لأنه جزء من سيادة القانون) إلى المجال الخارجي؛ أي إن مطالبتها بالحكم، وإن كانت غير معلنة، يتم إسقاطها على الدول الأخرى -وفي حالة القوة العظمى، يتم إسقاطها على العالم بأسره-. وثانياً تتم تعبئة كافة القوى لتأمين هذا المطلب -باسم «المصالح الوطنية»، وخاصة الأمن القومي-. وهذا يعني نوعاً من «التعبئة الشاملة» (إرنست يونغر، «العامل: السلطة والتشكيل» Ernst Jünger, «Der Arbeiter: Herrschaft und Gestalt»، 1932)، باستخدام الإمكانات الصناعية العسكرية بأكملها، بما في ذلك القوة الإعلامية([15]). وما يعنيه هذا في ظل الظروف الحالية يظهر بوضوح في «استراتيجية الأمن القومي» لعام 2002 المذكورة أعلاه. وباستخدام تعبير شائع حالياً في مناقشات اليوم، يمكن للمرء أيضاً مقارنة هذا النهج بمنطق الحرب «الهجينة»([16]).
كل هذا يكشف الإفراط في ممارسة القوة الدولية تحت ذريعة الأمن القومي. ويغذي هذا انعدام الثقة البنيوي بين الدول، بوصفها جهات فاعلة ذات سيادة، وهو ما تحدثنا عنه من قبل. هكذا تتطور دائرة خطيرة من عدم الثقة والإفراط، والتي أوصلتنا، من بين أمور أخرى، إلى «توازن الرعب» بين القوى النووية في القرن العشرين. وبما أن أحدهما يفترض من حيث المبدأ أن الآخر، إذا جاز التعبير يهدده منذ البداية، -ويسعى في نهاية المطاف إلى القضاء عليه من أجل تجنب التهديد بدوره-، فإن الجميع يحشدون كل قواهم، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى زيادة انعدام الثقة في الأساس، ويتطلب بدوره خطوات جديدة لتعبئة السلطة السياسية، وهكذا إلى ما لا نهاية. إن نموذج هذه الحلقة المفرغة من عدم الثقة هي الفكرة التي طورها كارل شميت Carl Schmitt في «مفهوم السياسي»، والتي بموجبها -على عكس الشخصي- يُنظر في مفهوم السياسي إلى الآخر بشكل أساسي في فئة العدو (العدو السياسي hostis، على النقيض من العدو الخاص inimicus)، يعني ببساطة كتهديد لوجود الفرد. في مفهوم شميت، يقع «العدائي» خارج كل الفئات الأخلاقية. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بمعركة بين وجهات النظر أو الأيديولوجيات العالمية. ولقد رأينا ما قد يعنيه هذا بالتفصيل فيما يسمى بسباق التسلح أثناء الحرب الباردة، حيث كانت الإيديولوجيات مجرد ذريعة.
في العصر النووي، أصبحت دائرة عدم الثقة والإفراط -التعبئة الشاملة- مختلة تماماً؛ بمعنى أنه من الواضح أنه لم يعد من السهل على الجهات الفاعلة أن تفهمه: إن إمكانات التدمير الهائلة، والتي يمكن من خلالها القضاء على الخصم مرات عديدة، وليس فقط مرة واحدة، والكلمة الأساس هنا هي «قدرة التدمير المتعددة» «nuclear overkill» - تعني أن الـمُهاجم يعرّض وجوده للخطر كذلك. وفي مجموعة من «الدمار المؤكد المتبادل mutually assured destruction» -والتي تترجم عادة باللغة الألمانية بشكل مُلَطّف على أنها «توازن الرعب» - يصل منطق القوة إلى حدوده القصوى: إذا كان تراكم وسائل القوة يعني في نهاية المطاف خطر تدمير المرء لنفسه -وإذا كان من الممكن تجنب ذلك فقط إذا تصرف المعارضون بعقلانية، بما يتوافق مع غريزتهم في الحفاظ على الذات؛ فإن الأمر برمته ينتهي إلى نوع من الاستسلام، لعبة حصيلتها صفر. سيكون من المعقول ببساطة أن يتفق الجميع في نفس الوقت على التخلي عن إمكانات الأسلحة النووية.
إن مصير معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT NPT / Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons) يظهر بوضوح أن «منطق القوة»، الذي يقود الدول حتى الآن، يمنع تطبيق هذه المعاهدة، كما يمنع أيضاً استمرار عدم دخول معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية (CTBT / Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) حيز التنفيذ، والتي احتفلت «لجنتها التحضيرية» بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على تأسيسها في فيينا العام الماضي. وفيما يتعلق بهدف نزع السلاح النووي الوارد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا يبدو أن أحداً يرغب في اتخاذ الخطوة الأولى. وكون بعض القوى النووية، التي سيكون تصديقها على المعاهدة ضرورياً لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، لا ترغب بعد في الالتزام بالحظر المفروض على التجارب النووية -وعلى وجه التحديد: الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة- يوضح بأن الأسلحة النووية لا تزال تمثل خياراً استراتيجياً. ويبدو أن انعدام الثقة بين الدول أمر لا يمكن التغلب عليه، كما يبدو أنه لا توجد هناك دولة تمتلك هذه الأسلحة، ترغب في قبول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل كملاذ أخير.
إن مدى ترسيخ هذه الرغبة شبه الأخروية لتأكيد الذات، التي يغذيها عدم الثقة، في التفكير الدولي الحالي، قد ظهر أيضاً، على سبيل المثال، من خلال احتفاظ فرنسا لنفسها، في شكل «إعلان تفسيري» في سياق انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالتأكيد أن أعمال الحرب التي تنطوي على استخدام الأسلحة النووية لا تقع ضمن اختصاص نظام العدالة الجنائية الدولي. قدمت فرنسا هذا «التحفظ النووي» الفعلي -متنكراً في شكل «تفسير»-، على الرغم من أن التحفظات مستبعدة صراحة عند التصديق على النظام الأساسي لمجموعة الدعم الدولية، وفقاً لهذا النظام الأساسي([17]). ويثبت هذا بوضوح التناقضات الجوهرية لسياسات القوة. ويتفق معظمهم على أن الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة التقليدية يمكن أن يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، بوصفها «جرائم دولية». ومع ذلك، ينبغي تطبيق نوع من المحرمات على استخدام تكنولوجيا الدمار الشامل في حد ذاتها. إن وسيلة القوة (الدولية) النهائية التي تعتقد الدولة النووية أنها قادرة على ضمان بقائها من خلال الردع -ولكن يمكنها أيضاً أن تضمن سقوطها-، ينبغي أن تكون، إلى حد ما، خارجة عن القانون ومحايدة في التعامل مع جميع الفئات القانونية والأخلاقية.
إن ما يتجاهله (أو يقمعه) أولئك الذين لا يريدون أن يتم كبح جماحهم عندما يتعلق الأمر بممارسة الخيار النووي -وهذه الدول لا تشمل فرنسا فقط- هو أنه في ضوء «المزيد من الانتشار» لهذا الخيار الذي اتخذ بالفعل وفي المجمل، لم تعد تكنولوجيا التدمير تجلب أي ميزة استراتيجية لوضع هذه الدول كقوى نووية. فبدلاً من الأمن المشكوك فيه dubiosen من خلال «التدمير المؤكد المتبادل mutually assured destruction»، كما سبقت الإشارة، تستطيع القوى النووية الكبرى أن تحصل على ضمانة سلام أرخص كثيراً: بالتخلي معا في نفسه الوقت عن إمكاناتها النووية. وتبدو المعضلة غير قابلة للحل حاليا: طالما أن نزع السلاح (النووي) الشامل لا يمكن تحقيقه من قبل هذه الدول إلا من خلال التدابير القسرية، ويكون تهديدهم غير فعال منذ البداية، لإمكانية التدمير المتاحة لهم، فلا سبيل للخروج من الحلقة المفرغة لسياسة نزع السلاح، ويحكم على مبدأ الأمن الجماعي بالفشل هنا.
يتجلى وهم سياسة القوة، الذي وصفته باستخدام الأسلحة النووية كمثال، أيضاً في حقيقة مفادها أن القدرة على تنفيذ «قدرة التدمير المتعددة» النووية، لا تؤدي إلى المزيد من الأمن للدولة المعنية بهذا التنفيذ؛ لأن هناك خطرا في أي لحظة يتم فيها تفعيل الأسلحة، بسبب خطأ أو سوء فهم (مثل سوء تفسير البيانات)، كما أظهرت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. إنه لظرف مؤسف حقاً بالنسبة إلى البشرية ككل أن تضطر الإنسانية إلى العيش تحت سيف ديموقليس، التدمير الذاتي الجماعي، بسبب تأكيد الذات من قبل عدد صغير نسبياً من الدول، التي تتجاوز كل الحدود. وهنا يصبح منطق القوة حماقة سياسة القوة.
على الرغم من هذا، فإن ما سماه عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر John Mearsheimer («بمأساة سياسات القوى العظمى Tragedy of Great Power Politics, 2014») لا ينبغي له أن يقودنا إلى الانهزامية. لا يمكن أن يكون المصير الذي لا رجعة فيه للجنس البشري هو التضحية بعقل الفرد، -وبالتالي القدرة على التصرف بمسؤولية-، في العمل الجماعي على مذبحة الحفاظ على قوة الدول ذات السيادة والرفع من هذه القوة، والتي تنظر بشكل أساسي إلى بعضها البعض كعدو (كتهديد لوجودها).
إن حالة الفوضى التي تنتج في الأساس عن انعدام الثقة المتبادل بين الدول -وفي كثير من الأحيان بين الشعوب التي تمثلها-، والتي تسببت في حروب لا تعد ولا تحصى على مر التاريخ، لا بد من التغلب عليها من خلال نهج تعاوني، إذا كان يُراد للبشرية أن تبقى على قيد الحياة، ويتجاوز هذا نموذج سياسات القوة الحصرية الموجهة فقط نحو الجماعة الخاصة بالفرد.
إن الواقعية في التعبير عن المصالح الوطنية -في ضمان بقاء المجتمع-، يتطلب تصحيح المثالية لكي يكون هدفها بقاء البشرية. إن التفاعل بين المثالية والواقعية هو وحده الذي يضمن الرخاء للجميع على المدى الطويل، بما في ذلك أقوى الجهات الفاعلة.
إن النظام العالمي لا يمكن أبداً أن يكون في صورة حالة من الفوضى بين الأقوى، ولكن يكون فقط على أساس توازن القوى بين الدول ذات السيادة. ويشكل هذا، مع ما يلزم من تعديل، «النقيض» المثالي الضروري للتمسك «الواقعي» بالوضع الراهن، الذي يكون محكوماً عليه بالفشل في نهاية المطاف، حتى في القرن الحادي والعشرين.
([1]) محاضرة لقراء مجلة «إشكاليات الوقت» «Zeit-fragen»، زيورخ، 30 ديسمبر/كانون الأول 2021. منشورة من طرف المنظمة العالمية للتقدم، 2021
([2]) انظر أيضاً جردي السابق في:
"The Politics of Global Powers", in: The Global Community. Oxford University Press, 2009, S. 173-201
([3]) المقصود هنا ليس طريقة التحليل النفسي الفرويدي، بل التحليل النفسي عامة (إضافة المترجم).
([4]) Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Resolution der UNO-Vollversammlung, 24. Oktober 1970
([5]) في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول 2019، صاغ دونالد ترامب هذا المبدأ، مقترناً بمناشدة إيران، بطريقة تنطبق بالتساوي على جميع الدول، وهو أمر يتطلب، رغم أنه غير معلن، التفاوض على المصالح. المعاملة بالمثل تعني: «يضع القادة الحكماء دائماً مصلحة شعوبهم وبلدهم في المقام الأول».
([6]) National Security Strategy of the United States of America, 17. September 2002, Kapitel IX: "Transform America's National Security Institutions to Meet the Challenges and Opportunities of the Twenty-First Century".
([7]) إضافة المترجم: المقصود مسرحية فاوست Faust لغوته.
([8]) إضافة المترجم: إشارة إلى سفر الأمثال 18:16: «قَبْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِيَاءُ، وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّوحِ».
([9]) إن رد السيدة أولبرايت في مقابلة شبكة إن بي سي مع ماكس لوير Max Lauer المذكورة أعلاه أصبح يضرب به المثل لعمى السلطة، وهو ما يحدث دائماً عندما ترى دولة ما نفسها في موقع القوة المهيمنة بلا منازع: «(...) إذا كان علينا استخدام القوة، فذلك لأننا أمريكا؛ نحن أمة لا غنى عنها. نحن نقف شامخين ونرى أبعد من الدول الأخرى في المستقبل، ونرى الخطر هنا علينا جميعاً» "(...) if we have to use force, it is because we are America; we are the indispensable nation. We stand tall and we see further than other countries into the future, and we see the danger here to all of us.".
Hans Köchler, Demokratie und Neue Weltordnung – Ideologischer Anspruch und macht_politische Realität eines ordnungspolitischen Diskurses. Innsbruck: Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft und Politik, 1992
([11]) Vgl. Chalmers Johnson, Blowback: The Costs and Consequences of American Empire. New York: Metropolitan Books, 2000
([12]) إضافة المترجم: منطقة نمساوية قسمت بعد الحرب بين النمسا وإيطاليا.
([13]) تحدد المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي مهمة الناتو فيما يتعلق بالدفاع الجماعي عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
([14]) للاطلاع على الأحكام المناسبة من ميثاق الأمم المتحدة، راجع هانس كوكلر:
Hans Köchler, Das Abstimmungsverfahren im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Innsbruck: Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft und Politik, 1991
([15]) فيما يتعلق بالجانب التوتاليتاري، انظر أيضاً فريدريش جورج يونغر:
Zum totalitären Aspekt vgl. auch Friedrich-Georg Jüngers, des Bruders, 1939 geschriebenes und 1946 erstmals veröffentlichtes Werk "Die Perfektion der Technik".
Hans Köchler, The New Threat: Hybrid Wars as Tool of Subversion. Rhodes Forum 2015, i-p-o.org/Koechler-New_Threat-Hybrid_Wars-Rhodes%20Forum2015.htm.
([17]) Hans Köchler, Global Justice or Global Revenge? International Criminal Justice at the Cross_roads. Wien/New York 2003, S. 223ff.