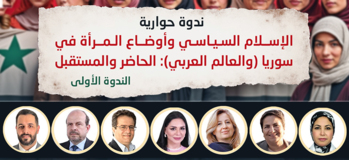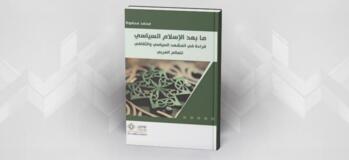المُتخيّل في الإسلام السياسي
فئة : مقالات

المُتخيّل في الإسلام السياسي
يُقصد بالإسلام السياسي أو الإسلاموية l’islamisme تلك الحركات أو الأحزاب التي تخلط بين الدين والسياسة، فهي تتخّذ من الإسلام وتطبيق شرائعه ذريعة من أجل الوصول إلى الحكم أولاً، ثم إقامة نظام ثيوقراطي يشمل كل مؤسسات الدولة السياسيّة والقضائيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمدنيّة ثانياً؛ وذلك بالاستناد على أفكار وقيّم وعادات مُحاطة بهالة القداسة، وإن كانت في حقيقتها لا تتجاوز اجتهادات وثقافات السابقين (القرون الهجريّة الأولى)، ورغم وجود الكثير من المؤلفات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع، إلاّ أنّ الملاحظ اشتراكها في التركيز على التيارات الأصوليّة المعاصرة التي تجسّد هذه الظاهرة تحليلاً ونقداً مع إغفال كبير للجذور التاريخيّة لهذه الأخيرة؛ فالإسلام السياسي ليس وليد العصر كما يتصّور الكثير، بل نضج خلال العصر الأموي ثم نظيره العباسي عن طريق مجموعة من الأساليب لعّل "المُتخيّل" من أبرزها نظراً لأثره البالغ في توجيه العقل الجمعي، وهو موضوع المقال.
لقد اهتم حكام الدولة الأمويّة بأمر القصّاصين إلى درجة تخصيص وظيفة رسميّة "قصّاص" كما جاء عند المقريزي، وتكمن أهميّتهم في قدرتهم على إشغال الناس وملء فراغهم؛ وذلك بنشر الأساطير والخرافات، والسفر بعقولهم إلى عوالم الخيالات والأعاجيب، إضافة إلى ترسيخ عقيدة الجبر تحت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر الرباني، ومن هنا يمكن فهم لماذا تمّ منح الكثير من منابر المساجد لأهل الكتاب المسلمين (نظراً لإلمامهم بأساطير بني إسرائيل وعقائدهم)، والنتيجة تفاقم ظلم وفساد الحكام ومن دون إحراج أو خشية غضب الرعية عليهم، كيف لا وأبواقهم (الآلة الإعلامية خلال تلك الحقبة) يدعمون هذه الحكومات بإشاعة ما يريد الحاكم إشاعته من جهة، وإغراق العامة في قصص الخوارق والكرامات والغيلان والشياطين من جهة أخرى.
من القصص الشهيرة التي ردّدها القصّاصون شفاهة قبل أن تنتقل إلى كتب الأحاديث الصحاح والتاريخ والسرديات الإسلامية، قصة لقاء أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، الرواية باختصار مفادها أنّ هرقل، وهو في فلسطين (رواية تقول في القدس وأخرى في غزّة) تلقّى رسالة من نبيّ الإسلام صلى الله عليه وسلم، فطلب إحضار أحد ما من قومه للتّعريف به، حينها جاءوه بأبي سفيان الذي كان مع صحبته في بلاد الشام تاجراً، وقد دار بينهما حوار؛ إذ طرح هرقل عدة أسئلة تتعلّق بسيرة النبيّ عليه الصلاة والسلام وصفاته وأخلاقه وديانته التي يدعو إليها، وأجوبة أبي سفيان كانت لصالح النبيّ والإسلام، رغم عدم اعتناقه للإسلام بعد، لتنتهي القصة بقول الإمبراطور البيزنطي عن النبيّ: "ولو أرجو أن أخلص إليه، لتجشمت لُقِيَّه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه". ولهذا نجد في بعض كتب التراث أنّ هرقل أسلم.
إنّ المصدر الوحيد لهذه القصة هو أبا سفيان (الراوي)، ورغم العنعنة الطويلة فليس من الصواب التشكيك في أحد الناقلين لها والزعم باختلاقها ونسبها زوراً له نظراً لتأكّد من اختصوا في علم الحديث من وجود اتصال في سلسلة الناقلين، وبراءة هؤلاء من تهم الكذب والتدليس والنسيان، وبالتالي لا ريب كون أبا سفيان هو صاحب القصة والإشكال الآن حول حقيقتها بين تاريخ والمُتخيّل.
هذا اللقاء والحوار المزعوم بين أبي سفيان وهرقل لا ذكر له إطلاقاً في الوثائق البيزنطية، رغم أنّ ديوان الإمبراطور كان يسجّل كل تحركات هذا الأخير وضيوفه والرسائل التي تصل إليه، ومثال ذلك فإنّ الرسالة التي بعثها له نبيّ الإسلام عليه الصلاة والسلام عن طريق دحية الكلبي عثر عليها علماء الآثار، مثلما عثروا أيضاً على رسائله إلى المقوقس حاكم مصر، وخسرو ملك الفرس، والمنذر ملك البحرين، والغساني ملك الحيرة، وللجلندي حاكم عمان، ولهوذة حاكم اليمامة، ولوائل بن حجر في حضرموت، ولقبيلة همدان اليمنية، وأخرى لمسيلمة الكذاب...وهذا باعتراف عدد من المستشرقين من أشهرهم إدوارد جيبون، إضافة إلى أنّ هرقل لم يكن في منطقة فلسطين خلال فترة صلح الحديبيّة (كتب التراث الإسلامي حددت تاريخ هذا اللقاء بين أبي سفيان وهرقل بين اتفاقية صلح الحديبية وفتح مكة)، إذن لا وجود دليل مادي على هذا اللقاء، بل هرقل نفسه لم يكن في فلسطين خلال هذه الفترة.
عداء هرقل للفرس كان شديداً وقد تمكّن من هزيمة جيشهم عسكريّاً وتحييد نفوذ الإمبراطورية الفارسيّة في المنطقة، كما كانت حربه ضد المسلمين أيضاً شرسة، ورغم الخسائر التي تلقتها جيوشه، إلا أنّه استطاع صد تقدم المسلمين عسكرياً في آسيا الصغرى وفي شمال إفريقيا (مدينة قرطاجة التي كان يعّدها العاصمة الثانية بعد القسطنطينية)، فهل من المنطق أن يكون هذا الرجل المحارب للمسلمين محبًّا للنبيّ وللإسلام؟
على الرغم من أنّ هرقل لم يكن بالرجل المتديّن الملتزم، بل معروف بالفجور والطغيان وعدم احترام الشرائع الدينيّة، إلاّ أنّه مهتم جداً باللاهوت المسيحي إلى درجة التشدّد، والدليل اعتناقه لعقيدة مسيحيّة أرمينيّة مُلخصها أنّ المسيح ذو طبيعتين (الكلمة/الجسد)، ولكن إرادته واحدة بعد الاتحاد، فهذه العقيدة ظهرت كتفسير وردّ على إشكالية العلاقة بين الكلمة والجسد، وتسمى المونوثيليزم (لفظ يوناني معناه الرغبة الواحدة)، وقد أصدر مرسوماً إمبراطورياً (إكثيسيس) لتعميم هذه العقيدة في سائر البلاد ومستعمراتها، وافقت عليه كنيسة القسطنطينية. أما كنيسة روما، فوافقت في البداية قبل احتجاج بعض قساوستها واعتباره هرطقة، كما حاول هرقل إجبار الكنيسة القبطيّة على قبوله، وإن كان لا يمكن تجاهل هدفه السياسي من وراء هذا القرار الديني (توحيد كل شعوب الإمبراطورية البيزنطيّة تحت راية مقدسّة واحدة)، إلاّ أنّ اهتمامه وترجيحه ونصرته لمذهب مرفوض من مجمع خلقيدونيا الكنسي لدليل على تشبّعه بالعقيدة اللاهوتيّة المسيحيّة، فهل من المنطق أن يمدح مسيحيّ متعصّب النبيّ والإسلام وفي تعاليم كنيسته أنّ الإسلام هرطقة وخطر على المسيحيّة؟ بل هو نفسه كان يصف الإسلام بالمولود المشؤوم.
الحوار المسيحي الإسلامي المبكر له أبجدياته، إلاّ أنّها غائبة بالمطلق في هذا الحوار المزعوم، فواضح جدًّا أنّ مؤلف القصة صاغ الأسئلة بعقل عربي إسلامي (النسب والقبيلة والأمانة ...) وليس بعقلية بيزنطيّة مسيحيّة.
يذكر صاحب الرواية (أبو سفيان) أنّه كان في الشام بصحبة رجال من قريش، وقد حضروا معه مجلس هرقل، ولكنّه لم يذكر ولا واحد منهم بالاسم؛ فمن الغريب أن لا يدعم هذا الحدث المهّم في حياته بشهود عيان، كما وجب التنويه أنّه لم يقّص قصته إلاّ بعد فتح مكة وإعلان إسلامه، والسؤال لماذا كل هذا التأخر، إضافة أنّه حكاها فقط لعبد الله ابن العباس دون سواه، رغم صغر سنّ هذا الأخير (إحدى عشر سنة)، فهل فعل هذا بسبب علاقة القرابة بين ابن العباس والنبيّ عليه الصلاة والسلام؟ أم أراد استغلال صغر سن ابن العباس وعدم خبرته في هذه الأمور لتمرير حكايته؟ أو الاستفادة من كلا الأمرين؟
مما سبق، يتضّح لماذا يصعب تصديق حدوث هذا اللقاء واقعيًّا، والراجح أنّه من تخيّيل أبو سفيان، فبعد انتصار المسلمين وميل كفة ميزان القوى لهم دينيًّا وعسكريًّا وسياسيًّا، وخسارة سادة قريش وعلى رأسهم بني أميّة لنفوذهم، لم يعّد اعتناق هؤلاء الإسلام كطلقاء كافياً لتعويض خسارتهم والمحافظة على مكانتهم السياسية والاجتماعية، ولعّل هذا ما يفسّر لجوء سيد بني أميّة (أبو سفيان) إلى تأليف سرديّة من خيالاته يظهر من خلالها أنّه قبل إسلامه، ورغم كفره فقد كان مدافعاً وناصراً للإسلام والنبيّ محمد حتى بين يدي أقوى إمبراطور.
من علامات المتخيّل في الفكر الديني التمدّد وكثرة التفرع والانشطار، ولهذا ظهرت روايات أخرى على سبيل التآزر والتناسق مع رواية أبي سفيان، وعلى سبيل المثال قصة لقاء دحية الكلبي حامل رسالة النبيّ عليه الصلاة والسلام مع هرقل، وهو حدث تاريخي حقيقي بشهادات أركيولوجية؛ إذ نُسِب إلى دحية أنّ هرقل قال: "والله إني لأعلم أنّ صاحبك بنيّ ومرسل، وأنّه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا ولكنّي أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته"، بل تزيد مساحة المتخيّل إلى درجة وجود رواية منسوبة أيضاً لدحية مُلخصها أنّ هرقل على نحو سريّ أطلعه على صور الأنبياء، من بينها صورة النبيّ محمد وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر.
هذه القصة ورغم استبعاد صحتها تاريخيًّا، إلاّ أنّها ساهمت بشكل فعّال في تأسيس ذهنية وثقافة إسلامية تجاه هرقل بصفة خاصة، وبيزنطة بصفة عامة، فرغم الحروب المتكرّرة بينهما، بقي الاحترام وحبّ التعايش السلمي بينهما قائماً عبر التاريخ، ولعّل تحوّل المتخيّل إلى اليقين والعقيدة في العقل المسلم هو السبب الرئيس (الاعتقاد الجازم أنّ هرقل اعترف بالرسول والإسلام، وموقف الرسول المترتّب عن هذا الاعتراف حسب بعض الأحاديث)، كما أنّ حكام الدولة الأمويّة استغلوا هذه القصة لمنح الشرعيّة التاريخيّة والدينيّة لسلطتهم أمام منافسيهم الهاشميّين، ولهذا اشتغلوا على نشرها والترويج لها على نطاق واسع بين الناس (إلى درجة أنّ حكام الدولة العباسيّة فيما بعد لم يستطيعوا الحجر عليها).
حركات الإسلام السياسي المعاصرة تبني الكثير من تصّوراتها حول كيفية إقامة الدولة الدينيّة، وتطبيق العدالة الاجتماعيّة، وتحقيق التمكين للمسلمين، وكيفية التعامل مع الآخر المختلف دينيًّا أو مذهبيًّا على المتخيّل المخطوط في كتب الموروث الديني. ولهذا وقعوا في أزمة عدم إمكانية إحياء الماضي، وعدم إمكانية التصالح مع الحاضر ومستجداته، والنتيجة العيش في عالم الخيال والسعي إلى تجسيده بالعنف في حالة التمكين والانفلات الأمني. أما زعماء هذه الحركات وقادتها، فغالباً ما تحيط بهم مجموعة من القصص الخرافية كبرهان على تأييدهم إلهيا، وهي أيضاً من المتخيّلات لا أكثر، ومثال ذلك تلك القصص الخارقة لقوانين الطبيعة التي رافقت الخميني أثناء ثورته على شاه إيران وبعد توليه الحكم، وتلك الهالة من القداسة والبركة التي رافقت زعيم الجبهة الإسلامية عباسي مدني في الجزائر أواخر الثمانينيات إلى درجة ظهور كتابات دينية على الغيوم في السماء. أما ما حدث في اعتصام رابعة بمصر من كرامات حسب زعم الإخوان، فليس عنا ببعيد.