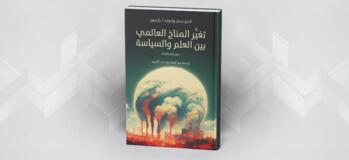المسائل الكبرى في القرآن فضل الرحمن
فئة : قراءات في كتب
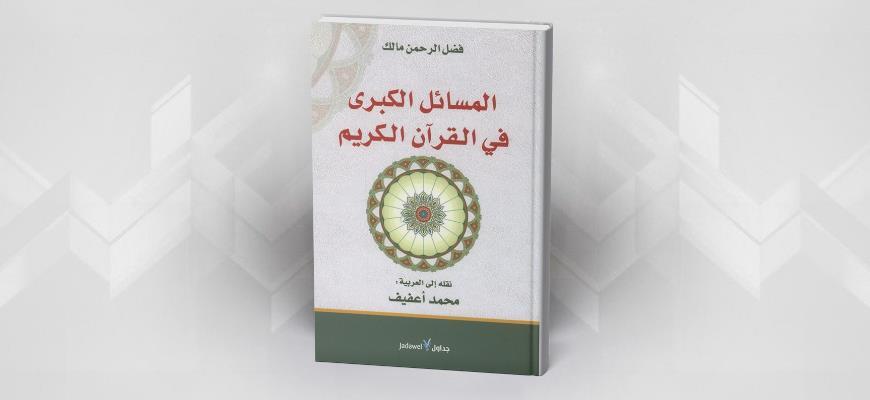
المسائل الكبرى في القرآن
فضل الرحمن
كتاب المسائل الكبرى في القرآن، فضل الرحمن، تعريب محمد أعفيف، دار جداول بيروت، ط.1، 2013م.
أهمية الكتاب
يرى فضل الرحمن، بأن القرآن الكريم حظي بكتابات كثيرة من لدن كبار الفقهاء والمفسرين، ومن بين تلك الكتابات المتون التي اعتنت بمختلف علوم القرآن التي تم اعتمادها في تفسير القرآن، وقد كان منهج المفسرين في فهم القرآن وتفسيره ينبني على التجزئة، حيث يفسرون الآيات واحدة تلو الأخرى، وهو ما جعلهم يسقطون في فخ انتزاع الآيات والألفاظ من سياقاتها النصية والزمانية. وبهذه الطريقة، فوتوا على أنفسهم وعلى من سار على نهجهم فرصة الإحاطة بالنظرة الكلية التي يكتنزها القرآن للإنسان وللعالم، وهذه المشكلة شكلت جزءًا أساسيًّا من تاريخ الفكر الإسلامي في علاقته بفهم القرآن.
يؤكد فضل الرحمن، أن العرض التركيبي في قراءة موضوعات القرآن وسوره وآياته، هو الأسلوب الأمثل لتمكين القارئ من التذوق الحقيقي لموضوعات القرآن وفهم مختلف الأوامر الإلهية الموجهة إلى الانسان.[1] فمعظم الدراسات المعاصرة التي اعتنت بالترتيب الكرونولوجي لآيات القرآن وسوره، والتي قام بها غربيون، على رأسهم، ثيودور نولدكه (-1930م) كرست بشكل مباشر أو غير مباشر الفهم التجزيئي لآيات القرآن، فالترتيب الكرنولوجي كما يدعي المستشرقون، أمر مستبعد. وبالتالي، فهو قضية تشغل الباحثين والمختصين عن الهدف الحقيقي، وهو فهم رسالة القرآن وفق نظرة تركيبية وكلية لمختلف مواضيعه.
هذا هو الهدف الذي ألف من أجله فضل الرحمن هذا الكتاب "المسائل الكبرى في القرآن"، حيث تناول فيه أهم المواضيع المحورية والأساسية في الخطاب القرآني. ولا شك أن هذه المواضيع الكلية تنطوي تحتها جملة من العناوين والقضايا التي لا يمكن فهمها إلا من خلال تلك المواضيع الكلية، وهذا يعني أن فضل الرحمن يؤسس لمنهج في فهم القرآن يأخذ بالكلي قبل الجزئي. ولا شك أن مختلف المواضيع التي درسها في هذا الكتاب لا يعني أنها غطت كل المواضيع الكلية في القرآن، بقدر ما هي من أبرز المواضيع الكلية، والتي انتظمت في فهرست الكتاب كالتالي: الفصل الأول: الله، الفصل الثاني: الإنسان فردا، الفصل الثالث: الإنسان والمجتمع، الفصل الرابع: الطبيعة، الفصل الخامس: النبوة والوحي، الفصل السادس: الإيمان بالأخرة، الفصل السابع: الشيطان والشر، الفصل الثامن: ظهور أمة الإسلام.
الدراسات القرآنية في الغرب
يمكن ترتيب الأدبيات الغربية المبكرة الخاصة بالقرآن الكريم "ضمن ثلاثة أصناف كبرى:
1- أعمال تسعى إلى تتبع تأثير الأفكار اليهودية والمسيحية في القرآن.
2- أعمال تحاول إعادة الترتيب الكرونولوجي للقرآن.
3- أعمال تهدف إلى وصف محتوى القرآن، إما ككل وإما بعض من جوانبه.
وعلى الرغم من أن الصنف الأخير من الأعمال يستحق الاهتمام، إلا أنه الأقل من الناحية الكمية. ربما يرى الباحثون الغربيون أن المسؤولية تقع على المسلمين أنفسهم؛ إذ عليهم تقديم القرآن كما يجب على النحو الذي قدم به القرآن ذاته".[2] لكن مع الأسف، ليس هناك القدر الكافي من الكتب الجادة والدراسات العلمية في الوطن العربي والإسلامي التي تعنى بموضوع تقديم القرآن كما يجب على النحو الذي قدم به القرآن ذاته؛ "وربما أن هذا يعود لعدم وجود شعور حقيقي عند الباحثين والدارسين المسلمين بملاءمة القرآن للعصر الراهن"[3]، الأمر الذي يحيل بينهم وبين تقديمه على النحو الذي يلائم احتياجات الإنسان المعاصر، وحتى إن وجد هذا الشعور سيعترضه سؤال المنهج في فهم القرآن تبعا لمقتضيات العصر؛ فضلا على اختزال القرآن وفهمه تبعا للآراء التقليدية التي قال بها المتقدمون، وهي آراء في غاية الأهمية في ما هو أعم؛ وينبغي أن يبنى عليها قصد تجاوزها إلى غيرها.
الله
الانطباع الذي يخرج به أيّ قارئ للقرآن الكريم، لأول وهلة هو اكتشاف عظمة الله وسلطانه الذي لا حدود له، ورحمته الواسعة التي شملت كل شيء. مع الأسف بعض من الدارسين الغربيين يختزلون صورة الله في القرآن بكونه جبروت فقط، وهذه صورة في الحقيقية ترتبط بتصورات مزاجية غريبة الاطوار.[4] لا ينبغي أن تشغلنا عن معرفة صورة الله الكلية في القرآن. تستند الرؤية القرآنية في مجملها على مبدأ التوحيد، فالتوحيد هو الإجابة الكونية الفطرية السوية للبعد الروحي للإنسان في فهم ذاته مبتدأ ومآلا، وهو سقف المنطق الإنساني في فهم أبعاد الحياة، والوجود وما وراء الحياة والوجود.[5] فكلمة "الله" الواحد الأحد تعد المركز المحوري والمفتاحي داخل الحقل الدلالي للقرآن الكريم، فهي أسمى كلمة صميميّة في المعجم اللغويّ للقرآن، لكونها مهيمنةً على الميدان كلّه. وهذا المظهر الدّلاليّ يعني أنّ عالَم القرآن مرتكزٌ أساساً على الله، وهذا ما صدم العرب زمن النزول وأثر فيهم[6]، لكونهم أدركوا معنى غير مألوف لديهم، رغم أنهم كانوا يعرفون هذه الكلمة؛ فالمعنى الذي أدركه العرب لأول مرة ومن تلاهم هو معنى التوحيد، فالله الواحد الأحد في القرآن ليس هو الإله المتعالي فحسب، "بل هو الموجود الوحيد الذي يستحق أن يسمى موجودا بكل ما في الكلمة من معنى، والذي لا يمكن لأي شيء في العالم كله أن يضادّه... إن الله يقوم في مركز عالم الوجود بالذات. وكل الأشياء الأخرى، الإنسانية وغير الإنسانية مخلوقات له"[7] سبحانه. قال تعالى: "سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)" (الحديد).
يرى فضل الرحمن أن "(نسيان الله)، يدمر الشخصية، سواء على الصعيد الفردي أم الصعيد الجماعي؛ لأن (تذكر الله) هو الذي بإمكانه وحده لُحمة الشخصية"[8] فنسيان الله في حد ذاته نسيان للنفس قوله تعالى: "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19)" (الحشر).
الإنسان والمجتمع
ليس هناك شك بأن هدف القرآن هو بناء مجتمع، قائم على قيم العدل والمساوات والأخلاق الفاضلة. فحسب القرآن ما اجتمع شخصان أو أكثر إلا وكان الله حاضرا معهم، وفاعلا مباشرا في العلاقة القائمة بينهم، حيث يشكل بعدا ثالثا، لا يمكن للمجتمعين نكرانه إلا إذا تعمدوا تحمل عاقبة نكرانهم[9] قال تعالى: "مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)" (المجادلة).
مراعاة الله جل وعلا في مختلف ما يقبل عليه الإنسان في مجالات الحياة أمر ضروري، وهذا الحضور الإلهي مقترن بالقيم والأخلاق التي يجب على الإنسان مراعاتها في علاقته بأخيه الإنسان وبمختلف الكائنات. ولهذا، فالآيات التي تحث على الإنفاق أو المعاملة بالحسنى أو التشريعات الزوجية، أو في البيع والشراء، أو في العلاقة ما بين الأبناء والوالدين... فهي تؤكد على البعد الأخلاقي بالدرجة الأولى أكثر من البعد التشريعي ذاته. فالقراءة الكلية لمختلف المواضيع التي تعنى بالإنسان والمجتمع في القرآن ينبغي التركيز فيها على فهم القيمة الأخلاقية التي أسس لها القرآن، ويريد لها أن تنمو وتتسع، وهي قيمة أخلاقية قد تتجدد وتظهر بأشكال مختلفة باختلاف المجتمعات والأزمنة. فينبغي أن نميز من داخل القرآن بين ما هو تاريخي ومتصل بمحيطه التاريخي، وبين ما هو ممتد في الزمان والمكان.
الطبيعة
الطبيعة في القرآن آية من آيات الله، فهي تعدّ باتساعها وانتظامها الغامض بمثابة آية إلهية للإنسان؛ لأن لا أحد بمقدوره خلقها[10]، ولسنا هنا في حاجة للتأكيد على أن القرآن الكريم غني بتصوراته من خلال مختلف الآيات والسور التي تتحدث عن مختلف الظواهر في الطبيعة، وحديث القرآن هذا لا يعني بأنه حديث علمي دقيق يعنى بمختلف الأجزاء؛ لأن القرآن ليس كتاب علوم، فهو كتاب هداية بالدرجة أولى، فحديثه عن الطبيعة أي عالم الشهادة، حديث متصل بعالم الغيب، وهو عالم يلف عالم الطبيعة من كل جانب. وبشكل أدق فحديث القرآن عن الطبيعة وظواهرها حديث متصل بمنظومة القيم والأخلاق في القرآن. فليس هناك فصل بين كتاب القرآن وكتاب الطبيعة، فالتصور الأخلاقي يلفت نظرنا لطبيعة التكامل الحاصل بين الطبيعة والغيب، فالقرآن يقدم نفسه ككتاب يتكامل فيه عالم الطبيعة بعالم الاخلاق كما هو في القرآن، وبالتالي فالقرآن يدعونا الى الفهم المركب لقضايا الانسان والطبيعة والأخلاق. فينبغي أن لا نغفل طبيعة التوازي ما بين الوحي/القرآن، والكون، فالهدف الأسمى من خلق الإنسان في هذا الوجود أن يفعل الخير ويصلح في الأرض بدل الفساد فيها.
[1] فضل الرحمن مالك؛ المسائل الكبرى في القرآن؛ ترجمة؛ محمد أعفيف؛ جداول؛ بيروت؛ لبنان؛ ط. 1؛ 2013م، ص. 8
[2] نفسه، ص. 10
[3] نفسه؛ ص. 10 (بتصرف)
[4] نفسه، 22
[5] أبو سليمان عبد الحميد، الرؤية الكونية الحضارية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار السلام للطباعة والنشر، ط.1، سنة 2009م.، ص. 115
[6] إزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرآن، ترجمة محمد الجهاد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط.1، سنة 2007م ص.31- 32 (بتصرف).
[7] نفسه، ص. 127
[8] المسائل الكبرى في القرآن، م. س. ص. 72
[9] نفسه، ص.90
[10] نفسه، ص. 150