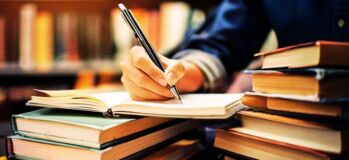المعرفة الدّينيّة في سبيل إنسيّة كونيّة
فئة : مقالات

المعرفة الدّينيّة في سبيل إنسيّة كونيّة
الشكّ بذْرة إنسانيّة أولى وعنْها شبّت ونمت شجرةُ المعرفة، لذا كان الشكّ ومازال فعل كينونة يتحقّق عبره الإنسان وجوديا في هذه الحياة، وتعالقات هذا التحقِّق مع الآخر المُختَلِف: (أنثى، ذكر، مخالف في الدّين، الملّة، الطائفة، القبيلة، العشيرة، مخالف في اللّون، العرق، الجغرافيا، مخالف في الإيديولوجيا، في الحزب السّياسيّ، مخالف في اختياراته القرائيّة، مخالف لك في ما تأكل وتشرب...) فيُخْرِجُهُ من دائرة الفرديّة المُقصية للشّريك الحضاري، ليدفعه ناحية الدخول في دائرة الكونيّة الرّحبة الّتي تعجّ بكلّ ألوان الطّيْف، ليكون بذلك كائنا مُفَارِقا.
في البدء وتحت وطأةِ السّؤال والسّعي إلى فكّ مغالق هذا الكون الفسيح، كان الشكّ تجاه الطبيعة مولّدا لاكتشافات عُظْمَى، أوجد الإنسان من خلالها النّار ودجّن الحيوان، وتتبّع حركة الأجرام والنّجوم ليعرف الاتجاهات في البرّ والبحر؛ شكّ "كوبرنيك" وشكّ "غاليلي" وشكّ "اينشتاين"... ويُخبرنا النصّ القرآني عن تقلّب وجه "إبراهيم" في السّماء، عن هيامه في الأرض ومُناجاته الشّمس والقمر والنّجوم السّابحات في الفضاء، في حِواريّة بديعة تصل بين الدنيوي والسّماوي، تربط بين الإنساني والمتعالي مُلْغية بذلك الحدود الّتي وضعها حرّاس السّماء. جاء في سورة "الأنعام": "فلمّا جنّ عليه اللّيل رأى كوكبا قال هذا ربّي فلمّا أفل قال لا أحبّ الآفلين فلمّا رأى القمر بازغا قال هذا ربّي فلمّا أفل قال لئن لم يهدني ربّي لأكوننّ من القوم الضّالين فلمّا رأى الشمس بازغة قال هذا ربّي هذا أكبر فلمّا أفلت قال يا قوم إنّي بريئ ممّا تُشركون"[1]. فشكّ "إبراهيم" تولّد عن ذات قلقة ولا ريْبَ، جاء مُنْسَجِمًا مع طبيعة الكائن البشريّ الّذي مُيّز بالعقل/الفكر=la raison، وقد كان اِنْبِلاَجًا لِرُوحٍ وفيّةٍ لإنسيّتها.
وعليه الشكّ بما هو مساءلة عقلانيّة منطقيّة لكل الحوادث والموجودات والأفكار، فِعْلٌ صَمِيمٌ منْثورٌ في كلّ الثقافات والحضارات، يَبِينُ ويَخْبُو عبر العصور لكنّه لا يَنْعَدِمُ البتّة.
لكنْ هل بإمكان العربيّ المسلم اليوم أن ينْظر إلى السّماء لِيُسَائِل لا ليسأل بمعنى يطلب؟ أيَقْدِرُ على مبارحة "دائرة الدّعاء" التّسليميّ التّواكليّ، ليدخل في "دائرة التداعي" فيغْرف من لُبّ الوجود عبر ذاته الجوْهر الفرْد لا ذات الفقيه والإمام؟
في مرحلة أولى، سعى الإنسان إلى تحطّيم العوائق الّتي فرضتها عليه الطّبِيعة والوجود، وفكّ مغالقه عبر تفْكيكه وفهم ديناميته، ممّا أهّله للسّيْطرة عليه وتطويعه لبناء حضارة الإنسان. في مرحلة أخرى، لم يكتف هذا الكائن الطموح ببناء معارف ويقينيات تُحطّم جهله بالوجود المُتَمَوْضع ضِمْنه، بلْ أسّس لعمليّة تَحْطِيمٍ ثانيةٍ أراد من خلالها هدم تلك اليقينيات التي شبّت ونمت واشتدّ عُودها لتصبح صنما فكريّا يستبدّ بالعقل البشري ويؤبّده في منطقة معرفيّة مرسومة المعالم سلفا من الصعب تجاوزها لاستئناف عمليّة البناء.
في عمليّة التحطيم الأولى كانت غايته التعرّف على الكون وامتلاك زمامه وتطويعه لفائدته. في عمليّة التحطيم الثانية كانت غايته هدم ذلك الصرح من المعارف التي باتت تَحْجبُ عنْه حقيقة الوجود من ناحية، وتجْعَله رهِين تلْك اليَقينيّات من ناحية أخرى، لجهة الانزياح عنها والبدء من جديد.
بناء على وعيه بذلك، خطا الإنسان خُطوات هائلة ناحية التحرّر، عبر بناء معارف أكثر ديناميّة ومواكبة لتطوّر وعيه بالعالم وبنفسه؛ ذلك أنّ ارتهان العقل البشريّ لمعارف أنتجها في زمان ومكان وفي سياقات ثقافيّة وفكريّة واجتماعيّة معيّنة، وفي مرحلة من مراحل تكوّن وعيه، يمكن أنْ نصفها بالجنينيّة، هو ضرب من الضمور الفكريّ والتقوقع المُودي إلى انحسار إمكانات تحقّق الوجود الإنساني، لناحية كونه تحقّق متواصل غير منقطع، يُبنى على أخطاء ونقائص الماضي.
المعرفة في أبسطِ دلالاتها بحث دؤوب في مجاهل الوجود لتجاوز العقبات التي يفرضها على الكائن البشري. والمعرفة الدّينيّة جزء من المعرفة الكُليّة الّتي يسْعى الإنسان مُنذ أنْ ألقي في هذا الكوْن إلى الإحاطة بها، لِمَا لهَا منْ علاقة وطِيدة بسؤال المصير الّذي ظلّ يقضّ مضجعه. هو سعيٌ محموم لفهم المُتعالي وتقريب المسافة بين السّماوي والدّنيويّ، لتيْسير عملية الفهْم والتّأْوِيل. ولهذا وعلى مدى التّاريخ، كان الإنْسان مُنتجَا للرّموزِ الدّينية الّتي تخْتَزِلُ صُورةَ المُتَعَالِي فِي ذِهِنِه.
فالدّين، كلّ دين غايته الإنسان لا المتعالي لجهة كونه هو مشكلة الوجود لا الإله، الإنسان جوْهره وغايته، بما يجعله الصّورة المُثْلى عن المتعالي، لذا ستكون المعرفة الدّينيّة المُنتَجة معرفة غايتها الإنسان ضرورة، لا معرفة استلابيّة تؤسّس لتسلّط السّائِس ولتسلّط "رجال الدّين". بأشكال أخرى سنكون إزاء معرفة غايتها الإنسان=السعادة /savoir=plaisir، لا إزاء معرفة غايتها السّلطةSavoir=pouvoir بحدّيْها الدّنيويّ المحْسُوس والمُتَعَالي الْمُجرّد.
ولئِنْ راجعَ الغرب الحقائق واليقينيات الدّينيّة التي قرّت في الأذهان وتحكّمت في الإنسان لقرون عدّة، ممّا جعل محاكم التّفتيش سِمة لتلك العصور المظلمة، خاصّة مع بروز عصر النّهضة وتبلْور فلسفة الأنوار المبنيّة على قيم الحريّة والتّسامح والعدل... ليَقْطَع نهائيّا مع الفهم الدّيني للعالم، وليَجعل العقل بوصفه "الأعدل قسمة بيْن النّاس" منْطلقا للمعرفة والسّبيل الأوحد لفهم الوجود. وما انفكّ الغرب يُجَدّد نفسه ويُجَدّد دِعامات معارفه، في تكْرِيس لمنطق قِوامه أنّ المعرفة فعل تطوّري، يُبنى على التراكم غَيْر مُنْتَهٍ، حتّى صَاغَ معارف جديدة أكْثر انسجاما ومواءمة لإنسان التّحديث والعصْرنة، بيْد أنّ الواقع العربيّ الإسلاميّ مغايُرٌ تماما لِمَا أعْلَنّا عنْه أعْلاه، فإذا ما نبشنا في مُدوّناته ومُنتجاته الفكريّة، سنجد أنّه ما بارحَ يقينيّات الماضي، بل باتَ يَبْحث عن طرائق لشرعنتها وإيجاد سُبلٍ لإسقاطها على راهن أهمّ ما يميّزه التبدّل والتغيّر.
فـ "محمّد الطاهر ابن عاشور" [1879. 1973] صاحب القراءة المقاصديّة للنصّ القرآنيّ، قد خصّص كتابه "أليس الصّبح بقريب" للحديث عن التعليم والمسلكيّات المُتّبعة من قبل الأمم القديمة والحديثة، والأعجميّة والعربيّة في تدريس أبنائها والعلوم المستنبطة، والّتي كانت مدار اهتمام الجماعات البشريّة المختلفة". وممّا أشار إليه، مسألة التصاق العلم والتعليم بالكهنة والأحبار والفقهاء والمتديّنين عموما، فهو لا يكاد يخرج عن هذا الإطار. وعليْه، نجد أنّ المعرفة والعلم وعمليّة التعليم برمّتها تخرج من بين أيدي الإكليروس الدّيني، وفق ما أقرّه "محمد الطاهر ابن عاشور".
وهنا يتبَادَرُ إلى الذّهن سؤال جوْهريّ: ما نوْع الْمعْرفة الّتي يُنتِجُها الْفقيه؟
وهل ينْطلق الفقيه في قراءاته لتأسيس رُؤى جديدة أم تأصيلا لرؤى قديمة؟
بالتمعّن أكثر وفيما يهمّنا وأقصد هنا الحضارة العربيّة الإسلاميّة، سنجد أنّ هذه المعرفة لا تخرج عن مسلكين اثنين وفق رؤية "ابن عاشور" الشّيخ الزّيتونيّ:
مسلك أوّل: الاهتمام بدراسة النّحو لِمَا دخل من خطل على لغة العرب نتيجة لاختلاف ألسن الأمم الدّاخلة في الإسلام من فرس وعجم... فما كان من العرب المسلمين إلاّ إيجاد سُبل لصون اللّسان العربيّ المبين اّلذي نزل به النص القرآني، وكان "لأبي الأسود الدؤلي" و"علي بن أبي طالب" فضل الابتداء في هذا النهج، بأن قيّدوا أحكام اللغة العربيّة التي كانت تجرى بين ساكنة الجزيرة العربيّة على السليقة.
مسلك ثان: ما يسمّيه "ابن عاشور" بـ "علم الإسلام"[2]، والمقصود به العلوم التي كانت حول القرآن ذلك النصّ الملهم والمعجز. في تلك المرحلة من التاريخ الإسلامي وقع الانتقال من الثقافة الشفاهية والحفظ في الذّاكرة إلى الثّقافة الكتابيّة والتدوين والحفظ في الكتب. بداية دُوِّن القرآن عبر عمليّة واسعة امتدّت من خلافة "أبي بكر الصدّيق" حتّى خلافة "عثمان بن عفّان" الّذي أقرّ المصحف العثماني على صيغته الحاليّة المتداولة في أيّامنا متلفا ما عداه من النسخ. ويذكر "ابن عاشور" بأنّ الجماعة المسلمة اشتغلت بتفسير القرآن ودوّنت الحديث وبرز "مالك بن أنس" صاحب "الموطّأ"، أو ما يعرف بالسنّة النبويّة، وأوجدوا علم الرجال والتّراجم والجرح والتعديل، والفقه وأصول الفقه مع الشافعي (204هـ)، وعلوم البلاغة والتّاريخ والأخبار، والعلوم الرياضيّة والفلسفيّة. ومع قيام الدّولة العبّاسيّة حدثت طفرة في العلم والتعلّم، ووقع الاهتمام بترجمة آثار الأمم الأخرى؛ كتب الطبّ اليوناني وعلم الفلك. ومع "المأمون" عرفت العلوم ذروتها عبر حركة الترجمة وإنشاء "بيت الحكمة" في "بغداد". وبرز "أبو نصر الفارابي" (تـ339هـ) و"ابن سينا" (تـ428هـ) الملقّب "بالشيخ الرئيس".
ما يُمْكِن أنْ نَخْلُصَ إليه أنّ "ابن عاشور" وإنْ كان قدْ طوّر من رؤيته لفهم النصّ الدّينيّ لكنّ الأغلال الّتي أنتجتها الثّقافة العالِمَة الّتي يمثّلها شيوخ الزّيتونة آنذاك، يرفدها في ذلك حماس المؤمنين المانع لكلّ نهوض، ظلّت تُكبّل رؤيته لِلَبِنَة جوهريّة من لبنات تطوّر الأمم ألا وهي التّعليم، فقد جعله لصيقا بالفقيه أوّلا ومنعه عن نصف المجتمع ألا وهي المرأة متعلّلا بعدم حاجتها إليه[3].
على الرغم من ذلك، نجد أنّ التّاريخ الإسلاميّ زاخر بمفكّرين وفلاسفة كانت المعرفة ديدنهم وغاية سؤلهم، لكن لمَ اِنْقطَعَ الحبْل السرّيّ بين مسلم اليوم، مسلم عصر العوْلمة والتكنولوجيا الرّهيبة، ومسلم عصر "المأمون"؟ لمَ كان مسلم ذلك العصر وفيًّا لمبدإ البحث والسؤال والشكّ، بينما يعجز مسلم اليوم رغم التطوّر الحاصل عن بناء نسق فكريّ يُعْلِي من شأنه ويجعله شريكا فاعلا في البناء الحضاريّ؟ هل لذّت له الإقامة في شرْنقته الأولى والانكفاء على نفسه دون البحث عمّا به يُحقّق كيْنونته المُثلَى؟
إنّها لمفارقة-استعادة لحظات الجمود الفكريّ وترك اللّحظة الرّشديّة (ابن رشد) على سبيل المثال وجعلها قبسًا من نور يهتدي به إلى معالم الطّريق- خلقت انقسامات اجتماعية مهّدت إلى خلقِ مُشكلات عدّة؛ فمن كُره الشّريك في الوطنِ والشريكِ في المِلّة إلى كُرهِ الآخر المُختلف في كلِّ شيء، حتّى بات منطق الكراهيّة هو المنطق المتحكّم في حياة الإنسان. منطق مثّل بذرة لتنامي التناحر الدّيني والمذهبي، وأزف بدول ومجتمعات بأسرها، هذه اليقينيات باتت قيودا كبّلت العقل وجعلته مرتهنا إلى الأجداث فيتْرك الأخذ بالأسباب ويُقلّب وجهه في السّماء عجْزًا ورُعْبًا.
وغيْر بعيد وفي زمن الوباء، كلّ العيون توجّهت وتتوجّه نحو المخابر العلميّة الغربيّة التّي بناها العقل العلميّ لا الدّينيّ، علّها تنتج في القريب العاجل مصْلاً يُنْهي أشهرا من الخوْف والتّرقب والعزلة، ويدْفع عن البشريّة شَبَحَ الفناء. ففي أزمة "كورونا" وعندما عصفت موجة جديدة مهدّدة لحياة الإنسان في كلّ أصقاع العالم، ما جعل الحكومات تُغْلِقُ دُور العبادة (مساجد، كنائس، معابد، مراقد...)، أَبَى "العقل الغيْبي" الانصياع إلى هذه الإجراءات الوقائيّة للحدّ من انتشار المرض في ظلّ غياب أدوية ناجعة. فرأيْنا النّاس يفرّون ممّا يحسبونه قضاء الله، إلى أوليائه وأصفيائه؛ فهذا يحتمي بالمراقد الشيعيّة طالبا الفرج، وأولئك يصرّون على أداء صلاة الجماعة "فبيوت الله طاهرة مطهّرة"، وآخرون يهرعون ليْلا إلى الطّريق العامّ لينظّموا حلقة دعاء جماعيّة ترفع عنهم البلاء.
كلّ هذه الطّقوس الّتي حرصت الجماعة على تأديتها في الفضاء العموميّ تعود إلى ضرب من التمثّل اللاعقلاني للدّيني، الّذي كرّسته- وللأسف- الحكومات عبر تشجيعها لخطابٍ دينيّ يغيّب "العقل النّاقد" ويستحضر نماذج كالحة من "الجهل المقدّس" كبديل يخوّل السّيطرة على الجموع لتحقيق مصالح آنيّة، وغاب عنْها أنّ الاسْتِثْمار في الجهْل وعلى حدّ عِبَارة "عبْد الرّحمان بن خَلْدُون" "مُنْذِرٌ بخراب العمران" إنْ عاجلا أوْ آجِلاً.
تَحْفَظُ لنا كُتب التّاريخ حوادث ألمّت بالمجتمع الإسْلاميّ الأوّل؛ ففي زمن الطّاعون الجارف أمر الرّسول بالتزام البيْت وأداء الصّلوات فرادى لا جماعات لمنع انتشار العدوى بيْن النّاس، باعتبار أنّ حفظ النّفس مقدّم على حفظ الدّين. ونظرا لما تُمثّله شخصيّة النبيّ الاعتباريّة في نفوس الجماعة المسلمة، لم تُعص أوامره ووقع التقيّد بِها. لكنّ "الملاك الدّيني" الّذي يتوق إلى الاسْتحواذ على السّلطة الرّوحية للجماعة المسلمة يأْبَى الانْصياع لهذا المبدأ العقْلانيّ مدّعيا الطهْرانيّة والمثاليّة. فالإشْكال هنا ليْس مناقشة حُجّية الصلاة أو الصّيام أو غيرها من الفرائض، فذلك راجع لقناعة الفرد أوّلا وأخيرا انسجاما مع قوله تعالى "لا إكراه في الدّين"[4]، الإشكال بأيّ حقّ يشرّعون للنّاس ما ينفعهم وما يضرّهم؟ هل أُوتُوا معارف تجعلهم يتكلّمون باسم السّماء أوّلا وباسم الأطبّاء ثانيّا؟
بأشكال أخرى ماذا قدّمت المُؤسّسات الدّينيّة الرّسميّة وغير الرسميّة للاجتماع البشريّ وللظّاهرة الدّينيّة؟ وأيّ مشْرُوعيّة لِوصَاية الشّيوخ والدّعاة على ضمير الإنسان عبر مِطلّات لاهوتيّة مُتعالية؟
من نافل القول إنّه ليس هناك من باب يدخل عبره الإكْليروس الدّيني إلاّ باب المعنى وتأويليّة النصّ الدّيني، ليعمل في مرحلة لاحقة على تحويل تلك القراءات التأويليّة، تشريعات تُهنْدِس الاجتماع البشري وتضْبِط تصرّفات النّاس ومعاملاتهم، وترْسم تطلّعاتهم ورؤاهم إزاء أمور معاشهم ومعادهم. وعليه، نحن في حاجة اليوم وأكثر من ذي قبل إلى "تحرير المعنى من الكاهن" وفق تعبير نيتشه[5]، لكن كاقتضاء لواقع الحال استعاد الناطقون باسم السّماء أو ما يسمّيه "أركون" بـ"الملاك الدّينيّ والمدنيّ" الأدوار الكلاسيكيّة له عبر تبرير السُّلُطات القائمة شرعيّا محافظة على تلك الثنائيّة السّلطويّة القديمة أو ما يُصطلح عليه بـتعبير "ميشال فوكو" "السّلطة الرعويّة" القائمة على ثنائيّة الرّاعي والرّعيّة بدل الحاكم والمواطن، من ناحية. وفي نفس السياق التبريري، احتمت الدّولة أو السلطة في مرّة أولى بالخطاب الفقهِي المؤسّساتِي والخطاب الّذي يمثّله بعض الشّيوخ/الوعّاظ المقرّبِين من بلاطات الحكم من خطر حركات الانبعاث الدّيني المتطرفة التي ترى في الدّولة مارقة ولا تحكم بما أنْزل الله، واستدعته مرّة ثانية لِتُوهِن الْخطابات العَلمانيّة التي تردّدها الجهات المعارضة للسياسات المُتّبعة، من ناحية أخرى[6].
فهل قدّم المشتغل بالنصّ الدّيني إمكانات قرائيّة قادرة على انتشال الفرد -بصفته كائنا دينيّا- من بوتقة القراءات الفقهيّة الحسِيرة؟ وهل من سبِيل لِإيجاد إمكانات قرائيّة تأويليّة، إمكانات مَعْرفِيّة تعِليميّة لِتَقْوِيضِ هذه البُنَى الفقهيّة المتكلّسة تدْرِيجِيًّا؟
لا يخْلُو تاريخ الأفكار عامّة والمدوّنة العربيّة الإسلاميّة خاصّة من علامات مضيئة بالإمكان الاهتداء بِها كما ذكرنا سابقا، فانْطِلاقا من القراءات العقلانيّة الّتي أنجزها ثلّة من المفكّرين العرب[7] يُمْكِنُ أن نبْنِيَ إمكانيّة للتّغْيير، رَغْم اِنْحسار تأثير هذه الرؤى والأفكار في الواقع، ذلك أنّها مشاريعٌ فرديّة في مُجْمَلِهَا، لم تَجِدْ الدَّعْمَ المَادّي والمؤسّساتِي اللاّزم من قِبل الدّول لِتسُودَ وتُعوِّضَ الأفكار البالية الْمبثوثة فِي الأذْهَان، بيْد أنّها فتّحت الأبواب المغلّقة بإحكام وكان لها فضْلُ البحْث فِي الطّابو الدّينيّ.
وعلى اعْتِبار أنّ عمَلِيّة تشْكِيل الوعْي الجَمْعي منْ جَدِيد عَمليّة فِي غاية الصُّعوبة، وزحْزحة تلْك الأفْكار الصّنميّة القارّة في ذِهْنيّة العامّة منْ الجُذور رِهان عظِيمٌ ينْبغِي أنْ تُشْحذ لَهُ هِمم كلّ الفئات الاجتماعيّة ومؤسّسات الدّولة، وبالتّالي على المجْتمعات العربِيّة الإسْلامِيّة أنْ تسْتعيد كلّ ما أنْتجه اللاّهُوت الإسْلامِي عبْر تارِيخه لِتسائله وتفْحصه، عليْها أنْ تُراجع لِتُؤسّس، وتتخَلَّى لِتجدّد. ذلك أنّ الإنْسان كائِن مُتّسق الهُويّات، لا يُمْكِن حصْره فِي جانِب هُويّاتِي بعيْنه. فكان لِزاما على الدَّوْلة المدنيّة الحَدِيثة التخلِّي عنْ دوْر حِراسة الإيمان والنّظر إِلى الإنْسان المُؤْمِن أو غيْر المُؤْمن بما هو مُواطِن له حُقوق وعلَيْه وَاجِبات يُنظِّمُها القانون. فالرّبط بيْن الهُويّة الدّينيّة وما يُمْكن أنْ نُسمّيه بالهُويّة "المُواطنيّة" بِحيْث لا تقُوم الواحدة إلاّ بالأخْرى، هو ربْط لا معْنى له فِي السّياقات القانُونِيّة والفِكْريّة والاجْتِماعيّة للرّاهن، نظرا لتنافره مع مقْتضيات العصْر، ولما ترتّب عنْه منْ نتائج كارِثيّة فِي الواقع. فالهُويّة الدّينيّة هِي هُويّة قاصِرة ومُنْغلقة على ذاتِها، تَفْرِز وتصنِّف النّاس على أساس الإيمان وتقسّمهم إلى مؤْمن وكافر، وتسْحب الفرْد منْ الدّائِرة الإنْسانيّة الكُبْرى لِتحْشُره في دوائِر هُوياتِيّة ضيّقة، تخْتزِل حُضوره فِي بُعْد واحِد منْ أبْعاد الوُجُود هُو الدِّين والمِلّة والطّائِفة والجماعة. وهُنا يُمْكن الحديث عنْ إنْسِيّة كَوْنيّة تقُوم على العقْلانِيّة، كبدِيل عمليّ بالإمْكان تحْقِيقه إذا ما توفَّرت دعائِم ذلك.
أمّا دور المُؤسّسات وخاصّة المؤسّسة التعليميّة فهو دور وظيفيّ ومحْورِيّ فِي تنْشِئة شخصيّة الفرْد وتكوين نشْء جَدِيدٍ فِي حِلٍّ من إكْراهات السّابِقِين، فالتّعْليم القائِم عَلَى ترْبِية النّاشِئة عَلَى رُوح النّقْد واِسْتِشْكال البدِيهِيّات أوّلا، وعلى دراسة الظّاهرة الدّينيّة عبْر "علم الأديان المقارن" الّذي يُتِيحُ لهم تكْوين صورة واضحة المعالم، منْفَتِحة على تعدّد التجارب الإيمانيّة، لا تَنْظُر إلى الآخر المختلف كعدوٍّ وجب الفتْكُ بِهِ، بل كشَرِيك حضاريّ رغم خصوصيّته. ثانيًا، وهو جوْهر الإصْلاح الدِّينِي المنْشُود[8] في رأيي. فالطّالب العربيّ فِي مُختلف المنظومات التعليميّة يتلقّى تعليمه الابتدائيّ والإعداديّ والثّانويّ والجامعيّ دون أن يكون لهُ اطّلاعٌ البتّة على الكتب المقدّسة للدّيانات التوحيديّة؛ اليهوديّة والمسيحيّة، فما بالك بالبوذيّة والهندوسيّة... وفِي غَمْرة جَهْلِه بهذا يُقوْلِبُه مُجْتمع الإيمان [العائلة، الشّيخ، الكتاتيب، شبكات التّواصل الاجتماعي الّتي أتاحت لكلّ من يعانِي من هوْسٍ دينيّ بثّ آرائِه...] كيفما شاء وأراد. ولا نَعْجَبُ حينها منْ رَفْضِهِ القاطعِ المبنيّ على الانفعالات السيكولوجيّة لا قناعات عقلانيّة منطقيّة، لمحاولات التنّوير والتحديث وتطوير المجتمع.
ويَحْضُرُنِي هنا مثال من الواقع التّونسيّ الرّاهن، فرغم محاولات جِيل من المتنوّرين _وأذكُر منهم رائد تحرير المرأة الزّيتونيّ "الطّاهر الحدّاد" الّذي خطّ كتاب "امرأتنا فِي الشّريعة والمجتمع" ليُمثّل فيما بعد بذْرة أولى لصياغة مجلّة الأحوال الشخصيّة الّتي أقرّها "الحبيب بورقيبة" في 13 أوت/أغسطس 1956، مجلّة اِنتشلت المرأة التّونسيّة من ربِقةِ الظّلم والهوان والأميّة وأخْرجتها من ظُلمات أقْبِيَةِ الحرِيم إلى نور التعلِيم والمعْرِفة_ النّهوض بالمجتمع عبْر سنّ القوانِين الكفيلة بذلك إلاّ أنّ المرْأة ظلّت تحِنٌ فِي لاوعيها إلى عصور الحريم والتعدّد والنّقص، وها أنّ بعضهنّ يتزوّجن بعقود عُرْفِيّة مُلْغِيَةً بِذَلكَ كلّ حُقُوقها الّتي ضمنتها القوانِين.
فأيْن الإشْكال؟
لئِن مثّلت القوانِين الثوّرِيّة دفْعًا إيجابيًّا لواقع المرأة، لكنّها لمْ تُسْتَنْبت فِي الأذهان لتعوّض بذلك ما قرّ فِيها من أفكار تنْسُل من ثقافة الحرِيم، ثقافة ظلّت ثاويةً فِي الزّوايا المعتمة، وكلّما وجدت فرْصة أطلّت برأسها معْلِنة أصالتها بل وحُجِّيتِها فِي صُلب مجتمع الإيمان. هذا النُّكُوصُ على الأعقاب ليْس مُفَاجِئا، فما قامت به الدّولة الوطنيّة من نشْرٍ للتّعْلِيم ودعم الثّقافة في البدايات لمْ يُسْتَكْملْ على أكْمَلِ وجْهٍ بلْ تعرّض لعمليّة بتْرٍ ومحْوٍ فيما بعد.
وعليْه، فإيجاد الحُلول لأنْظِمة التّعْليم المُتأزّمة داخل الدُّول العَربِيّة الإسْلامِيّة سيُمكّن منْ استِنْبات مَقُولات العصْر مثْل الحُريّة والمُساواة وحُريّة الضّمِير وحُرّيّة المعْتقد في تُرْبة خِصْبة، تُساعِد عَلى تخلُّق أجْيَال منْفتِحة تنْتمِي لِحضَارة الإنْسان لا حضارة الإيمان وأُطَرِها الضّيّقة. وقدْ أكّد "العفيف الأخضر" في كتابه "إصْلاح الإسْلام بدِراسته وتدْرِيسه بِعلوم الأدْيان" أَهمّية التعْلِيم، باعتباره لَبِنَة جوْهريّة للاِنْتقال منْ "الإيمان الأعْمى إلى الإيمان كرِهان[9]". فالتنْظِير إِلى الإِيمان كرِهان معْرِفِيّ يُؤسّس لجدلِيّة بيْن المُعْطى الدِّيني والإنْسان، جَدَلِيّة قَائِمة عَلى التّفاعل الإيجابِي تؤُول بمقْتضاها الظّاهِرة الدّينِيّة ضرْبا منْ ضُرُوب العلاَقة العقْلانِيّة بالحياة والكوْن. قبْل أنْ يكون إيمانا تعبّدِيا طُقُوسِيّا تسْلِيميّا، ينْبع منْ خوْف داخليّ يسْتبْطِنه الإنْسان تُجاه هذه القُوّة الماورائِيّة. مِمّا أسَّس لخلْق نماذِج إيمانيّة وقوالب دِينيّة صلْبة، قرّت في الضّمِير الجمْعِي للمُجْتمع الإِسْلاميّ، غَايتُها اتّقاء غضب هذه القُوّة المُحْتَجِبة ونيْل الخلاص الدّنْيوِي المُفْضِي بِدوْرِه إلى الخلاص الأُخْرَوي المنْشُود، لا خلْق احْتمالات جَدِيدة للْفهم والتّأْويل تُؤصِّل لِرحْمانِيّة تنْتَفِي بمُوجِبها الصّورة النّرْجَسيّة للِدّيني المبنِيّة عَلى مُسلَّمَات منْ قبِيل "نحْن خيْر أُمّة أُخْرِجت لِنّاس" وحديث "الفِرْقة النّاجِية" الّتِي فتَكت بِالإنْسان. وبِمُوجِبها أُلْغِيت كُلّ إِمْكانات العيْش المُشْترك دَاخِل المُجْتمعات الإِيمانِيّة مُتعدّدة الإثْنِيّات والطوائِف، لتنتشر الكراهِية والقتْل العبَثِي[10]. لذلك وجَبَ القطْع معَ منْطق الوِصَاية علَى "الدِّين القوِيم" الّذي جعَل فهْم وقِرَاءة النصّ الدّيني حِكْرا علَى الفُقهَاء منْ أنْصَار المدْرَسة التفْسِيرِية الكلاسِيكِية.
إنّ عمليّة العقْلنة أوْ التثْوير المطْلوب القِيام بِها يجِب أنْ تطَال كُلّ أنْساق التّفْكير الدّينِي الّتي نسَجَتْها الجَمَاعة الدّينِيّة عبْر تَارِيخها قصْدَ بِناء أنْساق تفْكِير أخْرى لا ترْتهن إِلى إيدْيولوجِيات نصّية وقِراءات تأْوِيلِية جَاهِزة تأْبَى اسْتنباط معانِيَ أخرى للنصّ المقدّس موائمة للْعصْرِ ولتطوّر المجتمعات. هذِه الإيدْيولُوجِيات المُتَعَالِية عنْ الوَاقِع ظلّت تحْتَكِم إلى أهْواء أصْحابها منْ فُقهاء وشُيوخ تارة، وأهْواء الحُكّام تارة أخْرى، أوْ مراعاة لِمشاعر مُجْتمعات الإِيمان المُنْغَلِقة عَلَى نفْسِها طوْرًا آخر.[11]
[1]الأنعام، 77. 78
[2] محمد الطّاهر بن عاشور، أليس الصّبح بقريب، دار السّلام للطّباعة والنّشر، ص 24
[3] في فصل عنونه بـ "تعليم المرأة" وقد خصّه بثلاث صفحات لا أكثر، أشار إلى أنّ الأمم لم تكن تعط كبير اهتمام لتعليم المرأة، وكانت العرب تعدّ تعليم المرأة ترفا لا حاجة إليه، وبمجيئ الإسلام صارت المرأة إضافة إلى تعلم تدبير شؤون بيتها وبعلها تحفظ القرآن وتحضر حلقات تعليميّة في المساجد. وممّا يلفت الانتباه قول "ابن عاشور" بأنّ "اقتصار المرأة على تدبير المنزل وتربية الأبناء كان من تلقاء نفسها متعلّلا بأنّ ذلك يُرهق قواها" نافيًا مسؤوليّة الفقيه عن عطالتها المعرفيّة، مقتنعا بلا جدوى تعليمها. المرجع السابق، ص 52
[4] سورة البقرة، الآية 256
[5] "إنّ الكاهن لم يعد يتّخذ هيئة لاهوتيّة واضحة، بل صار يسكن كلّ المُثل العليا التي عرفها البشر من الأخلاق إلى الفنّ ومن الفلسفة إلى العلم. إنّ الكاهن قد تسلّل إلى مخبأ "الحاجة إلى المعنى" التي تؤرق الحيوان البشري: أن تكون لحياته المعذّبة معنى. وطالما يفلح الكاهن في توفير المعنى، فهو سيستمرّ في تسميم الحياة وتحويلها إلى تهمة" فردريك نيتشه، جينيالوجيا الأخلاق، ترجمة فتحي المسكيني، نشر معهد تونس للترجمة، تونس. ص 16
[6] محمد أركون، نافذة على الإسلام، ترجمة صيّاح الجهيّم، دار عطيّة للنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1996.ص ص 107.106
[7]محمّد أركون، عبد المجيد الشّرفيّ، محمّد طه عبد الرّحمان، نصر حامد أبو زيد....
[8] للتّوسّع أنْظُرْ فِي ذلك: العفيف الأخضر، إصلاح الإسلام بدراسته وتدريسه بعلوم الأديان. منشورات الجمل.
[9] العفيف الأخضر، إصلاح الإسلام بدراسته وتدريسه بعلوم الأديان. منشورات الجمل، ص 19
[10] طالت جملة من التفجيرات العديد من الكنائس في مصر، فمن تفجير كنيسة القدّيسين بالإسكندريّة في أبريل 2011، إلى تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا شمال القاهرة في 29 أبريل 2017، خلّف 25 قتيلا و59 مصابا. إضافة إلى هجمات استهدفت المسيحيين شمال سيناء. انظر الرابط التالي: https://www.aljazeera.net%2Fencyclopedia%2Fevents%2F2017%
و قد وقع كذلك هجوم مسلّح على مسجد للصوفيّة في 24 نوفمبر 2017 بمنطقة سيناء، خلّف 305 قتيلا...انظر الرابط التالي: https:// www.hafryat.com%2Fblog%3U5_kNfspuRYEse
واكتفت مؤسّسة الأزهر بإصدار بيانات شجب وإدانة للهجمات الدموية، مؤكّدة براءة الإسلام من ذلك، دون البحث في سُبل تجاوزه عبر تفكيك المرجعيّات التي شرّعت لهذا الهذيان الدّيني القاتل.
[11] تضمّنت بعض الدساتير الحديثة بنودا تنصّ على تجريم نقد الأديان: مثل قانون ازدراء الأديان في مصر الذي سجن بموجبه إسلام بحيري في 2017. في قضيّة رفعها ضدّه المحامي "محمد عسران"، اتهمه فيها "بازدراء الأديان وإنكار وجود الحور العين، وإنكار أحكام الشريعة، ووصف الصلاة بأنها أداء حركي فقط، وطعنه في السنة النبوية وصحيح الإسلام." مستندا في دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160. 161 من قانون العقوبات. أنظر الرابط التالي: https://www.youm7.com%2Fstory%2.
وينصّ الدستور المصري في فصله الثاني: "الحقوق المدنيّة والسياسيّة"، في المادة 44 على "حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة". ممّا يجعل عمليّة نزع القداسة عن هذه الشخصيّات الدّينيّة لجهة دراستها كشخصيّات تاريخية في سياق البحث العلمي الأكاديمي، تعدِّ يرقى إلى مستوى الجرم الذي يعاقب عليه القانون. وهذا يؤسّس لدولة ثيوقراطيّة لا مدنيّة.
أمّا الدستور التونسي الذي تمتّ صياغته في 2014 فقد نصّ الفصل الأول من الباب الأوّل "المبادئ العامة" على أنّ: "تونس دولة حرّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها". أنظر الدستور التونسي على الرابط التالي: https:// www.google.tn%2Furl%3Fsa%3Dt%26
ويستبطن التنصيص عن دين بعينه للدّولة إقصاء للأديان والإثنيّات الأخرى (المسيحيّة واليهوديّة)، من ناحية. إضافة إلى ذلك، فتديين الدّولة فاقد لمشرُوعيته إذا ما اعتبرنا أنّ الدّولة ظاهرة طبيعيّة جاءت استجابة لحاجة المجتمع إلى تنظيم العيش في جوانبه الاجتماعيّة والاقتصاديّة عبر مؤسّسات تحكمها قوانين وضعيّة مدنيّة، كما ويتعارض مع الفصل الثاني من نفس الباب المذكور الذي ينصّ على أنّ "تونس دولة مدنيّة، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلويّة القانون"، من ناحية ثانية.