المنهج النقدي بين ترويض النص العربي وتغريبه
فئة : مقالات
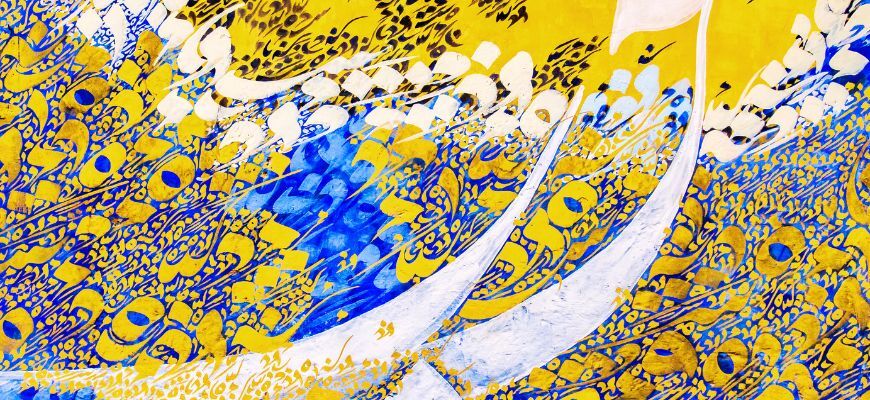
المنهج النقدي بين ترويض النص العربي وتغريبه[1]
من الملاحظ أن الساحة النقدية العربية باتت مسرحا لمختلف النظريات الوافدة، وهذا ما تفرضه طبيعة الاحتكاك الثقافي في ظل العولمة والانفتاح وضرورة الاطلاع على فكر الآخر وفلسفاته، إلا أن الأمر لم يبق محصورا في زاوية الاطلاع فحسب، بل تعداها إلى محاولة تقمص الفكر النقدي الغربي، من خلال استيراد مختلف نظرياته ومناهجه وتطبيقها على النص العربي، حيث إنه "ابتداء من العصر الحديث تراجعت فكرة المذهبية في الأدب والنقد وحلت محلها فكرة المنهجية"[2]، ما جعل القارئ الجاد يقف موقف الحائر المرتبك، وهو يرى النص العربي يرتدي أقنعة لا تمت إليه بصلة، بينما يرى في الناحية الأخرى أن المنهج الغربي استطاع في الكثير من الأحيان أن يكشف الأقنعة عن العديد من النصوص ويستنطقها، حيث تعدى الأمر باستخدام المنهج إلى النص القرآني، فأصبحنا نجد العديد من الدراسات وخاصة الأسلوبية منها تعنى بهذا النوع من النصوص، هذا التجاذب الفكري الذي أصبح يلقي بالنص تارة في تيار التراث النقدي العربي وتارة أخرى يجتذبه تيار المناهج النقدية الحديثة، ما أجبر الباحث على طرح العديد من الأسئلة:
- ما هو السبب المباشر أو غير المباشر الذي يجعلنا نلهث وراء كل جديد آت من الغرب، ونتبنى مناهج ونسقطها ولو بالقوة على النص الأدبي وكأنه قدرها المحتوم؟
- ما مبرر هذا العجز والقصور في خلق منهج نقدي يتماشى وطبيعة النص الأدبي العربي وخصوصياته، خاصة وأننا نمتلك رصيدا فكريا وفلسفيا ولو في شكله البدائي؟
- هل الأزمة أزمة منهج أم فكر؟
- وهل استطاع المنهج الغربي فعلا أن يستنطق النص العربي؟
- وهل نجح النقاد العرب في خلق منهج بديل؟
يعد المنهج في أبسط تعاريفه طريقة علمية عملية نتمكن خلالها من فهم النص وشرحه وتحليله، كما أنه "أسلوب في التفكير وخطوات منظمة تهدف إلى حل مشكلة ما ومعالجة أمر من الأمور، وهو برنامج عمل في البحث العلمي وفي نقل النظري إلى التطبيق".[3] فلم نعجز عن خلق منهج نتكئ عليه في قراءة النص؟، وهل سبب ضعف مناهجنا وعدم تطورها يعود إلى النص أم الفكر؟ ألا يستحق النص العربي مفكرين ينطلقون من خلاله ويبتكرون لأجله مفاتيح تليق به، ومناهج تستنطقه، دون أن نترك ندوب الفلسفات الغربية تشوهه، ولا أن نلبسه أقنعة لا تليق بجذوره ولا بأبجدياته؟
تعد إشكالية اختيار المنهج وفقا للنص المراد قراءته واحدة من أهم المعضلات التي تؤرق الناقد العربي، كما أنها "من المسائل الجوهرية التي تأتي في صدارة الطرح النقدي المعاصر، باعتبارها مسألة شائكة مرهونة بما حققه العصر من إنجازات نقدية واسعة"[4] فبعد أن كانت الأزمة تتجسد في إمكانية تطبيق المنهج على النص أزمة تتعلق بخصوصية اللغة، وكانت دوافع ومحركات هذه الأزمة تتجاذبها تيارات فكرية متزمتة من أولئك الذين يخافون على تشظي النص وتشتت متنه بين ثنيات المنهج وتزمته، كما يخافون على التراث النقدي العربي من الاختفاء التدرجي لظلاله التي بات يلقي بها على استحياء في الساحة النقدية خاصة بعدما غزاها دعاة القطيعة بين التراث والحداثة، بين ما قدمه قدامة والقرطاجني والجرجاني وغيرهم، وبين ما أتى به دوسوسير ودريدا وبارث. فقد باتت الساحة النقدية العربية في أغلبها منقسمة إلى طائفتين "واحدة تعتمد المناهج الغربية الحديثة بكل ما لها من حمولة حضارية فكرية وأيديولوجية تجعل منه خطابا نقديا معربا أكثر منه عربيا...وأخرى توظف مناهج عربية أصيلة تمتد جذورها لتضرب في عمق التاريخ الأدبي"[5]. أصبحت الأزمة أزمة اختيار، فالنص الشعري والروائي والقصصي وحتى القرآني لكل خصوصياته وطبيعته التي تفرض عليه اتباع نمط منهجي معين، لا يخل ببنائه الدلالي "إن طرح مشكل المنهج قد اتخذ في الدراسات الأدبية والإنسانية المعاصرة أشكالا عديدة يمكن القول عنها بأنها تختلف باختلاف الهموم والمشاغل أو بحسب المنطلقات والمقاصد".[6]
مشكلة التعامل مع المنهج الغربي
لا أحد ينكر أن المنهج وليد الثقافة، وأن الثقافة وليدة الحضارة، وأن كل حضارة تختلف عن أخرى، ما يجعلها تختلف عنها فكريا، هذا ما يفسر ذاك الاصطدام الذي نشهده، ونحن نحاول أن نقرأ نصوصا عربية بمناهج غربية، إنها أشبه بمن يحاول فتح باب بمفتاح ليس له، وهذا ما يفسر الأغلاط الكثيرة والندوب العديدة التي يخلفها المنهج على النص. فالنظرة المجردة إلى المنهج هي نظرة قاصرة و"لقد شاع أن المنهج مجرد وسيلة للبحث عن المعرفة، وفحصها؛ أي مجرد خطة مضبوطة بمقاييس وقواعد وطرائق تساعد على الوصول إلى الحقيقة، وهي في نظرنا لا تمثل إلا جانبا واحدا من المنهج، أقترح تسميته بالجانب المرئي.... ولكن هناك جانب آخر غير مرئي باعتبار المنهج أولا وقبل كل شيء وعيا ينطلق من مفاهيم ومقولات وأحاسيس ذاتية"[7]. إن عالمية الثقافات وتناسلها وتكاملها لا تعني أبدا أن نغرس نصا عربيا في تربة أجنبية، ولا أن نقرأ حرفا عربيا بمنهج غربي، بل علينا أن ننطلق من المنهج ونحاول أن نأخذ منه تلك الأجزاء المشتركة، والتي لا تشوه النص إذا ما اتصلت به.
وما قد يسيء للنص العربي، ويجعله أشبه بنص بارد باهت بعد أن يخضع للمنهج تعسفا، هو تلك الخلفية المعرفية الغربية التي يلقي بثقلها المنهج على كاهل النص العربي الذي يملك هو الآخر مرجعيات ثقافية مغايرة، ما قد يؤدي بالناقد إلى الإخفاق في خلق قاسم مشترك ولو أصغر بين نص عربي ينطلق من هوية عربية معينة ومنهج غربي، حيث إن المنهج لا يأتي عبثا، وإنما هو وليد الثقافة فهو يأخذ منها جيناته الأولى وتفاصيله وكلما يتعلق به، ومن غير الممكن أن نفصل بين منهج وبيئته، أو أن نأتي بمنهج ونغرسه في تربة غير تربته وبيئة غير بيئته، هذا الإخفاق من قبل الناقد يتحمل وزره النص فيفقد جماليته وحيويته، ويضطر إلى لبس لباس فضفاض لا يظهر مفاتنه، ويكسر في الكثير من الأحيان مجاديفه، فلا يتمكن من استعراضها. فحتى وإن نظرنا إلى المنهج بصورة تجريدية وحاولنا استئصاله من جذوره، فإنه لا يمكن مطلقا أن نتناسى تلك المورثاث والكروموزومات التي يخفيها المنهج في داخله ولا ينفك ينفثها في جسد النص ونحن نقرأه، إن "كل مصطلح أو منهج إلا ويحمل في أحشائه، حتما خلفية فكرية. تختصر نفسها، ورؤيتها، وتحليلها، من خلال المصطلح النقدي".[8]
كما وأن التدفق المتسارع الذي توالى على الساحة النقدية في فترة وجيزة الواحد تلو الآخر، حرم النقاد فرصة هضم المنهج كما ينبغي، فما يكاد يأتي منهج وتعكف عليه الدراسة حتى يأتي آخر. إن سرعة التوافد هي التي حالت دون فهم المنهج كما ينبغي وبالتالي نقده، فالنقد في المنهج النقدي العربي رهين بالوقت، قد يطرح السؤال نفسه هنا: هل من مستفيد وراء ركود حركة النقد في العالم العربي؟ ومن المتسبب فيها؟ وهل حضارة الاستهلاك التي نعيشها على المستوى المادي امتدت لتصل إلى المستوى الفكري فبات العقل العربي خاملا لا يجيد إلا فلسفة الاستهلاك والانبهار بكل ما هو آت من الغرب، حيث إن أزمة "المنهجية في النقد العربي تتجاوز حدود الهم الأكاديمي الضيق إلى مجمل الحياة العربية بصفة عامة"[9]. كما أن حالة التلقي المتأخر للمناهج الذي تشهده الساحة النقدية العربية هو الذي عكر هذه الساحة وجعل المتلقي العربي/ الناقد العربي في حيرة من أمره، وبالتالي أدخله في دوامة التذبذب.
هذا وتعد أزمة المصطلح أول عقبة تقف في وجه النقد العربي، وذلك لعدم وجود اتفاق بين المترجمين والنقاد، خاصة وأن أزمة المصطلح تتعلق تعلقا وثيقا بالترجمة "التي يغلب عليها الغموض والتراكيب الغريبة، ويعز التقاطها على القارئ المختص".[10]
ولا يمكن لأحد الفصل بين النكسة الحضارية والنكسة الأدبية الفكرية فالحياة الثقافية والسياسية حياة متلازمة متداخلة والأدب يزدهر ويتطور بتطور الحياة السياسية وانفتاحها وينتكس بانحطاطها وهذا ما شهده نقدنا الأدبي، إذ عانى في الفترة الأخيرة من الركود وبات نقدا مقلدا ومعتمدا في كثير من الأحيان على التراث، مما جعله نقدا مكررا، كما أنه لم يسلم من عنصر التقليد بعد أن فتحت نافدة الانفتاح وصار الاحتكاك بالفلسفات الوافدة من الغرب متاحا، بل ظل التقليد هو الممارسة الإجرائية الوحيدة التي تبناها معظم النقاد العرب، فعمدوا إلى استهلاك المنجز النقدي الغربي دونما تعديل أو حتى مراعاة لمدة صلاحيته، وطبيعة مواده وخصوصيتها، خاصة مع تأخر أعمال الترجمة وتداخل المناهج. فما إن يقتنع العقل النقدي الغربي بعدم جدوى منهج ويسعون إلى نقده وإيجاد البديل عنه حتى نعكف نحن على تطبيق المنهج البائد والأخذ به.
كثيرة هي المرات التي نصادف فيها ونحن نطلع على منجزنا النقدي ذاك التعسف الإجرائي الذي يحيط بالنص من كل حدب وصوب، ويكبل مواطن الجمال فيه ولا يبرحه إلا وهو يتخبط في جداول ومربعات ومخططات، ويقطع جميع جوانبه، وكأنما يقحمه داخل المنهج إقحاما، فهو بذلك يقيس النص بمقياس المنهج، ولا يهمه إن كان هذا المنهج يقطع أوصال النص أو حتى يلبس النص منهجا فضفاضا يخفي مواطن الجمال والإبهار به.
إن عدم القدرة على اختيار المنهج المناسب للنص المناسب هي من أهم المشكلات التي تواجه الناقد العربي، فإذا كانت الغاية من نقد النص هو القبض على الدلالة وتفجيرها والظفر بالمعنى، فلم نأتي إلى نص شعري أو سردي واضح جلي ونحاول أن نغلقه بمفاتيح المنهج بينما نأتي إلى نص مغلق ونقرأه بسطحية تحيد به عن المعنى وتبهمه.
لا يمكن عقد صفقة بين المنهج والنص إلا بالإضرار بأحدهما
في عملية التوحد التي يواجهها النص أثناء فنائه بالمنهج، يحدث أن يؤثر أحدهما على الآخر، ويحدث أيضا أن يتجاوب أحدهما مع الآخر ويقدم لأجله التنازلات، إذ إنه "من المنطقي أن استمداد مناهج من مجتمع ونقلها إلى مجتمع آخر، لا يبقي على هذه المناهج كما هي، وإنما هو بالضرورة يعمل على تعديلها وتحريرها بما يتناسب مع وضعه الخاص"[11]. فلا يمكن أن نجد قراءة ناجحة حتى نعلم أن النص قرئ على حساب المنهج أو العكس، فمن غير المنطقي أن يتجه أحدهما إلى الآخر، وهو يرتدي كامل أسلحته دون أن يؤدي هذا إلى حدوث صدام.
هذا وقد بات المتلقي البسيط وحتى الأكاديمي في أحيان كثيرة بحاجة ماسة إلى طرف ثالث يحل محل الوسيط بين النص العربي ونص آخر ليس له من العروبة إلى حروفه التي كتب بها، حيث يمكن أن نعتبر أن المناهج النقدية أحدثت أزمة واختلالا في منظومة التواصل، بل وقطعت ذاك الخيط الرفيع الذي كانت الذائقة تغذيه، فأصبحنا نرى النص الرديء مزدانا بزخرفة منهجية ومساحيق نظريات وافدة ما قد يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، والنص الجيد الذي بقي بعيدا عن هذه المناهج، نصّ موؤود.
إن الإخلاص للمنهج أشبه باستنساخ للفكر الغربي، وبما أن للمنهج خصوصيته وبيئته وخلفياته ومرجعياته، فإنه من غير الممكن تقمصه كما هو من طرف نقادنا العرب، هذا ما يفسر عدم الإخلاص للمنهج وهذا ما يعلل الكثير من المفاهيم الخاطئة التي نكونها عن المنهج؛ إذ إن النقد العربي مازال يئن تحت وطأة الذهول ومازال مقيدا بمرحلة الاستيعاب التي لا بد أن يتجاوزها إلى مرحلة قراءة القراءة أو نقد النقد، ذاك أن المناهج تتوالى عليه وتزداد تعقيدا وتداخلا، فـ "المسار النقدي العربي ظل هو الذي يوجه النقد الأدبي العربي ويفرض عليه في كل مرحلة إبدالاته الخاصة والمتجددة. ولما كانت هذه الإبدالات تصل إلينا متأخرة كنا مضطرين إلى ملاحقتها ومواصلة متابعة الإبدالات الجديدة على إيقاع متواتر خارج عنا. وتستدعي هذه الملاحقة الاستعجال في الانتقال، رغم عدم إنجاز المطلوب إنجازه مع أي إبدال، فنجد أنفسنا في النهاية أمام تراكمات عديدة، لكن محصلتها هزيلة أو تكرارية. ويؤدي هذا في أغلب الأحيان إلى جعل ملاحقتنا لما يتحقق في الغرب ناقصا وجزئيا ومبسترا"[12]. فما إن يبدأ العقل النقدي العربي في استيعاب منهج وفهم أدواته حتى يبزغ للوجود منهج آخر. إن هذا التسارع في ابتكار المناهج وتشعبها، قد يحصر الفكر النقدي العربي في خانة التقبل والاستيعاب دونما التنقل إلى مراحل متطورة كالنقد والتفكر.
محاولة خلق منهج بديل
لعل أبرز وأسهل طريقة للتخلص من هذه الأزمة النقدية هي بمحاولة قراءة جادة للوافد المنهجي الغربي، وإيجاد مصبات يلقي بها تلك الشوائب التي غالبا ما تكون عالقة بالمنهج، وما إن تتخلل بنيات النص العربي حتى تستفرغ سلبياتها ولا جدواها فيه، ما قد يسيء للنص هذه القراءة الجادة تتمثل في "القدرة على اصطناع المقابل، مثلا أو ضدا، فهلا أمكننا تصور ضروب من المنهجيات ... بتعديل المنهجيات المنقولة، إن بحذف بعض قيودها أو بإضافة قيود جديدة إليها، مع معرفة تامة بما يتطلبه هذا الحذف أو هذه الإضافة من مقتضيات صناعية تحفظ إجرائية هذه المنهجيات المحصلة"[13]. وعلى الرغم من أن العقل العربي تعود على فلسفة الاستيراد المعرفي وتبناها، إلا أننا لا ننكر جهود الكثير من النقاد الذين يسعون إلى تطبيق المنهج دون المساس بخصوصية النص، بل ويسعون إلى إخضاع المنهج للنص حتى ولوا اضطروا إلى تعديل المنهج ما قد يؤسس لمنهج نقدي عربي بدل اجترار المناهج الوافدة، و"يمكننا أن نرصد عددا من النقاد حريصين على التعرف على الجديد في النقد الأوروبي، لكنهم يتعاملون معه بقدر من الوعي بأصوله من ناحية، وبنوعية احتياجهم إليه من ناحية أخرى...عبر تخليص عناصره من محمولاتها الأيديولوجية كلما أمكن ذلك أو إدماجها في نسق جديد يحملها ملامح نسقهم المنهجي الخاص".[14]
لا ضير في أن نعتبر أن الواقع النقدي العربي قد أضحى كيانا مسخا بعد أن عكف على استنساخ الواقع النقدي الغربي وصنع منه منهجا شائها، فلا هو تمسك بالتراث وطوره، ولا هو استعان بالحديث وفهمه وتجاوزه، وهذا لا يعني أنه لابد من الانطلاق في التأسيس للصرح النقدي المنهجي العربي من التراث فقط دون اللجوء إلى ما توصلت إليه الساحة الغربية من نظريات ومناهج، بل لابد من خلق نقد مطور، ولا ينبغي بحال من الأحوال المكوث والغرق أكثر في وحل الفلسفات الآتية، ذاك أنها قد تضر بالنص العربي أكثر مما تنفعه، وأنها قد تضماه أكثر مما ترويه؛ فالقارئ دائما متعطش للدلالة والمعنى والكثير من هذه النظريات إن مورست بالطريقة الخطأ، فإنها تحول النص الواضح إلى نص مبهم، وتحول حروف العربية إلى طلاسم من الحروف والترسيمات باسم المنهج، والسؤال هنا هل بات العقل العربي عاجزا عن صنع منهج يحمل ثقل فلسفته ورؤيته؟
إن محاولة خلق منهج بديل لا تتأتى إلى بأمرين "أولهما الرجوع إلى تراثنا وسبر أغواره واكتشافه من جديد لحصر العناصر المعرفية والمنهجية، واستحضار ما هو منها حيّ وملائم لتوظيفه كما هو، وما هو قابل للتطوير قبل التوظيف، وكذا استخلاص ما هو صالح لننطلق منه أو نستوحي أو نستمد بعض ما يقوي فينا قدرة الإبداع أو يفتح أبوابه، وثانيهما التفتح بوعي وعمق وحرية على تراث الغرب، في شتى نواحيه ومختلف ميادينه، ليس لمجرد إتباعه والبقاء في مؤخرة الركب... ولكن لاكتساب المقومات التي أهلته للتقدم وامتلاك المفاتيح...إن إجراء هذه العملية يتطلب وسائل وإمكانيات تقوم على مدى إحساسنا بالواقع الذي نعيشه ومدى الرغبة في تغييره والقدرة على هذا التغيير"[15] إن هذا الحل لمشكلة المنهج لم يتفرد به سيد بحراوي فقط بل نادى إليه معظم النقاد العرب، فقد دعا الدكتور عبد المالك مرتاض إلى تهجين المنهج وعدم الخضوع المطلق له، بل لابد من اتباع طرائق خاصة تتماشى وطبيعة النص، ولابد من المزاوجة بين سلطة المنهج وخصوصية اللغة، حيث يقول: "إننا بدون المنهج الصارم في الحقيقة لا نستطيع أن نقرأ، لكننا أيضا بالخضوع المتلبد القاصر لمثل هذه المناهج، نستلب حريتنا منا، ونتقيد بقيود تكبلنا، فلا نستطيع أيضا أن نقرأ قراءاتنا الخاصة بنا؛ أي أننا لا نستطيع أن نبدع في هذه القراءة".[16]
هذا، وقد فتحت القراءة الحديثة الباب أمام النص من خلال ما تمنحه إجراءاتها من آليات تمكن القارئ من الولوج إلى عالمه، واستقراء مكنوناته واكتشاف مغلقاته. كما وأنها ساهمت في الكثير من الأحيان في إعادة اكتشاف التراث وفهمه، ولا يستطيع أحد أن ينكر "أن في المناهج النقدية الحديثة – مهما تنوعت مصادرها- ما يساعد على الكشف عن هذا الجزء المهم من تراثنا الأدبي، ثم تقييمه التقييم الموضوعي والابتعاد عن الدعوات المعدة والمترجلة البعيدة عن الدقة العلمية...وقد آن الأوان لإعادة النظر في هذا التراث ولن يتأتى لنا إلا باتباع الخطوات العلمية والموضوعية التي منحتها إيانا بعض المساعي والجهود الفكرية التي سعت إلى توظيف روح العلم في دراسة الأدب"[17]. هذا ما توصلت إليه الدكتورة آمنة بلعلى في كتابها "تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية الحديثة"، حيث مزجت فيه بين مختلف النظريات والحقول المنهجية، فمن نظرية التلقي عند كل من ياوس وايزر، والتي استطاعت من خلالها أن ترصد خطاب فعل الحب في بدايات الخطاب الصوفي، وخاصة في شقه الشعري كما استطاعت أن ترصد آليات التواصل التي أسسها المتصوفة الآخرون لخلف أفق تفاعل إيجابي بينهم وبين المتلقي، إلى المظهر التداولي لخطاب المعرفة، حيث بينت كيف عمد النفري والتوحيدي في القرن الرابع إلى تجسيد التفاعل والتواصل من خلال أفعال الكلام، بينما اعتمدت على السيميائيات السردية لاحتواء فعل الحكي وقراءة المظهر القصصي، إن هذا التنوع المنهجي خدم الباحثة ومكنها من استقراء الجانب الأكبر من الخطاب الصوفي.[18]
كما وأن الغذامي هو الآخر سعى إلى خلق منهج مستمد من التراث، حيث يقول في كتابه الخطيئة والتكفير "وأنا شخصيا في كتاب الخطيئة والتفكير اعتمدت على التشريحية... مستعينا على ذلك بالمفهومات العربية الموجودة عند ابن جني والجرجاني والقرطاجني"[19]. وسعى هو الآخر إلى المزاوجة بين المناهج واعتماد أكثر من منهج في عملية القراءة، وهذا لا يعني بشكل من الأشكال خلطا منهجيا ولا خلقا لمنهج مركب هش، وإنما هذا الخلط والمزج قد تفرضه طبيعة النص، هذا ما دعا إليه الغذامي أيضا، حيث "حاول أن يصنع منهجا ألسنيا أو نصوصيا على حد تسميته، تأتلف فيه البنيوية والسيميائية والأسلوبية والتشريحية (التفكيكية) ولا يهمه أن يوصف بأنه بنيوي فقط أو تفكيكي فقط بقدر ما يهمه أن يستجيب للمعطيات الألسنية العلمية"[20]. إن فهم النص في أبسط صوره، ما هو إلا انعكاس لتلك المسالك التي يسلكها القارئ بغية الوصول إلى الدلالة والظفر بها، فإذا كان فهم النص هو الغاية، فليس من المهم إذن أيّ طريق يسلك القارئ طالما أنه يصل إلى المنتهى.
وعليه
تعد أزمة المنهج واحدة من أهم الأزمات التي تعصف بالساحة النقدية العربية، ويعد النص أكبر متضرر من آثار هذه العاصفة، حيث إنه بات يُرسم في معلم تُحدد المناهج الغربية في الكثير من الأحيان إحداثياته، مما قد يفقده خصوصيته ويهشم بناءاته، إلا أنه في الوقت ذاته قد تكون المناهج عامل استنطاق لهذه النصوص واستقراء لها، وكشف عن دلالاتها ومفاتيحَ للولوج إلى مغاليقها وملء فجواتها وثغراتها، كما أنه لا مفر من خلق منهج بديل ينطلق من مرجعية نقدية عربية قوامها التراث، مرورا بما حقق الغرب على المستوى النقدي وانتهاء إلى بلورة منهج يليق بالنص العربي وحمولته، وهذا ما يبدو أنه تحقق في أعمال الكثير من النقاد كعبد المالك مرتاض والغذامي وغيرهم.
الهوامش:
[1]- ذوات العدد46
[2] صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، افريقيا الشرق، المغرب، 2002، ص 16
[3] مجموعة مؤلفين، قضايا العلوم الإنسانية وإشكالية المنهج، إشراف وتقديم د. يوسف زيدان، القاهرة، ص 7
[4] مولاي بوخاتم، الدرس السيميائي المغاربي: دراسة وصفية نقدية في نموذجي عبد المالك مرتاض ومحمد مفتاح، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2005، ص 63
[5] عبد العال بوطيب، إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث، مجلة عالم الفكر/ مج 23، عدد 1-2، 1994، الكويت، ص 458
[6] د. عبد الله أحمد بن عتو، مشكل المنهج في بعض الكتابات المنقبية بالمغرب، مجلة عالم الفكر، عدد25، مج 02، ص 235
[7] عباس الجراري، خطاب المنهج، منشورات السفير، مكناس، المغرب، ط1، ص 40، 41
[8] عباس الجراري، خطاب المنهج، المرجع نفسه، ص، 41
[9] د.سيد البحراوي، البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، دار شرقيات، القاهرة، الطبعة الأولى، 1993، ص 8
[10] صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط1، 1998، ص 7.
[11] د.سيد البحراوي، البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، ص 113
[12] سعيد يقطين وفيصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار الفكر سوريا، دار، ط1، 2003، ص، ص 30-31
[13] طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، ط2، ص 11
[14] د. سيد البحراوي، البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، ص 116
[15] عباس الجراري، خطاب المنهج، ص 31
[16] د. عبد المالك مرتاض، القراءة وقراءة والقراءة، مجلة علامات في النقد، جدة، ج15، مج04، 1995، ص 207
[17] آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية الحديثة، منشورات الاختلاف، ط1، 2002، ص 331
[18] ينظر، آمنة بلعلى، المرجع السابق، ص، ص 13-14
[19] جهاد فاضل، أسئلة النقد، الدار العربية للكتاب، تونس- ليبيا، ص 208
[20] يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، دار البشائر للنشر، الجزائر، 2002، ص 91






