تقديم كتاب "من أجل إنهاء الاستثناء الإسلامي" لمحمّد شريف الفرجاني
فئة : قراءات في كتب
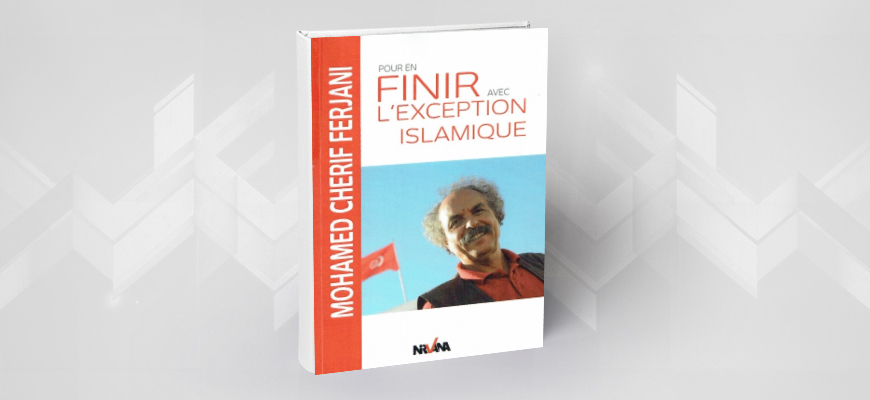
تقديم كتاب "من أجل إنهاء الاستثناء الإسلامي" لمحمّد شريف الفرجاني
باسم المكيّ[2]
أصدر الباحث التونسي محمّد الشريف فرجاني كتابا بعنوان "من أجل إنهاء الاستثناء الإسلاميّ" عن دار "نيرفانا" سنة 2017. والباحث من مواليد 1951، وهو أستاذ مختصّ في العلوم السياسيّة والدراسات الإسلاميّة يدرّس في الجامعات الفرنسيّة، وله عدّة مؤلفات نذكر منها أطروحته المنشورة باللغة الفرنسية عن دار أمل للنشر[3]. وتجدر الإشارة إلى أنّ الكاتب لا يخفي التزامه السياسي منذ التحاقه في السبعينيات بحركة آفاق/ العامل التونسي، وهي حركة يسارية لها مرجعيّة ماركسيّة- لينينيّة[4]. وقد تحمّل مسؤوليّة هذا الاختيار وسجن في العهد البورقيبي من سنة 1975 إلى سنة 1980. وهذا الالتزام، عند الباحث، له أهميّة كبرى؛ فهو يؤكّد أنّ الفكر لا يمكن أن يكون بمعزل عن شواغل المثقّف وتصوّراته السياسيّة، فضلا عن أنّ هذا الأمر قد حدّد في ما بعدُ مساره العلمي، ليهتمّ بتفكيك خطاب الإسلام السياسي، وينخرط في التفكير في إطار الفكر العلماني وفكر حقوق الإنسان عموما.
هذا الكتاب مجموعة من المقالات كُتبت في مناسبات مختلفة، وفي فترات متباعدة يجمعها هاجس معرفي يتمثّل في دحض أطروحة "الاستثناء الإسلامي" التي يروّج لها أنصار الإسلام السياسي في العالم العربي الإسلاميّ وعدد من المستشرقين البارزين من أمثال "برنار لويس" "Bernard Louis" (ت 2018) في الفضاء الغربي والأمريكي. يتضمّن الكتاب مقدّمة وتوطئة مهمّة لمحمّد صغيّر جنجار وأربعة مقالات مختلفة المواضيع، ولكنّها مشدودة إلى هاجس دحض القراءة الجوهرانيّة للإسلام. وخُتم الكتاب ببعض الملاحظات التي تسمح، في اعتقاد الباحث، بالخروج من أطروحة "الاستثناء الإسلامي". ونحن في تقديمنا للكتاب، لن نفصّل القول في كلّ مقال على حدة، وإنّما سنسعى إلى النظر في الخيط الناظم لأطروحة محمّد الشريف فرجاني.
لا شكّ في أنّ الوعي بالعلاقة المعقّدة بين الديني والسياسي في الفضاء الإسلامي قد بدأ يتشكّل عند الباحث مبكّرا منذ متابعته للثورة الإيرانية ورجوع الخميني من منفاه سنة 1979، ليحكم قبضته على الثورة ويؤسّس الجمهورية الإسلاميّة في إيران تحت وصاية "إمامة الفقيه". هذا الحدث الذي تابعه المناضل اليساري في سجن "برج الرومي" كان له تأثير في تشكّل وعيه بقوّة الإيديولوجيا الدينيّة وقدرتها على تحريك الجماهير الغاضبة من سياسة الحداثة المبتورة التي اعتمدها الشاه. ولذلك، توجّهت اهتماماته البحثيّة منذ سنة 1985 لتفكيك خطاب الإسلام السياسي متوسّلا المعارف الحديثة التي كان محمّد أركون (ت 2010) يدعو إلى استثمارها في دراسة "الظاهرة الدينيّة" عموما، و"الظاهرة الإسلاميّة" على وجه الخصوص.
إنّ رهان البحث في مقالات هذا الكتاب معقود على تفكيك بنية القراءة الجوهرانيّة للظاهرة الدينيّة. ولعلّ هذه المقاربة قد بدأت تتمظهر أوّلا في كتابات منظّري الإسلام السياسي، ونذكر على سبيل المثال مؤلّفات محمّد باقر الصدر (ت 1980) من قبيل كتابيْه "فلسفتنا" و"اقتصادنا". تقوم هذه المقاربة الجوهرانيّة على ركيزتين: تتمثّل الركيزة الأولى في الاعتقاد بالخصوصيّة الثقافيّة الممجّدة لخطاب انغلاق الهويّة. أمّا الركيزة الثانيّة، فهي اعتبار التصوّرات الدينيّة جواهر ثابتة ومتعالية على التاريخ، ومن ثمّ فهي جواهر اعتقادية تستعصي على الدرس العلمي. وقد غذّت الثورة الإيرانيّة هذه الأطروحة في الفضاء الإسلامي. ولئن رأى فوكو في هذه الثورة "إرادة عامّة لشعب" يريد التحرّر من الهيمنة الغربية والرأسمالية الأوروبيّة[5]، فإنّ الشريف فرجاني قد رأى فيها، منذ البداية، علامة على بداية زمن الظلاميّة[6]. وقد وعى من خلالها ضرورة الإقرار بكونيّة حقوق الإنسان والعمل على تدعيم الأطروحة العلمانيّة في الفضاء العربي الإسلاميّ. ولم يزد التطوّر الحاصل في سيرورة العولمة هذه الأطروحة الهوويّة إلاّ انغلاقا على ذاتها. فلئن وفّرت العولمة ووسائل الاتّصال الحديثة فرصة مهمّة للاطّلاع على ثقافة الآخر وتجاربه، فإنّ هذا السياق الجديد قد ولّد مخاوف جديدة خاصّة في فضاء بات يعرف بـ"الجهل المقدّس"، بل إنّ الأطروحة الجوهرانيّة للإسلام وجدت لها في الغرب منظّرين من أمثال برنار لويس خاصة في كتابيه "عودة الإسلام" و"الخطاب السياسي للإسلام"، إذ يرى برنار لويس أنّ الإسلام لا يفصل في جوهره بين ما هو دينيّ وما هو سياسيّ، فهو لا يعرف المقولة الشهيرة الواردة في الأناجيل "أَعْطُوا مَا لقَيْصَرَ لقَيْصَرَ وَمَا لله لله" (مرقس، 12/ 17). ومن ثمّ، فالإسلام في جوهره دين شموليّ لا فصل فيه بين المجال الدنيوي والمجال الديني، فهو دين ودولة، وهو دين قدري متخلّف غير قابل البتّة للحداثة؛ ذلك أنّ مفهوم الأمّة الإسلاميّة يتعارض تعارضا تامّا مع خصائص الدولة العلمانيّة القائمة على أساس المواطنة بغضّ النظر عن الاختلافات العقدية التي هي في الأصل مصدر ثراء في هذه الدولة.
لقد كان لأطروحة برنار لويس تأثير خطير في الفضاء الغربي والفضاء العربي الإسلامي، إذ غذّت هذه الأطروحة القائمة على مقاربة جوهرانيّة للإسلام في فضاء الغربي نزعة الإسلاموفوبيا، وتمثّلت نتيجتها المنطقيّة في ظهور أطروحة "الصراع بين الحضارات" التي طوّرها صموئيل هنتغتون (Samuel Huntington)، والتي تفترض أنّ الصراع بين الحضارات هو في جوهره صراع بين الأديان. أمّا في الفضاء الإسلامي، فقد كانت آراء برنار لويس تصبّ الماء في طاحونة النزعات الاسلامويّة وخطاب الإسلام السياسيّ. ولا شكّ في أنّ دحض هذه المقاربة الجوهرانيّة يفترض تغييرا في المقاربة، وتبنّي المقاربة التاريخية والمقارنيّة للظاهرة الدينيّة عموما؛ وذلك للبحث عن تاريخيّة الأفكار السياسيّة في الإسلام وتبيّن منطق تطوّر المؤسسات. فإذا كانت الثقافة المسيحيّة قد فصلت بين الديني والدنيوي؛ لأنّ جوهر تعاليم المسيح يقوم على هذا الأمر فَلِمَ ظلّت الدول الغربيّة لفترة طويلة من الزمن لا تقرّ بمبدأ الفصل، وتجمع بين الدين والسياسة؟ ألم يحتج الأمر إلى صراع مرير بين المرجعيّة الدينيّة ومناصري العلمانيّة للإقرار بهذا الفصل بين المجالين؟ ثمّ ألا يمكن أن نجد في النصوص التأسيسيّة للإسلام ما يدعم هذا الفصل من قبيل حديث "أنتم أعلم بشؤون دنياكم"؟. فضلا عن ذلك، فإنّ دحض المقاربة الجوهرانيّة تحتاج إلى التسلّح بمناهج البحث الحديثة لتفكيك الخطاب والكشف عن زيف الرؤية الجوهرانيّة للأديان؛ ذلك أنّ نصوص كلّ دين يمكن أن تؤّول في هذا الاتّجاه أو ذاك. فالنصوص تظلّ صامتة ما لم تخضع إلى القراءة والتأويل، وهي عادة ما ينطق بها البشر للتعبير عن آرائهم وتصوّراتهم الإيديولوجيّة. فيصبح الدين من ثمّ وسيلة لإكساب الشرعيّة لهذه الايديولوجيا أو تلك. إنّ المقاربة العلمية القائمة على المقارنة والقراءة التاريخيّة للحدث الديني قد تكشف خطل القراءة الجوهرانيّة وتدحض أنّ المسيحيّة في جوهرها لا سياسيّة، وأنّ الإسلام في جوهره شمولي يجمع بين الدين والسياسة.
يرى الباحث أنّ المقاربة القائمة على المقارنة بين الأديان قادرة على تجاوز الرؤية الهووية للدين والثقافة، ولذلك خصّص المقال الأوّل من عمله "أهميّة الدراسة المقارنة للأديان وإشكالياتها" للخوض في أهميّة هذه المقاربة وتقديم بعض الملاحظات النقدية التي تؤسّس أرضيّة معرفيّة موضوعيّة لدراسة الظاهرة الدينية تحقّق قيمة الاحترام المتبادل بين الأديان. يعود تاريخ الدعوة للحوار بين الأديان إلى ما بعد الحرب العالميّة الثانيّة والتغيير الحاصل عقب المجمع الفاتيكاني الثاني (1962- 1965). فنُظّمت العديد من اللقاءات في اتّجاه التقريب بين أتباع الأديان وقد كانت تحت إشراف "منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" "UNESCO" في ما يخصّ الأديان التوحيدية الكبرى اليهودية والمسيحيّة والإسلام. واهتمت "المنظّمة الإسلاميّة للتربية والعلوم والثقافة" "ISESCO" بتنظيم الحوار السُنّي - الشيعيّ. ورغم تزايد الوعي بضرورة الحوار بين الأديان والنتائج المهمّة التي يمكن تسجيلها، فإنّ الحوار ظلّ منقوصا، حسب الباحث، فهو لم يشمل كلّ الأديان واقتصر على تقريب وجهات النظر بين الكنائس المسيحية والحوار بين اليهودية والمسيحية أو بين المسيحية والإسلام. وقد غابت عن هذا الحوار العديد من التقاليد الدينية العريقة مثل الهندوسيّة والبوذية واعتبرت الأديانَ "الإحيائيّة" تقاليد دينيّة "ضالّة"، بل ظلّت الكثير من التجارب الدينيّة الحاضرة في العصر الحديث بمثابة "البدع" التي لا يجب التحاور معها. أمّا في خصوص محتوى هذا الحوار، فقد ظلّت هذه اللقاءات دبلوماسيّة ووديّة وعزفت عن الخوض في المشاكل الحقيقيّة والأسئلة المحرجة التي من شأنها أن تعرقل الاحترام المتبادل بين أتباع هذه الأديان. كما كانت هذه اللقاءات فرصة لإدانة الحداثة والعلمانيّة والفكر الالحادي والنزعة الماديّة الحديثة، وصبّت جام غضبها خاصّة على الحركات النسويّة[7]. أمّا في مستوى مقاربة التجارب الدينيّة المختلفة في البلدان العربية، فقد حافظت على صبغتها التقليدية التي تتميّز بثوابت مازالت تؤثّر فيها، من نحو ما استقرّ من آراء في كتب الملل والنحل. فمازالت المؤسسات التربوية والدينيّة في جلّ المجتمعات العربية تدرّس الإسلام، باعتباره الدين الصحيح وأنّ المسلمين هم "خير أمّة أخرجت للنّاس" وبقيت النظرة إلى اليهوديّة والمسيحيّة محافظة تسيطر عليها فكرة تحريفهم لكتبهم ومن ثمّ تحريفهم للتوحيد الخالص الذي أتمّه الإسلام. أمّا في خصوص النظرة إلى الآخر المختلف في الفرقة، فعادة ما تسمع بأنّ الإسلام واحد، وأنّ الاختلاف بين التصوّرات داخل الإسلام بسيطة ولا تمسّ جوهره. ولكنّ واقع الأمر يكشف صراعا حادّا بين السنّة والشيعة. وهذا ما يؤكّد أنّ المرجعيّة في تدريس الدين في جلّ المجتمعات الإسلاميّة ظلّت تقليديّة محافظة، رغم دعوة البيروني قديما إلى تجاوز الأحكام المسبقة واحترام بقيّة الملل والنحل. وفضلا عن ذلك، فإنّ أغلب البلدان العربيّة تنصّ في دساتيرها على المرجعيّة الدينيّة وتقرّ بأنّ الشريعة هي أهمّ مصدر من مصادر التشريع. ولهذا السبب انعدمت الديمقراطية وغابت المبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان من قبيل حريّة المعتقد والضمير.
وإذا كانت المجتمعات الغربية عموما قد تبنّت الفكر العلماني فتقلّصت سلطة المرجعيات الدينيّة، فإنّ واقع الدراسة المقارنة للأديان تظهر فيه العديد من الهنات. فقد بدأ البحث المقارن للأديان منذ القرن 19 مع "ماكس ميلر" و"جيمس فريزر" وعرف تطوّرا مع "ميرسيا إلياد" في القرن العشرين، وهو ما ساهم في تراجع الأحكام المسبقة وتجاوز النزعة المركزية المسيحيّة، غير أنّ الواقع يكشف عن أنّ الطريق لا يزال طويلا أمام هذه الدراسات. ولعلّ الاطّلاع على برامج التدريس في فرنسا التي قطعت أشواطا كبيرة في العلمنة يبرز تعثّر دراسة الأديان دراسة موضوعيّة. فأساطير الخلق والمعجزات مازالت تدرّس في المدارس الفرنسيّة باعتبارها أحداثا تاريخيّة ومازالت الكثير من التجارب الدينيّة مثل الإحيائيّة تعتبر تيّارا سحريّا لا يرتقي إلى الدين فضلا عن هيمنة النزعة الجوهرانيّة في التدريس من قبيل عدم الاعتراف الجوهري للهندوسية بالنزعة الكونيّة، بل إنّ النزعة الإثنيّة المركزية لم تختف البتّة حتّى عند كبار المنظّرين؛ ذلك أنّ ماكس فيبر "Max Weber" يعتبر أنّ الرأسمالية ما كان لها أن تنشأ لولا البروتستانية. كما أنّ مارسيل غوشيه "Marcel Gauchet" يرى أنّ الحداثة خاصيّة مسيحيّة؛ لأنّ المسيحيّة هي وحدها "دين الخروج من الدين"[8].
لا شكّ في أنّ الدراسة المقارنة للأديان قد تطوّرت ممّا سمح بدحض العديد من الأفكار المسبقة، غير أنّ الرغبة في مزيد تطوير هذا المبحث دفع محمّد الشريف فرجاني إلى تقديم بعض الملاحظات نرى أنّها على درجة كبيرة من الأهميّة، لخلق أرضيّة معرفيّة تسمح بعدم السقوط في النزعة الجوهرانيّة من جهة، أو النزعة المركزية لدين من الأديان من جهة أخرى. فلا يمكن الحديث عن حوار حقيقيّ بين الأديان والحضارات إلاّ على أرضيّة الاعتراف بكونيّة حقوق الإنسان[9] وكرامته وحريته والإقرار بتعدّد الأنظمة الاعتقاديّة. ومن ثمّة الكفّ عن ادّعاء امتلاك الحقيقة والدين الحقّ. ولذلك، يجب النظر إلى الحدث الديني باعتباره بُعدا من أبعاد التجربة الانسانيّة وعنصرَ ثراء يعبّر عن رغبة الإنسان الجامحة لإيجاد معنى لوجوده. ومن أجل أن تكون الدراسة المقارنة للأديان ناجعة يجب وضع الظاهرة الدينيّة في سياق تشكّلها التاريخي في أبعاده المعقّدة ونفي القراءة الجوهرانيّة للدين.
وإذا كانت الدراسة المقارنة للأديان تكشف عن تاريخية الظاهرة الدينية، وتفضح خطل المقاربة الماهويّة، فإنّ الباحث يؤكّد ضرورة التسلّح بالمعارف الحديثة في دراسة الحدث الديني. وقد اهتمّ في كتابه بـدراسة "محمّد أركون للحدث الديني". لقد كان محمّد أركون من المدافعين على ضرورة الانفتاح على العلوم الحديثة مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وتحليل الخطاب، وتوظيفها توظيفا علميّا لمزيد فهم الحدث الديني. فهذه العلوم توفّر للباحث العدّة المنهجيّة لنقد التصوّر الجوهراني للدين. وقد وجهّه محمّد أركون نقده إلى اتّجاهين من اتّجاهات البحث. أمّا الاتّجاه الأوّل، فأصحابه لم يخرجوا عن المقاربة التمجيدية ولا يخفى أنّ هذه المقاربة تفتقر إلى النزعة النقديّة التي هي سمة العلم. أمّا الاتّجاه الثاني، فيتضمّن الاستشراق الكلاسيكي الذي ظلّ محافظا على النزعة الوصفيّة. وهكذا دعا أركون إلى الدراسة النقدية ونزع الأسطرة عمّا ترسّخ من هالة تقديسيّة للموروث الديني الإسلامي. لقد لاحظ أركون تفشّي المقاربة الجوهرانيّة؛ وذلك من خلال إلصاق نعت "إسلامي" بكلّ المجالات من قبيل "اقتصاد إسلامي" أو "لباس إسلاميّ"[10]... وللخروج من مأزق هذه الرؤية الهوويّة، يرى ضرورة الفصل بين "الحدث القرآني" و"الحدث الإسلامي". والمقصود بالحدث القرآني هو الرسالة الشفويّة التي جاء بها الرسول، ومن أهمّ خصائصها الانفتاح على قراءات عدّة وتآويل مختلفة، غير أنّ الحدث الإسلامي هو التأويل الذي ارتضته الجماعة الإسلاميّة في ظروف معرفيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة مخصوصة، وهو تأويل يمكن نقده وتجاوزه حسب شروط العصر ومتغيّرات العمران. والحقيقة أنّ هذا التمييز بين الرسالة من جهة وتطبيقها في التاريخ لا يمكن الكشف عنه وتبيّنه إلاّ بالاعتماد على ما توفّره لنا المعارف الحديثة من آليات. لا شكّ، عند الشريف فرجاني، أنّ لمقاربة أركون وتحمّسه لمقاربة حديثة للحدث القرآني والحدث الإسلامي أهميّة قصوى في تعميق فهمنا للظاهرة الدينيّة عموما والإسلاميّة على وجه الخصوص؛ غير أنّ الباحث لم يقتصر على ما توصّل إليه أركون، إذ قدّم جملة من الملاحظات لتجاوز بعض الهنات في هذه المقاربة. فقد بيّن أنّ هذا التمييز بين الرسالة والتاريخ قد يؤدّي إلى مآزق حقيقيّة من قبيل القراءة الإيديولوجية التي تسعى إلى توظيف الدين توظيفا يخدم غاياتها السياسيّة. ولذلك، فهو يمضي قدما نحو ضرورة اعتبار النصّ في حدّ ذاته إنتاجا ثقافيّا في تشّكله، ومن ثمّ وجب الكشف عن سياق تبلوره حتّى نربط معناه بالظروف الحافّة بإنتاجه. ولعلّ هذا العمل النقدي قد يحدّ من البحث الدؤوب عن المعنى الأصلي للنصّ. فإذا كانت غاية أركون معرفيّة تسعى إلى الكشف عن الدلالات الأصليّة للحدث القرآني، فإنّ بإمكان الحركات المتطرفة أن تدعيّ هي أيضا أنّها تمتلك المعنى الأصليّ للنصّ. ولا شكّ أنّ هذا الأمر سيعزّز التراشق بتهمة التكفير[11] ويفسح المجال أمام المزايدة التأويليّة.
ومن القراءات الحديثة التي سعت إلى تطبيق معارف العصر، نظر الباحث في المقاربة الأنثروبولوجيّة التي قام بها "غيرتز" "Geertz". فقد درس "غيرتز" الإسلام الأندونيسي والإسلام المغربي دراسة أنثروبولوجية ميدانيّة؛ فهو أقام في مدينة "جاوة" الأندونيسيّة بين سنتي 1952 و1954 وسكن في المغرب في 1964 و1965. وقد كان همّه البحث عن المشترك والمختلف في تجربتين تاريخيتين للإسلام. فاختار تجربتين مختلفتين في البيئة والجغرافيا، سعيا منه كي يلتقط عناصر الخصوصيّة في الإسلام المغربي والإسلام الأندونيسي. دخل الإسلام في المغرب عبر الغزو، واستقرّ في بيئة بربريّة تغلب عليها القبيلة دون أن يشير إلى الخصائص الحضارية لثقافة البربر، وهو ما طبع الإسلام بِسِمَة "الإسلام الطُرُقي" القائم على الزوايا وتقديس الأولياء[12]. أمّا الإسلام في أندونيسيا، فقد دخلها عبر التجارة في وسط غلبت عليه حياة التمدّن والاختلاف الديني. هذه الخصائص ستطبع الإسلام في البلديْن بطابع مختلف. فإذا كان الإسلام المغربي مشدودا إلى الزوايا والاعتقاد في سلطة الوليّ، فإنّ الإسلام الأندونيسي سيكون إسلاما "متمدّنا" يغلب عليه التوليف بين الاعتقادات السائدة في تلك المنطقة. وليدلّل على هذه الخصوصيات، ارتكز "غيرتز" على بعض النماذج في البلدين، وهما "الوليّ المحارب اليوسي" و"محمّد الخامس ملك المغرب" (ت 1961). وقد لاحظ أنّ أنموذج الوليّ المحارب يقابله في أندونيسيا أنموذج "التاجر المسالم كاليجيكا". أمّا النزعة المحافظة لمحمّد الخامس، فتقابلها الرؤية المنفتحة والتأليفيّة لـ "سوكارنو (ت 1970)" الذي لا يرى تعارضا بين أن يكون ماركسيّا ومؤمنا في الوقت نفسه[13]. ويرى في نفسه نقطة الوصل بين مختلف التيارات والإيديولوجيات[14]. كلّ هذه الأسباب جعلت المجتمع المغربي يعيش إسلاما طرقيّا محافظا غير قابل للتطوّر، في حين استطاع الإسلام الأندونيسي أن يكون منفتحا قابلا لقيم الحداثة. ما من شكّ في أنّ الإسلام متعدّد، ومأتى هذا التعدّد طريقة تقبّله والبيئة التي احتضنته. ولكنّ الأسئلة الأساسيّة في نقد هذه المقاربة هي التالية: هل يمكن أن تمثّل هذه الشخصيات المجتمع وثقافته المتعدّدة؟ ألا يمكن أن نجد في المجتمع الأندونيسي نماذج مشابهة لليوسي الوليّ المحارب وللحاكم المحافظ محمّد الخامس؟ ألا يمثّل "سوهارتو" مثالا دالاّ على هذا الإسلام الراديكالي في أندونيسيا؟ لقد حذّر الشريف فرجاني من هذه المقاربات التي تميل إلى التعميم انطلاقا من نماذج يمكن أن تعكس تصوّرها للإسلام دون أن تعكس تصوّرات المجتمع في عمومه. إنّ هذه المقاربة رغم طابعها العلمي واجتهاد صاحبها لَتؤكّد مرّة أخرى على خطر المقاربة الجوهرانيّة للظاهرة الدينيّة. ولذلك يرى الباحث ضرورة مقاربة الدين، باعتباره "ظاهرة ثقافيّة نشأت في بيئات مختلفة (اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة واقتصاديّة وجغرافيّة وتاريخيّة...)[15]. هذه القراءة التاريخية هي الكفيلة بدحض المقالة الجوهرانيّة، وهي القادرة على تنسيب الرؤى والخروج من "الاستثناء الإسلامي".
لا شكّ في أنّنا نثمّن طرح الباحث ومحاولة الكشف عن عقم المقاربة الجوهرانيّة للظاهرة الدينيّة، واقتراح منهج المقارنة ووضع الأديان والتصوّرات الدينيّة في تاريخ تشكّلها وتطوّرها. كما نثمّن جهوده النقديّة في ما يتعلّق بضرورة مراجعة علم مقارنة الأديان والنتائج التي توصّل إليها أركون وغيرتز. ولكنّنا نشير في الأخير إلى أنّ الخروج من مأزق "الاستثناء الإسلامي" يتطلّب وعيا إسلاميّا جديدا، وهو وعي لا يمكن أن ينشأ إلاّ بتوفّر عوامل عديدة ومتداخلة أهمّها مراجعة تدريس الدين في الفضاء العربي الإسلامي. كما نرى أنّ الخروج من هذا الاستثناء يتطلّب تغييرا في النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في العالم الإسلامي، وهو أمر يحتاج إلى الوقت، فضلا عن إرادة صادقة لأنظمة الحكم. ونحن إذ نصوغ هذه الملاحظات النقدية ندرك عسر المهمّة، مثلما نعوّل على وعي الباحث بها.
[1] FERJANI, Mohamed Chérif, pour en finir avec l’exception islamique, Nirvana, éd, 2017
[2] باسم المكّي، أستاذ جامعي بكليّة الآداب والعلوم الانسانيّة بصفاقس وباحث في الفكر الإسلاميّ.
[3] Islamisme, Laïcité et Droits Humains, Amal éd, 2012
[4] Pour en finir avec l’exception islamique, p. 45-46
[5] Ibid, p. 45
[6] Ibid, p. 46
[7] Ibid, p. 24-25
[8] Ibid, p. 38
[9] Ibid, p. 40
[10] Ibid, p. 73
[11] Ibid, p. 83
[12] Ibid, p. 106
[13] Ibid, p. 111
[14] Ibid, p. 111
[15] Ibid, p. 138

