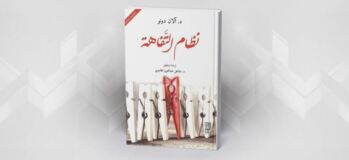ثقافة المواطنة اليوم بين نظام التفاهة وضرورة استدعاء قيم التنوير
فئة : أبحاث محكمة

ثقافة المواطنة اليوم بين نظام التفاهة وضرورة استدعاء قيم التنوير
على سبيل التقديم
تجعل المواطنة citizenship السيادة أمرا راجعا إلى جماعة المواطنين، وهم تحديدا أولئك الذين يحملون جنسية البلد الذي يقيمون فيه[1]، والذين منهم تنبثق القرارات المتعلقة بالشأن العام public affairs-res-publeca. إن المواطنة بهذا المعنى تقتضي مركزية المواطن في عملية صياغة القوانين عبر الاستخدام العمومي للعقل في نقاش علني سجالي تتعارض فيه المواقف المدعمة بالأدلة والحجج. تشكل المواطنة جوهر الممارسة السياسية الديمقراطية القائمة على التشاور العمومي واتخاذ القرارات بشكل حر ومسؤول منزه عن أي نزعة كانت دينية أو عرقية أو إيديولوجية أو غيرها. يتجلى هذا المعنى العلماني secular meaning لمفهوم المواطنة داخل الفضاء العام، بوصفه شكلا من أشكال إشاعة السلطة بين الناس وإتاحة فرصة المشاركة في تكوينها للجميع؛ فتتحقق النقلة العملية من مشروعية وشرعية الحاكم إلى مشروعية وشرعية الجماعة السياسية المتمثلة في مجموع المواطنين citizens.
ولا يخفى على أحد أن مفهوم المواطنة يرجع في أصله إلى جذور يونانية ارتبطت أساسا ببروز شكل الحكم المسمى "الديمقراطية" dimocracy[2]، ضمن مؤسسات سياسية أطلق عليها مسمى المدينة-الدولة [3]etat-cite/city-state، التي تشكل الأغورا قلبها النابض، وقد صار هذا المفهوم مرجعا معتمدا في بناء التأويلين الفلسفيين الحديث والمعاصر لما يسمى المواطنة العالمية [4]global citizenship. فلا مواطنة من دون ديمقراطية وفضاء عمومي يستضيف الجميع باختلافهم وتنوعهم، كما أنه لا مواطنة بدون حوار ونقاش سياسي هدفه لا الدفاع عن حقيقة بعينها يمتلكها أحد أطراف النقاش، وإنما بناء حقيقة جماعية يؤول إليها النقاش العمومي نفسه؛ فالحقيقة في المواطنة أفق للنقاش لا منطلق له، مع ما تقتضيه الروح الفلسفية المعاصرة من تنسيب التعامل مع مفهوم الحقيقة ذاته، سواء اعتبرت هذه الحقيقة دالة على الخير الأسمى لعموم المواطنين بالمعنى الأرسطي القديم أو على المنفعة بالمعنى الفلسفي الحديث.-وربما هذا هو الخيط الرفيع الناظم بين التأويلين الفلسفيين الحديث والمعاصر لفكرة المواطنة من جهة، وفي علاقة هذين التأويلين بالجذور اليونانية لمفهوم المواطنة من جهة ثانية-.
ومع تغول الشعبوية populisme في العقدين الأخيرين من زمننا المعاصر، وما صاحب هذا التغول من سيادة قيم الصراع والانغلاق باسم المصالح الوطنية، وتراجع قيم الأنوار المتمثلة في العقلانية وتحالف الفعاليات الإنسانية لربح رهان تحدي التعصب والجهل والتخلف، صارت التفاهة نظاما يحكم النقاشات العمومية، ويوجهها -بآلية الإعلام المسيطر عليه والمتحكم فيه- نحو أبعاد مادية سطحية ومتع عابرة، ويعتم على ما وراء هذه الأبعاد والمتع. فغدونا نلج شيئا فشيئا في ما يسمى بـ "عصر التفاهة"the era of insignificance. تحول العالم في عصر التفاهة هذا من مجال الممارسة السياسية المحتكمة لقواعد الديمقراطية والعدل والإنصاف إلى مجال يحكمه الاستبداد والديكتاتورية الممانعة لظهور أي شكل من أشكال دولة القانون ومجتمع الحقوق والحريات. ولم يسلم الغرب نفسه، وهو محتضن الديمقراطية والعقلنة والعدالة والحق من الانخراط في سيرورة التفاهة هاته. الأمر الذي يسائل مصداقية ما دأب يزعم التبشير به على الصعيد الكوكبي منذ المرحلة الاستعمارية (المهمة التحضيرية مثلا la mission civilisatrice (إلى الزمن الراهن. وهذا ما جعل منظومة المواطنة اليوم تعيش أزمة مركبة يتداخل في تشكليها والتصعيد من آثارها الإعلامي بالتكنولوجي والسياسي بالاقتصادي والنفعي الشخصي بالموضوعي الإيديولوجي، انطلاقا من ظاهرة التعقيد أو التركيب التي تسم الظواهر الإنسانية والمجتمعات المعاصرة وفق تعبير الفيلسوف الفرنسي الشهير إدغار موران.
ولعلنا نكون مدركين أن المسألة التي نطرحها هنا هي مسألة الفوضى...لا يعني هذا أنه لم يعد أمامنا ما نفعله...وإنما يعني ذلك بأسلوب عملي...أن الإقامة الذاتية للمجتمع[5]community self-accomodation... أصبحت مجرد حلم لا يجد شروطا يتغذى عليها. وهذا هو المعنى الحقيقي لطبيعة الفوضى التي يخلقها نظام التفاهة، لكن ألا يوجد ما يمكن فعله لمقاومة ومواجهة هذا النظام وهذه الفوضى الموجهان لاغتيال ثقافة المواطنة محليا وكوكبيا؟ وإذا كان فعل التفاهة صنيعة إنسانية ألا يمكن مواجهته بفعل إنساني أقوى منه؟ وما البداية المتيحة لوضع قطار المواطنة على سكته من جديد؟ هل يمكننا مواجهة نظام التفاهة دونما الوعي التام بمجموع شروط تكونه؟ هل تقتضي هذه المواجهة مجرد الشعور بخطورة هذا النظام فقط أم تقتضي الوعي به عقلانيا وأخلاقيا؟ وما سبيلنا الفلسفي حتى نعيد الاعتبار لثقافة المواطنة؟
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
[1] تجدر الإشارة ابتداء إلى ضرورة التمييز الذي رسخه الاستخدام القانوني والحقوقي الدولي بين مفاهيم المواطن والأجنبي واللاجئ والنازح والعامل المهاجر؛ فالمواطن الشخص الذي يحمل جنسية الوطن الذي يقيم فيه والأجنبي الشخص الذي لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه، واللاجئ الشخص الذي لجأ إلى دولة أجنبية جراء فقدانه حماية دولته الأصلية إن بسبب عدم قدرتها أو عدم رغبتها في حمايته، والنازح من ينتمي لمجموعة سكنية غادرت مكان سكناها اضطرارا وقد يكون النزوح داخليا أو خارجيا، والعامل المهاجر الشخص الذي يتمتع بحماية بلده الأصلي، لكنه هاجر إلى بلد أجنبي تحسينا لظروف عيشه.
[2] النموذج القديم للديمقراطية... فضل مبدأ الديمقراطية المباشرة الذي سمح للناس المجتمعين باتخاذ القرار مباشرة من داخل الأغورا مفتوحة أمام جميع المواطنين الأحرار، وهو نفس المبدأ الذي دافع على اعتماده نشطاء الثورة الفرنسية. انظر CHRISTIAN LE BART. CITOYENNETE ET DEMOCRATIE.LA DOCUMENTATION FRANCAISE.PARIS.2016. P.24
[3] "إن المدينة اليونانية هي التي أوجدت المواطن كعضو في جماعة المواطنين الأحرار المتساوين؛ أي ما كانت الاختلافات التي تفصل بين أولئك الذين يكونون المدينة من ناحية الأصل أو المكانة أو الوظيفة، فهم يبدون بشكل ما متشابهين، هذا التشابه يؤسس وحده المدينة" انظر
دومينيك شنابر وكريستيان باشولييه. ما المواطنة؟ ترجمة، سونيا محمود نجا. المركز القومي للترجمة. القاهرة. الطبعة الأولى. 2016.ص، 12
[4] المواطنة العالمية تعريب لكلمة cosmopolitisme، وهي تعبير يتكون من كلمتين يونانيتين؛ cosmos وتعني العالم، وpolites تعني المواطن، فالتعبير يعني حرفيا المواطنة العالمية القائمة على اعتبار الإنسانية أسرة واحدة وطنها العالم وأعضاؤها هم البشر جميعا بصرف النظر عن اختلافاتهم الدينية والعرقية والجنسية.
والكوسموبوليتية حسب "كانط إيمانويل" مثلا؛ فكرة تنظيمية يجب السعي دائما إلى تحقيقها دون تراخ إنها وجهة نظر فلسفية تتعلق بتقدم الحرية على الأرض بأكملها. إنها بمثابة خيط مرشد يجعلنا ننظر للتاريخ الكوني على أنه يتوجه نحو تحقيق نظام عادل على المستوى الداخلي وجمعية تتحد فيها أمم الأرض وشعوبها على المستوى الخارجي؛ أي نحو إقامة علاقات على المستويين الوطني والدولي تحكمها قوانين كونية عادلة، وفي هذه الوضعية ستنفتح كافة الاستعدادات الأصلية في الطبيعة البشرية. —كانط إيمانويل؛ فكرة عن تاريخ كوني من زاوية نظر المواطنة العالمية، ترجمة؛ محمد منادي إدريسي، نشر ضمن ترجمات مؤسسة مؤمنون بلا حدود، بتاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب، الرباط، ص2
[5] دولاكومباني كريستيان؛ الفلسفة السياسية اليوم، ترجمة؛ نبيل سعد، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2003، ص290/292