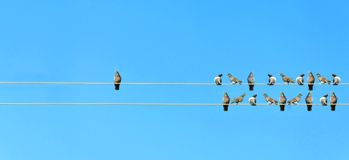ثنائيّة التنوّع والوحدة في الوعي الدّيني
فئة : مقالات

لا شكّ أنّ استشعار الإنسان لـظاهرة "الوحدة والتنوع" في الوجود الفيزيقي والرمزي والسيكولوجي يبدأ من اكتشاف أو ملاحظة الثنائيات، أو عندما تنشط فينا كأناسي القدرة على التمييز، من حيث هي قدرة فطرية للتحديد، فيشطر وعينا وجودنا ووجود العالم من حولنا إلى أزواج وثنائيات، فبمجرد "تحديد الأنا" يظهر "الأنت" أو الغير بصفة حتمية وآلية، فـ"الأنا" تتضمّن بالضرورة وجود "الآخر" ولا تكون إلا بوجوده، وعند حصول الوحدة ينتهي الزمن وينتهي معها إمكان المعرفة، فالوحدة في الفكر الشرقي الديني والميتافيزيقي كما يقال هي لا شيء، هي العدم لكلّ ما له حدود متعينة، (تورفالد دتلفزن. مقال مطبوع). وهكذا في كلّ تحديد تتعين المسافات وتدرك الأنواع والتنوع والآخر، ففي الوحدة تتقلص المسافات وتقلّ المعرفة إلى حيث الصفر، كلما تمّ الانصهار الكلي في الواحد، فالتخلي بعدئذ عن الحدود والتحديد والتشخيص يعني امتزاج الوعي باللاوعي، أو اتحادهما، فتصبح في ما يشبه حالة إبادة الأنا، وإبادة الأنت معها في الوقت نفسه، والدمج الكلّي في ما يُسمّى بالوحدة الكونية أو الاستنارة كما يقال في "النرفانا" أو الأنا والروح في الواحد كما في عقيدة التثليث (تورفالد دتلفزن. مقال مطبوع) أو في تجلي الله في كلّ شيء كما في الفلسفة أو التدين بوحدة الوجود، أو بقاء الطفل في الرحم، حيث المعرفة مستحيلة باستحالة الإرادة، وبالتالي استحالة التعدّد واستحالة حرية الاختيار، فكلّ ذلك تعبير عن حالة الاتصال النافي لكلّ انفصال وتعدّد، أو هو الكمال الذي لا هدف يتبقى له للإنجاز، كما هو الحال في اكتمال النظرية أو الأكثرية، أو الإجماع، أو اليقينية، أو فكر النهايات والانتصار الأبدي، أو منتهى الحقيقة... إلخ.
وعلى الرغم من وجاهة القول إنّ العالم ليس متعدّداً ولا قطبياً، وهو واحد، ولا توجد طبيعته القطبية إلا على مستوى الذهن البشري، وأنّ الحقيقة واحدة غير متعدّدة، وحال تعدّد العالم والحقيقة في أذهاننا أشبه بتعدّد مضامين الكتب في أذهاننا بتعدّد قراءتنا للمضمون نفسه الذي بقي واحداً وتعدّد في أذهاننا، إلا أنّ هذه الظاهرة الإدراكية تسمح لنا بالتأسيس على التعدّد والتنوع كحقيقة ما دام وعينا (الإنساني) يجعل العالم قطبياً أو متعدّد الأقطاب والأوجه بشكل حتمي، نقرر هذا ـ ولو على المستوى الشكلي ـ على الرغم من أنّ الموضوع بوصفه الحقيقة الموجود هناك في العالم يستعصي على التحول والتبدل بصفة كليّة حتى كمعرفة في الذهن، إذ يبقى ـ مهما أوّله العقل ومهما كانت عوامل التعرية التي تصيبه قوية ـ محتفظاً بخصائصه الجوهرية الصلبة التي لا تتبدّل، وتبقى على وحدتها ويبقى هو على وحدته، ولذلك أقرّت العقلانية بأنّ الوحدة بوصفها خاصية وجودية لكلّ فكر، ما هي إلا انعكاس لوحدة موضوع الفكر ذاته، والتعدّد بوصفه خاصية كذلك لفكر غني مرن، تأتي من تعدّد الموضوع الغني، وهو ما يفيد أنّ الحقيقة إذا كانت في أصلها واحدة، فإنّها تتجلى أيضاً بأوجه ومستويات متعدّدة، وحيث إنّ زوايا النظر إلى الموضوع الواحد متعدّدة، فمن الضروري أن تكون مقاربته بعدّة طرق أيضاً (تعدّد في المنهج)، أي أنّ الاقتراب إلى الوحدة بوصفها حقيقة يتمّ عبر انتخاب أفضل الطرق والمناهج، وهو ما ينفي في نظرنا صفة الإطلاق على تعدّد الموضوع، أو وحدته أو منهج مقاربته، ويتأكد لدينا انفتاح الوحدة على التعدّد في الموضوع والمنهج والعكس صحيح.
ومن ثمّة يجب ألّا يلغي أو ينفي أحدهما الآخر، كما هو الحال في الدوغمائيات حتى الوضعية منها، فإطلاق التسمية بوصفها فطرة إنسانية، هو في حقيقته تحديد وتشخيص وتعريف للشيء، وفي الوقت نفسه هو تجميع لعناصر متعدّدة وإدراك لنسقها وإلغائها بعدئذ بالتسمية من حيث هي تجريد لعدة جزئيات أو معانٍ في معنى كلّي واحد، فإطلاقنا على عصر معيّن (عصر الزراعة، وعصر النهضة، والصناعة، والحداثة، وما بعد الحداثة، والعولمة، والمجتمع المعلوماتي، والمجتمع الشبكي ...إلخ) إن هي إلا إدراك متنوّع لنسق الخصائص والعناصر المتنوّعة، فيتمّ تجميعها في اسم واحد بغرض السيطرة على دينامياته بخلفية قد تكون إيديولوجية، من حيث هي الخلفية الموحدة لما هو متعدّد، فميلاد علم الكلام واستنبات القول الفلسفي هو ميلاد للتعدّد والتنوع في مصدر المعرفة وطرق الوصول إلى الحقيقة، والاعتراف بعجز الواحد وحده، شخصاً أو ثقافة، للوصول إلى الحقيقة كما تبين لابن رشد، ولو أنّ الحقيقة المعنية هي واحدة، من حيث هي الشريعة في المنظور التقليدي الإسلامي.
فسواء وقفنا على تلك الحقيقة عبر البرهنة والحجج الفلسفية المثالية والوضعية التجريبية وغيرها، أم بالمعرفة اللاهوتية الدوغمائية (العقيدية) أم بالميتافيزيقا والبداهة المباشرة واليقين... إلخ فالنتيجة واحدة، من حيث هي حقيقة التنوع الذي يخفي الوحدة ولا يلغيها، وحقيقة الوحدة التي تبطن في ذاتها التنوع ولا تلغيه، فيجب ألّا تلغي الحداثة التراث، ولا الأنا تلغي الآخر والعكس، ولا الظاهر يلغي الباطن والعكس، ولا الرجل يلغي المرأة والعكس، ولا المركزية تلغي اللامركزية والعكس، ولا هذه النظرية تلغي الأخرى ولا الثورية في العلم تلغي التراكمية العلمية... إلخ، هذا ما تقول به أديان وعقائد التوحيد ومساحة كبيرة من الفكر غير الدوغمائي، مع التباينات والاختلافات التي تُعدّ هي الأخرى تجليّاً من تجليات التنوع والوحدة في الأديان ذاتها، باعتبارها ذات وجود تاريخي تتعدّد كصيغ للتدين والفهم. فوعينا في حدّ ذاته انشطر في المعرفة إلى وعي وما تحت الوعي واللاوعي، ودماغنا انشطر نصفين وتحدّد كلّ نصف في وظائفه، بينهما الجسم المحدّد هو الآخر بالوصل بينهما، وانقسم الإنسان في الفكر إلى عقل كلّي وعقل موضوعي، وإلى عاطفي وجسدي ...، وبين كلّ هذه الأقسام امتدادات...، وهكذا ينشطر الواحد (كواقع وحقيقة) إلى عدد (ثنائي) في وعينا، الظاهر والباطن، الأنثى والذكر، الصواب والخطأ، الخروج والدخول، جميل وقبيح، حداثة وتقليد، الحق والباطل، الظلم والعدل )...إلخ.
فلا يدرك أحد الزوجين (القطب) إلا وكان الآخر (القطب المضاد) قد أدرك هو الآخر في الذهن، وحدّد بحدوده الأنطولوجية، فكما يقال تدرك الأشياء وتعرف بأضدادها، فلا وجود للزوج ولا معنى له كزوج دون الزوجة والعكس صحيح، ودون الدخول في جدل الأزواج بوصفها أضداداً أو مظهراً متعدّداً للحقيقة الواحدة، إلا أنّه يمكننا التصديق من غير شك فلسفي، أنّنا ندرك الواقع بهذه الطبيعة الانشطارية التي تمنحها إيّاها طبيعة وعينا، من حيث هو "إمكانية المعرفة"، وهي في منظورنا نعمة الاعتراف بالآخر، إذ أنّ الأنا لا يمكن لها أن تعرف بدون استشعار وجود الآخر (الأنت والأشياء الأخرى...) باعتبار كلّ ما هو منفصل عنها موضوع للمعرفة.
فيصبح الوضع في الإدراك منقسماً إلى عارف ومعروف، وفاعل ومفعول، وهو ـ أي فعل الإنسان ـ ما يُعرف بـ"التاريخ" بوصفه تجربة مستمرّة من توليد المعرفة والصيغ وتنويعهما، وسجال العلماء بكلّ مستوياته وأشكال الحوار حول الحقيقة يُعدّ مصدر الغنى للتجربة والفكر، كما يُعدّ بذاته تعدّداً وتجليّاً من تجلياته في المواضع والأحداث والقراءات والفهم، ولذلك تعدّدت ـ تبعاً لذلك ـ المعارف والعلوم وانشطرت إلى تخصّصات ومناهج تثري المواضيع وتغنيها، ومن ثمّة فهيمنة الوحدة في أيّ صيغة من صيغ إدراك الوجود في مستوياته التجريدية الأعلى، يعني إلغاء لكلّ إرادة للمعرفة بمحو المسافة بين الذات والموضوع. ثمّ هو في مستويات أقل يهمل عناصر التعدّد الموجبة لإدراك الوحدة وفق انتظام تلك العناصر في وحدة، فلا ينتج إلا الدوغمائية من حيث هي بحث عن الوحدة في التجانس ورفض لأيّ تعدّد، أي هي القفز عن جدلية الوحدة والتعدّد، كما أنّ التماهي مع خاصية التعدّد من غير إدراك أو اعتبار لانتظام عناصرها يقود إلى التفكك وإلى اللامعنى.
والإدراك من جهة أخرى وبما هو تجربة إنسانية يتعدّد بواسطته العالم، فهو لا يتمّ إلا بشكل تعاقبي، فلا تدرك الوجوه المتعدّدة للواقع الواحد إلا بشكل تناوبي أو تعاقبي، وبذلك ينشأ عنه الزمن كتاريخ، وتزامن الإدراك للقطبية يكاد يكون مستحيلاً، ويكون الزمن فيه منعدماً، ويصعب بعدئذ إدراك الوحدة وراء القطبية إلا بما يُسمّى البصيرة، بوصفها مرجعية خلفية تجمع بين القطبين أو بين الأقطاب يتيحها إدراك انتظام عناصر التعدّد، فتدركها كما لو أنّها واحد متصل وملتحم ومتّحد، والبصيرة رغم أنّها ميزة عامة للنوع الإنساني، إلا أنّها تتجلى وظيفياً أكثر عند ذوي النهى أو البصيرة أو النخب والراسخين في العلم، يتمّ بها إدراك كلٍّ من التنوع والوحدة في مستويات معرفية عليا، إذ أنّ التمدد النخبوي والراسخ في العلم والمتعمق في الفهم، بحيث يكون غير قابل للتصنيف والتنميط في هذا المذهب أو ذاك، أو في هذه النظرية أو تلك، يمكنه تمدّده المعرفي من اختراق "الحدود والتحديد" (الديني، الطائفي، العرقي، الأيديولوجي، التخصص العلمي، الوطني، القومي، الطبقي...إلخ) فيرى الخلفيات الموحدة (أرضيات لصور) بما يظهره الإدراك من تعدّد وتناقض الأشياء والصور، فيكشف عن انتظام عناصر التعدّد كما لو أنّها وحدة.
فليس من السهل إذن على البسطاء إدراك ما بين المؤمن والكافر ـ المتناقضين ـ من اتصال في الدائرة الإنسانية، بوصفها دائرة التجلي لوحدة الإنسان والإنسانية والتي تحتوي التنوع والاختلاف، وليس من السهل على بسطاء الثقافة إدراك ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفريضة، والحرية كفطرة ـ المتناقضين ـ من تناغم ووصل في محيط أو مستوى من الفهم، تسمح بتمييزهما كصورة تظهر أرضية أو خلفية وحدتهما بشكل واضح، بحيث ينتفي فيه تعارضهما وتقابلهما كضدين. ومن ثمّة فلا يمكن للإدراك أن يدرك الوحدة كوجود مستبصر، إلا من خلال التعدّد المستوجب للمعرفة، ولا يمكن له أن يعرف إلا من خلال انشطار العالم وانقسامه وتعدّده، ومن ثمّة ضرورة التأسيس للحوار بين المختلفين تحكمه أخلاقيات من طراز التسامح.
ولعل صعوبة إدراك تلازم هذه القطبية وإدراكها بشكل تعاقبي، هو ما جعل الوعي الإنساني في كثير من الأحيان ـ في موقع الدوغمائية أو التطرف ـ يدركها كما لو أنّها متضادات ومتناقضات، أو أقطاب وقطبيات متجاذبة مغلقة لا صلة بينها، فينحو العقل أو المرء نحو الإلغاء والإبادة، كما في حالة محاولات إلغاء الشر وإلغاء الباطل وإلغاء القبيح وإلغاء الظلم...، وكلّ ما تحدده المعايير ـ المختلفة هي الأخرى ـ أنّه مضاد للأنا، وقد يمتدّ الإلغاء إلى الآخر المتماثل في النوع حيث المساس بالتسامح، كما في حالة إلغاء الآخر الإنساني والثقافي بوصفه منافساً مهدداً، وفي الجملة هو إلغاء للتعدد لإنتاج التجانس والوحدة بصفة قسرية (ديكتاتورية).
ولعل هذا الإلغاء يعود في عمقه التاريخي كتجربة معرفية إلى ميراث الإنسان "الصراعي" بين عقيدة تعدّد الآلهة، والإله الواحد، حيث إنّ عقيدة التعدّد في الفكر الفلسفي المادي وكأنّها تنحاز كما يتجلى في كلّ صيغه المعرفية إلى رفض الوحدة، ابتداء من رفض النبوة وقدسيّة النص والشخص كمصادر للمعرفة، وتعويضها بالفيلسوف الذي يتسنّى لأيّ أحد قبول أو رفض أفكاره في نطاق النسبية، فلم تعد هناك حاجة إلى الكليّة والانقياد لفكر واحد في كثير من الأفكار المادية، بقدر ما أصبحت المعرفة في حاجة إلى التجزيء وهو ما قاد أيضاً بحسب التطور الكرونولوجيسوسيولوجيا إلى تكريس المجتمع الصراعي وهيمنته على الفكر المادي الحداثي، العلمي منه خاصة، فصار كما لو أنّه إعادة إنتاج الدوغمائية في ثوب حداثي.
فعلم النفس رصد ظاهرة الصراع تلك في ذات الفرد نفسه بإدراكه ورصده لبنيته النفسية كما لو أنّه أقسام متعددة متصارعة، وأنّ الفرد يعيش حالة الانفصام في تجاذب الحداثي والتقليدي، فيطمح أو يميل إلى أن يعيش العصرنة والحداثة، فيخرق التقليد والطابوهات الجنسية مثلاً قبل زواجه، في حين يميل إلى استحضار الطابوهات والتقليد في حياته الزوجية ليعيش أصالته...، وفي السوسيولوجيا يعيش الإنسان صراعاً بين اللغة الأم التي تحمل له قيمه وتقاليد جماعته الكبيرة مجال انتمائه وهويته، فتحمله على التمسّك بها وتيسير دمجه في نسقها بوصفها صورة من صور الوحدة أو الكليّة أو الوطنية، لا ترتاح للتعدّد الناشئ للتفرد اللامتناهي المفضي إلى التشرذم، وفي السياسة تكرّس عقيدة التعدّد في النظم الليبرالية، فيفسح المجال للتعدّد الحزبي من حيث هو تجلٍ من تجليات تعدّد الآراء الموجب للحوار والنقاش الديمقراطي، ومن ثمّة البحث عن صيغ يتمّ فيها توزيع الإرادات والقوى والسلطة بشكل يمنع العنف، ويقلل من احتمالاته بالحوار والتسامح السياسي والديني، وفي الاشتراكية عوض التعدّد في الفردانية بالتعدّد الطبقي والصراع بين الطبقات، ولم يعر الماركسيون لعناصر التعدّد الأخرى المتورطة في إغناء التغير الاجتماعي أيّة أهميّة، إلا من حيث هي صراع إلغائي، إن صح التعبير، وفي كلّ الصيغ هي إدارة للتعدّد وحفاظ على الصراع، من حيث هو تعدّد صراعي ـ إن صحّ التعبير كذلك ـ يهيمن بعضه على بعض وفق موازين ومعايير توزيع القوة والسلطة.
وفي الدين المنقسم في التدين إلى طوائف من المفترض فيها أن تكون مدارس معرفية تثري التنوع وتغنيه وتقوي وحدة الدين الواحد، إلا أنّها تعيش حالة التشرذم وصراع الطوائف واختزالها للدين في الطائفة، من حيث هو من قبيل اختزال الكلّ في الجزء، فنشأ الإلغاء والصراع المذهبي والطائفي باسم التعدّد ذاته فيتعذر إدراك الوحدة والحقيقة، ويبتعد الراسخون منهم في العلم عن الحقيقة الكليّة كلما انغمسوا في الطائفية، وفي التنظيم البيروقراطي نعيش صراعاً بين المركزية من حيث هي تجلٍ من تجليات الوحدة والشمولية، واللامركزية من حيث هي مدخل لبروز التعدّد اللامتناهي، وصراع بين المركز الموحد والهوامش المتعدّدة، وصراع اللبرالية بوصفها حرية الانوجاد والتعدّد والمبادرة، والاشتراكية من حيث هي تحويل الفرد إلى عضو لا معنى له إلا من حيث وجوده الاجتماعي، وصراع الشعب الواحد المتوحد (الشعب العربي) الذي يلغي ويحجب كلّ تنوع ثقافي بهيمنة الثقافة المشتركة الحاجبة لكلّ الثقافات الفرعية والمناطقية ... إلخ، كما هو الحال في تضخم البيروقراطية في صيغ الدولة القومية والوطنية، حيث تختفي كلّ معالم الثقافات المناطقية واللغات الفرعية والمبادرات الجهوية ... إلخ.
إنّ هذه الأمثلة وهذه الشواهد نعدّها مؤشرات تشير إلى ما آلت إليه المقاربات الصراعية للشأن الإنساني، من حيث ثنائية الوحدة والتنوّع، التي انعكست بهيمنتها كباراديغم نوعي في العلوم على صيغ التدين ذاتها، فصارت "تدينات متعدّدة" إن صح التعبير بدون مرجعيات موحدة، وظهر في كل من المقاربات العلمية والمقاربات الدينية المتأثرة بالمجتمعات الصراعية انحياز واضح لفكر الانفصال الذي يلغي الاتصال رغم إقراره بالاتصال الشكلي كما أوضحنا، وهو تاريخ للنفي مستمر، نفي دين لدين، ونفي نظرية لنظرية، ونفي جماعة لجماعة، ونفي نسق لنسق ولغة للغة... إلخ لا ينتج إلا الصراع والإغلاق في الأنساق، والتمركز حول الذات في الثقافات، وهو ما يجعلنا غير مرتاحين لكلّ من يجاري الفكر الصراعي من حيث إنّه فكر يرزح تحت ضغط البداهة الدوغماتية أو الوثوقية والأرثوذوكسية نافياً للتعايش وتعدّد المشارب والمنافذ، مهما ادّعى أنّه تنافسي غير صراعي، فهو ليس إلا أصولية متدثرة بالحداثة والتنوع والحرية، ذلك أنّ كلّ ميلاد في المعرفة الحداثية ذاتها ليس طفرة ولا هو إلغاء لما قبل الميلاد، فانفصال الطفل عن الأم كميلاد للتعدّد الاجتماعي والنفسي، ليس إلغاء للاتصال، من حيث هو نزعة للوحدة والتآلف والتعاون التي تصحب الميلاد وإعلان الطفل عن حاجته للاتصال بالأم عبر آليات الرحم الاجتماعي، إن صحّ التعبير، بل يعتبر حضورهما في وجدان البشرية وتصوراتها تنوعاً في حد ذاته، ولعل هذا ما انتبهت إليه مدرسة فرانكفورت وأبدعت ما سُمّي بالعقل التواصلي من حيث هو فتح المغلقات والأنساق المكتفية بذاتها، سواء في مقاربات اللاهوت، أو في الفلسفات الوضعية الإمبيريقية.
وبالعودة إلى مقاربة الدين في منابعه الصحيحة أو الدين كما هو كما يقال لمسألة الوحدة والتنوع، فيبدو أنّ ما كرّسته التعاليم الدينية المتعدّدة في ضمائر المتدينين من "الوحدة والتنوع" في الوجود، ليس تناقضاً وليس صراعياً كما هو في الفكر المادي أعلاه والفكر المختلط الممزوج بالميتافيزيقيات واللاهوتيات، فما كرّسته الأديان في عقول وضمائر المتدينين، من فكر الوحدة والتوحيد (الأصل الواحد، والإنسان الواحد، والله الواحد، والدين الواحد، والشرائع المنزلة الواحدة، والكون الواحد، والأرض الواحدة، والسماء الواحدة، والقوانين الكونية الواحدة، والمجتمع الواحد، والإنسانية الواحدة، والمصير الواحد... إلخ) هو تكريس لعقيدة التوحيد ونبذ الشرك، وتكريس من جهة أخرى لفكرة توحيد الجهود الفردية المتنوعة لإنجاز مهمة الخلافة والاستخلاف في الأرض، من حيث هي قضية بشرية مشتركة بين جميع الأمم تتعلق بالعمارة، تتطلب حشد كلّ الطاقات لإنجازها، إذ لا يمكن لفرديات ولا لإثنيات ولا لحضارات متفرّدة أن تقوم بمفردها بمهمة الإعمار الموجبة بمقتضى استخلاف الإنسان المطلق، ومن ثمّة فلا مناص من الاعتقاد بـ"أمّة القطب" كما يسميها "طه جابر العلواني"، من حيث هي أمّة البشرية ـ ولو على سبيل الافتراض ـ بحيث تكون هي الجاذبة لكلّ الجهود كهدف إجمالي من الوجود، تجتهد كلّ البشرية بما تنتجه من مفاهيم ومضامين معرفية وصيغ وطرائق ووسائل متنوعة في تحقيقه، (لكلًّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً)، فأبواب الخير كما يقال متعدّدة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بما أوتوا من السمع والبصر والفؤاد والحكمة البالغة.
وظاهرة التنوّع هي الأخرى أصلية في الوجود، سواء تلك التي تبدو في حتمية الاختلاف في الإدراك الإنساني للموجودات، فالشيء الذي دخل الذات لا يخرج هو، فالحقيقة وإن كانت واحدة خارج الذات، إلا أنّها تتعدّد في الأذهان، كما سبق أن أوضحنا، أو تلك التي تتجلى في الطبيعة للعين المجرّدة من مشاهد التنوع في كلّ الحياة، كاختلاف الليل والنهار واختلاف الألسن واختلاف الحضارات والثقافات والنماذج واختلاف الأزمنة واختلاف الطرق والمناهج والوسائل، فهذا المشهد المتعدّد والتنوع بمظهريه الوجودي المادي والإدراكي الإنساني، حتى لو يختزن في ذاته وحدة، لا تفارقه العين المجرّدة وتلتقطه الحواس وتدركه العقول في كلّ لحظة. ومن ثمّة فما يظهر من تناقض بين الوحدة التي تعكسها مظاهر الوجود الكبرى وغاياته وكرّستها الأديان في كليّاتها كعقيدة للبشرية، والتنوع الذي يتجلى في صيغ الوجود الطبيعي والحياة البشرية، هو في حقيقته سنن الحياة والطبيعة. فانقسام كلّ الأحياء إلى الأزواج كتنوع أو تعدّد، لا يلغي وحدة الأزواج كنوع، والرجل والمرأة بوصفهما ـ كما يتجليان ـ زوجاً، لا يلغي وجودهما الزوجي وحدتهما كنوع بشري. وهو ما يقتضي وضع التنوع الطبيعي وتسخيره في جهود بشرية من الإعمار، لبلوغ الهدف الإنساني الإجمالي. ولن تكون تلك الجهود إلا متنوعة من حيث المضامين والطرق والمناهج والمواد المُسخّرة من أجل المصير المشترك في الدنيا (كسعادة)، وفي الآخرة (كنجاة).
وبمقتضى هذا التركيب السنني للتنوع والوحدة، استوجب ضرورة إحضار الوحدة بوصفها كليّة لمنع التشتت والتجزيء المفضي إلى الفوضى، واستحضار التنوّع كسنّة من أجل الإبداع والابتكار وتنويع الجهود لتكريس ثقافة الخيار من حيث هي مبرر الحرية. وأنّ كلّ تجاوز لهذا التركيب السنني يُعتبر انحرافاً في الإدراك، فلا يساعد على الإعمار وبلوغ أهداف السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وأنّ إقصاء ورفض الوحدة لصالح التنوّع أو العكس، هو تجاوز أيضاً للسنن لا يساعد على بلوغ الأهداف ذاتها، لأنّه انفصال لمركب الوحدة والتنوع في الوجود، لا يؤدي تكريس أحدهما كمهيمن على الآخر في الحضور إلا إلى إنتاج صيغ التعصب والتصلب والهيمنة والسيطرة (أنا خير منه)، إن في حالة التنوع المضاد للوحدة، وإن في هيمنة الوحدة اللاغية لكلّ تنوع، فكلّ مظاهر الدمج القسري في الواحد أو كلّ مظاهر التشتت والتفكك، هي آتية في ما نرى من الابتعاد عن ما يمكن أن نسمّيه سياسة "التآلف والتعارف" الموجبة بموجب سنّة "الانفصال والاتصال".
وبموجب الاختلاف في الإدراك بين الناس لأسباب موضوعية وذاتية حتمية، يقتضي التسليم باستحالة امتلاك أيّة ذات أو جماعة للحقيقة، كما ثبت ذلك عند ابن رشد فتوسلها أيضاً في الفلسفة، ويقتضي أيضاً التسليم بتعدّد مصادر المعرفة كما ثبت ذلك عند ابن خلدون، فتوسلها في السوسيولوجيا بدل الاقتصار على النص، ويقتضي أيضاً التسليم بما أخذ يتعمّم من صيغ المجتمع الشبكي، من حيث هو مجتمع متعدّد غارق في الخصوصيات الفئوية والفردية والواقعية ينفك عن سلطة الدولة الدمجية الحارسة، وفي الوقت نفسه هو متعالٍ عن الزمن والمكان (العولمة). ويقتضي التسليم بحق كلّ الناس في أن يعيشوا واقعهم كما يدركونه ويغيّرونه كما يريدون، وحقهم في البحث عن الحقيقة وإبداع طرق الوصول إليها بما يملكون من معارف وقيم، ويقتضي عدم المفاضلة بين الناس بالعرق أو الجنس أو اللون أو الطائفة...، إلا في نطاق العلم من حيث هو أفضل صيغ التدين والرقي إلى معرفة الحقيقة، فلا هيمنة لعرق أو لفكر أو لطريقة أو لثقافة أو للغة في معرفة الحقيقة، الأمر الذي يقتضي العمل بالمراكز المتحركة في السياسة والاجتماع والثقافة، فلا احتكار لمركز واحد، واستحضار الحوار كمبدأ إنساني لانتخاب أفضل صيغ العمارة في الأرض، إن عبر الإقناع وإن عبر التدافع في نطاق التعارف بين الثقافات، ولهذا أمر (بضم الهمزة) النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم على ألّا يُكره أحداً على غير ما يختار، ولا يسيطر على أحد (لست عليهم بمسيطر). وهو ما يجعلنا نرفض صيغ الدمج القسري كأساليب في السياسة، فيسيطر الحزب الواحد على كلّ مفاصل ومفاتيح التنمية، أو التربية فتهيمن فيها وتسيطر إيديولوجية أو بيداغوجية أو لغة أو ثقافة طائفة واحدة، أو في السوسيولوجيا فيهيمن كلّ ما هو ماكرو على الميكرو... إلخ، ففي كلّ تلك الصيغ لا تقود الجيل أو الأجيال إلى الوحدة بقدر ما تقود إلى سيطرة الديكتاتورية وثقافة الشيطان (أنا خير منه)، ونشوء النزاعات والصراعات والعنف.
ومن ثمّة فالتأسيس لهذا التركيب لظاهرة الوحدة والتنوع أعلاه ليس تأسيساً فكرياً صورياً أو ميتافيزيقياً، بل هو قبل ذلك تجلٍّ وجودي في الحياة، ولذلك ففي مستويات أخرى من التحليل لمركّب الوحدة والتنوّع، يتبين أنّه حقيقة لا تدرك فقط بالتحديد والتشخيص والانفصال، بل هو مركّب موجود ومتضمن في بنية الواحد، فالتنوع موجود في الواحد كطبقات بما في ذلك المجتمعات، وكذا النصوص القبلية الدينية والموضوعية بوصفها معرفة، فكلّ نص إنّما هو سطوح وأعماق من الطبقات، والمجتمعات البشرية كذلك، فبما هي نوع واحد فهي كذلك متنوعة، وتنوعها طبقات، يخرق سطوح وجود الإنسان في تجمعات إثنية وجماعات منظمة، إلى أعماق الفردية والخصائص الجينية، والثقافات سطوح وأعماق لا نهاية محددة لها، ولا تخلو طبقة من خاصية أو سنّة مركّب التنوع والوحدة في ذاتها، فلم تلغ كلّ صيغ التنوع وتعدّد الطبقات جهود البشرية لإنتاج صيغ الوحدة، ولو في تقرير ما يمكن اعتباره "المشترك الإنساني"، فكلّ معابد ومساجد العالم ـ مع تبايناتها وخصوصياتهاـ تتفق على وحدة أخلاق الجنس البشري، وكلّ مدارس العالم في كلّ المجتمعات تستقبل الأطفال كفرديات شديدة التنوع في ذاتها وفي أصولها الثقافية، لجمعهم في محيط مشترك واحد.
ومن ثمّة فإذا ما قاربنا مسألة الوحدة والتنوع تربوياً من حيث إنّ التربية هي أولى من غيرها المعنية بإنمائها في الذات من حالتها الفطرية إلى حالتها كفضيلة سلوكية أخلاقية، فنؤسّس ذلك على أنّ المدارس كالمجتمع طبقات، وليست مجرد سطوح، فإذا كانت السياسات التربوية من حيث هي مبادئ وخطوط عامة توحيدية للاتجاه التربوي العام، وهي من سطوح المنظومة التربوية تتكفل أيضاً بإدارة التنوع الثقافي واللغوي وتنوع المصالح والرغبات بتنويع المسارات الأكاديمية والمحتويات، فإنّ المدارس في محيطها وفي داخل الفصول الدراسية تتكفل بتدريس ما نسمّيه سنّة أو مركّب (التنوع والوحدة) كما لو أنّه الأرضية الصلبة الملائمة لبيداغوجيا التدريس ضمن مفهوم التربية حرية (مفهوم أسّسناه في بحث تحت الطبع والنشر)، حيث تستنبت سنّة التنوع والوحدة كتمثلات ذهنية على مستوى التفكير وممارسات سلوكية على مستوى الاستجابات. فكلّ قفز عن هذه الحقيقة بأن تلغي السياسات أو المدارس خاصية التنوع والتعدد في الثقافات والفرديات، سيكون بالضرورة في حكم التناقض مع الفطرة، وينحرف إلى حيث غايات تضرّ المجتمع والفرد على حد سواء.
وعليه فإذا كان ما دأبت عليه المدارس من اختزال التنوّع تحت ضغط أيديولوجية "التربية الوطنية" بإبراز مظاهر التماثل والوحدة، بفرض بعض الطقوس كالحضور الموحد في الوقت وباللباس الموحد في الشكل واللون، والوقوف في صفوف واحدة، وضبط قانوني للحركات وحتى للسان، واستحضار للقيم الوطنية الجامعة واحترامها من الكل... إلخ يندرج ذلك كله في تربية النزعة الغيرية والوحدة الكليّة، وتدخل ضمن وظائف السياسات الجامعة في سطوح التربية المدرسية العمومية، فإنّ البيداغوجيا هي أكثر الطبقات التي يتعين عليها أن تكون وفيّة لتربية التنوّع وتعليمه واستنباته كتمثلات في التلاميذ، من حيث هم فرديات متمايزة بيولوجياً ومعرفياً وثقافياً، وهو ما يستوجب على البيداغوجيا إبداع صيغ التآلف لإنتاج الوحدة من التنوع، دون فرضها من الخارج، وفي صياغة المشاريع المجتمعية في مشكلات جزئية محلية (مشكلة الاتصال، مشكلة الغذاء، مشكلة الصحة، مشكلة التقدّم، مشكلة الهويّة، مشكلة القيم... إلخ) في نطاقها العالمي والإنساني كما تتجلى في الواقع المعيشي هي تربية لحضور ما هو محلي واقعي متعدّد ولحضور ما هو عالمي متجاوز للزمان والمكان، ومن شأن ذلك أن يربّي في النفس والجيل سنّة المركّب (التنوع والوحدة)، وهو تحدٍ للمدارس والبيداغوجيات لاستنبات قانون الاتصال والانفصال، وتمدّد ما هو محلي إلى ما هو إنساني، وما هو مركزي إلى ما هو لا مركزي...، فالكائنات البشرية سيكولوجيات متنوّعة وألسن متعدّدة، وكلّ ذات سيكولوجية وكلّ جماعة ثقافية هي حالة بحدّ ذاتها، ممّا يستوجب إدارة التنوع والوحدة من غير إلغاء أحدهما الآخر.
فإذا استحضر المعلم طقوس التنوع والتعدّد، كما تستحضر أدبيات التربية الوطنية طقوس الوحدة، فيستحضر في كلّ درس يبنيه إمكانية الوصول إلى نتائج واحدة في كلّ ما يطرح من إشكالات رياضية أو فيزيائية أو تاريخية أو أخلاقية أو اجتماعية أو سيكولوجية. وليس حتماً أن يصل إلى النتيجة الواحدة عبر طريقة واحدة لا ثانية لها. واستحضار ذلك كترجمة بيداغوجية واعية، فإنّ الطريق لتعليم التنوع كتحدٍ سيصبح على طريق الإنجاز في الصفوف الدراسية، حيث يتعلم الأطفال ـ بهذا الاستحضار ـ تنوّع البرهنة وتنوّع طرق إنجاز العمليات الحسابية من طرح وضرب وقسمة، وأنّ المسالك والطرق التحليلية والمناهج لمقاربة الظواهر الاجتماعية والإنسانية قد تكون شديدة التنوع، ولكنّها توصلنا إلى نتيجة واحدة. بمعنى أنّنا ننتهج "الصراطات المستقيمة" إذا ما جاز لنا استعارة هذا المفهوم الذي وظفه "عبد الكريم سروش" ليعبّر به عن تعدّد قراءة الدين، فنعمّمه كبديل عن القراءة بالصراط الواحد في كلّ ما نتعلم.
ولتفادي التشرذم والتفكك في تدريس التنوع كمناهج وطرق ومضامين، وتفادي في الوقت نفسه الدمج والإكراه القسري في تربية الوحدة كأهداف وغايات، نرى في توظيف مفهوم "التآلف" وتحويله إلى سياسة بيداغوجية، المخرج الأكثر نجاعة لاستنبات ثقافة ما يُسمّى أخلاق الاعتراف والتعارف المتبادل بين الأنا والآخر، وتفادي خطر الأحادية الفكرية والمساس بالحرية والكرامة. فالتآلف بما يحمله من أخلاق يمكنه أن يساعد على ترسيخ ثقافة التفاهم من حيث تطلع التربية إلى فهم ما هو إنساني ويعطي معنى لمفهوم الإنسانية أكثر تساوقاً مع مفهوم الكائن الإنساني البشري، كما يمكن له ـ أي التآلف ـ أن يشكّل الإطار المفهومي لبيداغوجيا متساوقة مع مفهوم "التربية حريّة".
وبما أنّ التربية حريّة تقوم على مبدأ الإبداع في إنتاج البدائل البيداغوجية الملائمة للوضعيات الثقافية وللحالات الخاصة، فإنّها لا تمنع ـ من منطق برجماتي ـ أن تستفيد من صيغ ونماذج حديثة للمدارس التي تفرزها المجتمعات الشبكية المتنوعة في ثقافاتها وصيغها، من مثل مدارس التثاقف، ومدارس المواطنة، والمدارس الذكية، والمدارس المتنوعة، التي تسمح بتفاعل الثقافات في محيط مدرسي تربوي واحد، كما يمكن أن تستفيد من الصيغ البيداغوجية التي طوّرتها أحدث العلوم التربوية (الديداكتيكا) علم التدريس بالتجربة الميدانية، كبيداغوجيا الكفايات والوضعيات وحلّ المشكلات إلى غير ذلك من الصيغ المتساوقة من التعلم الذاتي ومبادئ السيبرنيطيقا من حيث هي التعلم الذاتي والتوجيه الذاتي والتوليد الذاتي. حيث تتيح هذه النماذج البيداغوجية ألواناً من التعدّد المنتظم في وحدة فتستنبتها كمركّب في النفس وثقافة في السلوك تحرّك الجيل أو الأجيال في المدى البعيد نحو إدراك الغاية الكبرى من وجود مركّب التنوع والوحدة والسعي لتجميع الطاقات لتحقيق الإعمار.
خلاصة:
التحليل أعلاه، وفي كلّ المستويات الدينية والفلسفية والسوسيولوجية والسيكولوجية، يوصلنا إلى أنّ ظاهرة "الوحدة والتنوّع" في الوجود ـ في الطبيعة وأحوال الناس ـ ظاهرة شاملة لها أصولها في الطبيعة كوجود مستقل عن الذات، وفي النفس الإنسانية كإدراك للموجودات كحقيقة واحدة، فيعدّدها بقدرة التحديد والتشخيص والتمييز، كما يدركها كمركّب من الجزئيات والخصوصيات والسطوح والأعماق، فيفرض على الذهن استحضارها كتنوع، وإذا كانت المقاربات المادية قد اكتشفت هذا التنوع والوحدة مبكراً واكتشفتها كمعرفة في الطريقة والموضوع، إلا أنّ إدراكهما يتمّ في كثير من الحالات كما لو أنّهما ظاهرتان منفصلتان، بل هما متناقضتان صراعيتان يقصي ويلغي بعضها بعضاً، فأخفقت مقارباتهما ـ بحكم "االتناول الصراعي" في إدراك خلفية التنوع باعتبارها خلفية للوحدة، فآل الأمر بمعظم المقاربات المادية وحتى اللاهوتية والميتافيزيقية إلى التحيزات والتفكيك والتشتت اللامتناهي، ممّا فرض عليها صيغ الدمج القسري وإنتاج الوحدة بالديكتاتورية في التربية والسياسة والاجتماع ... إلخ، غير أنّ المقاربة الدينية تقتضي استحضار الوحدة والتنوع لا كظاهرتين منفصلتين ومحاولة الجمع بينهما، بل باستحضارهما كمركّب غير قابل للتفكيك حتى في تلك الصور التي تبدو متناقضة بين الأزواج والثنائيات، بما تستفزّ الذهن النخبوي والراسخين في العلم لإدراك الخلفيات والدوائر والأنساق الكليّة الجامعة لما هو متناقض، فيتمدّد الكلّ للكلّ، فتدرك الوحدة بالتآلف بدون صراع ولا دمج قسري، وتلك هي الصورة التي ندعو إليها في تنظيم مدارسنا ومجتمعاتنا، تنتفي فيها حالات النفي، وتنتعش فيها حالات السعي بحرية نحو تجميع الطاقات لإنجاز ما هو مشترك، وغاية كبرى وهدف في العالمين. والله أعلم.
للبحث مراجع منها:
1ـ طه جابر العلواني. التعددية أصول ومراجعات. منبر الحوار. (العددان 32، 33) 1994. دار الكوثر. بيروت. لبنان.
2- الميلودي شغموم. الوحدة والتعدد في الفكر العلمي الحديث. (هنري بوانكاري وقيمة العلم) ط1/1984. دار التنوير للطباعة والنشر. بيروت لبنان.
3ـ فرتجوفشيئون. المعرفة شرط إنسانية الإنسان. ت. نهاد خياطة. ط1/2000. مؤسسة (مجد). بيروت، لبنان.
4ـ عبد السلام بن عبد العالي. في الانفصال. ط1/2008. دار توبقال. المغرب. الدار البيضاء.
5ـ دارن بارني. المجتمع الشبكي. ت. أنور الجمعاوي. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدوحة. بيروت لبنان.
6ـ علي بن مخلوف. التصديق والحقيقة في التقليد الفلسفي العربي في القرون الوسطى. في سلسلة مفاهيم عالمية. الحقيقة. إشراف نادية التارزي. ط1/ 2005. المركز العربي الثقافي. بيروت. لبنان.
مطبوعات:
1ـ تور فالدد تلفزن. القطبية والوحدة.
2 ـ محمد اسليم. هوامش في السحر. حبّ هذه وحبّ تلك، أو بين الحداثة والتقليد.