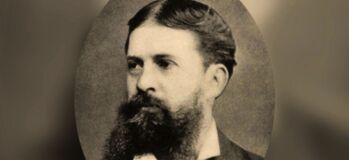دراسة في كتاب: «أبحاث في فلسفة المنطق للدكتور حمو النقاري» (مفهومي التقليد والتجديد)
فئة : قراءات في كتب

دراسة في كتاب: «أبحاث في فلسفة المنطق للدكتور حمو النقاري»
(مفهومي التقليد والتجديد)
تقديم:
إنّ هذه الدراسة الموسومة بعنوان «أبحاث في فلسفة المنطق» للدكتور حمو النقاري، تضعنا موضع الدهشة وتجعلنا نتلقّى موضوعاتها بانبهارٍ؛ لما تتميز به من فَرَادَة وعمق وجِدّة، وما تكتنزه من حمولات متعددة الروافد من مُعْجَميَّة وفلسفة ومنطق ... إلخ، وهي تنبني على إعادة بناء المفاهيم وفحصها من الداخل لاستكناه دلالاتها العميقة التي تمّ تشويهها في الاستعمال الاعتيادي للغة أو في التداول. وهذه الملاحظة تسترعي المزيد من الانتباه والبحث، حيث إنّ شطراً كبيراً من قاموسنا اللغوي يخضع لتغيّر وتحوّل، وهذا ما حاول د. حمو النقاري البرهنة عليه من خلال استحضاره لمفهومي التقليد والتجديد، وهي مفاهيم تبدو للوهلة الأولى ظاهرة للعيان ولا تحتاج لشرح، الأمر الذي لم يقبل به الدكتور، فسعى إلى إثبات أن الكثرة المطلقة من الألفاظ تُستَخدم في غير محلّها، فضلا عن كونها تنطوي على جوانب مُلْغِزة ومعقّدة تحتاج تأملا جدّياً وبحثاً عميقاً. وتمكّننا آليات التداول في اللغة من فهم انتقال دلالات الألفاظ، حيث إنها لا ترتبط كثيراً بالمعجم بقدر ما تنهل دلالتها من الاستعمال داخل النسق التواصلي1 وإلى جانب مفهومي التقليد والتجديد اللذين خاض فيهما الباحث، نستطيع أن نقدّم مثالا آخر هو لفظ "الزندقة" الذي يشير إلى فرقة الزنادقة التي تقول بأزلية العالم أو الدهرية، ويُطلق على الزرادشتية والمانوية وغيرهم، وتتفق الكثير من المعاجم العربية حول هذا المعنى، كمختار الصحاح ولسان العرب والمعجم الوسيط، وتُوسّع في المفهوم ليشمل كل ضال، شاك، أو ملحد.. وقد نتج هذا التوسّع عن التداول وقصدية المتكلّم، نحو:
قول أبي علاء المعري:
تستّروا بأمورهم في ديانتهم وإنّمَا دينهم دين الزناديق
وقول محيي الدين ابن العربي:
الصدقُ حليتنا والحقّ حلّتنا فمن يخالف حالي فهو زنديق
وقد وردت لفظة الزندقة في البيتين بمعنى الكفر والضلال.
وجدير بالذكر أنّ العمل هو اجتهاد في مبحث العلوم خصوصاً الابستمولوجيا، ويمتد ليشمل حقولا معرفية أخرى كاللغة والأدب والفلسفة؛ فالمؤلف سعى إلى ابتكار ميدان جديد يشقّ طريقه نحو مدّ الجسور بين اللغة والفلسفة والمنطق، ومن المُسلّم به أنّ الوشائج التي تربط بين هذه العلوم متأصّلة في تاريخ الفكر، فأغلب النظريات اللسانية ذات خلفيات منطقية وفلسفية، ولكن المنهجية التي اتبعها حمو النقاري تضفي على هذه الدراسة طابع الجِدّة والصرامة.
إنّ الباحث لا يحدّد هذه المفاهيم ويتقصّاها بشكل اعتباطي، وإلّا لما كانت الدراسة تحمل قيمة كبيرة، فقيمتها تتمظهر في سعيه لإغناء البحث الابستمولوجي من خلال تجاوز النظرة الشائعة للتقليد، بوصفه محض اتباع أو التجديد على أنه خلق وابتكار، فكل مقلّد مجدّد وكلا المفهومين يخدمان المعرفة بشكل إيجابي. فضلا عن تحفيز الإنتاج المعرفي للخروج من ضيق اختصار المعرفة في الجديد إلى سعة الجمع بينهما بشكل لا يقيم أي تقابل أو مفاضلة بين المفهومين.
يتأسس هذا الكتاب على تفلسف منطقي يفحص ويتدبّر جملة من المفاهيم المتداولة في الدرس المنطقي بوجه غير معهود في فلسفة المنطق المعاصرة ولِيدَ تحرّر نظري يتيح للباحث التحرر من المنطق المعهود إلى مجال أرحب وأوسع. وسنسعى في هذا التحليل إلى عرض مفهومي التقليد والتجديد كما حدّدها د. حمو النقاري، فهل يحمل المفهومان معناهما الشائع، أم إنّ استبطان شبكتهما الدلالية يكشف عن معنييهما المركّز والعميق؟ وماهي قيمة هذا التحديد إبستمولوجيا؟ أي ماهو دور البناء المفاهيمي في إغناء الحقل المعرفي؟
1.التقليد:
ماهو التقليد؟ إنّ أيّ جواب عن هذا السؤال لن ينأى عن وصف التقليد بالاتباع والاحتذاء والنّسج على المنوال. إنّه الجواب الذي تتفق عليه العامة. ولكن، هل يمكن اعتبار الإجماع معياراً للحكم على صحة أو خطأ طرح ما؟ بالطبع لا، فكثيراً ما اتفقت العامة وتواترت عن مفاهيم مغلوطة.
بعودتنا للجذر اللغوي للفظة "تقليد"، نجده يُحيل على المعاني التالية:
1. قِلْدٌ: جماعة مترافقة.
2. تقاليدٌ: اجتماع جماعة معيّنة على أمور من طبيعتها أن يُلتزم بها.
3. تقَلُّد: أمور قاهرة ومُلزِمة.
4. إقلاد: الضم والإغراق والاحتواء.
5. مِقلاد: مزوِّدة بما يمكن أن ينفع الفرد ويعينه.
نستنتج أن مفهوم التقليد ينبني على أربعة عناصر مترابطة، وهي: التئام الجماعة وارتباطها، الانتساب والانتماء لهذه الجماعة، التأثير حيث يتأثر المنتسب للجماعة بسلوكها وأفعالها ثمّ التأثّر. وبالتالي، فهذا التعريف بعيد كلّ البعد عن ضيق المفهوم المتداول، إذا سلّمنا بأنّ كلّ أحكامنا مستمدّة من الجماعة التي ننتسب لها، فهي تُلزمنا بهذه الأحكام وتمارس علينا قهراً لا يتيح للفرد حرية التصرّف. «فلا خروج عن جماعة إلا للدخول في جماعة أخرى، أو لتكوين جماعة بديلة؛ أي لا تحرّر من تقاليد وتقلّدات وتقليدات»2
ومن الدلائل الواضحة على أنّ التقليد أصل لا يمكن تجاوزه مسألة اللغة؛ فاللغة مستمدة من المحيط ويتقلّدها الفرد عن الجماعة المنتسب إليها، ولا يستطيع أن يضع لنفسه لغة خاصة به. وهذا يجعلنا نُقرّ أن كل تجديد هو بالضرورة تقليد؛ لأنه لا يخرج عن التقاليد والمقلاد السائد (البراديجم أو النموذج الإرشادي) وكل عالم يتقلّد بالضرورة هذا النموذج بوصفه مجموع القيم والمعارف والمهارات وكيفيات الاشتغال.
وإذا عدنا لمجال الأدب، نلاحظ أنّ التقليد والتجديد بوصفهما مفهومين متقابلين، يشعلان معارك أدبية تقسّم الأدباء إلى مقلّدين ومجدّدين، ولكن تحديد حمو النقاري لمفهوم التقليد من شأنه أن يخفف من حدة الصراع، ويغيّر الصورة الناقصة التي يظهر فيها المقلدون كأناس يفتقدون للحس الإبداعي، بل إنّ هذه التحديدات ستجعلنا نتساءل هل محاولة تجديد الشعر يمكن اعتبارها تجديداً، أم إنها تقليد إذا اعتبرنا أنّ كل مجدّد فهو مقلّد بالضرورة؟
2.التجديد:
بعد الخوض في مفهوم التقليد من منطلق شبكته الدلالية التي وسّعت من أفق النظر وفتحت آفاق جديدة للتفكير، سننتقل إلى مفهوم التجديد، للكشف عن خباياه واستنطاق شبكته الدلالية، فعادة ما يُعرف التجديد بأنه الإتيان بشيء جديد لم يكن موجوداً من قبل، أو يُعرّف بمقابل التقليد، فهل تحافظ الصورة المعجمية على هذا المعنى الشائع أم إنّها تحمل معان أكثر جِدّة وعمقاً؟
تحيل دلالة التجديد على مقام طبيعي يسلكُ فيه الإنسان طريقاً أو نهجاً محدداً واضح المعالم.3 ويكون هذا النهج مرتبطاً بخمسة أحوال، وهي:
- أن يكون سعياً في الطريق الواضح والسوي والمفضي إلى ما ينفع، سعياً يستدل فيه بالعلامات؛ بمعنى أن ينهج المجدد طريقاً واضح المعالم لتحقيق منفعة ما أو غاية.
- التجديد والسعي النافع الخالي من الهزل والمتصف بالتحقق ومتوخّي الإحكام والعقل؛ أي على المجدد أن يسعى بشكل جِدّي لتحقيق غاية ومنفعة ما بالاعتماد على منهجية محكمة قوامها العقل.
- التجديد والسعي لبيان اللامعهود واللامألوف؛ أي إنّ المجدد يسعى لإضاءة الجوانب المظلمة، والتي لا تصل لها عقول العامة، فهي غير مألوفة بالنسبة إليهم.
-التجديد والسعي لتحصيل فائدة نسبية التحقق؛ بمعنى أنّ المجدد يسعى إلى غاية ما أو فائدة من خلال تجديده، وقد يأتي التجديد بهذه الفائدة، كما يمكن للتجديد أن يخلو من الفائدة.
التجديد والاجتهاد:
يقيم د. حمو النقاري علاقة بين التجديد والاجتهاد في مجال فقه الأصول الإسلامي، حيث إنه تجديد مشروع بوصفه سعياً نظرياً في مجال الأحكام الشرعية، ويتمّ الاجتهاد بثلاثة ضوابط هي:
- محلات الاجتهاد والتجديد: أي الأمور التي يمكن التجديد فيها؛ لأنه ليس كل الأمور الشرعية قابلة للاجتهاد.
- الأهلية للاجتهاد والتجديد: فليس كل شخص أهلا للاجتهاد والتجديد.
- صور التجديد والاجتهاد التي تكون ترجيحية وليست قطعية.
محاولة في التركيب:
يمكن أن نُجمِل أهم الأفكار المُتوصّل إليها في النقاط التالية:
- العلاقة بين مفهومي التجديد والتقليد هي علاقة تكامل ولا تنطوي على أي تعارض أو تقابل؛ وذلك من خلال إعادة الاعتبار للمعاني التي فقدت دلالتها الحقيقية في الاستعمال التداولي.
- ضرورة العودة إلى المعجم العربي للاستفادة من الآفاق الاستدلالية والاستشكالية التي يفتحها أمام الباحث.
- القيمة الابستمولوجية لبعض مباحث علم أصول الفقه الإسلامي.4
الإحالات:
1. مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، ص 5
2. حمو النقاري، أبحاث في فلسفة المنطق، ص 11
3. حمو النقاري، أبحاث في فلسفة المنطق، ص 11
4. حمو النقاري، أبحاث في فلسفة المنطق، ص 20