ديكارت وكبح التخيلات السردية
فئة : مقالات
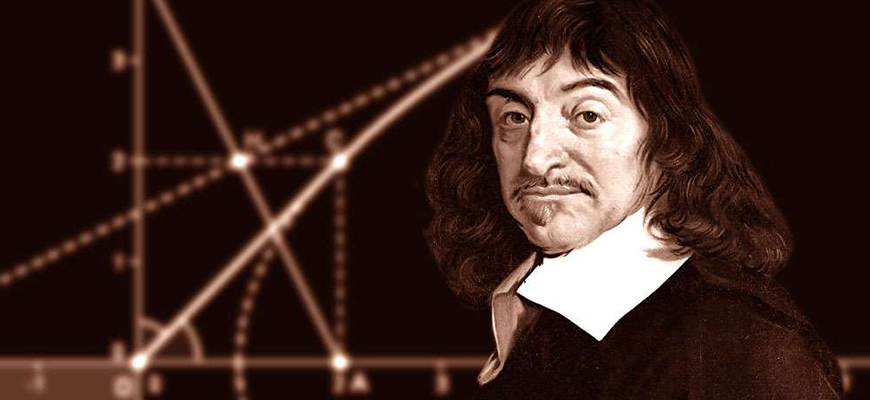
نظرت الثقافة الرسمية بازدراء للتخيلات السردية، ومنها الفكر العقلي الذي يهدف إلى ربط الظواهر ببعضها، واعتماد المقايسة دليلاً منطقياً لتحصيل الحقائق. ففي سياق نقد المعرفة الموروثة، ذمّ "ديكارت" التخيلات السردية، وحذّر منها. قال: "مَنْ أسرف في التطلّع إلى ما كان يحدث في العصور الخالية، ظلّ في العادة شديد الجهل، بما يقع في زمانه. وفوق ذلك، فإنّ القصص، تجعلنا نتخيّل ممكنا ما ليس ممكنا من الحوادث، بل وإن أصدق التواريخ، إذا لم يغيّر من قيمة الأشياء، ولم يزدها، كي يجعلها أجدر بأن تقرأ، فإنه على الأقل، يكاد يهمل دائما أدنى الظروف شأنا، وأقلّها شهرة: ومن ثمّ، فإن ما يبقى لا يبدو كما هو، والذين يتّخذون مما يستنبطونه منها أسوة لأخلاقهم يكونون عرضة للوقوع في الغلو الذي وقع فيه فرسان قصصنا، وللتطلّع إلى ما فوق طاقتهم"([1]).
إن حبس معرفة العالم بالشرط العقلي للمعرفة، واستبعاد التخيّلات باعتبارها مصدراً للأوهام، أفقد العصور الحديثة عنصرا مهما من عناصر التأويل الثقافي للعالم
من أجل أن يكبح ما حسبه ضررا مصدره التخيّلات السردية، رفع ديكارت من شأن العقل في تحليل الواقع، والحكم عليه؛ فهو المعيار الذي في ضوئه ينبغي تعديل التخيّلات، وذلك هو الطور الوصفي للغة الذي أشار "فراي" إليه. وحسب رأيه، فإن الإكثار من شيء كالإقلال منه؛ فالإسراف في التطلّع إلى الماضي، يجعل صاحبه جاهلا بعصره، والانكباب على التخيّلات السردية، يقتلع المرء عن عالمه الحقيقي، ويدفع به إلى العيش في عالم لا وجود له، كما حدث لـ"الدون كيخوته" الذي انقطع عن عصره، بالاستغراق في عصر فرسان لم يوجدوا إلا في بطون كتب الفروسية، فلأن "القصص تجعلنا نتخيّل ممكناً ما ليس ممكناً من الحوادث" نحاكي شطط أبطالها، ونتوهم المحالات وقائع، فلا تكتفى الروايات، بخداع القرّاء بتخيّل وقوع ما يتعذر وقوعه من الحوادث، بل إنها، بمحاكاة الأفعال المحالة لأبطالها، تجعلهم يتطلّعون إلى ما هو فوق طاقتهم، وذلك هو "الوهم". وكما قال "داريوش شايغان"، فقد خلط ديكارت بين الخيال والوهم، فرأى "أنّ الخيال هو الوهم بعينه"([2]).
بربط الخيال بالوهم، أجهز ديكارت على فعالية الخيال في العصر الحديث؛ لأن الخيال نوع من الوهم؛ فاشترط الملاحظات العيانية والعقلية بديلاً عن التخيلات في معرفة العالم. والحال هذه، فليس يجوز معادلة المعرفة الواقعية بالعالم، بالمعرفة التخييلة عنه، فهما خطّان متوازيان، وطريقان يساعدان في إدراكه، وفي معرفته. وتمارس اللغة دورا في الأولى، على غير ما تمارسه في الثانية. إن حبس معرفة العالم بالشرط العقلي للمعرفة، واستبعاد التخيّلات باعتبارها مصدراً للأوهام، أفقد العصور الحديثة عنصرا مهما من عناصر التأويل الثقافي للعالم، وهو ما حاولت الرواية إعادة الاعتبار له.
من أين استقى ديكارت موقفه من السرد؟ وما هي الظروف الثقافية التي ترعرع فيها هذا الموقف؟ في الوقت الذي اختمرت فيه أفكار ديكارت حول المنهج العقلي، الذي طرحه في "مقال عن المنهج"، كان قد قضى أعواماً ثلاثة في باريس، "يلهو، ويغشى الأندية، والمجتمعات، ويُكثر من قراءة القصص والأشعار"([3]). فرسم له ذلك صورة قاصرة عن وظيفة الأدب، وربما قوّى لديه ملكة خيال منضبط بقيود العقل. فقد وصفه "فولتير" بأنه "قويّ الخيال، وما كان هذا الخيال ليخفى حتى في آثاره الفلسفية، حيث تُرى في كلّ آن مقارنات بارعة ساطعة، وتصنع الطبيعةُ منه شاعراً تقريباً"([4]). ولكنه كبح الخيال بالإدراك العقلي للعالم، كما فعل أفلاطون بعد أن التحق ببطانة سقراط، فبدل أن يحتفي بالتخيّلات شرع في التحذير منها. فما الذي قرأه ديكارت من روايات غير التي ظهرت في وقته، أو سبقت ذلك؟ ذلك أن الآداب الكلاسيكية الفرنسية، التي مثّلها موليير، وكورني، وراسين، ولا فونتين، وبوالو، ازدهرت بعد وفاته.
يلزم الوقوف على تركة التخيلات السردية التي سبقت زمن ديكارت، أو عاصرته، فذلك قد يساعد في فهم موقفه من السرد بصورة عامة، إذ شاعت كتب الفروسية في فرنسا خلال القرن السادس عشر، وظهرت في عام 1540، أول ترجمة لرواية "أماديس الغالي"، وهي عمدة روايات الفرسان، في عهد الملك فرانسوا الأول، وإبان الفترة التي كان رابليه ينشر فيها روايته "غرغانتوا وبانتاغرويل". ولاقت رواية أماديس الغالي قبولا، فاق سواها في معظم لغات غرب أوروبا، ونما الاهتمام بتوسيع أحداثها، حتى بلغ عدد مجلّداتها أربعة وعشرين مجلداً في حلول عام 1615. وقُوبلت في فرنسا، بترحاب لا غبار عليه، فكان "تأثيرها في العادات الفرنسية عميقا، لدرجة أنها أصبحت مرجعا للتهذيب والأنس". ويعود شيوعها، إلى كفاءة المترجم الذي "كيّفها طبقا للذوق الفرنسي في ذلك العصر. وقد خفّف من الجزء الأخلاقي والتعليمي، وعزّز الجانب الشهواني"([5]). وعن الترجمة الفرنسية، ظهرت الترجمات الهولندية والإنجليزية، والألمانية لأماديس الغالي، وبلغ الاهتمام بها ذروته عند الفرنسيين حينما كان ديكارت شابا.
وإلى ذلك، فقد كثر القول بأنّ تأثير روايات الفرسان، انحسر بعد أن ازدراها ثربانتس في "الدون كيخوته"، وأجهز على تأثيرها في نفوس القرّاء. وهذا صحيح، إذا نظر إلى الرواية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر؛ ولم يكن كذلك في مطلع القرن السابع عشر؛ ذلك أن الحثالة التخيّلية لروايات الفروسية، انبعثت في روايات "الباروك"، التي استثمرت روح المغامرات القديمة، ودفعت بأبطال مغامرين يقطعون الفيافي والبحار، ويغوصون في عشق رعوي. وكانت الآداب الرومانسية في طريقها إلى الظهور، إذ نشرت رواية "آستريه" لـ"أونوريه دورفيه"، وهي رواية رعوية في مبناها ومعناها، جاءت بأكثر من خمسة آلاف صفحة، وطبعت بين الأعوام 1610-1627.
يلزم الوقوف على تركة التخيلات السردية التي سبقت زمن ديكارت، أو عاصرته، فذلك قد يساعد في فهم موقفه من السرد بصورة عامة
الراجح أن ديكارت كان على دراية بآداب عصره، فلا تغيب عنه آداب الفروسية، وأعمال رابليه وثربانتس، وربما قصدها في تحذيره من خطرها، لأنها توهم بغير ما يجري من أحداث في الواقع؛ فوضعها في تعارض مع العالم الواقعي، بدل أن يبقيها في جواره، للحيلولة دون استبداد النظرة النفعية فيه. وفضلا عن شهرة أعمال رابليه في فرنسا آنذاك، فقد شاع ذكر أعمال ثربانتس في كل من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، منذ مطلع القرن السابع عشر، وفي عام 1614، حينما كان ديكارت دون العشرين من عمره، ظهرت الترجمة الفرنسية للقسم الأول من "الدون كيخوته". وكان اسم ثربانتس معروفاً، في وسط جمهور الطبقة الأرستقراطية الفرنسية. وقد مرّ عقدان من حياة ديكارات، قبل أن يصدر كتابه "مقال في المنهج" في عام 1637، وخلالها أضحى اسم الكاتب الإسباني على كل لسان، بعد نشر القسم الثاني من روايته في عام 1615، وجرت ترجمتها إلى أهم اللغات الأوربية، ولا يستبعد أن يكون ديكارت قد اطلع على هذه الأعمال وسواها، وهجس خطرها، فكأنّ تحذيره الرنان للقراء بعدم الوقوع في شطط أبطال الروايات؛ لأنها تصور أهدافاً تفوق قدراتهم، قصد به رابليه وثربانتس وأضرابهما من الموغلين في التخيلات السردية([6]).
ردّ "كونديرا" على تحذير ديكارت: بتأثير من العقلانية الديكارتية، نُظر لميراث ثربانتس باحتقار، فقد دفعت العلوم بالإنسان إلى دهاليز شبه مغلقة، وأمسى الإنسان الذي ارتقى مع ديكارت إلى مرتبة "سيد الطبيعة ومالكها"، مجرّد شيء بسيط في نظر القوى التقنية، والسياسية، والتاريخية، التي تجاوزته، وارتفعت فوقه، وامتلكته، ولم يعد له أية قيمة، وقد انكشف أمره، وأصبح نسياً منسياً. فلولا الرواية، لدفع الإنسان إلى عالم مغلق، فهي التي تولّت الغوص في أعماقه، واستكشاف وعيه بنفسه وبالعالم: اكتشفت الروايات، واحدة بعد أخرى، بطرقها الخاصة، وبمنطقها الخاص، مختلف جوانب الوجود: تساءلت مع معاصري ثربانتس، عمّا هي المغامرة، وبدأت مع ريتشاردسون في فحص ما يدور في الداخل، وفي الكشف عن المشاعر السرية للمشاعر، واكتشفت مع بلزاك تجذّر الإنسان في التاريخ، وسبرت مع فلوبير أرضا، كانت حتى ذلك الحين مجهولة، هي أرض الحياة اليومية، وعكفت مع تولستوي على تدخل اللاعقلاني في القرارات، وفي السلوك البشري. وهي تستقصي الزمن، أي اللحظة الماضية، التي لا يمكن القبض عليها مع مارسيل بروست، واللحظة الحاضرة، التي لا يمكن القبض عليها مع جيمس جويس. وتستجوب مع توماس مان، دور الأساطير التي تهدي. تصاحب الرواية الإنسان على الدوام، وبإخلاص، منذ بداية الأزمنة الحديثة. واكتشاف ما يمكن للرواية وحدها، دون سواها، أن تكتشفه، هو ذا ما يؤلّف مبرّر وجود الرواية. إن الرواية التي لا تكشف جزءا من الوجود لا زال مجهولاً، هي رواية لا أخلاقية. إن المعرفة هي أخلاقية الرواية الوحيدة.
وانتهى كونديرا إلى الخلاصة الآتية: عندما كان الإله، يغادر ببطء، المكان الذي كان يحكم منه العالم، وسُلّم قيمه، يفصل بين الخير والشر، ويمنح معنى لكلّ شيء، خرج الدون كيخوته من بيته، ولم يعد قادراً على التعرّف على العالم. فقد بدا هذا العالم فجأة، في غياب حاكم أعلى، غامضا غموضا رهيباً؛ لقد تفتّتت الحقيقة المطلقة الوحيدة، إلى مئات الحقائق النسبية، يتقاسمها الناس. هكذا ولد عالم الأزمنة الحديثة، والرواية صورته ونموذجه. عارضت الرواية الحقيقة المنطقية، التي قالت بها فلسفة العقل الحديثة، واقترحت حقيقة متخيّلة، أخذت بتمثيل العالم تمثيلاً مجازياً، وهذا هو المعنى الذي قصده كونديرا بقوله، إنّ الرواية "هي جنّة الأفراد الخيالية؛ هي الأرض التي لا أحد فيها يملك الحقيقة"([7]).
[1]. رينيه ديكارات، مقال عن المنهج، ترجمة محمود الخضيري، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1968، ص 114-115. ورد في ترجمة أخرى النص بالصيغة الآتية "أكثر القصص أمانة إن لم تحرّف الأحداث ولم ترفع من شأنها حتى تجعلها جديرة بأن تُقرأ، فهي على الأقل تكاد دائما تحذف منها أكثر التفاصيل خساسة وأقلها جللا: وذلك ما يجعل البقية لا تبدو كما هي، والذين يسيّرون أنفسهم طبقا للنماذج التي يستقونها منها، هم معرّضون للوقوع في شطط أبطال الروايات، ورسم أهداف تتجاوز طاقاتهم" انظر: رينيه ديكارت، حديث الطريقة، ترجمة عمر الشارني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008، ص ص 55-56
[2]. داريوش شايغان، الأصنام الذهنية والذاكرة الأزلية، ترجمة حيدر نجف، دار الهادي، بيروت، 2007، ص 191
[3]. مقال عن المنهج، ص 62
[4]. فولتير، رسائل فلسفية، ترجمة عادل زعيتر، دار التنوير، بيروت، 2014، ص ص 102-103
[5]. جارثي رودريجريث دي مونتالبو، أماديس دي جاولا، ترجمة السيد عبد الظاهر غانم، وصبري محمدي التهامي، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 2007، ص 58
[6]. ويليم بيرون، سرفانتس: دراسة تاريخية، ترجمة عيسى عصفور، وزارة الثقافة، دمشق، 2002، ص 680، 619
[7]. ميلان كونديرا، ثلاثية حول الرواية، ترجمة بدر الدين عرودكي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2007، ص 18، 19، 20، 159






