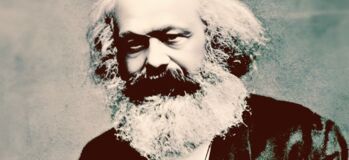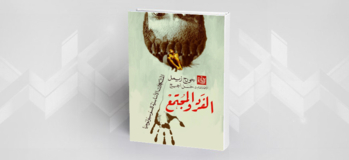سوسيولوجيا المجال الاجتماعي رؤى وتقاطعات
فئة : مقالات

سوسيولوجيا المجال الاجتماعي
رؤى وتقاطعات
ملخص:
يسعى هذا المقال إلى الوقوف عند أبرز النظريات التي اشتغلت على موضوع المجال من الزاوية السوسيولوجية، حيث ينطلق من مقدمة تبرز أهمية المجال في الدراسات السوسيولوجية، وكيف شكل المجال منعطفا مهمًّا في مسار هذه الأبحاث، ثم تنتقل لعرض أهم مضامين ثلاث نظريات رئيسة في السوسيولوجيا؛ وهي نظرية "هنري لوفيفر" حول إنتاج المجال، ونظرية "جون ريمي" التي تبين كيف أصبح المجال موضوعا رئيسا للسوسيولوجيا، ثم نظرية "مارتينا لاو" والنظر إلى المجال كاستعداد، لنبين في نهاية المقال كيف أن النظريات السوسيولوجية حول المجال حولت نظرتنا إليه، من كونه معطى محددا مسبقا ومحايدا، إلى كونه بناء اجتماعيا يتم تشكيله بناء على تفاعلات وصراعات تحكمها آليات وضوابط غير محايدة.
تـقـديـم:
يحتل مفهوم المجال مكانة متميزة ضمن موضوع الأبحاث السوسيولوجية في مختلف أشكاله الفيزيقية، والإيكولوجية، والنفسية والاجتماعية على السواء، فينظر إليه كمعطى أساسي ومرجعي، تتموقع في إطاره الظواهر والسلوكيات والممارسات والأنشطة الفردية منها والجماعية، فإذا كان هذا الموضوع ولزمن طويل حكرا على الأبحاث والدراسات الجغرافية، وبعدها الأبحاث المتعلقة بمجال العمران والهندسة المدنية، فإن النظر إلى المجال من منظور السوسيولوجيا شكل نقلة نوعية في قراءة وفهم تصور المجال وأشكال النظر إليه، فقد أصبح ينظر إليه كبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية وإيديولوجية، مادام لا يمكن تصور إنسان بدون مجال ولا مجال بدون إنسان، وفي هذا الصدد تبلور ضمن تاريخ النظريات السوسيولوجية ما يصطلح عليه بالمنعطف المجالي ضمن الدراسات السوسيولوجية، حيث شغل موضوع المجال أغلب الأبحاث والدراسات السوسيولوجية في مختلف الميادين والقطاعات.[1]
برز ضمن هذا الإطار الحديث عن تأثير المحددات المجالية وانعكاساتها في هذه الأنشطة، ومساهمتها في فهمها وتحليلها وتأويلها. إن هذا الأمر يؤسس لما يسمى بالمقاربة المجالية، التي تستند إلى مرجعية أوسع وأشمل، على اعتبار أن مختلف الأنشطة الفردية والجماعية هي بمثابة نتاج لمعطيات لا يمكن حصرها فيما هو اقتصادي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي فقط، كما أنها تقترح أسس تعامل أكثر تكيفا مع تراكم العوامل وتداخلها فيما يخص الظاهرة الإنسانية.
لكن مع تطور الأبحاث السوسيولوجية حول المجال وتراكمها، لم يعد النظر إلى موضوع المجال بوصفه مجرد حاو لمحتوى، أو معطى فيزيقي محايد في الواقعة الاجتماعية، بل إن الطبيعة المجالية لا تتحدد فقط في البعد المجالي لشكل الوجود المادي، وإنما تتداخل فيه أيضا التوافقات بين الحضور والبعد، المشاركة والإقصاء، توزيع المواقع في المجال وتوزيع المواقع في العلاقات....إلخ. إن هذا الأمر هو ما ساهم في تشكل نظرية سوسيولوجية حول المجال، وخصوصا عند "هنري لوفيفر" باعتبار أن كتابه "إنتاج المجال" يشكل أول وأبرز نظرية سوسيولوجية حول المجال. ولذلك سنتوقف عند نظريته حول المجال، وبعد ذلك سنعمل على تناول نظرية جون ريمي الذي نظر إلى المجال كموضوع رئيس للسوسيولوجيا، ونختم أخيرا بنظرية "مارتينا لاو" التي تبحث في أليات تأسيس المجال سوسيولوجيا. فما هي أهم محددات وتصورات هذه النظريات؟ وكيف حضر مفهوم المجال عند أبرز هؤلاء المنظرين له؟
لقد قامت النظرية الاجتماعية للمجال على نقد التصور الفيزيقي للمجال، وهو التصور الذي ينظر للمجال على أنه مجرد وقائع محايدة معطاة تتصارع داخلها وقائع أخرى، فليس المجال مجرد "سقط للمتاع" أو مجرد وعاء لمعطى الوجود، تسجل فيه الأشياء الموصوفة." إن المجال إنتاج اجتماعي وليس معطى طبيعي كما يمكن أن يعتقد، فالمجال وعاء ثقافي بامتياز. إن المجال ليس واقعة طبيعية-فيزيقية فحسب، بل انتاج اجتماعي ثقافي واقتصادي، وليس مجرد وعاء سلبي، بل مساهم بشكل فعال في بناء المجتمع".[2]
إن المجال السوسيو-اجتماعي الملموس يقدم نفسه حسب "ألان ليبيتز" بـ "اعتباره تمفصلا للمجالات التي يتم تحليلها، وأيضا كنتاج وانعكاس لتمفصل العلاقات الاجتماعية في الآن نفسه، فهو مجال ملموس معطى سلفا وإكراه موضوعي يفرض نفسه على انتشار وتشكل تلك العلاقات الاجتماعية في نفس الوقت، ثم إن المجتمع يعيد خلق مجاله انطلاقا من مجال ملموس، يكون دائما معطى سلفا وموروثا عن الماضي، كما هو الشأن في مسألة المجال الترابي".[3]
ومن منطلق النظرية الاجتماعية حول المجال بدأ التمييز بين المجال الظاهر والمجال الخفي، الحاوي والمحتوى.. والتمييز بين المجال المادي والمجال الرمزي، ومن ذلك أيضا التمييز بين المجال واستعمالات المجال، وإدراكات ذلك المجال. ضمن هذا السياق، يعدّ البعد التاريخي للمجال، المدخل الأول لتنظيم التصور الإمبريقي للمجال، والكشف عن أبعاده الاجتماعية، ومن هنا أهمية أبحاث ماكس فيبر، فردنارد بروديل، وإرنست لابروس التي تأسست على ربط الاجتماعي بالتاريخي. وأهم ما تمت الإشارة إليه في هذا السياق هو أن لكل نمط إنتاج زمن وتاريخ خاصين، منقطع بشكل خصوصي عن تطور قوى الإنتاج.
كما يشير ليبتز إلى أن المجال الاجتماعي يعد أحد أبرز أبعاد المجال، فهو بذلك أحد مقولات الوجود المادي لكلية العلاقات الاجتماعية، ولذا لا يجب فهم المجال بوصفه انعكاسا (أو سندا لانعكاس) للعلاقات الاجتماعية الموجودة. بالعكس، فالمجال المادي يبدو في إعادة الإنتاج الاجتماعي، أحيانا كأثر لتلك العلاقات، وأحيانا أخرى كمحدد لها، فالعلاقات الاجتماعية ليست سوى علاقات بين الناس والأشياء، بل إنها وبكل تأكيد ذات بعد مجالي.[4]
أولا نظرية: هنري لوفيفر (1901-1991) وإنتاج المجال، نحو نظرية متكاملة لمفهوم المجال الاجتماعي.
يعد هنري لوفيفر، صاحب كتاب "الحق في المدينة" والفيلسوف الذي عمل على نقد الحياة اليومية، أول من اشتغل على صياغة نظرية متكاملة حول مفهوم المجال، لينقله بذلك من اهتمامات الجغرافيين إلى موضوع أبحاث السوسيولوجيين؛ وذلك من خلال كتابه "انتاج المجال"[5]، هذا الكتاب الذي يقدم فيه صاحبه، معالم نظرية اجتماعية حول المجال، يستند فيها هنري لوفيفر إلى التصور الماركسي، حيث يتناول فيه الوقائع الاجتماعية تناولا ماديا، من خلال استعمالاتها في المجال.
فمن خلال هذا الكتاب يضع هنري لوفيفر أيضا أسس ومعالم علم للمجال، والذي عوض أن يكون عملا وصفيا للمجال تشكل بوصفه بحثا في كيفية إنتاج المجال، حيث إن المجال الاجتماعي يشمل المجال الفيزيائي للطبوغرافيين، وأيضا المجال الذهني للفلاسفة، وهو ما يسمح بإعطاء نظرية وحدوية للمجال، بالشكل الذي يجعل مفهومه عمليا وإجرائيا، هكذا يبني هنري لوفيفر أطروحته حول المجال على فكرة أن كل ظاهرة اجتماعية توجد ضمن مجال، وتشكل هذه الفكرة جوهر أطروحته، بخصوص إشكالية المجال، حيث يتم النظر إلى المجال الاجتماعي على أنه نتيجة لتاريخ المجتمعات ودعامة لوظائفها الآنية، واضعة في رهاناتها، وفي نفس الوقت ممارسات وتمثلات أدوات السلطة في خدمة الطبقات، وطبيعة نمط الإنتاج السائد، فكل نمط إنتاج يفرز مجاله الخاص به. إنه ما يجعل نظرية لوفير حول المجال بمثابة مرافعة ذات أبعاد سياسية وليست فقط محض نظرية علمية.
ينطلق هنري لوفيفر من نموذج المدينة الإغريقية متوقفا عند ذلك الترابط والتوافق الحاصل بين مجالات التمثل وتمثلات المجال، وما بين المجال الفيزيائي، والسياسي، والحضري، والتطابق الحاصل بين الفكرة النظرية، والواقع التطبيقي. مشكلا بذلك المجال المطلق، حيث كل ما هو واقعي فهو عقلي وكل ما هو عقلي فهو واقعي، بعبارة الفيلسوف هيجل.
لكن مع بناء روما وقيام نظام قانوني إلزامي فوق الواقع أي نظام تجريدي، ظهر المجال المجرد، أو تم تجريد المجال l’abstraction de l’espace فتصدعت فكرة إطلاقية المجال، لم يعد واقع الفكرة هو الفكرة نفسها، بظهور التمايزات المجالية، ومع سيادة فكرة الملكية الخاصة، بداية هيمنة المصمم على المعاش، أصبح إنتاج المجال الاجتماعي، من طرف السلطة السياسية، لأهداف اقتصادية، وظهر التوظيف الأداتي لصالح الاقتصادي وليس لصالح مستعملي المجال.
إن معالم نظرية لوفيفر حول المجال تبرز في خطاطة ثلاثية الأبعاد، تميز في أشكال المجال بين، المجال المعاش vécu، المجال المصمم conçu، والمجال المدرك perçu؛ وذلك في علاقتها بمجالات التمثلات les espaces de representations / تمثلات المجال les representations de l’espace / والممارسات المجالية les pratiques spatiale.[6]
يعمل لوفيفر من خلال هذه الخطاطة على أشكلة موضوع المجال فليس الغرض تقطيع مقولة المجال بغرض تجزيئها، بل الوقوف عند تداخلاتها الجدلية. فما المقصود بكل عنصر من عناصر هذه الخطاطة؟
المجال المعاش l’espace vécu إن التعريف الأكثر إيجازا لمفهوم المجال المعاش هو أنه مجال التمثلات، عبر الصور والرموز وهو مجال الثقافي، إنه مجال من يسكنونه ويستعملونه. يكشف كيف تتشكل التمثلاث المجالية، وكيف يتشكل العزل المجالي، ولا يتعلق الأمر هنا فقط بدراسة تاريخ المجال، ولكن أيضا تمثلاتها. إنه يشكل موضوع الفلاسفة والفنانين الذين يصفونه أو يعتقدون بأنهم يصفونه. [7]
المجال المصمم l’espace conçu إنه باختصار تمثلات المجال إنه مجال التكنوقراطيين، المخططين والمصممين، ووكلاء التهيئة المجالية، وإذا كان المجال المعاش ذو طبيعة ذاتية، فإن المجال المصمم يظهر على أنه ذو طبيعة موضوعية، وذو طبيعة تقنية، إن المجال المصمم يرتبط بتمثلات المجال، وهذا الجانب الذي يبدو فيه المجال محايدا وموضوعيا هو ما حاول لوفيفر كشف زيفه، فبالنسبة إليه هذه الوضعانية التي يبدو عليها المجال المصمم تفرض تراتبية للأشكال المختلفة للمجال، وتؤدي إلى خضوع للمجال المجرد، مقصية رمزية المجال المعاش ومادية المجال المدرك. إن تمثلات المجال هي في صميم إعادة إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالي، بل يمكن القول إنها ترتبط مباشرة بالنظام الذي يفرض تصوره على المجال وبالتالي على الأفراد.[8]
يرتبط المفهوم المجال المدرك l’espace perçu أساسا بالممارسات المجالية، من حيث إن الممارسات المجالية لمجتمع ما تفرز مجاله، تفترضه وتفرضه في تفاعل جدلي. إنها تنتجه ببطء وتهيمن عليه وتتملكه بكل تأكيد، إن الممارسات المجالية لمجتمع ما تكتشف حينما تفك شفرة مجالها، عندما تتعرف على مختلف تفاصيلها، وحينما يمتلك هذا المجال مستعملوه، حينما يصبح الباب الذي يولج منه إلى هذا العالم.
وإذا كان تقنيو المجال يركزون على المجال المصمم فإنه حسب هنري لوفيفر ينحصر اهتمام الإثنولوجين، وعلماء النفس على المجال المعاش، إنهم قد ظلوا حبيسي موضوع مجالات التمثل، والإشارة في هذا الصدد إلى أعمال كل من سيرج موشكوفيشي، إميل دوركهايم، وجون بياجي؛ ذلك أن كل هذه الأعمال تناست إشكالية تمثل المجال، ومعه نسيان إشكالية الممارسة المجالية.
بالمقابل، يؤكد لوفيفر أن الممارسة المجالية هي ما يتبقى، حول المجال الاجتماعي، بعدما يتم تناوله من طرف مختلف التخصصات؛ وذلك أنه بين المجال المصمم والمجال المعاش، يشكل المجال المدرك العلبة السوداء للمجال، فمن خلال اختراق هذه العلبة يكسر هنري لوفيفر جدار الصمت الذي كان سائدا حول الطبيعة الاجتماعية والسياسية لعملية إنتاج المجال؛ وذلك من خلال توضيح ذلك التقاطع الحاصل بين تمثلات المجال ومجال التمثلات وطبيعة الممارسات المجالية.[9]
ثانيا: نظرية جون ريمي حول المجال، أو المجال كموضوع رئيس للسوسيولوجيا
يتعلق التفكير في مسألة المجال عند جون ريمي أساسا بمنظور السوسيولوجيا البرغماتية؛ وذلك من أجل صياغة مفاهيم إجرائية، وأيضا بناء أدوات نظرية، فمقاربة جون ريمي للمجال تنطلق من الميداني لتصعد نحو النظري كمقاربة استقرائية، وتقوم نظرية جون ريمي حول المجال على اعتبار أن المجال وسيط بين المجتمع والأشياء المادية، من خلال البحث في أنماط المجالات الممكنة والمرتبطة بالحركية السكانية، وإشكالية الاختلاط الاجتماعي. يقول جون ريمي "لقد سلطت الضوء على التأثير الذي يخلقه المجال في تكوين الفاعلين الاجتماعيين وعلى العلاقة فيما بينهم فالنظر إلى المجال في إطار علائقي يخرجنا من تلك النظرة الكلاسيكية للمجال كوعاء لمحتوى، ويمكن من فهم الوضعية المعاصرة للحركية الاجتماعية"[10].
ومن أجل سوسيولوجيا في موضوع المجال، كموضوع رئيس، يعود جون ريمي إلى أبرز النظريات السوسيولوجية وإلى الآباء المؤسسين، فدوركايم بتمييزه بين التضامن الآلي والتضامن العضوي يقيم بذلك تمايزا بين المجتمعات التقليدية والمجتمعات الحديثة، ويستلهم جون ريمي من ماكس فيبر منهجيا فكرة النموذج المثالي، بوصفه بناء ذهنيا غير موجود واقعيا، لكنه يشكل بذلك إطارا تحليليا. وأيضا من حيث تعريفه للمدينة، بوصفها ترتبط بالتدبير الجديد للسلطة، كما أنه ربطها بمفهوم العقلانية التي تمتاز بتأثيرها على أنشطة مختلفة.[11]
يستند جون ريمي أيضا، وعلى وجه الخصوص، إلى الأبحاث النظرية التي قدمتها مدرسة شيغاغو باعتبار أن التفكير في قضايا المجال لا يكون ممكنا إلا من خلال العودة إلى نظريات جورج سيمل ومدرسة شيغاغو، فإذا كانت نظرية سيمل تقوم على استحضار البعد الوجداني والعاطفي للمدينة، حيث يعرف سيمل المدينة بأنها المكان الذي من خلاله تنتظم العديد من الأنشطة وتتخذ فيه قرارات التنسيق، ويركز سيمل على البعد التفاعلي للظاهرة الحضرية وأيضا على أشكالها الاجتماعية.[12]
أما لدى مدرسة شيكاغو، فسيتم الوقوف عند المدينة من خلال مرفولوجيتها العمرانية، تركيبتها الاجتماعية والديمغرافية خصائص السكان، الحجم، الكثافة، تباينات هذه الساكنة، ثم البعد العاطفي، من حيث إن المدينة هي منبع التفاعلات والتعارضات العاطفية، للتملك والتموقع، وأنها أيضا مجال مشترك يقوم على نظام سياسي للقرار يسمح بتنظيم الترابط والتعاون بين ساكينها.
سيسمح هذا الإطار النظري لجون ريمي بتأكيد خصوصية المدينة كوحدة للإنتاج ومكان للتملك، بعيدا عن اختزالها في تركيبة شكلية ومظهر خارجي مرفولوجي. إن المجال حسب جون ريمي محط رهانات، فيتم النظر إلى المدينة كمنتج للخصوصية ومن هنا ضرورة التمييز بين المدينة الظاهرة والمدينة الخفية، هذه الأخيرة التي تتشكل في إطار شبكة علائقية وأمكنة التقاء، تكون في الغالب خاصة.[13]
تبعا لهذه التراكمات السوسيولوجية التي يستحضرها جون ريمي في كتابه إنتاج المجال؛ وذلك من أجل الإجابة عن إشكالية مركزية أساسية، وهي هل يمكن للمجال أن يشكل أداة تحليلية للاجتماعي؟ من خلال الاستناد إلى منهجية استقرائية تحليلية جنيالوجية؟
تقوم النظرية الرئيسة لجون ريمي حول المجال بوصفه بعدا مبنينا لمادية الاجتماعي، معززا بمنطق وبوضع سوسيو-ثقافي خاصين، وهو ما يسمح لنا بتفكير الاجتماعي في تجلياته المادية، والأخذ بعين الاعتبار البنية الفيزيائية التي يحدث فيها الفعل. إن مفهوم المجال عند جون ريمي يرجع إلى مجموع متعدد من الأمكنة والعلاقات وأنماط الحياة، واستراتيجيات الفعل. فالرهان هو إعطاء مفهوم المجال نفس المكانة التي منحت لمفهوم الزمان ضمن العلوم الاجتماعية، ساعيا في ذلك من أجل بناء "نحو للمجال" un grammaire de l’espace.
لابد إذن من العودة إلى النظريات السوسيولوجية التي سبقت الإشارة إليها، والعودة خصوصا إلى تصور هنري لوفيفر حول المجال، وما قدمه من تمييزات حول المجال المصمم، المجال المعيش، وأيضا المجال المدرك. ومن أهم ما جاء به كتاب جون ريمي "المجال كموضوع رئيس للسوسيولوجيا"، فكرة أن البنايات المعمارية هي قبل كل شيء بنايات ثقافية. إنها منتوج مفاوضات ومضاربات قبل أن تكون بناءات معمارية. إن مفهوم المجال هو المفهوم الذي يجمع بين مفهوم الحركية الاجتماعية ومفهوم التحضر إضافة إلى مفاهيم أخرى. إنه العنصر المبنين للعلاقات الاجتماعية، وفي هذا السياق يتحدث جون ريمي عن البعد العلائقي للمجال ويبرز مفهوم (المجال العلائقي)؛ ذلك أن المعنى الذي نمنحه للمجال والاستعمالات التي نجريها عليه، هي نتاج للتفاعلات بين الأفراد والجماعات وبين الجماعات والأفراد. فبالنسبة إلى جون ريمي إن المدينة تجمع سكاني، حيث التصور والتهيئة تتطلب مجموعة من القرارات المتعددة التي لا تخرج عادة إلا بعد صراعات ومفاوضات وتوافقات ومقايضات عديدة.[14]
إن هذا الأمر هو ما ينتج تحولات وتغيرات اجتماعية من طرف فاعليين السياسيين، والاقتصاديين، والعلماء، كما أن هذه التحولات ترجع إلى مجموعة من التغيرات والمفاوضات والتجارب بين أشخاص يمتلكون مستويات ومصادر مختلفة للتدبير، تكون في الغالب مقبولة من طرف الجميع بعد أن يتم تقريب وجهات النظر، وهكذا يتم إنتاج المجال من طرف هؤلاء الفاعليين.
يعد المجال حسب جون ريمي بالنسبة إلى صانعيه أي واضعي التصاميم الحضرية وأيضا لمستعمليه موضع رهانات سياسية، ثقافية اقتصادية... فهو بالنسبة إلى البعض يشكل مصدرا يسمح للأفراد والجماعات بالحضور، في قلب الأحداث والوقائع، أخذا بعين الاعتبار استقلاليتهم كأفراد، حيث يتملكون هذا المجال وفق منطق التملك، la logique d’appropriation. أكثر من كونه يشكل مجال إنتاج، وهو بالنسبة إلى البعض الآخر موضوع إكراه يفرض عليهم أشكال التموقع والتواجد. إن إنتاج المجال هو إنتاج نمط من الوجود خاص بمن يمتلكون المجال مفروض على أولئك الذين لا يمتلكونه.
ثالثا: "مارتينا لاو" سوسيولوجيا المجال نحو نظرية لكيفية تأسيس المجال
تقوم الفكرة الأساس لمقاربة عالمة الاجتماع والتخطيط العمراني بالجامعة التقنية لبرلين "مارتينا لاو" لمفهوم المجال سوسيولوجيا، على نقطة أساس ورئيسة، وهي أن المجال يوجد في قلب كل التحولات الاجتماعية، وأنه أيضا جزء لا يتجزأ من التنشئة الاجتماعية، مستحضرة بذلك مفهوم الهابتوس الذي صاغه بورديو مبينتا دوره في عملية تشكل المجال، المجال كسيرورة وبناء اجتماعي تفاعلي.
ومن هنا، فإن "لاو" تعتبر أن المجال لا يولد ولادة واحدة ثابتة وأنه ليس شيء ساكن ومعطى ثابت، بل إن المجال هو ولادة متجددة، تتجدد بتجدد الفعل الاجتماعي، وبوصفه بنية مجالية مدمجة في إطار مؤسسات، فإنه يبنين وبشكل قبلي الفعل الاجتماعي.[15]
وإجابة عن سؤال، لماذا يجب أن تهتم السوسيولوجيا بالمجال؟ ترى "مارتينا لاو" أن كل مجال هو نتيجة لشروط اجتماعية، ولا بد أن كل واقعة اجتماعية تقع أساسا في مكان وزمان معينين، من حيث إنهما ليسا مقولتين ثابتتين، بل إنهما نتاج اجتماعي.
هكذا تطرح "لاو" إشكالية المجال من جانبين، وهما كالتالي:
1) ما هو النموذج النظري الذي يمكن أن يجمع مقولة المجال في مفهوم واحد على اختلاف تصوراته؟
2) كيف يمكن وضع تصور للمجال يسمح لنا باستيعاب التحولات البنيوية والتنظيمية التي تواجهنا في مختلف الأبحاث الإمبريقية؟
إن الغرض من هذين السؤالين هو الإجابة عن سؤال كيف يمكن تعريف المجال كمفهوم سوسيولوجي أساسي؟
لا يمكن أن تتحقق الإجابة عن هذا السؤال، دون العودة إلى الرصيد السوسيولوجي وتراكماته حول مفهوم المجال. ومن هنا، كان لابد من ربطه بالأبحاث الإمبريقية، والتأكد مما إذا كان هذا المفهوم يستوعب هذه التحولات الاجتماعية والنظرية، مع إمكانية تطويره وبالتالي صياغة تصور جديد لمفهوم المجال، تصور مواكب للسيرورات والتحولات الاجتماعية الراهنة من خلال تركيب تحليلي لمفهوم المجال؛ أي تكوين تصور ديناميكي لمفهوم المجال، والخروج من شرنقة خيانة المفهوم ومعجميته. فالرهان ليس البحث عن مفهوم صحيح أو خاطئ، بل عن مفهوم مفسر وإجرائي.
هكذا إذن تقوم نظرية "مارتينا لاو" على التفكير في مفهوم المجال من منظور علائقي، بالعودة إلى سوسيولوجيا كل من نوربرت إلياس، جورج زيمل، وببير بورديو أنطونيو غيدنز، تالكوت بارسونز وآخرون...
ولكن قبل كل هذا، ترى الباحثة أنه لا يمكن التفكير في سوسيولوجيا للمجال دون العودة إلى ما أنتجته النظرية الفيزيائية النيوتونية والإنشتاينية حول المفهوم، وأشكال حضوره داخل هذه النظريات. فإذا كان المجال في الفيزياء النيوتونية ثابتا ومطلقا ومقولة قبلية، تجري فيها أحداث متغيرة، فإن ثورة إنشتاين الفيزيائية جعلت من مفهوم المجال نفسه متغيرا نسبيا، يتشكل هو الآخر كما تتشكل مجموعة من المتغيرات، حيث تقوم النظرية النسبية الفيزيائية لمفهوم المجال على فكرة رئيسة، وهي أن أي حدث ما، يقع في مجال وسياق معين، ليس بالضرورة هو نفس الحدث في مجال وسياق آخر. [16]
إذا كانت الفيزياء تتحدث عن المجال في الكون، فالنظرية السوسيولوجية تتحدث عن المجال الاجتماعي. ففي البحث في تاريخ السوسيولوجيا تجد مارتينا لاو، أن مفهوم المجال قد أستعمل من خلال ثلاثة مفاهيم:
في المفهوم الأول؛ يحيل المجال إلى المكان le lieu، الملموس والمادي.
أما في المفهوم الثاني؛ فيحيل المجال إلى التراب le territorial، هو ما يمنح المجال معنى جغرافي.
والمفهوم الثالث؛ يحيل مفهوم المجال إلى المحلي le locale، ولما هو جهوي.
تشير "لاو" إلى أن السوسيولوجيا الحضرية تناولت مشكلات المجال، حيث أخذت بعين الاعتبار ضمن تحليلاتها موضوع المجال، وتم التطرق لهذا الأمر في العديد من الكتب، وطرحت أيضا مشكلة ترتيبات المجال حول إشكالية استعمالات المجال وإدراكه. وقد كان من أبرز قضاياها هو تحديد المدينة وتمييزها عن القرية، والاتفاق حول خصائص مفهوم التحضر والمدنية. وفي هذ الصدد تم تناول مفهوم المدينة كموضوع مستقل، ولم يكن المجال هو الموضوع الرئيس، بل تم استعماله كبديل عن مفهوم المجال مفهوم الأيكولوجيا الاجتماعية. [17]
هكذا تحدثت مدرسة شيكاغو عن الإيكولوجيا الاجتماعية، التي من مضمونها أن الإنسان يتكيف مع محيطه البيئي الطبيعي. فمجموعة من الأحياء والمدن ظهرت كنتيجة لتكيف الإنسان مع محيطه، لكن هذه المقاربة ربطت مفهوم المجال بالجغرافي، وأدرجت مقولة المجال في هذه الأبحاث والتحليلات بغرض الإحالة على هذا البعد بالأساس. لكن مع ذلك، فإن ما قدمته شكل مرتكزا لبروز سوسيولوجيا المجال، خصوصا من خلال ما أبدعته من مفاهيم وما قدمته من إشكالات، وأهمها إشكالية العزل المجالي، باعتباره تمركزا لمجموعة من الأفراد ضمن أحياء خاصة في المدينة، تولد عنه مفاهيم جديدة كـ "الغيتو" و"الهيبو".
لم تعد اليوم النظريات السوسيولوجية قائمة على فكرة أن الفعل والمجال شيئين مستقلين عن بعضهما البعض. ومن هذا المنطلق، فإن تشكل المجال حسب مارتينا لاو، يتم في ظل سيرورة اجتماعية للفعل، كما أن الوقائع الاجتماعية تتشكل في إطار سيرورة مجالية، ولم يعد المجال هو ذلك الوعاء الثابت، بل استعداد لشيء دائم الحركة والتحول، يوجد في استقلال للشروط الاجتماعية والمادية، فالجسد نتاج مجالي والمدينة نتاج مجالي... إن المجال استعداد قبلي علائقي تفاعلي. (dis)position relationnel.
وبالتالي، فإن فهم المجال حسب "مارتينا لاو" لا يتحقق إلا من خلال فهم طرائق تأسيسه، فهو يتحدد كاستعداد قبلي علائقي تفاعلي؛ فالوضعية التي يوجد عليها الأفراد، والطريقة التي يتحركون فيها تتدخل في عملية تشكيل المجال. إنه أشياء مادية وقيم رمزية في الآن ذاته، ومن هنا أهمية الانتباه إلى علاقة الإنسان بالأشياء المادية الملموسة، المشكلة للمجال ماديا، كمواد البناء، الكراسي، الديكور الجدران الألوان....إلخ، إن المجال يتأسس أيضا عبر التعبيرات الإيحائية، والحركات، الجسمانية، واللغة، والكلمات المستعملة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه المكونات، ومنه اعتبار المجال أشياء محايدة، بل إنها أشياء مؤثرة وفاعلة تشكل العلاقات الاجتماعية.[18]
يتىشكل المجال إذن داخل الفعل وبين الفعل والبنيات، وهو ما يجعلنا نتحدث عن سيرورة المجال spacing، وقد استعملت "لاو" العبارة بالإنجليزية لتحديد سيرورة المجال، فالمجال هو سيرورة تفاعلية للتمجيل (نقصد بها عميلة توزيع عناصر المجال المادية، من أجل تشكيله)، فعل تشكيل المجال في إطار سيروري، عبر الأشياء طرائق وأشكال الوضع والتموضع والتركيبة النهائية والمحصلة، مما يولد روح المجال أو نفس المجال، فيجعل كل مجال يمتاز عن الآخر، إن الأمر أشبه بالحديث شعريا عن عبق المجال.[19]
يتشكل المجال حسب مارتينا لاو، عبر سيرورتين وجب التمييز بينهما تحليليا، سيرورة التمجيل؛ أي عملية تشكيل المجال، وسيرورة التركيب، spacing et la synthèse؛ فمن خلال هذه الأخيرة، نستطيع تركيب مجموعة من المواد الاجتماعية، وأيضا الأفراد في عنصر واحد.
إذا كان يمكن أن نجمل أطروحة "مارتينا لاو" في فكرة واحدة، فيمكن أن نقول إن المجال هو استعداد علائقي لكائنات حية ولخيرات اجتماعية. إن المجال يتشكل عبر سيرورتين، التمجيل والتركيب، والتي تمنح للمجال روحا ونفسا، إن المجال يولد في سياق الفعل والتموضع، يتأسس المجال أيضا في إطار تفاعل بين البنيات والفعل، فالأمر لا يقتصر على الفعل فقط، ولكن أيضا في سياق الفعل ووضعية الفعل في تفاعل مع أشياء مادية ولا مادية، وهو ما يجعل المجال بمثابة تفاعل اجتماعي دائم وليس أبدا شيء ثابت أو قار.
خاتمة
إذا كان هنري لوفيفر يعد أول وأبرز من راجع النظريات الاجتماعية حول المجال، مبرزا كيف أن المجال إنتاج اجتماعي، وليس أبدا معطى سلبي محايد كما يمكن أن يعتقد، إنه إنتاج يعكس نمط الإنتاج السائد، ويترجم الإيديولوجيا السائدة وفقا لعلاقات القوى الكامنة في المجتمع. فإن جون ريمي حاول ربط المجال بسياق الفعل، معتبرا أن المجال محصلة مفاوضات ومقايضات بين مجموع القوى الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية...إلخ، على أساس أن المجال ينتج ضمن سياق منطق التملك، وهو ما سيجعل المجال يتشكل كموضوع رئيس للسوسيولوجيا. أما بالنسبة إلى الباحثة الألمانية مارتينا لاو، فقد توجهت في أبحاثها حول دراسة المجال إلى البحث في كيف يتأسس المجال، باعتبار أن المجال هو استعداد قبلي علائقي تفاعلي من حيث إنه سيرورة spacing وتركيب synthèse.
انطلاقا من قراءة هذه التصورات، فإنه يمكن القول إن القاسم المشترك بينها، هو كونها نظرت إلى المجال على أنه ليس شيئا ثابتا ومطلقا، كما أنه ليس معطى محايدا ضمن سياق تشكل الظاهرة الاجتماعية.
المراجع المعتمدة:
- عبد الرحمان المالكي، الثقافة والمجال دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب، منشورات مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية، جامعية سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب ظهر المهراز، فاس ط 1، 2015
- Gaston, Bachelard, la poétique de l’espace: Les Presses universitaires de France, Paris, France, 3e édition, 1961
- Henri. Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974
- Jean Remy, L'espace, un objet central de la sociologie, Toulouse, Erès, coll. « Sociétés urbaines et rurales (poche) », 2015, 183 p., préface de Maurice Blanc
- Martina Löw, Sociologie de l'espace, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, coll. « Bibliothèque allemande », 2015, 302 p., Traduit de l'allemand par Didier Renault ; préface d'Alain Bourdin
[1] Jean Remy, L'espace, un objet central de la sociologie, Toulouse, Erès, coll. « Sociétés urbaines et rurales (poche) », 2015, 183 p., préface de Maurice Blanc
[2] عبد الرحمان المالكي، الثقافة والمجال دراسة في سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب، منشورات مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية، جامعية سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب ظهر المهراز، فاس ط 1، 2015.
[3] آلان ليبيتز، ما المجال؟ ترجمة فريد الزاهي، ص ص 23/24
[4] آلان ليبيتز، ما المجال؟ ترجمة فريد الزاهي، ص ص 25-26
[5] H. Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974
[6] Ibid. 42-43
[7] Ibid.p49
[8] Ibid.p48
[9] Ibid.p 48-49
[10] Jean Remy, L'espace, un objet central de la sociologie, Toulouse, Erès, coll. « Sociétés urbaines et rurales (poche) », 2015 ; préface de Maurice Blanc p23
[11] Ibid P 99
[12] Jean Remy, L'espace, un objet central de la sociologie,p34
[13] Ibid p 37
[14] Jean Remy, L'espace, un objet central de la sociologie, p55
[15] Martina Löw, Sociologie de l'espace, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, coll. « Bibliothèque allemande », 2015, 302 p., Traduit de l'allemand par Didier Renault ; préface d'Alain Bourdin, P 27
[16] Martina Löw, Sociologie de l'espace,52.60
[17] Martina Löw, Sociologie de l'espace,p69..80
[18] Ibid P149…156
[19] Gaston, Bachelard, la poétique de l’espace: Les Presses universitaires de France, Paris, france 3e édition, 1961