عبد القادر فيدوح: التفكير في الأنسنة والإنسانية في الفكر العربي
فئة : حوارات
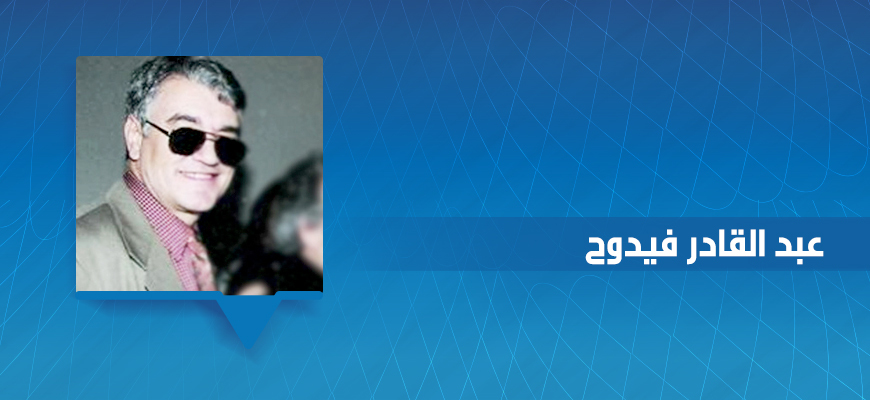
حوار خاص مع الأديب، والمفكر الجزائري الأستاذ الدكتور عبد القادر فيدوح
التفكير في الأنسنة والإنسانية في الفكر العربي
المحور الأول:
نور الدين علوش: بداية، من هو الدكتور عبد القادر فيدوح؟
الأستاذ فيدوح: لعل سؤالاً كهذا يثير فضول كل مؤرخ أو مبدع أو سياسي، لذا أعتقد أنه من الصعب جداً أن يعرّف المثقف نفسه، ولكنني أستطيع أن أقول في ظل هذا الزمن الموبوء إنني محرّك ـ شأني شأن أي مواطن عربي ـ بحسب ما فرض عليه، أو ما قدر له، لأنّ شقاءه في مصدر هامشيته، أو كما قال محمود درويش عن إدوارد سعيد: "على الريح يمشي، وفي الريح (يحاول أن) يعرف من هو"، وفي مثل هذا الموقف كل ما أستطيع أن أقوله ـ على رأي درويش: لا أعرِّف نفسي لئلا أضيِّعها - ومع ذلك فإنني "أنتمي لسؤال الضحية"، رابض في قاع كلمات تبحث عن معنى منفلت، فلا جدوى، بعد أن أصبحت المواقف متجاذبة والأفكار سوداويّة والحياة ملغزة، وما بين إبهام الحياة ولغز التعرف إليها تتشكل مسيرتي، شأني شأن الكثير ممن يحمل همّ الكتابة التي لم تعد قادرة على توصيل معنى الفهم، لذلك أصبح الإنسان حسب وليام دالتي Wilhelm Dilthey غير قابل للفهم. وحين يجد المرء نفسه في ظل هذا التصور، فهو مخير بين أمرين: إما أن يحمل قيمه، أو يمارس شذوذ التفكيك الذي يؤطره المعنى المنفلت، ولعلي من الذين يرفضون أن يعيشوا هذا الشذوذ الذي أضعف المبادئ، أو أن يعيشوا سر المعنى المضلل خارج سياق القيم، وليس للمرء في هذه الحال إلا أن يستفيد من تجارب الحياة ليجعل منها كشفاً.
نور الدين علوش: كثر الحديث في الأوساط الثقافية والأكاديمية عن مفهوم الأنسنة، باعتباركم أحد الباحثين الذين خصوا هذا الموضوع بالاهتمام والتفكير، ما هي الأنسنة؟ وما هي جذورها الفلسفية والعلمية؟ ومن هم منظروها؟
الأستاذ فيدوح: لقد ذكرت في دراسة لي عن هذا الموضوع أنّ الأنسنة في مجمل تعريفاتها تتمحور فيما رآه شيلر F.C.S.Schiller الذي يعتبر أنّ قوام الأنسنة هو إدراك الإنسان أنّ المشكلة الفلسفية تخص كائنات بشرية، وتبذل غاية جهدها لتفهم عالم التجربة الإنسانية، وزادها في ذلك أدوات الفكر البشري وملكاته، طبقاً لما أورده في كتابه "دراسات في المذهب الإنساني Studies in Humanism"، ولا خلاف ـ في ظني ـ بين الأنسنة وبين آراء الناس فيما تواضعوا عليه من أمور ما يستوجبه الواقع الداعي إلى الإصلاح. واضح، إذاً، أنّ أطروحة الأنسنة ترجع إلى مقتضيات تيولوجية Theologi، وإثنولوجية Ethnology، كونها تصور الإنسان وفق قوانين سنن الكون، وهو تفسير يسعى إلى وضع الإنسان تحت إمرة اللوغوس (العقل) في محاولة للبحث عن تفعيل التجربة الإنسانية في ضوء ما يقتضيه توحيد الكليّات عن دائرة التدرج الطبيعي لروح الوجود.
ووثْباً على النظر إلى هذا المصطلح في مساره التاريخي، وعلى الرغم من تفرع الحديث في هذا الموضوع إلى مجالات شتَّى، وعلى الرغم من اتفاق كل الدارسين على أنّ المفكر الجزائري محمد أركون حاز قصب السبق وشرف الدراية به، فإننا نرى أنه أول من وسّع من دائرة هذا المفهوم، وجعله متساوقاً مع تنامي الوعي الإنساني للحضارة الجديدة. وقد تبين لأركون ـ في حينها ـ أنّ الحضارة العربية ما زالت تعيش على فكر الفقه، ولم تسهم في بناء فقه الفكر، اعتقاداً من وعي هذه الحضارة أنها مركز الكون الإنساني، من دون تبصّر في المقام، أو التدبّر بالنظر في الدلائل التي تراهن على معايشة مستجدات العصر، سواء من الناحية المادية، أو البنيوية، أو المعرفية، أو الثقافية.
وقد استضاء أركون في "أنسنته" بتنوع انتعاش التمدّن، والنمو المطّرد الذي أسهمت في بنائه الحضارة الجديدة، ابتداء من باكورة التطور المعرفي إلى تنامي الوعي الثقافي في كل ما يتصل بالكائن البشري الذي من شأنه أن يظهر الإنسان على إنسانيته، ويعزز فيه دوره الاجتماعي؛ الأمر الذي من شأنه أن يسوّغ بزوغ ثقافة إنسانية مشتركة، لا تكتمل إلا بهذه المفاهيم: العمل المفضي إلى البناء، والحرية، والعدالة، والديمقراطية. وليس غريباً أن يكون أركون مدركاً هذا التصور من دون أن يجعل منه حافزاً لإنتاج معرفة قادرة على البناء، من هذا المنظور كان أركون يستمد رؤاه، كما استمدت أنسنته وعيها الفكري من نتاج قدرات الثقافة المتحررة، ومن المتغيرات التي أحدثتها نجاحات النهضة الحديثة في جميع مراماتها الملازمة لحياة الإنسان المتحضر، بوصفه مصدر الكون في منظومته البشرية.
وقد وظف أركون الأنسنة في مجالاتها المتنوعة كالأدب، والثقافة، والتاريخ، والدين، والإنسان في علاقاته الاجتماعية، والفكر في مساره التنويري، وكأننا به في أثناء تناوله وعي الأنسنة يدعو إلى تثوير العقل، بدافع الرغبة في التحديث، ونشر فلسفة الأنوار التي تمكّن في الإنسان نزعته الإنسانية، وتخلق فيه عقلانية متوازنة في الحياة الاجتماعية.
أمّا فيما يتعلق بجذورها فليس هناك أدلّ على الاحتفاء بالإنسان كما احتفت به الديانات بخاصة الدين الإسلامي الذي كرّم قيمة الإنسان وأعطاه الأفضلية على باقي المخلوقات، وجعله الله سبحانه خليفته في الأرض ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، وغيرها من الآيات التي جعلت منه حامل أمانة إنسانية على وجه الأرض، والغاية من خلقه عن سائر المخلوقات في شأوه، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع الثقافات التي احتفت به على مر العصور، إلى أن ارتبطت أهمية المصطلح بشكل محدود في الفكر الأوروبي الحديث، حين ورد لفظ "أنسنة" "Humanisme" لأول مرّة سنة 1808م، من فريديريك نيثهامر Friedrich Philipp Immanuel von NIETHAMMER في دراسته المعنونة بـ:
Der Streit des Philanthropinismus und des Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unserer Zeit
وقد ذكر الباحث هواري تواتي أنّ لفظ الأنسنة "Humanisme" اكتسى محتوى فلسفياً في أوساط اليسار الهيجلي، واستعمل كمفهوم في الفلسفة الأنتروبولوجية. كما نجد له أثراً عند ماركس Marx في مخطوطات 1844 وفي العائلة المقدسة (1845) الذي ألفه بالتعاون مع فريدريك إنجلزFriedrich Engels. حيث ربطا المفهوم بالتحرر الإنساني، إلى أن استوى المفهوم في سياقه الفلسفي مع فريديريك فيورباخ Friedrich Feuerbach. وعلى الرغم من تداول هذا المصطلح "أنسنة" Humanisme منذ عام 1840 في مختلف الحلقات الفرنسية المهتمة، فإنه لم يدخل القاموس الفرنسي إلا بعد هذا التاريخ بثلاثة عقود، في ملحقه لسنة 1877، ثم توالت الدراسات الغربية فيما بعد، التي وصفت الأنسنة بأنها ستكون "دين المستقبل". (ينظر، هواري تواتي: من أجل نزعة إنسانية متوسطية، موسوعة الأنسنة المتوسطية).
نور الدين علوش: لم تظهر النزعة الإنسية في الغرب بدون مقدمات وإرهاصات فكرية وعلمية، فما هي الشروط الثقافية والعلمية والدينية التي أنتجت الأنسنة؟
الأستاذ فيدوح: لا أحد يزايد على أنّ لحركة الإصلاح التي تبناها الفكر الإنساني عبر مر العصور دوراً في تغيير الإنسان إلى طريق القيام بما عليه من واجب، والأخذ بيده إلى أن ينال كرامته، ودفعه إلى أن يأخذ حقوقه من دون منٍّ بما يُعطَى له.
لقد وجد العلماء والمفكرون أنّ التغييرات الاجتماعية لا سبيل لها إلا إلى نموها؛ بدافع الفعل المشترك لحدوث التفاعل في الاتجاه السليم خدمة للإنسانية، ولعل هذا التفاعل هو الفكرة المتبلورة التي رافقت واعز تكوين القيم التي حصنتها كل الحضارات، وعززت دورها في الحياة، من منظور أنّ كل حضارة لا بدّ لها من عوامل ومبادئ تستمدها من غرائز الإنسان وطبيعة تكوينه الفطري والثقافي كنتيجة حتمية لإشعاع يبعث على النمو، من دون إهمال منعطف الوعي، واستخدام العقل الذي من شأنه أن يفضي إلى الإنتاج، وعلى أساسه تتم الدورة الحضارية في اتجاهها المتنامي كنتيجة حتمية لانبعاثها، بعد تحطيم كل ما يمت بصلة إلى الأغلال التي رافقت الإنسان في مسيرته البالية، في مقابل إصفاء العقل من كل ما هو رَمِيم، وذلك حتى نتجاوز الحد الفاصل بين ما هو سلبي متوارث، بخاصة ما اتخذ منه عُشاً مظلماً في ضمائرنا، وإيجابي يروم المدنيّة، أو بتعبير آخر حتى نفرق بين عهد الجمود وعهد الترتيب، والتحليل والتصويب لإدراك التدبر وإعمال العقل، حينها يمكن القول إنّ مثل هذه الإرهاصات الفكرية هي ما كان دافعاً لإنتاج وعي إنساني اتخذ سبيل منعطف بناء الدورة الحضارية والشعور بالانتماء إليها، والاستعمال العقلاني لركائزها ومبادئها، وهذا ما نلمسه في الحضارة الغربية التي تداركت أخطاء الماضي بالصواب، واتبعت المستجدات وعالجتها، وألحقت الآخِر بالأول في تنامٍ مستمر، يبحث عن فكر جديد ووضع جديد، وهو ما تمّ رسمه للنهضة بما يمكن أن يكون عليه الوضع في إيجاد صلة تربط الإنسان بالإنسان، والإنسان بالمجتمع، والإنسان بالواجب، وهو ما أشار إليه مفكرو عصر النهضة في أوروبا الذين أرشدوا الوعي إلى الموضوعية، ودعوا إلى تبني المنهج التجريبي خدمة لتقدم الإنسانية وبناء مدنيتها، وإعطاء الأهمية للقيم، وحرية الرأي بوصفها اللبنة الأولى لبناء مجتمع صالح في احترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بمنظومة العقد الاجتماعي المشترك.
وإذا رجعنا إلى الباحث العالم الهولندي ديدي إرزمس Didie Erasmes فإنه حسب رأي الباحثة حياة بنت مناور الرشيدي كان يرى أنّ الدراسات الإنسانية وسيلة لغاية، وهي إصلاح المجتمع الأوروبي وتخليصه من الشرور والآثام والفضائح الخلقية التي كانت ترتكب جهاراً، وكذلك من الجهالة المتفشية فيه. وبعبارة أخرى كان يرى أنّ الدراسات الإنسانية يجب أن تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى علاج الأمراض الاجتماعية والمساوئ الخلقية.
وإذا أضفنا عامل الرغبة في التحرر من قيود الأعراف والتقاليد العقدية المزيفة عندهم، استطعنا أن نعرف مدى اهتمام الغرب بقيمة معنى التحرر من سيطرة الأفكار الضالة، سواء ما كانت تمارسه زعامة الكنيسة بسيطرتها الدينية، أو ما ترسب في ثقافاتهم البالية، ومحاكاتها بوصفها جزءاً من قداسة الماضي.
ولعل في حركة الإصلاح هذه ـ بخاصة منها الجانب الديني ـ ما جعل البحث الإنساني يأخذ حيزه الموضوعي في الدراسات الغربية، رغبة في تعزيز مكانة الدراسات الإنسانية في الثقافة الحديثة، ومن هذا المنظور تواضع المفكرون على أن يكون العقد الاجتماعي الجامع بين الواقع المعمول والواقع المأمول هو الارتباط الوثيق بين الوعي الإنساني والوعي الإصلاحي، وهو ما عملت على تحقيقه النهضة الأوروبية بوجه عام، وكرسته الدراسات الثقافية التي اتخذت من القيم الإنسانية وسيلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية.
نور الدين علوش: ارتبطت الأنسنة تاريخياً بالتنوير والعلمانية، فما هي دلالة هذا الارتباط؟
الأستاذ فيدوح: مع تقديري لهذا الرأي إلا أني لا أميل إليه، بعد أن ذكرت لك قبل قليل أنّ الحاجة إلى الأنسنة فرضتها ضرورة "دين القيمة" وليس دين العلمانية؛ أي جوهر المبادئ الإنسانية، وإذا كان الشأن الديني عند العلمانيين يستند إلى طريقة الاعتقاد بصحته، من عدمه، فإنّ دين القيمة الإنسانية يستند إلى الترابط والتكافل والانخراط والتآلف والتوحد والائتلاف سواء أكان ذلك بالفطرة أم بما تدعو إليه التوجيهات بالأدلة والبراهين، وإذا كان التنوير يستمد أفكاره من الحاجة إلى التغيير بالفكر والإنجازات المادية والمعرفة الإنسانية، فإنّ الأنسنة تشترك مع هذه المعرفة بالطرق التي تؤمّن وصول الإنسان إلى القيام بدوره، بوصفه إنساناً منتجاً في هذه الحياة، وإذا كان كل من التنوير والعلمانية يشتركان في مساعيهما إلى نشر التمدّن بين المواطنين، فيما يسبغانه على الحياة من تحضر وتطور، فإنّ مصدر الأنسنة يكمن في مقومات المجتمع المدني في تآخيه عبر الوسائل الموكلة إليه لبناء مجتمع صالح لا يختلف على ما سنته القوانين الطبيعية التي لا تختلف كثيراً عن القوانين السماوية أو الوضعية، ولذلك لا أجد غضاضة فيما تشترك فيه الأنسنة مع العلمانية والتنوير في بعض الأمور، ويختلفان معها فيما هو خصوصي، على الرغم من أنني أرجح كفة من يرى أنّ العلمانية لا تعارض الدين في جوهره إلا بمقدار ما يساء فهمه، على النحو الذي دعا إليه العقل التنويري بالتشجيع على إعمال العقل، وهي ميزة لا تختلف كثيراً عما رسمته الديانات السماوية بخاصة الدين الإسلامي الذي نوه بالعقل، وأعلى من مكانته، وجعله في مقام التعظيم، والعمل بموجب ما تشتمل عليه وظائف الإنسان العقلية - على اختلاف أعمالها وخصائصها ـ حيث تكررت قيمة العقل في القرآن ـ بما في ذلك مشتقاته ـ بعدد وافر؛ الأمر الذي أعطاه ميزة متفردة بين الديانات والمذاهب.
المحور الثاني:
نور الدين علوش: ارتبط موضوع الأنسة في الفكر العربي كثيراً بالمفكر الجزائري محمد أركون، فما هي الأطروحة المركزية التي يدافع عنها؟
الأستاذ فيدوح: لقد ذكرت في دراسة لي عن هذا الموضوع ما نصه أنّ محمد أركون كرّس جهده لموضوع "الأنسنة" حتى أصبح أكثر الموضوعات جدارة بالدراسة. وقد نظر إليها الباحثون من شتى الأهواء، يمكن حصرها في حكمين: أحدهما أنّ الأنسنة قيمة علمية مائزة في فكره، أما الحكم الثاني فيتمثل في نظر منتقديه على أنّ الأنسنة زلة شائنة في منهجه، وشائبة في رؤيته، ومبالغ في تجسيمها بهذا الطرح، بالنظر إلى ارتباطها بالمنهجية الاستشراقية، في حين رأى المنافحون عنها أنها تعود بجذورها إلى مهد الفكر الإسلامي، مروراً برواد النهضة العربية، ومن ضمنهم حسن العطار (1766 - 1835) في مطلع القرن التاسع عشر، ومن بعده رفاعة الطهطاوي (1801 - 1873) فيما دعا إليه من فكر تنويري، الذي بعثه طه حسين (1889 - 1973) ومن تبعه بقدر من الإصلاح والإبداع، ومن قبله مُحَمَّد عبده في حديثه عَنْ نظام الحكم والوطنية وقضايا المرأة، وعلي عبد الرازق في تبنيه علمنة الدولة، ولطفي السيد في دعوته إلى القومية المصرية بديلاً عَنْ الرابطة الدينية، وقاسم أمين في دعوته إلى تحرير المرأة. فإننا نجد للأنسة في ارتباطها بتحرر الإنسان من أغلال العوائق ما يؤكد مكانتها في الثقافة العربية الحديثة، على نحو ما كانت عليه نزعة الأنسنة الإسلامية منذ القرن الخامس الهجري.
وإذا كان أركون يعزز مكانة "الأنسنة" فلأنه في تقديرنا يَعدُّ إرادة الإنسان، في تعقُّله، فرعاً لإيمانه بالانتصار لمبادئ الدين بفضل استعداده العقلي. والحال أنّ أنسنة أركون لا تبتعد كثيراً عن النزعة الإنسانية من حيث كونهما لا ينفصلان عن بعضهما كثيراً في رسم المقاصد التي تكفل للإنسان حمل الأمانة الإنسانية، والتعهد بها في الإعمار. فأين وجه الخطأ ـ إذاً ـ في حمل أركون على المروق بهذه الحدة؟ وهل يكمن الخطأ في اختزال "أنسنة" أركون في مجرد الثيولوجية السلبية؟ إذا كانت الأنسنة ترى أنّ الوعي سلطان العقل الداعي إلى حرية الإرادة، وفق رغبات الإنسان بحسب ما يعرف بالحتمية التاريخية، فإنّ النزعة الإنسانية تنبثق من جوهر الأشياء في ارتباطها بالكمال المطلق، وقد نجد في إنسانية الإنسان المتطابقة مع التصور الديني المحض ما نعتقد أنه يجمع بين الأنسنة والإنسانية، أو بين قوانين التطور العامة في "الإرادة البشرية" و"العلة الكبرى".
نور الدين علوش: يرجع أركون كثيراً في كتابته إلى أبي حيان التوحيدي، وابن مسكويه، بوصفهما علمين من أعلام النزعة الإنسية في الحضارة الإسلامية، فما هي الأسباب التي دفعته إلى ذلك؟ وأين إسهامات الفارابي التي أعلت من شأن الإنسان؟
الأستاذ فيدوح: لقد بينت في كتاب لي بعنوان "التجربة الجمالية في الفكر العربي" أنّ لأبي حيان التوحيدي دوراً حيوياً في تطرقه لموضوع الإنسان، وكل من يتعمق في كتابات التوحيدي يجد فيها مادة سائغة للقيمة الإنسانية، وهو ما حدا بكثير من المفكرين إلى تناول مادته الفكرية بقدر من التدبر والتبصر، وعلى رأسهم محمد أركون الذي تشبع بأفكار الفلاسفة العرب القدامى، ولعل مرد الاهتمام بأبي حيان هو أنه من بين الفلاسفة الذين أولوا عناية مطلقة لقيمة الإنسان من حيث إنه لا قيمة له بطبيعته، بل بالتحقق المطلق لحركته الدائبة، على اعتبار أنّ من شروط المعرفة التقلب من حال إلى حال، ومن هيئة إلى أخرى، يتجرد من خلالها الإنسان بوصفه عالماً أصغر، ولمّا كان كذلك فقد كان الكون عالماً أكبر. وكأنّ الكمال في نظر الفلاسفة، والتوحيدي على سبيل المثال، هو نظير المعيار الخلقي الذي يشكل بعرفانيته معرفة الحق ومصداقاً له، وذلك من خلال المعرفة اللدنية التي تحدد فضائله الإنسانية في وجودها الأخلاقي والاجتماعي، بما يقابلها من كمال لصفة العالم الآخر؛ لأنّ الإنسان في نظر التوحيدي "إذا أحسّ بهذه الفضائل التي في نفسه، والرذائل التي في نفسه - وجب عليه أن يستكثر من الفضائل ليرتقي بها، إلى درجات الإلهيين". (الهوامل والشوامل، ص 28)، على اعتبار أنّ معرفة الكمال والتحلي به إنما تنطلق من جوهر وجود الإنسان في حركته الدائبة التي تسعى إلى معرفة النفس عبر صفة العقل. على أنّ هذا الكمال لا تتحدد معالمه في نظر التوحيدي إلا من خلال ما يحتوي الإنسان من معرفة يقينية للنفس التي تندرج بين الروح والجسد، وهي ثنائية تحدد مدار القيمة الفنية على خلاف غيرها من المخلوقات، وأنّ معرفة العالم لا تتحدد إلا من منظور منطق معرفة الإنسان ذاته. ذلك أنّ كل تجربة جمالية تصدر عن اهتمام الإنسان بذاته بما هي قيمة إنسانية، أو بما هي مشروع يتطلع إلى المعرفة، هذه المعرفة التي تصل بها النفس إلى حقيقة الكون، ألا وهي الذات الإلهية، ومن ثمة تصبح المعرفة شرطاً لمعرفة الحقيقة، كما أنه لا حقيقة من دون معرفة الإنسان لنفسه، بوصفها جوهراً إلهياً، وفي هذا يقول التوحيدي: "فمن أخلاق النفس الناطقة ـ إذا صفت ـ البحث عن الإنسان، ثم عن العالم؛ لأنه إذا عرف الإنسان فقد عرف العالم الصغير، وإذا عرف العالم فقد عرف الإنسان الكبير، وإذا عرف العالمين عرف الإله الذي بوجوده وجد ما وجد، وبقدرته ثبت ما ثبت، وبحكمته ترتب ما ترتب" (الإمتاع والمؤانسة، ص 134).
ومن ثمَّ، فإن الاهتمام بالإنسان عند التوحيدي وتقديمه على ما سواه لا يعني وصفه لذاته. وإنما بما هو قوة خارقة للإنتاج المعرفي، بل هو المقام الأول، وبذلك استبعد أبو حيان في الإنسان جانبه الروحي لصالح النفس، على اعتبار أنّ الإنسان لم يكن إنساناً بالروح بل بالنفس، ولو كان إنساناً بالروح لم يكن بينه وبين الحيوان فرق، ومن ثم فإنّ العقل الإنساني ـ في نظره ـ موجود بالفعل وهو فائض عن عقل موجود بالقوة هو (الله) ومن ثمَّ يكون الإنسان قوة بعقله.
وإذا كانت قيمة الإنسان على هذا النحو في فكر التوحيدي فإنها لا تقل أهمية في أبعادها المتنوعة عنها في فكر ابن مسكويه الذي وصف أصناف الناس إما على أنها كريمة بالطبع، أو عادية بالطبع، أو أنها عديمة التفاعل مع الآخر (ينظر، تهذيب الأخلاق ص51)، وفي هذا إشارة منه إلى تفاضل الناس في "الإنسانية" بالفضائل القائمة على العلم والأخلاق، وعلى بذل العطاء، وفي هذا غاية ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من قبول قوة العقل، حتى يصبح في الأفق الذي هو مدار الإنسانية ولا حالة للإنسان أعلى من هذه ما دام إنساناً. وما دام الأمر على هذا النحو فلا تتم للإنسان السعادة إلا بتحصيل التمام بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية، وفي هذا الشأن يقول: وينبغي أن تعلم أنّ كل إنسان معد نحو فضيلة ما فهو إليها أقرب، وبالوصول إليها أحرى، ولذلك لا تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر إلا من اتفقت له نفس صافية وطبيعة فائقة، فينتهي إلى غايات الأمور وإلى غاية غاياتها، أعني السعادة القصوى التي لا سعادة بعدها (ينظر، تهذيب الأخلاق، ص 84 ـ 72).
أما الفارابي فقد نال الحظوة نفسها التي نالها غيره من الفلاسفة الذين تعرض لهم أركون، وعدَّه من أهم الشخصيات التي بيّنت الموقف الإنساني المنفتح، وأنه أحد ركائز الفضاء العقلي الجريء، بالإضافة إلى أسماء أخرى تمتُّ بصلة إلى هذا الموقف، منها على سبيل المثال: الجاحظ، والكندي، وابن سينا، وأبو سليمان المنطقي، وأبو الحسن العامري، وغيرهم كثر، وعلى الرغم من ذلك تظل مواقفهم تحت سقف الإرهاصات الأولى، ويبقى موقفهم سبّاقاً في تاريخ الحركة الفكرية عن النزعة الإنسانية، وعقد مصالحة بين الدين والعقل، بغض النظر عما قام به الغربيون تباعاً من نهضة فكرية ركزت على استقلال العقل عن النقل، ليس المجال هنا للتفصيل فيه.
وبالعودة إلى طرح سؤالك، بخاصة في الشق المتعلق بالأسباب التي دفعت أركون إلى تبني أفكار هذين المفكرين، ألا نجد فيما عرضناه مبرراً قوياً لاقتناع أركون بما توصل إليه الوعي الفكري العربي لأنْ يكون في مصاف القيم الإنسانية التي تطرحها المعارف ـ والفلسفة منها على وجه الخصوص ـ عبر العصور، والفلسفات الحديثة على وجه التحديد؟
وإذا أضفنا إلى هذه المبرارات مسوِّغ محاولة أركون إبراز مكانة الأنسنة في الفكر الإسلامي، وأنّ هناك نزعة إنسانية يدعو إليها الإسلام، فإنّ ذلك ما يحسب له في السبق الكشفي الذي تفردت به أفكاره، والتي أفاضت في الحديث بما تستوجبه القيم الإنسانية.
وقد ذكر هاشم صالح، أقرب الناس إليه، في مقال له: (هل أركون فيلسوف؟ وبأي معنى؟) أنّ حرْصَ أركون على مصطلح الأنسنة كان نابعاً من أطروحته: "النزعة الإنسانية والعقلانية العربية في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي ـ مسكويه فيلسوفاً ومؤرخاً". ويذكر أنه اختلف معه كثيراً حول ترجمة هذا المصطلح الأوروبي: هيومانيزم Humanisme "وعلى الرغم من إصراري على مصطلح النزعة الإنسانية كمقابل له إلا أنه أصر على كلمة الأنسنة وفرضها في نهاية المطاف، بل واشتق كلمة جديدة في اللغة العربية من خلالها. ومهما يكن من أمر فإنّ أركون أثبت وجود نزعة إنسانية حقيقية في العالم العربي الإسلامي، وفي القرن العاشر الميلادي، بل وحتى قبل ذلك. لقد برهن على ذلك من خلال تحليله لأعمال مسكويه والتوحيدي وسواهما من مفكري ذلك الجيل. وقال إنّ النزعة الإنسانية والعقلانية العربية سبقت النزعة الإنسانية الأوروبية في عصر النهضة بخمسة أو ستة قرون على الأقل. ولكنّ المستشرقين لا يعترفون بذلك، ويصرون على القول إنّ العرب لم يعرفوا النزعة الإنسانية في تاريخهم، وأنّ هذه النزعة محصورة بالقرن السادس عشر، وعصر النهضة في إيطاليا، ثم كافة أنحاء أوروبا. وبالتالي فهي حكر على الغرب وثقافته فقط".
نور الدين علوش: يحتل التأويل موقعاً مهماً في مشروعه النقدي فما هو التأويل؟ وما هي آلياته؟
الأستاذ فيدوح: أعتقد في هذا الموضوع أنه لا حاجة إلينا بالعودة إلى الإرهاصات الأولى في جميع الثقافات، والنظريات الغربية على وجه التحديد، وصولاً إلى الفيلسوف الألماني هانس- جيورج غادامر، الذي صُنف على أنه رائد التأويل الفلسفي المعاصر، ولعل الكل يتفق على أنّ التاويل طلبته حاجة اغتراب النص، وهجرته عن فهم المتلقي له فهماً يليق بما يرمي إليه النص، ويلتمسه المتلقي، ويبتغيه في هذا النص، وقد ذكرت في كتابيَّ "نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية"، وبخاصة كتاب "إراءة التأويل" ما يشير إلى أنّ التأويل يأتي ليربط الألفة بين المتلقي والنص بآليات متنوعة، غالباً ما يفرضها النص، ويختار المتلقي ما يناسب منها للتحليل، أضف إلى ذلك أنّ التأويل يربط المتلقي بالكيفية التي يتمثل فيها اللامقول في القول، غير أنّ نظرة خاطفة تجعلنا نستسلم للشروط الممكنة لنظرية التواصل ـ من المنظور الجمالي ـ مع المفاهيم الكامنة في هذا العالم، وتشكلاته الدلالية، التي لم يعد يحدها حد، وليست قابلة للنقض أو المساءلة ما دامت الرغبة تكسر المنهجيات، وتطلب الحاجة إلى التعبير عن الأشياء الخافية. وما دام العالم يفيض بالمستجدات فليس هناك حكم ناجز. وإذا كان ذلك كذلك فإنّ العين الرائية تبقى ملتمعة بكل ما هو كشفي يشع بالتأمل الذي يستمد قيمته من ذاته، لا من مرجعية الطي، أو المطوي في ذاته، الضامر في منابعه.
وفي مثل هذه الحال يأتي التأويل ليكشف اللامقول في النص، ويرفع عنه ما يواريه ويغطيه، ويزرع فيه روح التجديد إلى اللامتناهي من الدلالات، امتثالاً لمقولة محي الدين بن عربي "ما في الكون كلام لا يتأول"، بغرض الحصول على أجوبة مرتبطة بمشروع الإنسان في الوجود من ظاهر وباطن.
ومن ثمّ، إذا كان التأويل الذي نقصده، بحسب شمولية السؤال، يقتحم الخبيء واللامرئي في النصوص المعتمدة، فذلك لأننا نرفض أن نكون مرآة للصورة، أو المرآة العاكسة، وإنما رغبة كل متلقٍ تكمن في الاندماج مع النص الذي يشغل باله ويعزز افتراضاته؛ لأنّ هناك مسوغاتٍ تدفعه إلى ذلك، وفراغات تأسره وتشده إلى تضاعيف النص وفيوضه. والتأويل بهذا المنظور مسار مفتوح، يصوغ أسئلته في فضاء النص، اعتقاداً منا أنّ العلاقة التي تجمع التأويل بالإبداع هي علاقة تكامل، رغبة في البحث عن أغوار الشيء في الذات ومحيطها الكوني، وأنّ كلاً منهما يفيد الآخر فيما تنطوي عليه مظاهر الكون من أقنعة متعددة، والبحث في جوهر الحياة الإنسانية التي يرمي إليها كل نص.
نور الدين علوش: ما الفرق بين الأنسنة في الفكر الإسلامي الكلاسيكي، والأنسنة في الفكر الغربي؟
الأستاذ فيدوح: انطلاقاً من إصرار محمد أركون نفسه، لزمه في دراساته، فإنّ "الأنسنة" بنزعتها الإنسانية في إرهاصاتها الأولى واكبت الفكر العربي قبل الفكر الغربي، غير أنّ منافحة المستشرقين له وقفوا في وجه كل رؤيا مستنيرة جاء بها الفكر العربي، ومن ثم تصدوا لآراء أركون، وتصدوا له بما يناقض نتائجه العلمية المستنيرة التي توصل إليها في أبحاثه، وواجهوه بقسوة فيها نزعة من الصلف والنزق، وبكل ما تحمله معاني العجرفة، مستكثرين على الفكر العربي سبق تناول النزعة الإنسانية في دراساتهم، وقد ذكرنا سابقاً أنّ النزعة الإنسانية لم يكن لها وجود بالسياق الذي أسسه الفكر العربي حسب ما تذكره الموسوعات والقواميس المختصة إلا في القرن التاسع عشر، وبالتحديد في سنة 1808 حين استعملها F J Nithammer وربطها بالمنظومة التربوية رغبة في خلق ناشئة تنهج سبيل السلف في السلوكيات، وهو ما يمكن أن يدخل ضمن سياق الإعلاء من قيمة الإنسان ومكانته في الحياة اليومية. غير أنّ الذي يعنينا في هذا المقام أنّ الأنسنة في الفكر الإسلامي لم تخرج عن تعزيز مكانة العقل، والدعوة إلى حرية الإرادة وفق رغبات الإنسان بحسب ما يعرف بالحتمية التاريخية، وضمن هذا السياق نظرت الفلسفة الإسلامية إلى النزعة الإنسانية من منظور أنها تنبثق من جوهر الأشياء في ارتباطها بالكمال المطلق، وقد نجد في إنسانية الإنسان المتطابقة مع التصور الديني المحض ما نعتقد أنّ الفكر الإسلامي يجمع بين الأنسنة والإنسانية، أو بين قوانين التطور العامة في "الإرادة البشرية" و"العلة الكبرى".
والحال هذه، فإنّ اختلاجات الإنسان لا تخرج كثيراً أو قليلاً عن ظلال سنّة "علل العلل" في تساؤلات الإنسان وتطلعاته ضمن اتساع مدى الأنسنة، بما في ذلك نزعتها الإنسانية. ومن ثمَّ، فإننا لا نرى ضيراً من أن تحقق الأنسنة جزءاً من أهداف النزعة الإنسانية التي دعا إليها الفكر الإسلامي، اعتقاداً منا أنّ الأنسنة والإنسانية يتطابقان في غاية الرسالة، من منظور أنّ الإنسان موجود كونه خاضعاً لإرادة قادرة على توجيهه، وموجود بفعل إرادته، وهي مسألة ناقشتها الفلسفة العربية القديمة في موضوع "إرادة الحتم وإرادة الأمر"، وفي علم الكلام تحت مفهوم "المحكم والمتشابه"، أو ما قيل في "نظرية الكسب".
أمّا الأنسنة في الفكر الغربي فإنها شطت بنا في منظورها، بدءاً من ربطها النزعة الإنسانية بعلم اللاهوت الذي حاول أن يجبر الإنسان في إحداث علاقة بين إدراك الكليّات بإدراك المفردات لمعرفة العقيدة الدينية، بما تستلزمه القيم، كونها تضمن التقاليد الدينية، إلى أن جعلت من الإنسانية في مرحلتها المتأخرة كينونة شيئية بنظرتها المادية للإنسان، بمعزل عن الجانب الروحي أو الإنساني، وإخضاع كل شيء للتجربة، وتطبيقها على الإنسان، ومن ثم أصبح الإنسان في تعامله الإنساني بمثابة مرجعية للقوانين المادية، وكل ما يتصل بآليات التشتيت، والتشكيك، والاختلاف، والتغريب، والعدمية، والتفكيك، واللامعنى، واللانظام، والغرابة، والشذوذ، وغموض الآراء والأفكار والمواقف. فأين الإنسانية المشتركة في ظل تشظي الإنسان وانهيار قيمه وتشتتها إلى هذا الحدِّ؟
وتتفق جلّ الدراسات على أنّ الفارق بين نشأة العلمانية في الغرب عنها في الثقافة العربية، هو أنها جاءت في الغرب نتيجة تأزم مجتمعه ـ في حينه ـ الذي كانت تسيطر عليه المؤسسة الدينية، وهو ما لا يتطابق مع ثقافتنا التي سيطرت فيها المؤسسة السياسية على المؤسسة الدينية، بغض النظر عن مؤدى النتيجة.
نور الدين علوش: ما هي العوامل التي حكمت ظهور الأنسنة في العصر الكلاسيكي الإسلامي؟ ولماذا تراجعت ولم يكتمل مشروعها؟
الأستاذ فيدوح: لعل الروابط التي حددت مسار الرؤية الكونية "برؤية علمية محضة" هي ذاتها التي حددتها الرؤية الكونية من المنظور الديني في نظرته الشمولية من حيث (العبادة، والشريعة، والفكر، والعمل) وهو ما اعتبره محمد أركون في أثناء تطرقه لـ"الحادث القرآني" ضمن "مسار الفكر العليم"، اعتقاداً منه أنّ الإناسة الثقافية تسهم في فهم معالجة الظاهرة الدينية، وفي هذا تعارض ـ حسب رأي أركون ـ مع "الطريقة الأخبارية" التي يتبعها المستشرقون (ينظر، رون هاليبر: العقل الإسلامي، ترجمة جمال شحيد، 196).
وتتفق معظم الدراسات على أنّ ما وحد فكرة النزعة الإنسانية بين العرب المسلمين هو عوامل كثيرة، منها العامل الاجتماعي والثقافي والديني، قبل أن تنتصر التوجهات الفقهية الدوغمائية في عهد السلاجقة لتقيض الفكر الحر، والتي أطلق عليها أركون الثقافة الأرثوذكسية في إجبار الناس على الالتزام بالموروث، كما يمثلها الجانب الفقهي الذي لا يملك الحقيقة سواه.
نور الدين علوش: كيف يمكن بعث الأنسنة من جديد في الفكر العربي المعاصر؟
الأستاذ فيدوح: لعل أول مبادرة يفترض أن نقوم بها هي معالجة قضايانا فكرياً، بما تستدعيه النظرة الكونية، وفيما له صلة بما تنجزه الرؤية المعرفية الإنسانية، والعناية باستثمارها عناية تامة، بدءاً من نهضة تعلّمية، وتعليمية، وصولاً إلى نهضة فكرية فلسفية بعيداً عن العموميات. حينذاك نستطيع القول إننا أوشكنا على الاقتراب من المعرفة، وتوظيفها في حياتنا اليومية، والانتقال من النقل إلى العقل، وأعتقد أنّ هذا الأمر لن يتم إلا بإصلاح منظومتنا التعليمية، وإصلاح الوعي، لما يحتاج إليه من تصور واضح وجلي لرؤاه، أو كما قال المتصوفة: "رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته بواردٍ قويّ"؛ لما في دلالة العارف من معانٍ مختلفة بيننا وبين المتصوفة. وكم نحن بحاجة إلى وارد قوي لاسترجاع مكانتنا في هذا الوجود!
نور الدين علوش: ما هي الأبعاد الفلسفية والأسس المعرفية للأنسنة عند أركون؟
الأستاذ فيدوح: ذكرت في دراسة لي في هذا الشأن أنّ محمد أركون كان وسيطاً بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي؛ أي صوتاً مخاطباً الآخر من داخل منظومة الفكر الغربي الداعية إلى الفصل بين النقل والعقل، بعد أن تبيّن لهذه المنظومة أنّ المقومات التي تحدد مسار التلاقي بين صحيح المنقول وصريح المعقول متباينة في السبل الإجرائية، ومتباعدة في المعاني الضمنية، وهو تصور يستوجب ـ الحاجة الماسة في نظرها إلى ـ الإصلاح بغير ما درج عليه البحث الذي قاده النهج التقليدي في ضوء مجريات الوصف، والشرح، والتبيين. وقد تبين له أنّ النسق الفكري عليه أن يَدْرُج إلى مراتب إعمال العقل في فهم الواقع، في مقابل انشغاله بالنقل فقط، وجعله في أسوار الماضي، كما تبيّن له أنّ الوعي العربي بحاجة إلى إدخاله في معترك المختلف بعد أن عمّر في المؤتلف، وأنه بحاجة ـ في نظره ـ إلى انقياده لمشيئة نقد النقد، والتفكير في الأشياء كما ينبغي أن تكون عليه بالمعنى التساؤلي الأنثربولوجي بطرائقه الوظيفية.
المحور الثالث:
نور الدين علوش: بعد الربيع العربي ما موقع الأنسنة والتنوير في المشهد الفلسفي والثقافي؟
الأستاذ فيدوح: لا أحد يشك ـ بعدما آل إليه الوضع، وتحول إلى اللامعقول ـ في أننا نتأرجح بين صعود اللامعنى أوسقوطه، بالنظر إلى المتعارضات المركبة التي توجه ثقافة الشعوب المتناقضة، وبعد أن أصبح كل شيء يتحرك وفق وجهات لا يحدها حدّ، وكل شيء يحكمه التفكيك والتذرّر، حتى غدا مجتمعنا، "مجتمع رمي كل شيء" ـ كما أسماه ألفان توفلر Alvin Toffler ـ حقيقة واقعية، وهو في ذلك يعني أكثر من مجرد رمي سلع مستهلكة، وما يتبعها من تراكم فضلات، بل أيضاً القدرة على رمي القيم، وأنماط العيش، والعلاقات المستقرة بعيداً، ورمي الألفة مع الأشياء، والأبنية، والأمكنة، والناس، حيث انهارت معها كل القيم الإنسانية على النحو الذي أشار إليه "دافيد هارفي". وفي ظل هذا التصور كيف تريد من الأنسنة أن تتأطر بعد أحداث ما يُسمى بالربيع العربي مجازاً، كونه كرّس انفلات المعنى، وعزز هيمنة الفكرة المضللة، وأسهم في تشتيت مجتمعنا الذي لم تعد تحده فواصل؛ بفعل إدخالنا فيما وضعنا فيه من تباريح الهموم وانفصام الحياة وانصداعها، وتشرد الجيل الطالع بين التفصيل والتقسيم.
وبالعودة إلى موقع الأنسنة في ظل حالة الأهوال، والفزع، والهلع، وكل ما يمتّ بصلة إلى الرعب، فإننا أصبحنا نعيش حياة يعمها الهجر والابتعاد عن الحقيقة بجفاء، بعد أن لُفَّ بالربيع لفًّاً؛ بمخادعة ومداورة التصور والتوائه، بما لا يَدَع مجالاً للشك، ولا يقبل الجدال عن خلفيات ما يقع من أحداث تدعو إلى الريبة الملوثة؛ الأمر الذي أفضى إلى صرعنا، وأسهم في تضييع مسارنا الحقيقي، وأصبحنا مثل الليل في حُلكة حده الأقصى، وبعد أن سقينا مما هو أمرُّ من الحنظل. والحال أنه لا بدّ من صحوة ضمير الوعي المغيّب، والاسترشاد بمقولة كانت Kant: "السماء مرصعة بالنجوم من فوقي، والقانون الأخلاقي في باطن نفسي". بغرض الابتعاد عن الانغلاق الفكري، والقطيعة مع الثبوتي المزيف والمنخدع، والولع بالآخر المضلّل في كثير من غاياته.
نور الدين علوش: ما دور الأنسنة في محاربة التطرف والإرهاب؟
الأستاذ فيدوح: كل شيء قابل للرتق وإصلاح شأنه، إذا كانت النية صادقة والإرادة ثابتة؛ للقضاء على منبع التخلف قبل منبع التعصب؛ لأنّ التبشير بالجهل والتخلف من مؤسساتنا التعليمية والدينية أفضى بنا إلى الابتعاد عن المنطق والعقلانية والمعرفة المثمرة. أضف إلى ذلك أنّ كل رغبة في التغيير هي بمثابة زرع أمل بما يجنيه هذا الأمل من خير على أرض الواقع، ولذلك يشترط في مسيرتنا التغيير، وما أحوجنا إلى التغيير قبل أي وقت مضى!
صحيح أنّ مقاربة هذا الموضوع في هذا الموضع يثير حفيظة بعض الناس، ولكن بعيداً عن المزايدات بجميع أنواعها، على مؤسساتنا أن تتحمل تبعات ما زرعناه حتى أصبحنا نحصد الزؤان الذي أدخل أنسانيتنا المسلوبة في موقع المتفرج على بشاعة الوضع، وكأننا نيام أو مخدَّرون، ومصابون بالفتور والبلادة، وإلا ما معنى أن نعتاد على هذا البلاء وهذه الآثام، من دون أدنى حراك، سوى الآهات المتصاعدة، والتأوّه من توجّع تقطيع فلذات أكبادنا، بفعل تغاضينا عن الحقيقة، وبصمتنا عن تفشي الجهل الذي أوصلنا إلى هذا الانحدار والحضيض المقيت؟
ولكن "هل يصلح العطار ما أفسد الدهر"؟ وكيف يمكن للأنسنة أن تصلح ما لا يمكن إصلاحه؟ ومع ذلك فإنّ الاستسلام للأمر الواقع والخضوع للضغوط مردود، ما دام العقل سبيلنا، والوعي مرشدنا، والفكر نجاتنا، والإنسانية مآلنا، ومرجعيتنا؛ لذلك فإنّ قطع دابر شر التخلف هو من أولويات مهام الإنسانية لمنازلته، لا لشيء إلا لأنه مصدر خراب الوعي، وتفشي كل الأمراض الاجتماعية، ومن ضمنها التطرف الذي لا يمتّ بصلة إلى ثقافتنا أو ديننا الحنيف. من هنا لا بدّ أن يكون التعامل مع هذا الموضوع فكرياً؛ لأنّ "الأفكار لا يمكن انتزاعها، أو تعديلها إلا بالفكر"، وأن استمرار الإرهاب هو نتيجة حتمية لاستمرار انحطاطنا معرفياً، وكان يفترض التصدي له بالعلم من الجذور منذ مدة حتى نصل إلى الإشعاع النوراني الذي تسهم في بنائه الإنسانية، ولكن "إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" (سورة الرعد: من الآية11).
نور الدين علوش: هل يمكن الحديث عن الأنسنة بدون أرضية العلمانية؟
الأستاذ فيدوح: أعتقد أنّ كل معرفة أو نظرية تأتي لحاجات إنسانية، لكن مشكلتنا تكمن في سوء تمثيل المجتمع الإسلامي لهذه المعارف والنظريات، وحتى لحقيقة الإسلام الذي نؤمن به، ولكن ما نفعل إذا كانت مقولة مالك بن نبي "قابلية الاستعمار" أو التقبل الذاتي لتقليد الغرب في كثير من مفاهيمه هي ما يأسرنا. وإذا كانت العلمانية تتبنى شعار الديمقراطية، أو شعار "الدين لله والوطن للجميع" أو شعار "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين"، فإنّ هناك إقراراً في حياة الكثير منا بأنّ الإسلام هو التشريع القادر أيضاً على تنظيم القيم الفاضلة للمجتمعات بشكل يوضح الحقوق والواجبات، وما أحوجنا إلى ذلك!
ولعل ما أشار إليه القاموس الفلسفي لفولتير حين وضح أكثر ـ مما أرمي إليه في هذا المقام ـ ما يفي بالغرض في هذا المقام، وذلك حين ذكر: "هناك قانون طبيعي مستقل عن الاتفاقات الإنسانية، يبدو لي أنّ معظم الناس قد أخذوا من الطبيعة حساً مشتركاً لسن القوانين". وفي هذا إشارة إلى أنّ مصدر الإنسانية تحددها قيم سنن الطبيعة التي تخدم الغرض السامي للإنسان بالفطرة، كما تمنحها الضوابط الأخلاقية في غايتها الكونية. وهو ما أشار إليه أيضاً إميل بوترو Émile Boutroux في كتابه (العلم والدين في الفلسفة المعاصرة) من أنّ الإنسانية هي الموجود العظيم الذي يسمو بنا عن أنفسنا، ويضيف إلى ما عندنا من تعاطف قدراً فائضاً من القوى التي يحتاج ذلك الميل إليها؛ لإخضاع ميول الأثرة، وفي الإنسانية يتحابب الناس ويتآخون، ثم في الإنسانية يستطيع الناس أن ينعموا حقاً بالخلود الذي يتطلعون إليه.
ومن هنا فإنّ الحديث عن الأنسنة بأرضية علمانية أو من دونها، يبدو أنها أصبحت متجاوزة في الألفية الثالثة؛ بعد أن تحول موضوع الإنسان إلى ما يشبه الانفصامية التي أدت بحياتنا إلى التشظي الذي يمنع علينا ـ حسب رأي دافيد هارفي ـ حتى تصور فكرة متماسكة لمستقبل أفضل، وإذا كان ممكناً للإنسان المستلب، كما أصرّ ماركس، أن يلتحق مع قدر من التماسك والتنظيم بمشروع التنوير، وبما يكفي لبلوغ مستقبل ما أفضل، فإنّ فقدان الذات المستلبة سيحُول حتماً دون البناء الواعي لمستقبل اجتماعي بديل إلا بالقيم النبيلة المستمدة من سنن الطبيعة، وما تدعو إليه الشرائع في غاياتها الإنسانية، تعزيزاً لحرية الإنسان الداخلية ومسؤولياته تجاه واجباته. وأمام هذا وذاك يكمن الداعي الأكبر في إصلاح المجتمع عن طريق العلم الذي من شأنه أن يسهم في التزود بمعرفة القيم الإنسانية، وبالعلم وحده نتخطى الأصفاد المفروضة علينا.






