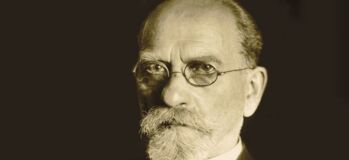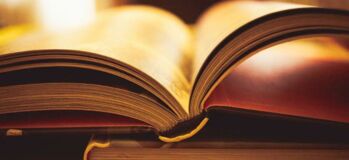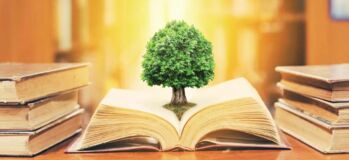عبد الله إبراهيم: النصوص الدينية مستودع رمزي للأفكار وتمثيل شامل لشؤون العصر
فئة : حوارات

فرش معرفي:
من الثابت أنّ المنجز الذي قدمه الأستاذ عبد الله إبراهيم، عبر مسيرته البحثية، خاصة في تمظهرها الأكاديمي، يُعدّ في نظرنا محطة مفصلية في الخطاب الفكري العربي المعاصر، ونحن على مقربة كبيرة من الصواب أنّ مفكرنا يسعى جاهداً إلى تطوير هذه الرؤية المعرفية بكل تؤدة وهدوء، لأنّ الأمر لا يتعلق فقط بتأليف كتب توضع في رفوف المكتبة العربية، وإنما هو جهد معرفي يرمي إلى إعادة النظر في القراءات المنتشرة في النصوص الفكرية العربية، وفي المفاهيم التي تخشبت وتكلست في تلافيف الذهن العربي.
في حوارنا معه تبين لنا أنّ مفكرنا لا يريد أن يتخندق في مذهب فكري جاهز وناجز، وإنما يريد أن يبقى خارج النسق، يطرق القضايا ويعالجها بمناظير معرفية متعددة، يستقيها من الدين، والتاريخ، والأدب، والسرد، والحياة، ويتوجه صوب الأخذ بالمنور الإنساني المنفتح. على أساس ذلك، عمل على تفكيك المركزيات المختلفة التي ترتبط دوماً بالرؤى اللاهوتية والتعالي والعنصرية، وقد استند إلى دراسات التابع، ومنجزات الهامش.
ويمكن إجمالاً أن نتحدث عن مسار أكاديمي مازال مفتوحاً على ممكنات التأويل والقراءة الناقدة، لأنه من الحري بنا أن ندفع بهذه المشاريع إلى مستويات عليا من التفكير معها حتى نستوعبها وضدها، لكي نبين جسر تواصل بناء بين الأجيال.
وقد تجسد المسار الأكاديمي لمفكرنا في المنجزات التالية:
1- المطابقة والاختلاف، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات، 2005.
2- المركزية الغربية، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1997، ط2، المؤسسة العربية، بيروت، 2003، ط3، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2010.
3- المركزية الإسلامية، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2001، ط2، الدار العربية للعلوم، بيروت 2010.
4- الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1999، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004، وط3، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2010.
5-موسوعة السرد العربي (مجلّدان) بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2005، ط2، 2008.
6- السردية العربية، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1992، ط2، المؤسسة العربية، بيروت، 2000.
7- السردية العربية الحديثة، بيروت، المركز الثقافي العربي 2003، والمؤسسة العربية للدراسات، 2013.
8- المتخيّل السردي، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1990.
9- الرواية العربية: الأبنية السردية والدلالية، دار اليمامة، الرياض، 2007.
10- المحاورات السردية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2012.
11- التخيّل التاريخي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2011.
12- السرد النسوي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2011.
13- السرد والهوية والاعتراف، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2011.
14- التفكيك: الأصول والمقولات، الدار البيضاء، 1990.
15- النثر العربي القديم، الدوحة، المجلس الوطني للثقافة، 2002.
16- التلقي والسياقات الثقافية، بيروت، دار الكتاب الجديد، 2000، ط2، دار اليمامة، الرياض، 2001، ط3، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2005.
17- السرد والترجمة، بيروت، دار الانتشار العربي، 2012.
أهلا وسهلا بك على منبر مؤسسة مؤمنون بلا حدود
الأستاذ ربوح البشير: هل تؤمن بالصروح الكبرى على المستوى الفكري والنقدي والفلسفي؟ وهل يملك عبد الله إبراهيم مشروعاً نقدياً أو فكرياً؟ وهل صاحبك الوعي بفكرة المشروع من البداية؟
الصروح الفكرية الكبرى هي التي أعطت معنى للعالم الذي نعيش فيه
الدكتور عبد الله إبراهيم: أرجّح أنّ الصروح الفكرية الكبرى هي التي أعطت معنى للعالم الذي نعيش فيه، وأسهمت إلى حد بعيد في تفسيره، فلولاها لكان العالم مبهماً ومُلتبساً. حينما أبدأ حديثي بهذا القول أتذكّر صروح الفكر العظيمة عند أفلاطون، وأرسطو، والغزالي، وابن رشد، وديكارت، وهيغل، وماركس، وأركون، والجابري. تلاحظ أنّني تغاضيت عن التباين في الرؤى التي قدَّمتها تلك الصروح للعالم، والمنظورات المختلفة للمفكرين، فلست هنا في مقام التحليل والحكم إنما في مقام الوصف والمعاينة، فتلك المشاريع الفكرية اقترحت تأويلاً للعالم ووصفاً للمعرفة، وتخطّت ذلك إلى وضع ركائز لتغيير الأفراد والمجتمعات، ويقطف العالم الآن ثمارها في كل مكان. وعلى الرغم من كل ذلك، ينبغي التأكيد على أنّ كثيراً من تلك الصروح أمست في ذمّة التاريخ؛ لأنها انتظمت في إطار نموذج (paradigm) خاص بعصرها، كالنموذج اللاهوتي، أو الميتافيزيقي، وما عادت فاعلة لكنها حفّزت الأفكار الجديدة إما لمعارضتها، وإما لموافقتها، وإما لتخطيها، وبما أنه لكل عصر نموذجه الفكري، فمن اللازم الاعتراف بأنّ عصر بناء الصروح الكبرى قد انحسر وتوارى، وحلّ محله عصر التحليل، أي تحليل الصروح الفكرية العظيمة، وتجدني قريباً إلى هذا المنحى دون أن أنسى تلك الصروح المُحكمة التي وضعت تحت تصرف العالم نظاماً متّسقاً من الفرضيات والنتائج، وهي تلهمني بالطموح والعمل المتواصل، وليس بالنتائج، فلكي يقع الإلمام بظاهرة كبيرة، كالمركزيات الثقافية والدينية والعرقية، أو حتى الظواهر السردية أو الشعرية، فينبغي تمهيد الأرضيّة ووضع الإطار المنهجي واقتراح المفاهيم، ثم صوغ رؤية يصدر عنها الباحث في مقاربته لتلك الظواهر.
لقد انغمست في كل ذلك نحواً من ثلاثين سنة، ولست في موقع أقيّم فيه نتائج عملي، وما خطر لي ذلك، ولست مؤهلاً، ولا راغباً في أن أقوم بذلك، إنما ينبغي الاعتراف بأنني انخرطت في دراسة ظواهر كبيرة كالمركزيات الثقافية والظاهرة السردية، وعالجتها على مستويين: أولهما الظاهرة في سياقها الثقافي، وثانيهما تحليل بنياتها وفرضياتها، والسعي إلى تفكيكها من أجل تفريغ حمولاتها الإيديولوجية، وكنت أجري تعديلاً على بعض أفكاري كلّما وجدت حاجة لذلك غير خائف من الاعتراضات، فأنا أفكّر بالموضوعات التي أعمل عليها، ولا أفارقها، وهي بدورها لا تنفكّ عني، وحيثما وجدت أمراً يقتضي تعديلاً كنت أقوم به، فتجد إضافات بين طبعة وأخرى من كتبي.
من الصحيح أنها كُتبت ونُشرت على مرّ السنين، ولكنني دائم الصِّلة بما تحمله، ويخيل لي أن تصنيفاً لنظام الأفكار في أعمالي التي أربت على عشرين كتاباً ربما تضعها في المكان المناسب لها في تاريخ الأفكار، لكنني كنت منذ البدء منفتحاً على طيف كبير من القضايا المتلازمة، وما حبست نفسي في قضية جزئية أو نص منفرد، فلي شغف بالاستغراق في القضايا الشائكة، وأفنيت طرفاً طويلاً من عمري في ملازمتها ومحاورتها، وتآلفت معها، فصرت دائم التفكير بها، ومن التمحّل القول إنه ينبغي على الباحث أن يكون مجهزاً منذ البدء بالوعي الكامل للمشروع الذي انخرط فيه، إنما ينمو الوعي بنمو العمل عليه، فلا انفكاك بينهما، وتجربتي الشخصية تؤكد لي ذلك، فالوعي بظاهرة قبل الانغماس فيها لعقد أو عقدين ستختلف بالدرجة عن الوعي بها بعد ذلك، ومن المغالطة ادّعاء الباحث أنه عارف بالأشياء قبل الشروع بها.
ربوح البشير: هل يحتاج المفكّر إلى الحسم في خياراته على مستوى المنهج أو الرؤية من البداية ليكون متميزاً على مجايليه ومعاصريه؟ وهل لك أن تصف الخلفية التي صدرت عنها في تأسيس مشروعك النقدي والفكري؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: يحتاج المفكّر أو الناقد إلى الوضوح، ومجانبة الإبهام، والابتعاد عن الغموض، في كل مرحلة من مراحل حياته الفكرية، ولكن من الادّعاء القول إنه قادر على حسم خياراته المنهجية منذ البدء، فتلك دعوى باطلة، تصدر عن وعي لاهوتي لا وعي تاريخي بالظواهر الفكرية، ولا أخال باحثاً جاداً يشتغل منذ البدء في أن يكون متميزاً على أقرانه، أو متفوقاً عليهم، فهذا وعي مدرسي له صلة بالكتاتيب وليس بخوض تلك المشقات الهائلة في تضاعف الظواهر الكبرى، فالأمر برمّته ليس سباقاً للمسافات الطويلة يصل فيه أحد المتسابقين إلى خطّ النهاية قبل الآخرين، إنما البحث في الظواهر الكبرى أقرب إلى الولوج في متاهة. أنت لست متأكداً أنك ستبلغ النهاية، والأرجح أنك لا تعرف طريق العودة من حيث بدأت، ولذّة التفكير في كونك عالقاً في تلافيف ظاهرة لا نهاية لها، ولا حدود واضحة إنما تخوم غير ثابتة، وعليه فلا حسم، ولا وصول إلى نتيجة، إنما خوض غمار البحث في عالم يعطيك بعضاً منه كلما تآلفت معه، وفكّرت فيه، واستعنت من أجل تفسيره بعدد وافٍ من المفاهيم الواضحة.
والحال هذه، فالأفكار الكبيرة، بالنسبة إليّ، تتجلّى في تشريح أعماق الظواهر وليس الطرق الخارجي عليها، وبما أنني أخذت بتفكيك الظواهر وليس الاكتفاء بوصفها، فما خلتني أقف بجوارها واصفاً، إنما انغمست فيها حافراً، فلا أنتظر نتيجة، ولا أعِدُ بوصفة، فليس ثمة كنز مفقود أعثر عليه، وأودعه متحفاً، إنما خريطة بحث قابلة للتصحيح عن أمر كامن في أذهاننا أو في مجتمعاتنا أو معتقداتنا، والباحث الحقيقي هو من يدلّ الآخرين على الكيفية التي أخفيت فيها الأشياء وطُمرت، لا الخروج ظافراً وهي بيديه، وأنا ميّال لجعل البحث نوعاً من المتعة العقلية وليس قسراً للنفس على ما لا ترغب فيه، ولعلّي كثير التشديد على خلق أُلفة كاملة بين الباحث وموضوعه؛ فالمعرفة تقوم على التعارف. ومن المتعذّر أن يتوصّل الباحث إلى معرفة جديرة بالتقدير عن ظاهرة لا يعرفها، ويجهل سياقها، ولهذا تراني أشدّد على الألفة التي تضع مسافة بين الباحث وموضوعه تتيح له ممارسة التحليل والاستنطاق والتأويل دونما خوف.
وأراني أحوم في دائرة الرؤية والمنهج لاعتقادي أنهما السبيلان المتلازمان اللذان يساعدان الباحث لبلوغ غايته، وغايته ممارسة التحليل، وتوفير السياقات المنهجية التي تتيح للظواهر أن تسفر عن نفسها دون عَنَت أو تقويلها ما لم تقل، ولست مشغولاً بالنتائج، فذلك قد يتولّاه سواي، وإلى كلّ ذلك فوظيفة الباحث زعزعة المسلّمات الداعمة للظواهر الهوسيّة في حياتنا سواء أكانت دينية أم ثقافية أم سياسية، وتغيير مسار تلقيها عند الأفراد، وهو ما يسهم في خلق وعي يتجرّأ على تهديمها، فلا يمكن، على سبيل المثال، تهديم المركزيات، كائناً ما كانت طبيعتها: عرقية أو دينية أو ثقافية، إنما يمكن التشكيك بشرعيتها، وفضح تحيزاتها، وتقويض فرضياتها، ويتأدّى عن كل ذلك ارتياب بها، يجعل الناس يعيدون النظر في علاقتهم بها، مما يؤدي إلى العزوف عنها، ثم التجرّؤ عليها بالنقد الكاشف لمخاطرها، فالنزعات المذهبية، والممارسات العنصرية، والأنظمة الأبوية، والتحيزات القبلية، لا تتفتّت بالطرق عليها إنما بالتوغل فيها لبيان مخاطرها، وإبطال فرضياتها، ونزع المشروعية عنها، ولن يتأتى للباحث أن يقوم بذلك إن لم يكن مهيّئاً على مستوى الرؤية والمنهج بالعُدّة التي يحتاج إليها في رحلته الطويلة. لقد انحسرت كثير من الظواهر الخطيرة في العالم حينما جرى استكشافها من الداخل وليس إصدار القوانين بحظرها، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يكون الباحث طويل النفس، كثير الصبر، وغير ملول في الانفتاح على سائر العلوم الإنسانية الداعمة له في عمله، ما عاد من الممكن أن يتولّى الباحث مهمة جليلة بِعُدَّة وحيدة وكليلة.
ربوح البشير: يبدو أنّ همّ التأسيس صاحبك منذ البداية، فنجد لديك شعوراً رهيباً بالتأسيس، كما ظهر في كتابيك "المركزية الغربية" و"المركزية الإسلامية"، فضلاً عن كتابك "الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة"، ألا تلاحظ أنك جنيت على المركزية الإسلامية حين نقلت مسألة مركزية الحضارة من النص إلى الإنسان؟ ألا يأخذنا هذا إلى الحديث عن ممثلي المركزية لا النص الناطق فيها؟ ألا تتصور أنّ الحديث عن النص يجعل المركزية الإسلامية أكثر جذرية، فيما نقلها إلى الإنسان يجعلها مرتبكة، فندخل في عدمية لا متناهية؟ هل مازلت مؤمناً بفكرة المركزية في زمن الأقطار؟
النصوص الدينية تشعّ بالإيحاءات
الدكتور عبد الله إبراهيم: ليس الإيمان بالمركزية هو غايتي باحثاً وإنساناً، إنما على العكس من ذلك، فلطالما عملت في سائر مؤلفاتي الفكرية على تفكيك المركزيات، والتحذير من خطرها على الإنسان، وما أهتم به هو التجليات الدنيوية للمركزيات، والصور الزائفة عن الذات، وتزوير حقائق التاريخ، وبخاصة المركزيات الدينية والمذهبية، ولم أغفل أنّ كثيراً منها يمنح نفسه الشرعية بناء على تأويل مقصود للنصوص الدينية، والنصوص نفسها لا تبرأ من تصريحات أو إيحاءات فيها درجة عالية من التمركز حول الذات كائناً ما كان نوع تلك الذات، فالنصوص الدينية تشع بالإيحاءات، ويمكن العثور على النظائر والأضداد فيها بغير عناء، ولطالما جرى تحميل النصوص بغير ما يظهر أنها تحمله، وليس في واردي الذود عن تلك النصوص التي تركّبت في ظروف غامضة وبعيدة، وليس من الفائدة الارتياب بمضامينها العامة لأنها شكّلت البطانة الداخلية لمعتقدات الناس، ورسمت هوياتهم بما تنطوي عليه من قيم أخلاقية أو روحية، ومن ناحيتي فأذهب إلى أنّ التأويل الذي وقع لنصوص متفرقة كان أكثر تأثيراً من أحكام واضحة طوتها النصوص الدينية، فقد أحيطت تلك النصوص بممارسات تأويلية خطيرة، وجرى اعتبارها بطانة للنصوص، وقد تراكمت الظاهرة التأويلية، وغمرت النصوص، فتراجع تأثيرها الفعلي، وتشكّلت المركزية الدينية على التأويل الديني وليس على فحوى النصوص، وحينما حللت ذلك، وبخاصة في كتابي المركزية الإسلامية، وجدت أنّ التأويل نجح في خلق نظام تراتبي يفصل بين المسلمين وسواهم من ذوي الأديان الأخرى، وأنه منح أرجحية لهم على ما سواهم، بل إنه شقّ العالم إلى ثنائية متضادة الأطراف، ولم يأخذ به على أنه وحدة كليّة متنوعة، وجرى عمل شاق لترتيب سلّم قيم خاص بالمسلمين يحميهم من هجمة السقوط في مهاوي الرذيلة الاعتقادية والحياتية، ويدرأ عنهم الشبهات، ويسم الآخرين بسوء المصير إن لم يهتدوا إلى طريق الصواب، ولم يكتفوا بذلك إنما أعطوا شرعية للتنكيل بالمخالفين، وقسرهم على الأخذ بسلم القيم الإسلامي، ولم يغب عنّي النموذج الفكري (paradigm) الذي عاصر كل ذلك هو النموذج الديني الذي أنتج لاهوتاً سجالياً لحماية المعتقدات، وقد تورطت فيه كافة الأديان السماوية التي صدرت من اعتقاد يرى أنّ كلاً منها يملك الحقيقة الكاملة، وفيها يكمن الوعد الأخير لسعادة الإنسان، وبالطبع فإنّ هذا الاعتقاد سينتهي إلى قسر الآخرين على ما أمسى مُعتقداً مطلقاً بمرور الزمن بعد أن كان مجرد سلوك خاص بجماعة، وقد رأيت أنّ محاولة تعميم تلك المركزية على مستوى العالم القديم قد جرى بطرق عدة إحداها، وربما أهمها، آداب الرحلة خارج دار الإسلام، ولكنّ للمركزية الإسلامية تجليات أخرى يمكن أن يتولّى أمرها غيري من الباحثين كالجهاد بأشكاله المختلفة. وأراني داعياً إلى ضرورة وقف التأويلات المتحيّزة للظاهرة القرآنية وفتحها على تأويلات جديدة، فهي المانحة لشرعية التمركز حول الذات، واقتراح تأويلات تتخطى النموذج اللاهوتي، والأخذ بالنموذج الدنيوي الحديث، فيتوارى الدعم الاعتقادي للتمركز حول الذات الدينية، وبكل ذلك نستبدل الشراكة والتعددية والتنوّع الثقافي.
ربوح البشير: ما خطورة الأخذ بالنموذج اللاهوتي؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: لا أخطر من النموذج اللاهوتي إلا النظام الشمولي الاستبدادي الذي أفرزه العصر الحديث، فقد تغلغل النموذج اللاهوتي خلال القرون الوسطى في تضاعيف التخيلات العامّة، وتوارى في طيّاتها، واستبطن التصورات الجماعية، فتحكّم في توجيه المواقف تجاه الآخر، ثم ركد مطموراً تحت أكداس المرويّات والمدوّنات، فحجبَ، ولمدة طويلة، إمكانية البحث في أمر تعديلها بما يناسب الرؤية التاريخية التي تُدرج كل شيء في سياق متحوّل ومتغيّر. وينبغي إعادة النظر في كثير ممّا اعتُبر من المسلّمات اللاهوتية لكشف فداحة الأوهام وخطورة المصادرات، ثم طرح رؤية نقدية تتعرض لإشكالية "الأنا" و"الآخر"، ليس بوصفها مسألة تاريخية انقضى عصرها، وانتفت أهميتها، وتلاشى تأثيرها، إنما باعتبارها ممارسة نقدية تروم عِتْق الذات من أوهام التمركز حول الذات، وهوس التفوّق، والأفضلية المفترضة، وذلك بنقدها من أصولها، وتحريرها من تخيلاتها، وفكّ الالتباس القائم على علاقة غير سليمة مع الآخر.
ربوح البشير: وكأنك ترى أنّ الكراهيات مصدرها المركزيات؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: هذا صحيح بحق وحقيق، فكلّ مركزية ثقافية أو عرقية أو دينية تقوم على فكرة الاختلاق السرديّ الخاصّ بها، فهذه سُنن المركزيات، وبمواجهة الحاجة إلى توازن ما تُصطنع لها ذاكرات توافق تلك التطلّعات. ويمور التاريخ الإنساني بذاكرات مختلقة، أو فيها كثير من عناصر الاختلاق، ما يؤدي إلى ظهور الكراهيات، ويعود ذلك إلى الرغبة شبه المَرَضيّة عند كثير من الأمم في الانتساب إلى ماض عريق، أو لانتزاع شرعية في عالم محتدم بصراع الهويات، والأدوار الكبرى، ويضخ هذا التوتر رغبات متوسّعة تريد استخدام الماضي استخداماً متحيّزاً لخدمة الحاضر، بما يضفي على الأنا سمّواً ورفعة، وعلى الآخر خفضاً ودونيّة.
لاحظت أنّ المركزيات تترسّخ نتيجة الأخذ بمرويات تكرارية تكتسب مضامينها وضعاً شرعياً، وبما أنّ تلك المرويّات توجه أفكار الرحّالة، والأدباء، والمؤرّخين، والجغرافيين، والفقهاء، وصنّاع الأعلام، والرأي العام، وشبكات التواصل الاجتماعي، وكلّ مَنْ يسهم في صوغ الصور الذهنية للآخر، فمن المنتظر الحصول على سلسلة من الأحكام غير المنصفة بحق الأمم الأخرى المختلفة في عقائدها وتقاليدها وقيمها، وبمقدار تعلّق الأمر بالمركزية الإسلامية، على سبيل المثال، فإنّ المخيال الإسلامي المعبّر رمزيّاً عن تصورات المسلمين للعالم أنتج صوراً منتقصة للآخر، لكونه صدر عن رؤية دينية في تفسيره للظواهر البشرية والطبيعية؛ فالعالم خارج دار الإسلام، كما قامت المرويات بتمثيله، غُفل ومبهم وبعيد عن الحق، وبانتظار عقيدة صحيحة تنقذه من ضلاله. تراكم سرد غزير حول معظم الأمم خارج دار الإسلام، قام بمعظمه على الاستغراق المتواصل بمرويّات متشابكة امتزج فيها الخيال بالواقع، وهي سرود لا تعرف البراءة في التمثيل، إنما اشتبكت المرجعيّات في نوع من التمثيل الكثيف الذي تداخلت فيه أحكام القيمة بالمواقف الثقافية.
ربوح البشير: أصبحت بحاجة ماسّة إلى تعريفك للتمركز كائناً ما كان.
الدكتور عبد الله إبراهيم: التمركز، فيما أرى، هو ضرب من التخيّل المترفّع، والتصورّ المتحيّز الذي يحبس نفسه في إطار رؤية مغلقة، فلا يقارب الأشياء إلا عبرها، ولا يراها إلا بها، وينتهي بتوظيف المعطيات من أجل تأكيد صواب فرضيّاته الجاهزة. ويحتاج هذا النمط من التخيّل والتصور إلى نقد متحرّر من أية مرجعيّة ثابتة، سواء كانت عرقية أو دينية أو ثقافية، فالمرجعيّة المناسبة لنقده هي الممارسة التحليلية الجريئة التي تتعرّض لفك التداخل بين الظواهر التي تلازمت فأوجدت هذا الضرب من التخيل القائم على الرغبة لإشباع تصورات جاهزة.
ربوح البشير: وكأنك تريد القول بضرورة تفكيك المفاهيم القديمة كلها، ومنها مفهوم المركزية الإسلامية الذي خصصت له كتاباً كاملاً.
يمكن اعتبار المكوّن الثقافي أحد أهم المكونات المؤثرة في قضية التراتب والتفاضل بين دار الإسلام ودار الحرب
الدكتور عبد الله إبراهيم: للحديث عن المركزية الإسلامية في الماضي صلة كبيرة بالحاضر، فهذه قضية معاصرة من ناحية كونها ترتهن بنوع التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية، وهذا هو سبب الانطلاق من الحاضر حيث تتضارب المفاهيم والقيم والأنساق الثقافية إلى الماضي حيث تبلورت فيه صور الآخر بأسوأ الأشكال. يلزم كشف طبيعة المركزية الإسلامية، والظروف التاريخية التي أسهمت في صوغها، ثم الكيفية التي تأدت من خلالها صورة الآخر، وموقعه في أعين المسلمين. ولا يمكن تجاوز المحددات الثقافية التي لعبت أدواراً حاسمة في تثبيت المعايير التفاضلية بين المجتمعات، فهي قادرة بفضل موقعها الرفيع على أن تجيز، وتهيمن، وتحلّل، وتحرّم، وأن تخفض منزلة شيء ما أو ترفع من مقامه؛ الأمر الذي يعني قدرة المحددات الثقافية على أن تكون الوسيلة الأساسية لتثبيت التّمايز في المجال الذي تعبّر عنه، وقد كان هذا شائعاً في الثقافة الإسلامية في القرون الوسطى، ويمكن اعتبار المكوّن الثقافي أحد أهم المكونات المؤثرة في قضية التراتب والتفاضل بين دار الإسلام ودار الحرب، وظلت الثقافة بوصفها منظومة للتصورات الذهنية حاضرة في كلّ الصراعات عبر التاريخ.
ربوح البشير: أفهم منك أنّ العالم القديم كان منقسماً على نفسه.
الدكتور عبد الله إبراهيم: بالطبع، فقد تحدّث القديس أوغسطين عن مدينة الله ومدينة الأرض، ومدينة الله هي البلاد التي بسطت فيها الكنيسة نفوذها، أي العالم المسيحي، وقبل ذلك لم ير الإغريق ولا الرومان أنهم امتداد للعالم، إنما العالم بالنسبة إليهم عالمان: عالم الإغريق أو الرومان، وعالم البرابرة، وقد بسطت القول في هذا الموضوع في كتابي "المركزية الغربية"، وعلى غرار ذلك استخدم القدماء مصطلح "دار الإسلام" باعتباره نقيضاً لـ "دار الحرب". كانت دار الإسلام تشكّل قلب العالم في القارات الثلاث القديمة، قبل الكشوفات الجغرافية في العصر الحديث، وعلى الحواشي المحيطة بهذه الدار ظهرت الممالك الكافرة، تترقّب أن يصل إليها نور الحقيقة السماوية. وفي ضوء ذلك قامت المرويات بتمثيل الذات والآخر استناداً إلى آلية مزدوجة أخذت شكلين متعارضين: ففيما يخص الذات أنتج التمثيل "ذاتاً" نقيّة، وحيويّة، ومتضمّنة الصواب المطلق، والقيم الرفيعة، وفيما يخص الآخر أنتج التمثيل "آخر" يشوبه التوتر، والالتباس، والانفعال، والخمول، والكسل، وذهب بالنسبة للجماعات النائية، إلى ما هو أكثر من ذلك، حينما وصفها بالضلال والتوحش والبهيمية، فاصطنع التمثيل السرديّ بذلك تمايزاً بين الذات والآخر، أفضى إلى متوالية من التعارضات التي تسهّل إمكانية أن يقوم الطرف الأول في إنقاذ الثاني، وتخليصه من خموله وضلاله ووحشيته، وإدراجه في عالم الحق.
ربوح البشير: ما الذي تقصده بـ "دار الإسلام"؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: يشير مصطلح "دار الإسلام" إلى ذلك المجال الشعوري الذي تتراسل فيه منظومة من القيم الروحية والأخلاقية والعقائدية التي انبثقت عن القرآن، وعزّزت بفهم المسلمين لطبيعة الرسالة التي يتضمنها، وهو تراسل يتجاوز الانتماءات العرقية، والثقافية، والجغرافية، ولكنه لا يهملها ولا يتعارض معها، ذلك أنّ الإسلام لم يضع أية شروط محددة للتوفيق بين العرق والعقيدة، فهما انتماءان لا تعارض بينهما في المنظومات الدينية، يتوازيان ويلتقيان ويتماسّان دون أن يلغي أي منهما الآخر، وهذا الأمر هو الذي أظهر إلى الوجود إسلاماً متعدد الأبعاد، يتم تلقيه وإنتاجه والتفكير به طبقاً للخصوصيات الثقافية والاجتماعية، لكنّ الإسلام كمنظومة قيم روحية وعقائدية عامة انتظم في نسق شامل، ضم تلك التصورات، وهضم الاختلافات والخصائص الثانوية، وذلك أمر فرضه واقع حال المسلمين المتصلين بأعراقهم الكثيرة، والمنتمين إلى هويات ثقافية متعددة، داخل إطار الثقافة الإسلامية العامة.
ربوح البشير: هل ترى حذراً في استخدام مصطلح "العالم الإسلامي"؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: مع بداية العصر الحديث راح مصطلح "العالم الإسلامي" يحلّ بالتدريج محلّ "دار الإسلام" فتسبّب هذا في نشأة وضع إشكالي، يمثله التفكير في البحث عن المصطلح الذي يمكن إطلاقه على "العوالم الأخرى"، فمادام هذا العالم قد غُطّي بغطاء ديني، فما الذي يمنع من خلع أغطية مماثلة على العوالم الأخرى التي تشترك بالعقائد، والثقافات، واللغات؟ ينبغي الحذر من استخدام هذا المصطلح؛ فهذا الوصف يشوبه نوع من عدم الدقّة من جهة، والتعميم من جهة أخرى، وهو لا يأخذ في الاعتبار ما تمور به هذه المناطق الشاسعة التي استوطنها المسلمون كأغلبية، أو شكلّوا في بعضها أقليات ضخمة، لها خصوصيات عرقية، ولغوية، وتاريخية. استعمال مصطلح "العالم الإسلامي" الآن يدفع بظهور عوالم دينية مناظرة، وهو أمر متعذّر في عالم تداخلت مصالحه، وعلاقاته، وأفكاره، وشعوبه، وهوياته، وتخلّص جزء كبير منه من سجالات القرون الوسطى التي قام نموذجها الفكري على الثنائيات الضدية: الإيمان والكفر.
ربوح البشير: هذه المركزية التي تتحدث عنها تريد أن تخلع كلّ أشكال القداسة على السلط الدينية والكهنوتية والسياسية. هل مشكل المركزية الإسلامية مع النص الديني أو مع الفهوم التي صاحبت النص؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: كما أشرت في جواب سابق، فمن الضروري التوغل في قلب الظاهرة الدينية وكشف تحيزاتها، ولا يجوز أن تتحصن النصوص وراء قداسة تحول دون تحليلها، فقيمة النصوص الدينية تكمن في قدرتها على قبول التحليل والاستنطاق وليس في منع الباحثين من الاقتراب منها، النصوص الدينية ليست زجاجاً هشاً قابلاً للكسر ما أن نضع أيدينا عليه، ولا هي غشاء رقيق يتفتت من أول لمسة، إنما هي مستودع رمزي للأفكار، قامت بتمثيل شامل لشؤون عصرها. لكن ملاحظتي أنها جهزت النموذج اللاهوتي بتأويلات خطيرة لمضامينها، وهي تأويلات لها علاقة بالظروف السياسية والتاريخية والثقافية القائمة آنذاك، وحالت دون ظهور تأويلات أخرى، والآن صار من اللازم مراجعة تلك التأويلات، ونقدها، وكبح تأثيرها، بإحلال تأويلات بديلة تنزع عن الظاهرة الدينية تلك الهيبة المخيفة وتقترح هيبة تقوم على الألفة والمودة والشراكة، وليس هيبة تقوم على الخوف والعبودية والترهيب.
وما دام قد انتصر تأويل متحيّز للنصوص الدينية في وقت مضى فقد ظهر ما اصطلح عليه "القداسة بالمجاورة"، فكل من يجاور المنطقة الدينية سواء أكان شخصاً أم ضرباً من الحكم أو العمل، فقد ورث تلك الهيبة، وشُمل بتلك القداسة، انظر معي حول التعديلات الهائلة في مواقع الأفراد والنصوص بسبب ارتباطها بالظاهرة الدينية، فقد اكتسب "الصحابة" درجة عالية من القداسة لأنهم صاحبوا الرسول، فمجاورتهم له أكسبتهم صفات ما كانت لهم من قبل ولا من بعد، والأنكى من ذلك أنّ "ملوك العرب" حصّنوا أنفسهم بقداسة حينما اعتبروا أنفسهم خلفاء لرسول الله، فيما هم ملوك دنيويون ما كانوا مؤهلين لحمل تلك الرسالة، شأنهم في ذلك شأن "البابوات" الذين يعتبرون أنفسهم خلفاء السيد المسيح، وقسْ على ذلك الأئمة الوارثين للعلوم اللدنية، والقادة في العصر الحديث الذين يزوّرن انتسابهم إلى الرسول والشخصيات المؤسسة للإسلام، بظن أنهم محصنون من المطالبات والواجبات والحقوق، وشمل ذلك "رجال الدين" المشتغلين بالتفسير والفقه والحديث، فحازوا المكانة الأرفع في التاريخ الإسلامي، ليس لأنهم أتوا بما لم يأتِ به أحد إنما لأنهم اشتغلوا في حقل له حماية خاصة، حتى قيل إنّ علمهم هو العلم، وما سواه فضلات، ومعلوم أنّ "الخطيب البغدادي" اعتبر المحدثين ورثة الأنبياء، وهؤلاء خلفوا تركة هائلة تحتاج إلى تفكيك ينزع عنها الشرعية فيدرجها في مجال "الآداب الدينية" وهي ليست من الدين، إنما من الحواشي عليه، ويترك النصوص الدينية حرة بين أيدي الناس دون اعتبارها مانحة أو مانعة للشرعية، وكما تعلم أنه في الوقت الذي نتحدث فيه الآن فإنّ كتاباً في الفتاوى، وعذاب القبر، أكثر أهمية من كتاب في علم الذرة، أو الحقوق المدنية، وظني أنّ النقد العميق لكل ذلك سوف يسحب مع الزمن الشرعية الزائفة لمعظم الظواهر الاجتماعية والدينية والسياسية التي تغمر مجتمعاتنا، وهي ضمناً سوف تنزع الغطاء الثخين عن الظاهرة الدينية، وتجعلها تظهر بعيون لم تعتد على تلك الظلمة التي احتجبت فيها طوال ألف سنة. النقد، في تقديري، يمكّن المؤمنين من إعادة الاعتبار للظاهرة الدينية والنظر إليها على أنها خيار فردي حر وليس تركة سياسية واجتماعية مذلّة يساق الناس لتطبيقها بالعصي والسياط وتقطيع الرؤوس غير الآخذين بتفسير مخصوص لها.
ربوح البشير: أين موقع الحداثة من تفكيك المركزيات الثقافية؟
الكثير من المجتمعات الإسلامية لم يقترب إلى مخاض الحداثة، ولم يطوّر مفهوماً خاصاً بحداثته
الدكتور عبد الله إبراهيم: نعم، خلخلت الحداثة جزءاً من النظام التقليدي للقيم التقليدية، وبه استبدلت نظاماً مغايراً يقوم على التعاقد الاجتماعي والشراكة، ودشّنت لمؤسسات المجتمع المدني، وحرية الرأي، والاعتقاد، ولكنها لم تنجز وعدها كاملاً، وقد عرّف "هيغل" الحداثة بأنها تغيير العلاقات التقليدية في المجتمع. ولكن الكلام عن الحداثة في المجتمعات الإسلامية ينطوي على مفارقة مدهشة؛ لأنها متصلة بتطلّعات حالمة بالتحديث من جهة، وإخفاقات في الواقع من جهة أخرى، فكثير من المجتمعات الإسلامية لم يقترب إلى مخاض الحداثة، ولم يطوّر مفهوماً خاصاً بحداثته؛ فتلك المجتمعات لم تراكم معرفة عقلية - نقدية تمكّنها من الاقتراب إلى خيار الحداثة، الحداثة كمشروع لتغير البنى التقليدية في المجتمع والأفكار، ومازال النسق المهيمن في علاقاتها الاجتماعية نسقاً إقطاعياً- أبوياً يقوم على الطاعة والخضوع، ويحكمه التراتب الفئوي، والطبقي، والجنسي، والمذهبي، ومازال مفهوم الحريم شديد السطوة في قطّاعات واسعة من هذه المجتمعات الأبوية في ثقافتها وعلاقاتها، وفي بعضها يشمل عالم المرأة بأجمعه، والتمايز بين المرأة والرجل يخضع لمفهوم الجُنوسة. تقوم الحداثة الاجتماعية بتفكيك العلاقات التقليدية المعيقة للتطور، وبها تستبدل ضروباً مختلفة من العلاقات القائمة على التكافؤ والشراكة، وليس التمايز والتراتب، فتضع الجميع في منطقة مشتركة وعامة، وليس خلف الأسوار العرقية، والعقائدية، والمذهبية، والقبلية، والجنسية التي تحول دون التواصل والتفاعل.
ربوح البشير: هل يتعذّر تحديث المجتمعات الإسلامية؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: ينبغي الحذر في التعميم، ومع ذلك يمكنني وصف معظم المجتمعات الإسلامية بأنها "مجتمعات تأثيمية" تستند في تصوراتها عن نفسها وعن غيرها إلى مرجعيات عقائدية أو عرقية ضيقة، وتتحكّم بها روابط دينية أو عرقية أو عشائرية أو مذهبية، ولم تفلح في صوغ تصورات شاملة عن نفسها وعن الآخر، فلجأت إلى الماضي في نوع من الانكفاء الذي تفسّره على أنه تمسك بالأصالة، وهي مجتمعات أبوية يتصاعد فيها دور الأب الرمزي من الأسرة، وينتهي بالأمة، ولم تتحقق فيها الشراكة التعاقدية في الحقوق والواجبات بين أفرادها، وتخشى التغيير في بنيتها الاجتماعية، وتعتبره مهدداً لقيمها الخاصة، وتؤثّم أفرادها حينما يقدِّمون أفكاراً جديدة، ويتطلعون إلى تصورات مغايرة، ويسعون إلى حقوق كاملة، فكل جديد عندها نوع من الإثم، وكل ابتكار فيه نوع من المروق، وبدون إعادة النظر في كل ذلك، وإجراء تعديلات جذرية فيه، فإنها تذهب إلى غير ما ينبغي أن تذهب إليه المجتمعات الحيّة في العالم.
ربوح البشير: ما سبب ذلك؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: لأنها لاذت بتفسير ضيق للنصوص الدينية، وصارت مع الزمن خاضعة لمقولات ذلك التفسير أكثر من خضوعها للقيمة الثقافية والأخلاقية والروحية للنصوص الدينية الأصلية، وراحت تقدّس سرداً خيالياً عن نفسها وماضيها وتعتبره صائباً بإطلاق، وتسكت عن كل ضروب الاختلاف في تاريخها، وتعدّه خروجاً على الطريق القويمة، ولم تتمكن من التمييز بين الظاهرة الدينية من جهة، والشروح والتفاسير والتأويلات التي دارت حولها، فتوهّمت بأنّ تلك الشروح والتفاسير والتأويلات هي الدين عينه، فأضفت قدسيّة عليها، وصارت تفكّر بها وتتصرّف في ضوئها، وتحتكم إليها، وهي تختلف باختلاف المذاهب والطوائف والأعراق والبلدان والثقافات والأزمان، وأنتجت تصورات ضيقة عن مفهوم الحرية والمشاركة، فمفهوم الحرية ليس مشروطاً بالمسؤولية الهادفة إلى المشاركة والتغيير، إنما هو مقيّد بالولاء والطاعة، وكل خروج على مبدأ الطاعة والامتثال للنسق الثقافي السائد يعدّ ضلالة، لا يهدف إلى الإصطلاح وإنما إلى التخريب؛ لأنّ المرجعية المعيارية للحكم على قيمة الأشياء وأهميتها وجدواها مشتقة من تصوّرات منكفئة على الذات، ومحكومة بمفاهيم مستعارة من تفسير مخصوص للماضي، وقائمة على ثقافة الوعظ وليس على ثقافة الفكر. باختصار لم تستطع تلك المجتمعات أن تنجز فهماً تاريخياً متدرّجاً ومطوّراً للقيم النصيّة الدينيّة، بما يمكّنها من إدراجها في صلب السلوك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولم يستطع كثير منها، في الوقت نفسه، هضم كشوفات العصر الحديث في كل ما يتصل بالحياة الحديثة، وشروط الانخراط والمشاركة فيها. أي أنها لم تتمكّن من إعادة إنتاج ماضيها بما يوافق حاضرها، وتعذّر على بعضها التكيّف مع الحضارة الحديثة، وعلى هذا فقد انشطرت بين قيم متعالية موروثة وقيم واقعية مستعارة.
ربوح البشير: هذا يطرح علينا مفهوم سؤال عن الهويّة الحقيقية لهذه المجتمعات.
الدكتور عبد الله إبراهيم: في الواقع انشطرت بين أغلبية مجتمعية، وأقلية ثقافية، فالقائلون بالهويّة الإسلامية التقليدية المميزة، وهم الأغلبية، قدّموا قراءة هشّة للإسلام تقوم على فهم مدرسي ضيّق له يعنى بالطقوس، والأزياء، والتمايز بين الجنسين، والحلال، والحرام، والطهارة، والتكفير، والتحريم، والتأثيم الدائم للنفس، والذعر من التحديث في كل شيء، وإخضاع الكون والبشر لجملة من الأحكام التي يسهل التلاعب بها طبقاً لحاجات ومصالح معينة، وإنتاج أيديولوجيا استعلائية متعصّبة لا تأخذ في الاعتبار اللحظة التاريخية للشعوب الإسلامية، ولا العالم المعاصر، ولا تلتفت إلى قضايا الخصوصيات الثقافية، والدينية، والعرقية للأقليات، وسعوا إلى بعث نموذج أنتجته تصورات متأخّرة عن الحقبة الأولى من تاريخ الإسلام، يقوم على رؤية تقديسية للأنا وإقصاء للآخر، فحبس الإسلام في قفص ذهبي، دون أن يسمح له بالتحرّر من سطوة الماضي، لينخرط في التفاعل الحقيقي مع الحاضر. وحجبوا عن الإسلام القيم الكبرى التي اتصف بها كنسق ثقافي يقرّ بالتنوع والاجتهاد. أمّا القائلون باحتذاء تجربة الغرب واستعارة حداثته، والاندماج بعالم يمور بالكشوفات العلمية والفكرية والاقتصادية، فيتخطّون حقيقة لا تخفى، وهي: أنّ النموذج الغربي تولّد من نسق ثقافي خاص، فاشتّق من الحالة التاريخية للغرب، وتكمن كفاءته في أنه زبدة ذلك الواقع، كونه متّصلاً به اتصال الجنين بالرحم، وقد تطور استجابة لواقع الغرب الذي تجري محاولات من أجل تعميمه ليشمل العالم، بكل الصيغ الممكنة، ولكنّ ركائزه الأساسية مبنية على وفق الخصوصيات الثقافية والسياسية والاجتماعية والتاريخية الغربية، وتكمن الصعوبة في تقليده ومحاكاته، ناهيك عن نقله وتبنّيه. والحال هذه، فكثير من التوتّرات القائمة في المجتمعات الإسلامية يرتبط بالصدامات الظاهرة والضمنية بين النموذجين اللذين ذكرناهما. لا يمكن تجريد نموذج من خصائصه الذاتية وفرضه على حالة مختلفة سواء أكان نموذجاً دينيّاً مستدعى من الماضي أم نموذجاً دنيوياً مستعاراً من الآخر، فالواقع يفرض نموذجه الخاص الذي لا يُشترط فيه التعارض مع النماذج الأخرى، إنما التفاعل معها.
ربوح البشير: ما وجه الخطر من الأخذ بالتفسير الأول للهويّة؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: يتعذر استدعاء نموذج أنتجته سجالات القرون الوسطى وتعميمه على الحاضر، إنما من المستحيل تطبيق فهم مختزل للإسلام يقوم على التمايز المذهبي، والتعارض الطائفي، والانغلاق على الذات، وتبجيل السلطة، وتسويغ طاعتها، والتكفير، وتجهيل الناس بحقيقة أحوالهم الاجتماعية والثقافية، ولا يمكن تبنّي نموذج لمجرّد الرغبة فيه، فذلك أدخل بباب المحالات، فلا بدّ من كفاءة وتنوع يفيان بالحاجات المتكاثرة للناس. وفي جميع الأحوال لا يمكن تطبيق أي نموذج مستعار من الماضي لاستيعاب الحاضر، فالأحرى اشتقاق نموذج حي، ومرن، وواسع، ومتنوع، وكفء من الحاضر نفسه، يأخذ في الاعتبار أوجه الحاضر، واحتمالات المستقبل، ويتجدّد بتجدّدهما، ولا ينغلق على نفسه، ولا يدّعي اليقين المعياري المستعار من حقبة تاريخية معينة مهما كانت أهميتها، ولا يزعم أنه يوصل إلى الحقيقة المطلقة، ويتفاعل مع المستجدّات الداخلية، ويتناغم مع حركة التاريخ بشكل عام، ويكون جريئاً في الحوار مع نفسه وغيره، ويتجنّب الانحباس داخل قمقم مغلق، ويترك للآراء والاجتهادات أن تتفاعل فيما بينها، ولا يتّكئ على السجالات اللاهوتية والمنطقية، إنما يقدّم نفسه نموذجاً مفتوحاً يُثرى بالاقتراحات والممارسات، ويفكّ نفسه من الأقواس التي تقيّده، فلا يدّعي أنه يقدّم الخلاص، ولا يعد بالنّجاة الكاملة.
ربوح البشير: بحثت في المركزية الغربية وانتهيت إلى نشوء فكرة التأصيل بما يناظر المركزية الإسلامية، هل التماثل قائم بينهما؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: للمركزية الغربية حديث طويل يرجعها إلى الجذور الإغريقية، فقد أدى القول إنّ الغرب الحديث هو وريث الإغريق وخلفهم إلى اصطناع نظرية الطبائع، وهي نظرية عنصرية ومتعصِّبة مؤدّاها أنّ للشعوب طبائع تتوارثها، وقد دعّمت هذه النظرية مقولاتها بكشوفات علم الأجناس، ثم عمّمت النتائج على الأجناس البشرية، اعتماداً على فرضية تقول بوجود سلالات بشرية ترث سمات ثابتة تتجاوز مراحل التطور التاريخي للمجتمع، وأنّ تلك السمات الوراثية هي المسؤولة عن اختلاف التطورات الاجتماعية. والطريف أنّ نظرية الطبائع العِرْقيَّة هذه، تقول بنمطين من الخصائص، أحدهما يمثل الطرف الإيجابي، والآخر يمثل الطرف السلبي، وقد أقام الفكر الغربي المتمركز حول ذاته تعارضاً بين اللغات والشعوب الهندية الأوروبية من جهة، واللغات والشعوب السامية من جهة أخرى، وتمّ إقرار التضاد الآتي: إنّ الأوربيين المتحدّرين من الجنس الإغريقي يتَّسمون بميل فطري إلى ممارسة الحرية والعقل، بينما يتصف الشرقيون باستمرائهم العبودية، وعجزهم عن الممارسة العقلية الصحيحة.
فرضت فكرة السموّ الغربي نفسها في العالم منذ القرن الثامن عشر، فأصبح الغرب نموذج التقدم الذي ينبغي على العالم أن يحتذيه. ذلك أنّ ما هدفت إليه المركزية الغربية، وحيثما وصل الغربيون أعلنوا أنّ هدفهم إدراج العالم الخامل في سياق التاريخ الإنساني الحيوي. وظهرت رسالة الرجل الأبيض مثلَّث الوجوه: الفاتح المسلح، والمبشّر الديني، والباحث عن الثروة. وترتّبت علاقات الأوروبي بغيره في ضوء علاقة جديدة. هي علاقة المتبوع بالتابع، وقد عبّر الأدب السردي رمزياً عن هذه العلاقة الملتبسة على لسان "دانيال ديفو" في روايته "روبنسن كروزو"، إذ يقوم "كروزو" الأبيض بتعليم "فرايدي" الملوّن: التفكير، والفهم، والسلوك، ليوفّق في خدمته، خدمة الرجل الأبيض. وإذا وضعت تلك العلاقة تحت النظر العقلي لتحليل مكوِّناتها نجد أنّ العلاقة بينهما كمتبوع وتابع تقوم على الركائز الآتية: قيم روحية، قيم فكرية، قيم سلوكية. أي أنّ الأبيض يلقن الملوّن: الدين، والعقل، والأخلاق. إنّ المتبوع يبشّر بهذه القيم، كغطاء مُخفِّف لواقعة التبعية ذاتها، أمّا التابع فيتلقّاها لا لكي يحقّق بها ذاته، وإنما ليخدم بها سيده، ويكون ماهراً في التعبير عن ولائه وطاعته. الكلمة الأولى التي يتعلّمها التابع من المتبوع هي "نعم" بلغة السيد. الطاعة أولاً. التبعيَّة تعني تفّوق طرف على آخر، وهي تنظم العلاقات بناء على هيراركية خطيرة تحجب معرفة الآخر، بقدر ما تحجب معرفة الذات على حقيقتها.
لم يسلم ذلك من نقد مارسه دريدا وهابرماس وفوكو، وقد أكد شتراوس أنّ كل ثقافة تتطور في اتجاه مواز للغربية هي ثقافة تجميعية، وتكون مفهومة عند الغربيين في حين تبدو سائر الثقافات سكونية؛ ليس بالضرورة لأنها كذلك، ولكن لأنّ خطّ تطورها لا يعني شيئاً بالنسبة للغربيين، أي أنه غير قابل للقياس في حدود نظام المرجع المعمول به لديهم، وتساءل: في كل مرّة نكون مضطرين لوصف ثقافة إنسانية بأنها جامدة أو سكونية، علينا إذن أن نتساءل عمّا إذا كان هذا الجمود الظاهر ليس ناتجاً عن الجهل الذي نحن فيه بالنسبة لمنافعها الحقيقية، بوعي أو بلا وعي، وإذا لم تكن هذه الثقافة ذات المقاييس المختلفة عن مقاييسنا ضحية الوهم نفسه فيما يتعلق بنا. وبكلام آخر، نبدو الواحد للآخر مجردين من أية منفعة، وذلك فقط لأننا لا نتشابه. هذا استنتاج يؤسس لقاعدة الاختلاف.
ربوح البشير: يبدو أننا معتقلون في اتجاهين: اتجاه نصوصي بنى لنا مخيلة عريضة للانتصار، واتجاه استعماري بنى مخيلة عن التابع؟ هل تعتقد أنه علينا أن ننخرط كما الهنود في إعادة تفكيك البنى القاعدية للتابع لنستفيد بشكل جيد من القوة الأنوارية للاستعمار، واستبعاد كل أشكال الاسترقاق العضوي والتاريخي؟
فالمحاكي بطبعه ينفي شيئاً جهراً من أجل تأكيده خفية
الدكتور عبد الله إبراهيم: أجل، فالانقسام قائم في صلب ثقافتنا، ووعينا، وتفكيرنا، وبدون الانسجام العام في النظر إلى العالم، والنظر إلى النفس، تبقى الأفكار مجرد شذرات شعرية فيها من الحنين إلى الماضي بمقدار ما فيها من رغبة في محاكاة الآخرين، ولهذا فنحن بحاجة إلى ممارسة نقدية نعيد فيها ترتيب علاقتنا مع الماضي والحاضر، لاحظ معي، على سبيل المثال، أنّ التجربة الاستعماريّة ما فلتت من إعادة تقييم شاملة قام بها كتّاب المستعمرات القديمة، فحاولوا نقد ركائز تلك التجربة وتداعياتها، والإفادة منها فيما نسعى نحن إلى تأجيج العداء، وبث الكراهية، والإحجام عن ممارسة النقد الحقيقي، فالمحاكي بطبعه ينفي شيئاً جهراً من أجل تأكيده خفية. لقد شرعت الأطراف في نقد التجربة الاستعمارية نقداً أثمر عن بدائل مفيدة، فلما كان قد رسخ في أذهان العموم أنّ الغرب هو مصدر المعرفة ومنبعها، اتّجهت الأنظار إليه تنهل الأفكار الجديدة والمناهج الحديثة وطرائق التحليل المبتكرة، إلى درجة رأى كثيرون فيها أنّ العالم يصنع هناك، ويصاغ تكوينه في تلك الربوع، وأنّ الفكر الغربيّ جاء بالحقائق النهائيّة لكلّ زمان ومكان.
ربوح البشير: متى بدأ ذلك؟ وأين؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: يمكن اعتبار منتصف القرن العشرين اللحظة الرمزيّة التي بدأت فيها حقبة نقد معطيات الخطاب الاستعماريّ، قام بها مفكّرون ونقّاد ينتمون إلى ثقافات طرفيّة، وبمرور الوقت أصبح هاجس إعادة النظر بمعطيات ذلك الخطاب ملموساً في المركز الغربيّ نفسه، فانبثقت "دارسات ما بعد الحقبة الاستعماريّة Postcolonial Studies" التي هدفت إلى إعادة النظر بالتركة الاستعماريّة الثقافيّة في العالم خارج المجال الغربيّ، وتشظّت تلك الدراسات إلى فروع عدة، فشملت سائر المظاهر الثقافيّة من فنون وآداب وكتابة تاريخيّة. ورافق تلك الدراسات نموّ الوعي القوميّ والثقافيّ، فحاولت إعطاء فكرة صحيحة عن الشعوب المستعمرة، فالكتابة في ظلّ الحقبة الاستعماريّة هي نتاج صفوة المستعمرين، والنخبة المحاكية لها، وهي مؤيّدة للقوى الاستعماريّة، وهي قاصرة عن تمثيل جذور ثقافة راسخة، لأنّها تمنح ولاءها للإمبراطوريّات المستعمِرة، فوطن المستعمِر هو المركز، أمّا المستعمَرات فهي هوامش مستبعدة.
كشفت دراسات ما بعد الحقبة الاستعمارية أنّ الأدب المكتوب في ظلّ التجربة الاستعماريّة اكتسب شرعيّته بقوّة السياسة وليس من مزاياه الأدبيّة الرفيعة، ولعلّ من أبرز ما تمخّضت عنه ظهور جماعات ناقدة اندرجت فيما يصطلح عليه بـ "دراسات التابع" ففي مطلع ثمانينيّات القرن العشرين ظهرت إلى الوجود جماعة "دراسات التابع Subaltern Studies"، وهم نخبة من المؤرّخين الهنود الذين قلّبوا مدوّنة تاريخ الهند الرسميّ المكتوب من قبل المؤرّخين المتأثّرين بالسياسات الاستعماريّة البريطانيّة، واقترحوا إعادة كتابته في ضوء مفاهيم مغايرة متّصلة بالتاريخ الشفويّ المنسيّ الذي استبعدته النخب الاستعماريّة، فتاريخ الهند بالنسبة إليهم مثّله صراع الطبقات المغلقة والتحيّزات الدينيّة والفئويّة والمرويّات السرديّة، وأحوال المعدمين في الأرياف والمدن وتبعيّة المرأة وكلّ الجماعات التي لم تنتج آثاراً مكتوبة، أمّا التاريخ الرسميّ الذي دوّن في ضوء التصوّر الاستعماريّ فهو مجتزأ ونخبويّ وزائف، ولا يمثّل حقيقة بلاد غنيّة بتاريخها وأفكارها وأعراقها وعقائدها.
ربوح البشير: ما الأهداف التي وضعتها دراسات "التابع" في اعتبارها؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: هدفت دراسات التابع إلى نقد الخطاب الاستعماريّ وفرضيّاته، واقتراح المناهج البديلة لدراسة التاريخ الاجتماعيّ والسياسيّ والثقافيّ، ومعالجة شؤون الطبقات والأقليّات وأساليب المقاومة والنزاعات المحليّة والولاءات، وتفكيك المقولات الغربيّة في الآداب والثقافات والمناهج وسحب الثقة العلميّة والثقافيّة منها، عبر اقتراحات أخرى مغايرة أكثر كفاءة، تعالج بها شؤون المجتمعات خارج المركز الغربيّ. مثّل دراسات التابع جماعة من المفكّرين والنقّاد، منهم: غاياتاري سبيفاك، ورناجيت جُحا، وهومي بابا، وطارق علي، وإقبال أحمد، وروميلا ثابا، وماساو يوشي، وغايان برافاش، وشهيد أمين، وديبش تشاكرا بارتي، وعشرات سواهم. أصبحت دراسات التابع عابرة للقارّات، وهي تتقاسم رؤى ووجهات نظر كثير من النقّاد والمفكّرين في كافّة أرجاء العالم تقريباً، وتقترح رؤية التاريخ الاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ للعالم الذي خضع للتجربة الاستعماريّة من الأسفل وليس من علٍ، وتطمح إلى كشف الحراك الاجتماعيّ من أسسه الأصليّة، وليس من نظرة استعماريّة متعالية تتجاهل أعماقه السحيقة، وانتهت إلى نتائج مهمّة في مجال دراسات المرأة والجنوسة والأقليّات والأديان والأعراق والطبقات، ثم سعت إلى تصحيح السرد المسطّح الذي دوّنه المستعمرون لتاريخ مجتمعات شديدة التعقيد في مكوّناتها الاجتماعيّة وتركيبتها الدينيّة وتاريخها العريق. ومن الطبيعيّ أن يكون خطاب التابع مغايراً للخطاب الاستعماريّ، فبلاغته واقعيّة وتحليلاته صارمة، وهو لا يهدف إلى الإقناع، إنّما إلى التحليل وتفكيك المقولات السائدة، وإنشاء مقولات جديدة تريد تقديم تحليل مغاير لكلّ ما تقدّم من تحليلات قدّمتها التجربة الاستعماريّة.
ربوح البشير: ما موقع سبيفاك في هذه الجماعة؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: انخرطت "سبيفاك" في جدل حول الهُويّات الثقافيّة، ومفهوم التبعيّات الاستعماريّة والطبقيّة والجنسيّة. ولعلّ بحثها "هل يستطيع التابع أن يتكلم؟" قد أسهم في صوغ بعض أفكارها في هذا الموضوع، فقد جاء عنوانه وكأنّه نوع من الاستفهام الاستنكاريّ، فمن الطبيعيّ أن يتكّلم التابع، فهو كائن بشريّ يستطيع الكلام والكتابة والتعبير. ومؤدّى الفكرة التي طرحتها سبيفاك هو: هل توافرت السياقات الثقافيّة المؤاتية للتابع لكي يتكلّم؟ وهل يملك القدرة على إسماع الآخرين صوته؟ فالشعوب المستعمرة سلب منها حقّ تمثيل نفسها، أي أنّها سُلبت حقّ التعبير عن ذاتها، والكلام هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس معرفة متماسكة عن التابع ووعيه ووجوده. ترى "سبيفاك" أنّ وعي التابع يمتثل لتأثيرات النخبة التي تصوغ الثقافة العامّة، فتلك التأثيرات تصوغه بسبب قوّتها وهيمنتها، فيتعذّر استعادة ذلك الوعي بصورته الحقيقيّة، لأنّه مستعاد عبر تمثيل قوّة النخبة وثقافة الاستعمار، ولهذا فهو منزلق عمّا ينبغي أن يكون عليه، ومنحرف عن هدفه، ومتشكّل ضمن استراتيجيّات خطابيّة أقوى منه يستحيل السيطرة عليها. ثمّ إنّها طرحت إمكانيّة فكّ شفرات كلام التابع من خلال فكرة التمثيل الاستعماريّ له. تطلّعت "سبيفاك" لأن يكون لكلام التابع تأثير وصدق، فليس كلّ كلام يحمل الحقيقة في طيّاته، وحديث التابع محاط بسياقات ضاغطة من الثقافة الاستعماريّة، تجعله غير قادر على التعبير عمّا ينبغي أن يعبّر عنه، فقد تواطأت السياسات الاستعماريّة فيما بينها على أنّ التابع عاجز عن تمثيل نفسه، ولا بدَّ أن تمثّله السلطة الاستعماريّة، فتتوارى إمكانيّة أن يقول شيئاً حقيقيّاً، فلن يتكّلم ما دام مكبّلاً بخطابات توجّه وعيه نحو مقاصد معينة.
ربوح البشير: هل يمكن الحديث عن الخطاب الاستعماري، والمعرفة الاستعمارية؟ وما تبعات الأخذ بها؟
أراد الخطاب الاستعماريّ تملّك الآخر، فلم يضعه في مستوى رتبته، إنّما حجزه في رتبة التابع
الدكتور عبد الله إبراهيم: ذهب "هومي بابا" إلى أنّ الخطاب الاستعماريّ جهاز ينظّم الاختلافات العرقيّة والثقافيّة والتاريخيّة في المجتمعات المستعمَرة، وهو يسعى إلى إقرار استراتيجيّة خاصة بإنتاج معرفة بالمستعمِر والمستعمَر تقوم على الصور النمطيّة، أمّا غايته فتأويل المستعمَرين بوصفهم شعوباً منحطّة بسبب أصلها العرقيّ. وعلى هذا فلا يقرّ الخطاب الاستعماريّ بالمساواة، ولا يؤمن بالشراكة الإنسانيّة في القيم العامّة، وتقوم فرضيّته على ثنائيّة ضدّيّة، فالمستعمِر ممثّل للخير وسموّ المقام والرفعة الأخلاقيّة والتقدّم، أمّا المستعمَر فمستودع للشرّ والانحطاط والدونيّة والتخلّف، ولا سبيل للقاء بينهما إلا حينما يدرج المستعمَر تابعاً للمستعمِر، فربّما جرى تعديل وضعه، لكنّه لن يكتسب السويّة البشريّة الطبيعيّة، فيكون مثل العبد الذي يحاول تقليد سلوك سيّده، لكنّه لن يتبوّأ رتبة السيادة، فعبوديّته هي المانحة لقيمته، وكذلك الأمر في سوق التداول الاستعماريّة، حيث تكون التبعيّة علامة امتثال بها تتحدّد قيمة التابع. وكما يقول "فرانز فانون" إنّ المستعمِر لا يكتفي بوصف المجتمعات المستعمَرة بانعدام القيم، أو عدم معرفتها بها، إنّما يعلن أنّه لا سبيل لنفاذ الأخلاق إليها.
أراد الخطاب الاستعماريّ تملّك الآخر، فلم يضعه في مستوى رتبته، إنّما حجزه في رتبة التابع، فمارس بذلك نوعاً من الرغبة في التملّك وعدم الإقرار بها، إذ قام المبدأ الاستعماريّ على فكرة السيطرة على الآخرين بالقوّة المعزّزة بالمراقبة والعزل، والأخذ بفكرة تفوّق الطبائع والثقافات، فروّج لمعرفة خدمت المصالح الاستعماريّة، وسعى إلى تثبيت صورة راكدة للمجتمعات المستعمَرة، فكان بذلك جزءاً من وسائل السيطرة عليها، لأنّه وضعها في موقع أدنى من موقع الشعوب المستعمِرة، فانشق مضمونه إلى شقّين: ظاهر ادّعى الموضوعيّة وقام بتحليل الأبنية الثقافيّة والاقتصاديّة والدينيّة لتلك المجتمعات، بمناهج وصفيّة لا تنقصها الدقّة العلميّة، ولكن تعوزها الرؤية الصحيحة، ومضمر روّج لفكرة التبعيّة، ومؤدّاها ألا سبيل لبعث الحراك في ركود المجتمعات الأصليّة إلا باستعارة التجربة الغربيّة في التقدّم، وتبنّي خطّ تطوّرها التاريخيّ.
وعلى هذا فليس من الصواب استعارة معرفة جرى تطويرها في سياق ثقافيّ غربيّ لتحليل مجتمعات نشأت في حواضن مختلفة، إذ قد تكون تلك المعرفة مهمّة وجديرة بالتقدير، ولكنّ كفاءتها تأتي من كونها مشتقة من موضوعها الأصليّ، فلا تكون كذلك إذا ما جرى الزجّ بها في تحليل موضوعات أخرى؛ فليس ثمّة معرفة عابرة للتقاليد والعلاقات الاجتماعيّة والخلفيّات التاريخيّة والعقائد الدينيّة، ولا غرابة أن ينهار كثير من نتائج بحوث الخطاب الاستعماريّ، ليس بسبب عدم دقّتها العلميّة وصرامتها المنهجية، إنّما بسبب عدم قدرتها على استيعاب موضوعها استيعاباً كاملاً؛ فالمجتمعات المستعمَرة تستقرّ على بطانة متنوّعة من الولاءات، كالتحيّزات العرقيّة والتواطؤات الفئويّة، والخلفيّات التاريخيّة الخاصّة، والعقائد الدينيّة الراسخة، لا تستطيع المعرفة الاستعماريّة الغوص فيها، ويتعذّر عليها تأويل دلالاتها الرمزيّة، فكثير منها لا يفهم إلا في السياق الثقافيّ الحاضن لها.
ربوح البشير: ألا تجد تعارضاً بين دقة المنهجية التحليلية والمعرفة الاستعمارية؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: أفضت التجربة الاستعماريّة إلى تدمير كثير من المأثورات الثقافيّة الأصليّة، وتخريب الذاكرة التاريخيّة للشعوب المستعمَرة، واستبعاد ما لا يمتثل لرؤية المستعمِر، فوصمت بالبدائيّة كلّ ممارسة اجتماعيّة أو ثقافيّة أو ودينيّة مهما كانت وظيفتها، فلم ينظر إليها بعين التقدير، إنّما بالغرابة، إذ تتعالى منها رائحة الأسطورة، ومجافاة الواقع، والعجز عن تفسيره، وأصبح أمر كبحها مشروعاً، فلا سيادة إلا لفعل المستعمِر القائم على نفعيّة مخطّط لها، حيث تجرّد ممارسات الشعوب المستعمَرة من شرعيّتها التاريخيّة، فتوصف بأنّها طقوس بدائيّة؛ ذلك أنّ الاتّصال بالطبيعة والاهتمام بها، وهو مبدأ إنسانيّ تولّدت عنه فكرة الانتماء والهُويّة، استبدل بضرب مختلف من العلاقات بين البشر يقوم على التبعيّة من خلال القوّة وبسط النفوذ والهيمنة.
وانتهى الأمر بالمعرفة الاستعماريّة إلى الوصول إلى نتائج لم تصدق على موضوعها، إنّما استجابت للشروط المنهجيّة الغربيّة التي حملتها معها، وليس ثمّة قيمة لمعرفة تعيد إنتاج موضوعاتها طبقاً لفرضيّات لا صلة لها بتلك الموضوعات، إلى ذلك لم تخلُ المعرفة الاستعماريّة من غايات مستترة جرّفتْ روح المقاومة عند الشعوب المستعمَرة، وأحلّت فيها أخلاقيّات الانصياع محلّ أخلاقيّات المقاومة، فجرى تمثيل أحوالها بصور بدائيّة غامضة، ليقع فصلها عن هُويّاتها الأصليّة، فتتوهّم بأنّ القطيعة معها ستقودها إلى الحداثة. ثم جاء مقترح الأخذ بمسار التطوّر الغربيّ وسيلة للتقدّم، فوضع المعرفة الاستعماريّة في مأزق خطير، إذ روّج الخطاب الاستعماريّ لفكرة تقدّم واحدة في التاريخ الإنسانيّ هي التجربة الغربيّة، وجعلها مثالاً ينبغي أن يحتذى، فمسار التقدّم الغربيّ هو السبيل الوحيد للتطوّر، وفكرة الاستمراريّة التاريخيّة من الإغريق إلى الغرب الحديث، وضعت أمام العالم مقترحاً وحيداً للتطوّر هو المقترح الغربيّ، وكلّ مجتمع لا يأخذ بذلك سوف يظلّ خارج التاريخ، فوقع تناسي تجارب المجتمعات الأخرى، ووصمت بالبدائيّة والتخلّف، ذلك أنّ التقدّم لا يأخذ معناه إلا من الوصف الغربيّ له، ولهذا تعثّرت تجارب التحديث في معظم المجتمعات التي مرّت بالتجربة الاستعماريّة؛ لأنّها ينبغي أن تمتثل لشرط الحداثة الغربيّة، وليس لحداثة متّصلة بهُويّة تلك المجتمعات وتجاربها التاريخيّة.
ركّز الخطاب الاستعماريّ على الاختلافات، وكرّس التباينات، فرأى في كلّ اختلاف عن المركز الغربيّ دونيّة، فكان عاجزاً عن تقدير الاختلافات بما هي عليه، ولم يقبل بها، إنّما أراد لها أن تكون وصمة عار ينبغي تذكّرها دائماً على أنّها علامة انحطاط وتخلّف، فعاشت المجتمعات المستعمَرة هاجس القلق والهشاشة والحيرة، وقد اقتلعت من أصولها، ولم تدمج في مسار التطوّر الغربيّ، فليس أمامها سوى خيار التبعيّة، إذ جرى تخريب معرفتها بأحوالها، وقُضي على مسار نموّها الخاصّ، وفرضت عليها معرفة أخرى، ووقع الترويج لتحديث غربيّ في أوساطها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أخفقت المعرفة الاستعماريّة من ملامسة مشاكلها، ولم يقع قبول حقيقيّ لاندراجها في مسار التطوّر الغربيّ، فجرى تكريس اختلافها عن الغرب في كلّ شيء، ولهذا اندرجت في علاقة التابع، فتضافرت المعرفة والقوّة الاستعماريّة في حجز تلك المجتمعات ضمن أطر محدّدة، فلا يسمح لها بالاندماج العالميّ، ولا يقبل لها بتطوير هُويّاتها الأصليّة.
ربوح البشير: ماذا نتج عن كلّ هذا على صعيد الهويّة والكتابة؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: ينبغي الاعتراف بأنّ الاستعمار انتصر في تفكيك الشبكة الرمزيّة من المعاني والتخيّلات والأخلاقيّات للجماعات الأصليّة، وأحلّ معها بالقوّة العسكريّة أو السياسيّة أو الاقتصاديّة أو بالتعليم الاستعماريّ، شبكة مختلفة من المعاني حملها معه من وراء البحار، وحينما استقام الأمر للقوى الاستعماريّة وصمت المجتمعات الأصليّة بالهمجيّة، ورسمت لها صورة سلبيّة. ولكي تنخرط في مسار التاريخ العالميّ، ينبغي عليها الاندراج في سياق الثقافة الاستعماريّة، وتبنّي ما تقدّمه من أفكار وتصوّرات ومناهج، وطبقاً لقاعدة التبعيّة، فلا يجوز الابتكار، إنّما تنبغي المحاكاة، فتلك وسيلة المرء الوحيدة ليكون موضع حظوة، فيكون له موقع في السلّم الإداريّ للسلطة الاستعماريّة، ذلك أنّ فصم الصلة عن الجماعة الأصليّة وهُويّتها الثقافيّة يعقبه البحث عن بديل. ولكن أفضى انحسار التجربة الاستعماريّة المباشرة إلى الدفع بظاهرة الكتابة المحاكاتيّة، ففي قلب المركز الثقافيّ الغربيّ ظهر نوعان من الكتابة، كتابة بيضاء أصليّة معترف بها، وكتابة ملوّنة هجينة يحوم الشكّ حول قيمتها، ولم يقع الاندماج بينهما؛ فما زال ينظر إلى الثانية بوصفها سجلاً لتجارب المنفيّين والغرباء والمهاجرين والمجتمعات النائية، استعار لغة المستعمر وشروط أدبه ليعبر بتخيّلات سرديّة متوتّرة عن موضوعات خارج المركز الغربيّ، فهي كتابة مقتلعة لم تفلح في الاندماج في مسار المؤسّسة الغربيّة بصورة كاملة، ولم تنبثق من سياق الثقافات القوميّة الوطنيّة للمجتمعات التي كانت موضوعاً للتجربة الاستعماريّة، ولا يخلو بعضها من نقد مسار التجربة الاستعماريّة نفسها، والجروح التي تركتها في الثقافات الأصليّة.
ربوح البشير: هل نحن بإزاء محو تؤدّيه هذه الكتابة؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: تسبّبت التجربة الاستعماريّة في ظهور قضيّة على غاية من الأهمّيّة، تتّصل بالاختيارات الممكنة في الأخذ بأشكال الكتابة. وطرحت احتمالات ثلاثة، فإمّا محو آثار تلك التجربة من تاريخ المجتمعات المستعمرة، واعتبارها تجربة تاريخيّة في سياق تاريخ قوميّ طويل، وإمّا أن يقع الأخذ بالخبرة الاستعماريّة والحفاظ على المؤسّسات التي خلفتها وكافّة أشكال الكتابة التي أشاعتها، وأخيراً يمكن اللجوء إلى اختيار التهجين بين تلك التجربة وتجارب المجتمعات في مرحلة ما بعد الاستعمار. والحال هذه، فلا مأزق أكثر تعقيداً من هذه الاختيارات أو الأخذ بأيّ منها، فذلك لا يعود إلى غياب إرادة تلك المجتمعات، إنّما للظروف العالميّة، ولطبيعة المؤسّسات البديلة للدولة الوطنيّة، ولدرجة المحو الذي تعرّضت له الموروثات الأصليّة، ثمّ إنّه يعود أيضاً بدرجة كبيرة إلى طبيعة التركة الاستعماريّة، في حال الاستيطان الذي تسبب في إبادة الجماعات البشريّة وثقافاتها الأصليّة، كما هو الأمر في أميركا وكندا وأستراليا، على سبيل المثال، فقد صار من شبه المتعذّر العودة إلى حقبة ما قبل التجربة الاستيطانيّة، ذلك أنّ المستوطن البديل ومثاله أميركا أصبح قوّة استعماريّة جديدة، فصارت تمارس دور الإمبراطوريّة القديم، بفرض هيمنتها وتعميم أخلاقيّاتها، وبسط نفوذها الاقتصاديّ والعسكريّ والسياسيّ والثقافيّ، فحدثت قطيعة بين تاريخين: قديم جرى طمسه هو والجماعة الحاملة له، وحديث جرى تثبيته هو والجماعة المؤسّسة له.
ربوح البشير: واضح أنّ الظاهرة الاستعمارية عابرة للحدود، فكيف ترى العولمة؟
صار من المؤكد أنّ المركزية الغربية صاغت مفهوم العولمة
الدكتور عبد الله إبراهيم: إذا كانت الظاهرة الاستعمارية عابرة للحدود فالعولمة ظاهرة عابرة للثقافات، فقد صار من المؤكد أنّ المركزية الغربية صاغت مفهوم العولمة، وكثيراً ما جرى التأكيد على أنّ الغاية الأساسية لنزعة العولمة هي تركيب عالم متجانس تحلُّ فيه وحدة القيم والغايات والرؤى والأهداف محل التشتت والتمزق والفرقة وتقاطع الأنساق الثقافية. ولكنّ هذهِ النزعة اختزلت العالم إلى مفهوم، بدل أن تتعامل معه على أنه تشكيل متنوع من القوى، والإرادات، والانتماءات، والثقافات، والتطّلعات. ووحدة لا تقرُّ بالتنوع ستؤدي إلى تفجير نزعات التعصب المغلقة، والمطالبة بالخصوصيات الضيقة؛ فالعولمة بتعميمها النموذج الغربي على مستوى العالم، واستبعادها التشكيلات الثقافية الأصلية، أوقدت شرارة التفرّد الأعمى؛ ذلك أنّ بسط نموذج ثقافي بالقوة لم يؤد إلى حلّ المشكلات الخاصة بالهويّة والانتماء، إنما تسبّب في ظهور أيديولوجيات متطرّفة دفعت بمفاهيم جديدة حول نقاء الأصل وصفاء الهويّة. إلى ذلك فإنّ عملية محاكاة النموذج الغربي قادت إلى سلسلة لا نهائية من التقليد المفتعل الذي اصطرعت فيه التصورات، فاصطدم بالنماذج الموروثة التي بُعثت على أنها نُظم رمزية مثلت رأسمال قابل للاستثمار الأيديولوجي عرقياً وثقافياً ودينياً.
ربوح البشير: أراك تدعو كثيراً إلى الاختلاف. ما نوع الاختلاف الذي تريده؟
النقد هو الممارسة التي يمكن اعتبارها دعامة الاختلاف الشرعية
الدكتور عبد الله إبراهيم: لا أريد من الاختلاف الدعوة إلى قطيعة مع الآخر، ولا مع الماضي، ولا الاستهانة بهما، ذلك أنّ القطيعة لن تحقّق إلا العزلة والانغلاق، والاعتصام بالذات ومطابقتها على نحو مَرَضي لا يمكّنها أبداً من أن تتشكّل على نحو سليم ومتفاعل ومتطور. أريد تنمية عوامل اختلاف جوهرية واعية تعمل على تغذية الذات الثقافية بأسئلة مرتبطة بواقعها، وألا يصار إلى اختزال الواقع إلى مفاهيم توافق رؤى ثقافية أخرى لها شروطها التاريخية المختلفة، فالاختلاف يبحث بنفسه عن الحلول الممكنة للصعاب التي تواجه أسئلته، ولكن في الوقت نفسه، الدخول في حوار متكافئ مع الآخر، كائناً ما كانت مرجعياته ومصادره، ومساءلته معرفياً ومنهجياً بغرض الإفادة منه، وليس الامتثال له، فليس ثمة اختلاف دون وعي أصيل بأهمية الاختلاف نفسه.
تدشين أرضية صالحة للاختلاف في الرؤية والمنهج، يوجب استئناف النظر بكلّ طبقات الثقافة العربية التي تراكمت خلال العصور التي مرّت عليها، وإلى جانب ذلك استئناف النظر بمعطيات الثقافة المعاصرة، وبدون منظور نقدي يصعب تصوّر ظهور اختلاف حقيقي، فالاختلاف انفصال إجرائي عن الآخر بما يمكّن من رؤيته بوضوح كافٍ، وانفصال رمزي عن الذات بما يجعل مراقبة أفعالها ممكنة. والنقد هو الممارسة التي يمكن اعتبارها دعامة الاختلاف الشرعية، وهو نقد لا يعني بأي شكل من الأشكال إصدار حكم قيمة بحق ظواهر ثقافية لها شروطها العامة، ولا يدّعي تقديم بدائل جاهزة، وليس في مقدوره استبدال معطىً بآخر بسهولة، لأنه نقد لا يقرّ بالمفاضلة، إنما هو ممارسة فكرية، تحليلية، كشفيّة، استنطاقية، غايتها توفير سياقات تمكّن من إظهار تناقضات الفكر المتمركز حول نفسه، وإبراز تعارضاته الداخلية، ومصادراته، واختزالاته للثقافات الأخرى.
ربوح البشير: وكأني بك تربط بين الاختلاف والنقد ربطاً محكماً؟
الدكتور عبد الله إبراهيم: أجل، فالنقد المقصود في هذا السياق لا يؤمن بتغليب مرجعية على أخرى، وهو لا يدّعي القدرة على الإجهاز على كتلة متصلّبة من الممارسات المتمركزة على نفسها سواء أكان ذلك على مستوى العلاقات الواقعية أم العلاقات الخطابية. فالنقد أبعد ما يكون عن كل هذا، فلا يصار الإجهاز على ظاهرة من خلال إبداء الرغبة في ذلك. "التفكير الرغبوي" تفكير انفصالي بطبيعته عن موضوعاته؛ لأنه يكيّف نظرياً مسار الوقائع للرغبة دون الأخذ بالاعتبار الهوّة التي تفصل الرغبة عن موضوعها، إنما يريد النقد أن يمارس فعله عبر الدخول إلى صلب ظاهرة ثقافية كبيرة والتفكير فيها، ولكن ليس التفكير بها. النقد المنشود نوع من العمل المنهجي الذي يتّصل بموضوعه، وينفصل عنه في الوقت نفسه، فهو يتجاوز التذلّل والولاء، فيُدخل موضوعه في سياق نقدي شامل، دون ادعاء أية حقيقة وأي يقين، كما أنه لا يصدر عن مرجعيات تجريدية ثابتة ترتبط بهذه الثقافة أو تلك. وهو ممارسة معرفية واعية تنتمي إلى ذاتها، تتوغل في تلافيف الظاهرة الثقافية لتكشف أمام الأنظار طبيعة الظاهرة، وآلية الممارسات التي تقوم بها، سواء في إنتاج ذات تدّعي النقاء، أو في اختزال الآخر إلى نمط يوافق منظورها، فيكون ممارسة تعي شرط حريتها، وهو نقد لا يتقصّد قطيعة بين الذات والآخر، إنما ترتيب العلاقة بينهما على وفق أسس حوارية وتواصلية؛ بهدف إيجاد معرفة جديدة تقوم على مبدأ الاختلاف الرمزي عن الذات المتمركزة وخرافاتها، والآخر المتمركز ومصادراته. ولا يمكن أن تكون معرفة الآخر مفيدة إلا إذا تمّ التفكير فيها نقدياً، والاشتغال بها بعيداً عن سيطرة مفاهيم الإذعان والولاء والتبعية، وبعيداً عن أحاسيس الطهرانية الذاتية وتقديس الأنا.