علم الآثار يفك شفرات الماضي، ويحل ألغازه المبهمة
فئة : قراءات في كتب
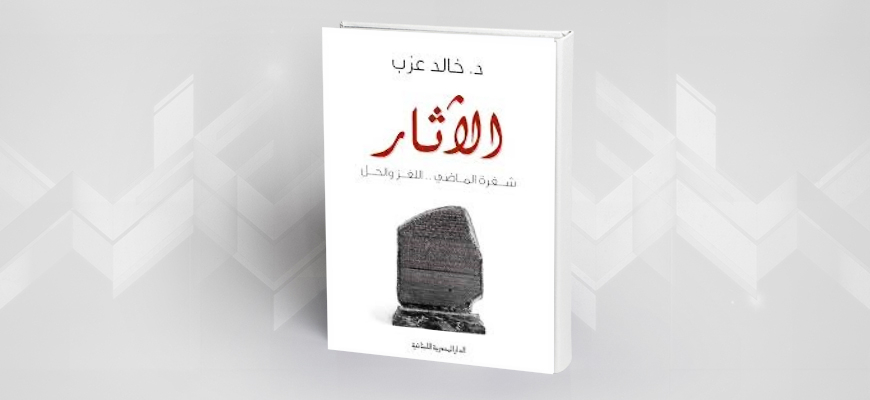
علم الآثار يفك شفرات الماضي، ويحل ألغازه المبهمة([1])
بقلم: د. هويدا صالح
في محاولة جادة لاستقراء علم "الآثار" وأهميته في كشف الدور الكبير الذي يقوم به في حفظ التراث الإنساني، وفهم مراحل تطور المعرفة الإنسانية، يأتي كتاب "الآثار.. شفرة الماضي.. اللغز والحل" للأكاديمي المصري خالد عزب، الصادر حديثا عن "الدار المصرية اللبنانية".
يُعدُّ الكتاب محاولة لاختراق هالة من الضباب الكثيف للماضي البعيد؛ وذلك من خلال الاكتشافات الجديدة التي تحدث بصورة مستمرة، يقوم فيه الباحث بطرح العديد من الأسئلة حول الموضوع، قبل أن يكشف عن الطرق التي أوصلته للإجابة الصحيحة عن تلك الأسئلة.
يرى الكاتب أن علم الآثار الاجتماعى، ينهض بدور جوهري هو بناء رؤية متكاملة عن المجتمعات القديمة، كيف كانت، وكيف كان الناس يعيشون ويتواصلون، ودور الباحث هنا هو القيام بتحليل معطيات آثار أمة من الأمم بغية بناء تصور في مخيلته عن هذه المجتمعات من خلال ما تبقى من آثار هذه المجتمعات أولاً، لكى يصل إلى الظواهر التى تعبر عن الحياة اليومية، ومن ثم يصل إلى النتائج المرجوة، وهنا تكمن صعوبة هذا العلم.
يحاول الكاتب أن يكشف عن "الإثارة الناتجة عن هذا العلم.. كيف كان؟ وكيف نحن الآن؟، وبين هذين التساؤلين مساحة واسعة، سواء من حيث الزمن أو المعرفة، أو التطور الذي لحق بالإنسانية. ويكمن دور علم الآثار في سد الفجوة بين التساؤلين"[2].
يقدم الكتاب تصورا عن مساحة المعرفة الإنسانية وامتدادها لما قبل معرفة الكتابة؛ أي إلى التاريخ السحيق الذي يحمل كما من الألغاز المعقدة، لذا فإن علم الآثار علم يقوم على علم تاريخ الأفكار ونمو نظريات المعرفة لدى الإنسانية والطرق التي تبحث عن الماضي؛ فبنية علم الآثار لا تعتمد فقط على الآثار، بل على مجموعة من التساؤلات تدور حول الأثر ذاته كونه منتجا لمجتمعات إنسانية تطرح حولها أسئلة مثل: من هؤلاء؟ وما الأشياء التي كانت تستهويهم وما الظروف التي عاشوا فيها؟ وماذا كانوا يأكلون؟ كيف تطورت حياتهم؟ مما يؤدي إلى بناء معرفي معقول عن هذه العصور يشكل لنا إطارا مرجعيا لأسلافنا.
بناء على هذه التصورات، يرى الباحث أن قضية الآثار" تتحول من مجرد الكشف عن أثر أو الحفاظ على تحفة فنية ليس إلا، إلى معرفة كل شيء عن الحياة الماضية للإنسان، لبناء صورة متكاملة عن حياته، لذا فالتعامل مع موقع الحفر الأثري المنظم، يهدف إلى تحليل ألغاز هذا الموقع، مما يؤدي لبناء تصور عن المجتمع الذي عاش فيه، وكيف تكيف مع هذا المكان، وسلوكيات هذا المجتمع وطرق معيشته، هذه الأسئلة التراكمية جعلت علما خاصا بها ينمو وتصبح له معطياته، هو علم الآثار الإجرائي الذي يهتم بتراتبية هذه الأسئلة؟ وبطرق حل شفرات الإجابة عنها، ثم بناء تصور يقوم على تتابع هذه الأسئلة عن الموقع الأثري أو اللقى أو المقتنيات الأثرية"[3].
ومن الأفكار المهمة التي ناقشها الكاتب هل علم الآثار علم واحد؟ أم عدة علوم متواشجة وترفد بعضها بعضا؟ ويرى أن علم الآثار تطور وتوسع في العقود الأخيرة، ليصبح علما عابرا للتخصصات؛ فقد ظهر علم الآثار البيئي الذي يمكن علماء الآثار ونظرائهم في العلوم الأخرى من دراسة استخدام الإنسان للنبات والحيوان، وتكيف المجتمعات البدائية مع البيئة المتغيرة باستمرار، بينما يعمل علم الآثار العرقي على دراسة حياة الشعوب ورموزها الثقافية، وعلم الآثار البيولوجي الذي يقوم بدراسة النباتات والحيوانات، والكائنات الحية الأخرى، وعلاقتها بالنظام الغذائي، وعلم الآثار الجغرافي، وهو اندماج بين علم الآثار وعلم الجيولوجيا من أجل إعادة بناء البيئات البدائية، والتعرف عليها، ودراسة الأحجار، وعلم الآثار الجيني الذي يعني بدراسة ماي البشرية من خلال استخدام تقنيات علم الوراثةـ وغيرها من العلوم كاللغات القديمة وتاريخ الكتابة واللغات المقارنة واللغويات. ثم يعلن الكاتب بعد أن استعرض كل العلوم والمعارف التي تتعلق بعلم الآثار أنه سوف يتوقف أكثر حول الأنثربولوجيا وعلم الآثار. ويؤكد الكاتب أيضا أن اهتمامات الآثاري أو عالم الآثار تتماثل إلى حد بعيد مع اهتمامات المؤرخ، إلا أن عالم الآثار يحاول الوصول إلى فترات تاريخية أقدم بكثير من التي يحاول المؤرخ بلوغها؛ فالمؤرخ يتناول تلك المعطيات التي تتميز بوجود سجلات مكتوبة أو مدونة، علاوة على هذا، فإن دراسته في أغلب الأحيان محدودة بفترة زمنية قوامها الخمسة آلاف سنة الأخيرة من تاريخ البشرية، هنا يغوص الآثاري في عمق الماضي السحيق من خلال إعادة تركيب الماضي، مستعينا في هذا ببقايا الإنسان التي يعثر عليها أثناء الحفر والتنقيب.
يتكون الكتاب من مدخل وخمسة فصول، يكشف الكاتب في المدخل عن دور ذاكرة الإنسان في الإبداع وصناعة التاريخ، كما يتساءل عن كيفية نمو المعرفة، ويرى أنه يطرح تصورا جديدا يتحدى الفكرة القائلة: إن البيولوجيا وحدها هي التي قادت إلى نشوء المهارات العقلية، وما يبرهن عليه هو قدرات مثل طاقة الإبداع والمهارات اللغوية والعمل هي نتيجة عملية مستمرة من التخصيب الثقافي بالتفاعل مع العالم الذي نعيش فيه، سواء مع أناس آخرين أو أشياء مادية أخرى. ويرى الكاتب أن "هذه الفكرة تذهب إلى أن العقل البشري دائم التغيير يتفاعل مع كل متغير في الحياة سواء كان هذا المتغير ثقافيا أو أشياء أو تقنيات جديدة، على نحو ما تفاعل الإنسان مع ابتكار البردي كمادة، لتسجيل يومياته كوثيقة ترتقي بالتعاملات بين البشر لسلم أعلى في الإنجاز الحضاري، وكتفاعله اليوم مع الهاتف النقال بتقنياته المتعددة التي تغير مفهوم الاتصال ونقل المعلومات"[4].
كما يطرح الكاتب تساؤلا آخر حول علاقة قدرة الإنسان على الابتتكار وعلاقة ذلك باللغة، ويذكر التجربة التي قام بها ديترايتش ستاوت وزملاؤه في كلية لندن، حيث قاموا "بعمل مسح ضوئي للمخ في ممارسة ثلاثة من علماء الأنثربولوجيا صنع أدوات مماثلة لأخرى تعود للعصر الحجري، وتوصلوا إلى أن الأجزاء التي نشطت في المخ عند هؤلاء العلماء هي نفسها الأجواء المستخدمة في اللغة".[5]
ويرى الكاتب أن مراكز النطق في المخ الإنساني تؤكد على أن اللغة مكون أساسي في الإنسان مثلها مثل الحواس التي لديه، والتي لها مراكز مماثلة في المخ، ومن هنا "فإن اللغة ابتكار إنساني خالص، قول في حاجة إلى المزيد من البرهنة على صحته؛ فاللغة في بدايتها كانت محدودة لمحدودية حاجة الإنسان لها الذي طورها وأكسبها يوما بعد يوم مزيدا من المفردات التي ينمو عددها مع نمو حاجة الإنسان لها.
كما يستقصي في الفصل الأول أهمية علم الآثار في قراءة تطور المجتمعات البشرية، ويرى أن علم الآثار الاجتماعي يسعى إلى فهم متغيرات المجتمعات الإنسانية على مدى زمني بعيد، ويقود ذلك إلى نشوء علوم جديدة منها: علم الآثار المختص بالهوية، حيث دراسة الأفراد بصورة مستقلة، بل إن كل مجتمع أصبحت له أسئلته الخاصة به، والتي تؤكد على فرادة هويته. وقد صنف الكاتب المجتمعات البشرية القديمة إلى أربعة أنواع هي: الجماعات المتنقلة، والتي تتكون من عدد صغير من الأفراد يقومون بالصيد وجمع النباتات، لا يزيد عددهم غالبا عن مئة فرد، يتنقلون بشكل موسمي للبحث عن مصادر طعام برية، ويرتبط أفرادها ببعضهم البعض من خلال الزواج، وهذه المجتمعات غالبا لا يكون لها، لذا لا توجد فروق اجتماعية أو اقتصادية بين أفرادها. وكذلك، المجتمعات الصغيرة التي لا يزيد عددها عن الألف فرد، ويعتمدون في قوتهم على الزراعة وتربية الحيوانات؛ لذا فهم فلاحون مستقرون، من هنا نشأت فكرة القرية، حيث لجأ القوم إلى نوع من تنظيم الحياة والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم. أما المجتمع المركب، حيث تتعقد حياة البشر، ليمارسوا نوعا ما من السلطة الاقتصادية والسياسية من خلال فرد أو مجموعة بعينها، ويظهر بهذه المجتمعات فكرة الأعراق والانتساب لجذر عريق، لذا فهيبة هذه المجتمعات ترتبط بالأصالة والنسب لشخص قائد المجتمع أو زعيمه، لكن من الملاحظ أن هذه المجتمعات غير طبقية، وتتمحور حياة الناس فيها حول المعبد، وقصرالزعيم، ويقدر علماء الآثار أعداد هذه المجتمعات ما بين الـ 2000 إلى 5000 آلاف فرد. والنوع الأخير هو المجتمعات المسيسة، حيث يكون الزعيم القبلي فيها قوة عسكرية، يستخدمها في تطبيق الأحكام وقواعد الحكم التي يفرضها. وينقسم المجتمع إلى طبقات لتظهر العبودية، فنجد المزارعين والعبيد والحرفيين المتخصصين والكهنة وحاشية الزعيم الذي يمتلك الأرض ويؤجرها للمزارعين الذين يؤدون ما عليهم تجاه حق زراعة الأرض.ويتحدث في نفس الفصل عن مجتمعات الصيادين وتطورها، سواء صيد البر أو البحر.
كذلك يتحدث عن تطور التقنيات ونمو المعرفة، وكيف أن الإنسان طور قدراته بصورة مستمرة، ويستقصي العصور التي مرت بها المجتمعات من خلال تطور الأدوات التي يستخدمها، مثل: العصر الحجري وعصر البرونز وعصر الحديد.كذلك يتحدث عن الفن الصخري وظهور النحت وأنواع هذا الفن وأنماطه.
وفي الفصل الثاني، يتحدث عن تطور فن الكتابة وطرائفها ودلالاتها، ويرى أن بين علم الآثار وعلم الأنثربولوجي مساحات كبيرة مشتركة ومن هذه المساحات الكتابة ودلالاتها ونشأتها وتأثيرها في حياة الإنسان. ويرى أن ذاكرة الإنسان كانت الأداة الرئيسة، لنقل المعلومات وخزنها، لكن ذاكرة الإنسان محدودة، لا تساعده على استيعاب الكم التراكمي من المعرفة الإنسانية، واحتاج الإنسان ليسجل بعض مشاهداته.لكن الكاتب يرصد الفروق بين ذاكرة الإنسان والكتابة؛ فالانتقال الشفهي يحتاج لشخص فطن وواسع الأفق. أما في حالة الكتابة، يتم تخزين المعلومات بطريقة آلية بالحفر والرسم، ومن الممكن أن تسترجع وتستخدم في أي وقت وفي أي مكان من قبل من لديهم قدرة على فك شفراتها. وللكتابة ميزات أخرى، فهناك حدود لذاكرة الإنسان، لاستيعاب كم المعلومات المطلوب تخزينها، بينما المعلومات المخزنة على الوسائط المختلفة لا حدود لها على عكس ذاكرة الإنسان.
ويشير الكاتب إلى أن الكتابة كانت وسيلة الإنسان الأول على خزن وتدوين المعلومات الضرورية حتى لا تفنى، من ثم فلا يوجد فرق في وظيفة الرسومات الصخرية التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. تنبه علماء اللغات القديمة بعد دراسات عميقة إلى "أن نوع الكتابة الذي يطوره المجتمع أو يختاره يدل على نوع هذا المجتمع؛ فالعديد من المجتمعات عرف بدايات مبكرة للكتابة، بعض المجتمعات رفضتها والبعض الآخر قبلها، فنشأت لديه حضارة، حيث صارت جزءا أساسيا من هذا المجتمع، فبنى عليها المجتمع معاملاته التجارية والإدارية وطقوسه الدينية، وهذا ما حدث في مصر القديمة والعراق"[6]. ثم يتحدث الكاتب في هذا الفصل عن علاقة اللغة والكتابة، كذا علاقة أشكال التخاطب المختلفة والكتابة، كذلك الكتابة التصويرية واستفاض الكاتب في سرد تاريخ اللغة المصرية القديمة مثل: الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية، وفصل القول في اللغة الهيروغليفية، باعتبارها اللغة الرسمية في مصر القديمة. كذلك فصل القول في اللغة السومرية القديمة وأدواتها المختلفة، ثم تحدث عن كتابة "المايا" التي وجدت في جنوب شرق المكسيك، ورموزها، وتساءل هل كتاب حضارة المايا فنانون أم خطاطون، ويشير إلى أن مصطلح فنان يتساوى مع مصطلح خطاط في تلك الحضارة القديمة.
وفي الفصل الثالث، يتحدث عن علم الآثار وعلاقته بغذاء الإنسان، وعما يمكن أن تخبر به الآثار القديمة للنباتات والحيوانات والأطعمة المختلفة التي كان الإنسان القديمة يستخرجها من الفواكة والخضروات. استفاض الكاتب في شرح طعام المصريين القدماء، وقام بسرد تاريخ الخبز عند المصريين، بعدها تحدث عن طعام قدماء العراقيين، والغذاء في التراث الإسلامي. كذلك، يستفيض الكاتب في شرح وسائل حفظ الأطعمة في مصر القديمة، ويشير إلى بعض الأطعمة والبذور التي وجدت محفوظة في بعض المقابر الفرعونية لم تفسد بعد مرور كل هذه السنين.
في الفصل الرابع، يتناول علاقة السياق بالأثر، وكيف أن الآثاري يتحرك بحثا عن السياق أو الإطار، وهو أمر أساسي لفهم النشاط البشري في الماضي. ويرى الكاتب أن سياق القطع الأثرية يتكون من المحيط الخاص بها، وهو المادة مثل طبقة التربة وما يحيط بها، ومصدرها أي وضعها الأفقي أو الرأسي داخل محيطها وارتباطها ببقية القطع الأثرية التي وجدت بجوارها. يقول الكاتب إن: "السياق الأساسي: هو المكان الذي وجدت فيه القطع الأثرية وترسبت فيه في الماضي. أما السياق الثانوي، فهو يطلق على القطع التي تحركت من مكانها الأصلي من خلال قوى الطبيعة أو النشاط البشري"[7]. ثم يشرح الكاتب علاقة السياق بالموقع. كذلك دور علم الآثار في إعادة بناء الماضي لفهمه بصورة صحيحة. ويرى أن الإنسان يتمكن من أن يميز بين عمليات التكوين الثقافية وعمليات التكوين الطبيعية؛ فالعمليات الثقافية تكمن في الأنشطة غير الجوهرية للبشر مثل صناعة التحف وبناء المباني وحرث الحقول وغيرها. أما عمليات التكوين الطبيعية هي الأحداث الطبيعية التي تتحكم فيما هو مدفون، وما هو ظاهر للسجل الأثري، فالسقوط المفاجئ للرماد البركاني الذي غطى بومبي عملية طبيعية استثنائية، لأن تلك العملية تحدث عن طريق الدفن التدريجي للقطع الأثرية بفعل الرمال والتربة التي تحملها الرياح، وبالمثل، فإن عملية نقل الأدوات الحجرية بفعل اندفاع المياه في النهر تعد مثالا على عملية التكوين الطبيعية، من هنا، فإن مستقبل فهم عصور ما قبل التاريخ في مصر مثلا يأتي من فهم حركة اليابسة والمياه بدءا من الغيوم التي كانت على شاطئ البحر المتوسط إلى تكون دلتا النيل الذي أحدث حراكا مع المياه أسفل الدلتا لكثير من أدوات عصور ما قبل التاريخ.
ثم يتناول الكاتب بعد ذلك بشيء من التفصيل البيئات الجافة والبيئات الباردة والبيئات المغمورة بالمياه، ومن ثم يخلص إلى عمارة الأفراد.
في الفصل الخامس، يتحدث الكاتب عن طرق تأريخ الأثر والتسلسل الزمني في عمر هذا التأريخ، ويفتتح الفصل بأن الغاية من الكتاب هي إلقاء الضوء على الحضارة البشرية حسب العصور والأزمنة المختلفة بما ينعكس على ما تركه الإنسان في عصر ما وفي بقعة بشرية ما، للوصول إلى غاية كبرى هي الوصول إلى المعاني التي تعبر عنها هذه الحضارة من رقي وتقدم في طرائق وعي البشرية لتاريخها ومنجزها الحضاري.
ويرى الكاتب أن طرق تأريخ الأثر المكتشف في موقع من المواقع ينقسم إلى "طريقين؛ إحداهما ميداني بواسطة الطبقات التي يسجلها المنقب، في الموقع، ومعرفته بالفنون وطرز الحقب التاريخية المرتبطة بموقع الحفرية، كالطرز الفنية والمعمارية وشكل، ومادة، وزخرفة، وألوان، وطريقة صناعة كل المكتشفات واللقى الأثرية التي يجدها المنقب في حفريته، وكذلك بواسطة الكتابات المنقوشة من حيث شكل الحروف وغيرها، والنوع الآخر معملي، حيث يرسل الآثاري بعينات من المواد المختلفة والتربة للمعمل لتحليلها وتأريخها"[8].
وحين يخلص إلى دور التسلسل الزمني في التأريخ للأثر، يرى أن كل علماء الآثار يتفقون فيما بينهم على أهمية التسلسل الزمني، ويوضح أن تحديد المتغير الزمني في علم الآثار أمر حاسم لجميع أنواع البحوث الأثرية، ابتداء من إعادة بناء الثقافة التأريخية المحلية، وحتى التفسيرات الإجرائية العامة للسلوك البشري.
ويرى خالد عزب أن من الأهمية بمكان تحديد بعض المصطلحات المرتبطة بعملية التأريخ من وجهة نظر العديد من علماء الآثار؛ فمصطلح التأريخ يشير إلى "الأحداث المرتبطة ببعضها البعض معا في إطار زمني أو إلى معيار تمّ إنشاؤه للقياس الزمني والتواريخ هي القيم التي تحدد الوضع الزمني للحدث المؤرخ، وهذه القيم يمكن أن تكون سنوات أرضية نسبية أو سنوات من الكربون المشع"[9].
وأخيرا يختم عزب كتابه بالفصل السادس الذي يرصد فيه قدرة علم الآثار على استعادة الماضي من أجل المستقبل؛ ففهم الماضي وسياقاته ربما تمكننا من فهم المستقبل وتوقعه. ويرى أن علم الآثار قد "تجاوز الكشف عن الأشياء، ليربطها بعضها ببعض لفهم طبيعة الماضي والتغيرات الثقافية وتطورها المجتمعات، وهذا يستغرق وقتا وجهدا كبيرا، لكن ينصح بتخزين النتائج للرجوع إليها في المستقبل. هذا هو علم الآثار، يقوم على تراكم المعرفة، وما لا يوجد له تفسير اليوم، سنجد له تفسيرا في المستقبل مما يعزز بناء صورة الماضي كما كان"[10].
ويرى الكاتب أن المطلوب الآن هو التزام واسع النطاق من جانب المجتمع ككل؛ فالمجتمع يجب أن يحدد في البداية أهمية فهم الماضي، وأنه جدير بالاهتمام، ومن ثم يقدم الوسائل اللازمة لتدريب الباحثين، ولتطوير التقنيات اللازمة لأعمال الحفر الأثري وتسجيل الحفريات وحفظ نتائجها ونشرها، وهذه المهام تتطلب وقتا وجهدا من فريق كبير من المختصين.
ويطرح الكاتب سؤالا مهما في نهاية بحثه، هل لدى العرب رؤية واستراتيجية لمتاحف المستقبل؟ ويرى أن تكوين هذه الرؤية، سيجعل متاحفنا في المستقبل تواكب المتغيرات الدولية، وتجعلنا نسبق الآخر في تفكيره؛ فالمتحف يعكس طبيعة ورؤية المجتمع للتراث ومفهومه. ثم يطرح سؤالا آخر يختم به بحثه لا يقل أهمية عن السؤال السابق، وهو: هل للعرب مستقبل في عالم المتاحف؟ ويرى أن الجهود العربية قد بدأت تلتئم في هذا المجال بعد تأسيس المجلس العربي للمتاحف (الأيكوم العربي) الذي يضم أبرز المتخصصين في هذا المجال من العرب والمتاحف العربية، لتنسيق الجهود، وكذلك لتأسيس شبكة عربية للمتاحف، وفي السنوات الأخيرة تزايد الوجود العربي في المجلس الدولي للمتاحف، خاصة مع اهتمام عربي بالمتاحف. لكن خسارة العرب كانت كبيرة في متاحف العراق أثناء الغزو الأمريكي عام 2003، وهي خسارة لن تعوض بسهولة، ويأمل الكاتب أن يكون هناك علم عربي للمتاحف، وفلسفة عربية خالصة وراء هذا العلم.
[1]- مجلة ذوات العدد40
[2] خالد عزب، علم الآثار: شفرة الماضي.. اللغز والحل، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2017، ص7
[3] المرجع السابق، ص9
[4] المرجع السابق، ص13
[5] المرجع السابق، ص15
[6] المرجع السابق، ص27
[7] المرجع السابق، ص147
[8] المرجع السابق، ص176
[9] المرجع السابق، ص202
[10] المرجع السابق، ص216






