فصل المقال بمنظور جديد قراءة في كتاب "فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال"
فئة : قراءات في كتب
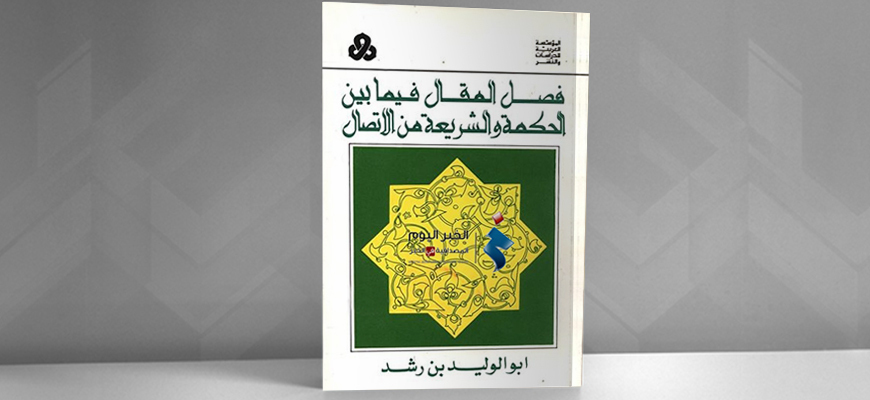
أولاً: طرح المشكلة
من المشرق الإسلامي إلى المغرب الإسلامي انتقلت مشكلة العلاقة بين الشريعة والفلسفة، وعندما بدأت المعالجات كان الفلاسفة يسعون إلى إيجاد الحلول المناسبة، مثلما فعل الفارابي في كتابه "الجمع بين رأيي الحكيمين"، حيث كان بصدد الدفاع عن الفلسفة وتأكيد مشروعيتها من خلال مبدأ وحدة الحقيقة، وكان سعيه نحو التوفيق بين الفلسفة والشريعة من خلال البرهنة على أنّ الاختلاف بين أرسطو وأفلاطون هو بالعرض وليس بالجوهر فالحقيقة واحدة، وبذلك فالفيلسوفان متفقان جوهراً وليس عرضاً، ومن هنا يلج إلى أنّ الفلسفة لا تعارض الشريعة مادامت تقود إلى الحقيقة، والحقيقة واحدة، لكنّ الفارابي لم يتجه مباشرة إلى حلّ المشكلة، بل اتجه إلى مشكلة جزئية فقط وهي المتمثلة في اختلاف الفلاسفة.
وهذا الجدل لم يحسم في المشرق، فهنالك ردات فعل كثيرة على الفلسفة منها ما كان من الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة[1]، الذي زاد من حدّة النقاش الفلسفي حول الموضوع. لذلك آن للمشكلة أن ترحل إلى المغرب الإسلامي، وهنالك تصدّى لها ابن رشد في كتابه الموسوم بـ: "فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال".
ولهذا العنوان وقعٌ في تاريخ القضية، فهو يأتي في مرحلة حرجة بالنسبة إلى الفلسفة، التي لولا كل من ابن باجة وابن طفيل لانطفأت شمعتها وركلت إلى التخشب والجمود، ولهذا وجب الفصل في قضية الصلة، وهنا يجب أن نقف عند بنية المشكلة من حيث أطرافها المكونة لها.
تنبني قضية العلاقة بين الدين والفلسفة على المكونات الآتية:
المكون المعرفي: حيث أنّ البراديغم السائد في العصر الإسلامي الأول كان ينبني على موجهين أساسين هما:
ـ وحدة الحقيقة: وهذا راجع إلى أساس أنطولوجي متمثل في التوحيد، فما دامت حالة الكون واحدة فإنّ الحقيقة حتماً صادرة عنه، وبالتالي فهي واحدة، وعليه فالحقيقة واحدة لا باعتبار القائلين بها، ولكن هي واحدة باعتبار مصدرها الإلهي، وهنا ينشأ النقاش بين الحقيقة المتوصل إليها عن طريق العقل والحقيقة المبثوثة في القرآن، أو بين الحقيقة المتوصل إليها من سبيل الفلاسفة أو من سبيل الفقهاء.
ـ اليقين: هنالك تمييز بين الظن واليقين ينبني عليه تمييز بين وسائط المعرفة الظنية واليقينية، وعليه فإنّ فكرة اليقين كانت مقياساً إرشادياً (براديغم) للمعرفة العلمية في تلك الفترة.
المكون السياسي الاجتماعي: المجتمعات الإسلامية في عصرها الأول تعتبر العقيدة مرجعية أساسية في تحقيق الصلات الاجتماعية وتكوين المؤسسات التربوية والدينية، وحتى الدولة كذلك تتخذ مشروعيتها بتبنيها أو فرضها لعقيدة ما، لهذا فإنّ الجدالات الكلامية تعتبر على وجه معرفي وإيديولوجي للحياة الاجتماعية والسياسية أو تأسيس لها تارة أخرى.
في هذه الساحة التصادمية وجدت الفلسفة نفسها، فهي تتراوح بين أمرين: الأول أنها مسلك إلى الحقيقة ومخرج من كل الصراعات، وفي أخرى أداة لتأكيد عقيدة ما أو ترسيخ سلطة سياسية معينة، وفي هذه الأخيرة قد يكون الترسيخ إما بتأييد منتحلي الفلسفة أو من خلال حرق كتبهم.
في إطار هذين المكونين برزت إشكالية العلاقة بين الشريعة والفلسفة، فهي على مستوى المكون الأول تظهر مدى نجاعتها المعرفية وفق براديغم ذلك العصر المكون من وحدة الحقيقة وبلوغ اليقين، أي مقدرة الفلسفة على بلوغ اليقين، وأمّا وفق المكون الثاني فهو مرهون بسابقه، أي الجدوى المعرفية للفلسفة هي من تستحق مشروعية الحضور الاجتماعي.
وبذلك فإنّ طرفي المشكلة المعرفي والاجتماعي يضعان الفلسفة في مواجهة حتمية أمام الدين باعتبارهما مصدرين مختلفين للحقيقة، وبالتالي فاعلين اجتماعيين مختلفين، وهنا يمكن أن نطرح سؤالاً على ابن رشد: هل يمكن الفصل في قضية العلاقة بين الدين والفلسفة؟ وإن أمكن فما النهج الصحيح إلى ذلك؟
إنّ الإجابة عن السؤالين المطروحين تقودنا إلى تقدير قراءة معرفية نقدية للكتاب سواء من حيث البنية أو من حيث المضمون، تقتضي بلوغ تفسير ذي كفاءة عالية يمكننا بدوره من ممارسة نقدية تنقلنا من أرضية الكتاب إلى آفاقه المعرفية الواسعة. ولذلك تلزمنا خطة للقراءة التي يمكن أن نلخصها في الخطوط التالية:
1) منهج القراءة
2) فصل المقال في تصميمه
3) الأفكار الأساسية والأفكار الناظمة
4) مآلات الفصل
أولاً - منهج القراءة: إنّ المنهج الذي نعتمده في قراءتنا للكتاب يستلهم من الرياضيات أساليبها وخاصة منها الهندسة، باعتبار أنها تعبر عن طريقة الإنسان في فهم العالم، فكل الأشكال الهندسية المتخيلة هي عبارة عن طريقة في تعقل العالم من خلال فعلين أساسين هما: وضع هيئة معينة للكائنات وتموضعها ضمن تلك الهيئة، وعليه يظهر هنا أمران أساسيان هما: الهيئة التي يتهيأ عليها العالم، ثم تحديد موضع الكائنات فيها.
وهذه الطريقة تسمح لنا بأن نفهم عملية نظم أو هندسة كتاب ابن رشد (فصل المقال)، والكيفية التي تموضعت فيها مجمل أفكاره داخل الكتاب، بحيث تؤول إلى نتائج محددة كان يسعى للوصول إليها. وعليه فإننا أمام محورين أساسيين يظهران في خطة المقال، وهما:
1- هندسة الكتاب: نبحث هنا عن تصميم الكتاب وشكله، وذلك لتحديد الإطار العام الذي انتظمت فيه أفكاره.
2- تموضع الأفكار داخل الهندسة: وهنا سنبحث في تراتب الأفكار ومجمل العلائق القائمة فيما بينها، وهنا نجد أنفسنا أمام نوعين من الأفكار، وهما الأساسية والناظمة، فالأساسية هي مجمل الأفكار التي تمحور حولها الكتاب، أما الناظمة فهي التي رتبت ونظمت الأفكار الأساسية داخل الكتاب، كما تنتظم الكلمات قصيدة شعرية ما، لتؤدي نغماً صوتياً جميلاً، فكذلك الأفكار الناظمة في تنظيمها للأفكار الأساسية لتقود نحو مقصد محدد.
ثانياً - فصل المقال في هندسته وتصميمه: النسخة الأصلية للكتاب لا نجد فيها عملية ترتيب وفهرسة كما هو حال المؤلفات العصرية، وعمل المحقق دائماً هو التدخل في تقسيم الكتاب وترتيبه وفهرسته بما يراه مناسباً أو متناسباً مع المخطوط، ونسخة فصل المقال المعتمدة في بحثنا هذا هي تلك الصادرة عن "مركز دراسات الوحدة العربية" التي قدّم لها "محمد عابد الجابري"، وحققها "محمد عبد الواحد العسيري"، وهذا الأخير عمل على تقسيم الكتاب إلى جزأين وضميمة، فالجزء الأول متعلق بالتكلم بين الحكمة والشريعة والثاني عن المؤولين وأصنافهم، وأما الضميمة فتكلمت عن طرق التصديق (ص53).
لكن هذا التقسيم - على صحّته - قد أغفل عنصراً مهماً أو قسماً آخر أساسياً في الكتاب، وهو "علوم القدماء وضرورة الاستفادة منها"، وهو قسم قائم بذاته لما له من أهمية في موضوع الكتاب الذي يقصد إلى وضع حقيقة مفادها أنّ الشريعة ليست مضادة للفلسفة، والقسم الأول هو عبارة عن فتوى شرعية تستند إلى أساليب الإفتاء، في حين أنّ حديثه عن علوم القدماء ليس بفتوى بقدر ما هو تحليل ونقد يخرج عن أساليب الإفتاء، ولهذا لا يمكن أن نضمه إلى القسم الأول، بل لا بدّ من وضعه قسماً منفصلاً قائماً بذاته. وبهذا يمكن أن نقسم الكتاب إلى أربعة أقسام، وهي:
- القسم الأول: فتوى وجوب النظر الفلسفي وإعماله.
- القسم الثاني: علوم القدماء والاستفادة منها.
- القسم الثاث: التأويل والمأوّلون.
- القسم الرابع: الشرع والتأويل.
ومن هذه الأقسام الأربعة تظهر هندسة الكتاب التي تجعل من منطقها فتوى شرعية تتأسس على النص، لتنتهي إلى آخر عنصر وهو منطق خطاب القرآن إزاء الناس وأساليب تأويله، وكيفيات تحقق ذلك الخطاب، ولذلك فالهيئة التي انتظم بها كتابه دائرية الشكل، اتخذت نقطة ما ورجعت إليها، حيث بدأ بالنص القرآني وانتهى إليه مروراً بالفلسفة والفلاسفة، منتهياً إلى القرآن وكيفية مخاطبته للناس وأساليبه في تبليغ الحقيقة.
وقد بدأ قسمه الأول بفتوى، وهذا راجع إلى أنّ غرض الكتاب هو الفصل والقطع في علاقة الفلسفة بالشريعة لهذا يقول: "...فإنّ الغرض من هذا القول أن نفحص، على جهة النظر الشرعي، هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور أم مأمور به إمّا على وجه الندب [وإما على] جهة الوجوب؟" (ص85). وهذا الغرض ذكي جداً من جانبه، فالغرض الخفي الذي كان يرمي إليه هو تأكيد وجوب الفلسفة بالشرع، وهنا أخذ بالنص القرآني كمنطلق تقف عليه الفلسفة في وجودها أولاً، بمعنى أنّ شرعية الفلسفة تأخذ من الشرع حتى يحق لها الوجود داخل المجال المعرفي للحضارة الإسلامية.
وأمّا القسم الثاني في علوم القدماء فقد أكد على أنّ النظر في الشرع محتاج لآلة للنظر، والتي لا يمكن فيها الاستغناء عن علوم القدماء وما قدموه من آلات للفكر والنظر، وهنا يؤكد على مشروعية ووجوب وجود الفلسفة بالنسبة إلى فهم مدلول النص القرآني.
وفي القسم الثالث: لم يؤكد فقط أو يحدد مشروعية الفلسفة، بل أفضليتها لكونها الأقدر على فهم وتأويل مدلول النص القرآني، وهنا ينطلق من التأكيد والمشروعية إلى مستوى الأفضلية.
وآخر قسم هو تتمة لما سبقه في تأكيد الأفضلية التي تعود لأهل الفلسفة في بلوغ الحقيقة من دون غيرهم في فهم مدلولات النص القرآني، وعليه فقد رجع مرّة ثانية إلى القرآن الكريم الذي بدأ به.
ثالثاً- الأفكار الأساسية والأفكار الناظمة: إنّ الهندسة التي يمتاز بها كتاب فصل المقال هي كونها دائرية الشكل، تنتقل من نقطة لتصل إلى نقطة تسمح للأفكار أن تترتب على نحو يسمح ببلوغ مقصد ظاهر وآخر باطن، ولن نتعجل في معرفتهما قبل أن نلج إلى الكيفية التي انتظمت فيها مجمل أفكاره، والتي يمكن أن نقسمها إلى أفكار أساسية وأخرى ناظمة:
الأفكار الأساسية: هي مجموع الأفكار التي تمركز حولها الكتاب، فهي الأفكار التي تعتبر محور الكتاب، ولكنها لا تقدر أن تؤدي دورها ما لم تنتظم في هندسة ما أولاً، ثم بواسطة أفكار أخرى تؤدي دور الناظم لها ثانياً.
أمّا الأفكار الناظمة: فهي مجمل الأفكار التي تنظم الأفكار الأساسية في إطار وحدة تقود نحو مقصد محدد إما ظاهر وإما باطن أو كلاهما، وهي بالتالي التي تعطي للأفكار الأساسية نظامها داخل الكتاب أولاً، ومعناها ثانياً، وأخيراً تعطيها حجيتها ومشروعيتها سواء في حالة التأكيد أم في حالة النفي.
ومن هنا يمكن أن نقرأ كتاب فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال في تشكيل يتوافق مع الأفكار الأساسية والناظمة وعلى ضوء هندسة الكتاب الكليّة، وعليه سنحلل ذلك حسب كل قسم من أقسام الكتاب ككل.
القسم الأول: فتوى وجوب الفلسفة
وهنا نجد أنفسنا أمام فكرتين أساسيتين هما: الفلسفة، والشريعة ولكن اتجاه العلاقة لا يتجه من الفلسفة إلى الشريعة بل من الشريعة إلى الفلسفة، أي وجهة نظر الشريعة إلى الفلسفة، حيث يظهر الحكم الشرعي بوصفه فكرة ناظمة للعلاقة بين الشريعة والفلسفة، وهو يظهر في بداية الكتاب على شكل احتمال أن يكون الحكم إما الإباحة أو التحريم، أو المأمور به إما وجوباً أو استحساناً، وهذه الأحكام الأربعة هي التي ستحكم على العلاقة إما بالسلب أو بالإيجاب أو بتعبير آخر، إما بالوصل أو الفصل بينهما.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى تحديد فكرة ناظمة أخرى هي من داخل الفلسفة ذاتها، والتي تتمثل في إعادة تعريف الفلسفة نفسها، حيث خرج عن المألوف من تعاريف الفلسفة كما هو سائد سابقاً من تعريف أرسطو للفلسفة والذي مفاده: "الفلسفة هي علم الوجود بما هو موجود،" بل ذهب إلى تعريفها "إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة ماهي مصنوعات، فإن الموجودات إنما تدل على الصانع بمعرفة صنعتها، وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم" (ص86)، وما نلاحظه في هذا التعريف هو أنه يحوي عنصرين أساسيين مترابطين هما:
1) فعل التفلسف
2) اعتبار دلالتها على الصانع
ويعتبر تعريف الفلسفة بكونها فعلاً وليس علماً نقلة نوعية في فهمها، ليس بوصفها مجموعة معارف يصطلح عليها بـ: "علم" بل هي فعل وممارسة، ما من شأنه أن ينقل الفلسفة نحو آفاق متجددة وكذلك ينقلها من الخصوصية اليونانية إلى المشترك الإنساني، ومعنى ذلك أنه قام بتوسيع نطاق الفلسفة من حالتها الجامدة المتوقفة عند حدود المعارف اليونانية القديمة، وتوسيعها إلى آفاق معرفية أخرى تتجدد بتجدد الفعل، ما يعني أنّ ماهيّة الفلسفة حركية وليست ثابتة، فالفعل حركة متعددة وبالتالي متجددة مترقية نحو آفاق متنوعة، على عكس الماهية الثابتة التي تتجلى في جعل الفلسفة علماً يونانياً.
ولكونها فعلاً فقد خرجت عن الخصوصية اليونانية إلى المشترك الإنساني، حيث بإمكان الإنسانية جمعاء أن تمارس فعل النظر والاعتبار لكونها تشترك في خاصية واحدة، وهي العقل أو قدرة النظر، على عكس أن تكون علماً متحيزاً في إطار ثقافي محدود تحكمه عوامله الخاصة به، ولهذا تصبح الفلسفة شأناً إنسانياً.
وإذا ما انتقلنا إلى العنصر الثاني، وهو النظر الاعتباري، فإننا سنجد أنّ ابن رشد أراد أن ينقل الفلسفة إلى الساحة الإسلامية، أي أنه أولاً سحبها من الخصوصية اليونانية بتحويلها إلى فعل إنساني مشترك، وهنا يريد أن ينقل هذا الفعل إلى مجال النظر الاعتباري الذي يعني حركة الفكر من مستوى القريب إلى أبعاده الخفية أو المترامية خلفه، وهو كذلك انتقال النظر من المخلوق إلى الخالق بعد الإمعان في الأول، وليتم هذا الإيلاج من عالم اليونان في عالم المسلمين نجده قد وضعنا أمام نقطتين هما:
1) الانتقال من النظر الملكي إلى الملكوتي.
2) الرؤية المعرفية التوحيدية مقابل النظر الحلولي.
ففي النقطة الأولى نلحظ بما لا يدع مجالاً للشك النظر الإسلامي، وهو الذي كما عبّر عنه طه عبد الرحمن[2] عند تحديده لطبيعة النظر الإسلامي بأنه لا يتوقف عند ظاهر الأشياء وهو النظر الملكي، بل يتجاوزها إلى خالقها النظر الملكوتي، وعليه فالتعقل الإسلامي يتعامل مع الموجودات لا بوصفها ظواهر بل بوصفها آيات تدل على الخالق، أي أنها تنقل من الظاهرة إلى الآية، وعليه فإنّ ابن رشد وضعنا أمام تحول آخر، وهو تحويل الفعل الفلسفي باعتباره مشترك إنساني إلى مشترك إنساني يمكن للمسلم أن يستعين به في فهم مشكلاته المعرفية وحلها وكذلك يمكن أن يشارك فيه.
أمّا الرؤية المعرفية التوحيدية المقابلة للحلولية فهي جلية في التعريف، وتتمثل في ردّ الكائنات إلى موحد أول وواحد، وهذا مقصده بـ"كلما كانت معرفتنا للمصنوعات أتم كانت معرفتنا بالصانع أتم"، أي ردّ المصنوعات إلى الخالق باعتبار أنه هو موحدها. وأنها هي علاقات دالة عليه، على عكس التعريف الأرسطي الذي يتمم بصبغة حلولية، تجعل كل الوجود حالاً في بعضه البعض، وهذا ما يظهر في تحويل الفلسفة إلى علم وجود بما هو موجود؛ أي إنها علم للوجود بموجوداته الحالة فيه.
وعليه فإنّ تعريف ابن رشد للفلسفة قد أحدث تحويلات جذرية، تتمثل في: نقل الفلسفة من كونها مجموعة معارف جامدة إلى فعل حركي متجدد قابل للتنوع، هذه النقلة جعلت من الفلسفة كونية يمكن للإنسانية أن تشارك فيها، فيمكن للمسلم عندها أن يشارك في الفلسفة وفق خصوصيته المتمثلة في النظر الملكوتي والرؤية المعرفية التوحيدية.
ومن خلال تعريفه للفلسفة استطاع ابن رشد أن يضع حلقة الوصل بين الشريعة والفلسفة، وهنا لم تعد الفلسفة محرمة بل أصبحت مأموراً بها، إمّا على وجه الندب أو الوجوب. وعن ذلك يقول: "وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات وحثّ على ذلك، فبين أن ما يدل [عليه] وهذا الاسم إما واجب بالشرع، وإما مندوب إليه" (ص86). ومعنى ذلك أنّ الحكم الشرعي يصل بين الشريعة والفلسفة في مستوى المأمور به، ولكن على أحد الوجهين إما الندب وإما الوجوب.
وهنا نجد أنّ ابن رشد يأتي بالأدلة النقلية والعقلية ليبرهن على أنّ حكم الشرع في الفلسفة هو المأمور به دون أن يفصل ما إذا كان الوجوب أو الندب، وهذا ذكاء من فيلسوفنا، لاعتبار أنه في الفصول القادمة، وخاصة منها الفصل الخاص بـ: التأويل وقانونه، فإنه سيحدد درجات المؤولين وغيرهم، وعندها يمكن أن يتحدد ضمنياً لماذوية الإبقاء على الاحتمال بين الندب والوجوب، فهو إذا حسم الأمر عند الوجوب، فليس كل الناس قادرين على التأويل، وإن كان حسمه بالندب فهذا سيضعف من موقف الفلسفة، وهذا عكس مراده الذي يسعى فيه إلى تقوية مكانة الفلسفة.
إذن انتظمت العلاقة بين الفلسفة والشريعة من داخل مكونات العنصرين ذاتهما أي من داخل الشريعة، وهو الحكم الشرعي، ومن داخل الفلسفة من خلال إعادة تعريفها، فكانت الفلسفة من وجهة نظر الشرع مأموراً بها (حكم شرعي) لكونها فعلاً اعتبارياً يسعى إلى معرفة الخالق أي الصانع (مفهوم الفلسفة).
القسم الثاني: علوم القدماء وضرورة الاستفادة منها
كلمة اعتبار هي صلة الوصل بين القسم الأول المتمثل في الفتوى والقسم الثاني من الكتاب، لذا وجب علينا أن نفصل فيها حتى نتمكن من ربط أجزاء الكتاب، خاصة وأنّ الاعتبار فكرة ناظمة أي تمارس عملية الوصل والربط بين الأفكار ضمن هندسة تتميز بكونها دائرية مترابطة الوصال.
ويعرّف ابن رشد الاعتبار بقوله: "الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم، واستخراجه منه وهذا هو القياس" (ص87)، أي أنّ الاعتبار هو قياس، وبالتالي هو آلة للعقل يتوسل بها لبلوغ الحقيقة العليا، وهي معرفة الحق سبحانه وتعالى.
من خلال تعريف الاعتبار بأنه قياس، يلج ابن رشد إلى مناقشة قضية أساسية وهي علوم المتقدمين، وبذلك يكون قد حطّ قدمه على مدخل علومهم المتمثل في آلة الفلسفة وهي المنطق، لكونه يدرس القياس وأنواعه ومستوياته، وأيها أكثر برهانية ويقينية من غيرها.
وهنا نجد أنفسنا أمام ثنائية تحتاج إلى رابطة والمتمثلة في القياس وآلة العلم عند الأقدمين، حيث يسعى ابن رشد للربط بينهما من خلال مجموعة من الأفكار الناظمة (التي هي استدلالات) على وجوب الصلة ويمكن أن نلخصها فيما يلي:
1ـ يستحيل أن يقف نفر واحد من الناس على كل أشكال القياس، لذلك وجب أن يستعين المتأخر بالمتقدم.
2ـ إن كان الفحص في الآلة فلا يهم إن كان ينتمي إلينا في الملة أم لها، وهنا يعطي مثالاً بأداة التذكية التي لا يشترط فيها أن تكون مسلمة أو كافرة، فهي أداة.
3ـ وآخر عنصر وهو أهم دليل ورابط وهو فكرة الفحص؛ وهي أن تفحص كتب الأقدمين لمعرفة آلة العلم عندهم، فما كان منها صواباً أخذناه، وما كان غير ذلك رفضناه ونبهنا إليه.
هذه الأفكار الثلاث الناظمة التي كانت تهدف إلى تحقيق وجوب الاستفادة من كتب الأقدمين، ولكن عن طريق الفحص وهذه الأخيرة عبارة دقيقة تتكرر كثيراً في هذا القسم، وهي ضمن الحقل الدلالي للكتاب تعني النظرة النقدية إلى معارف الأقدمين التي تناقض التلقي السلبي، وبالتالي فهي لا تأخذ بعلوم الأقدمين كما هي بقدر ما يخضعها للنقد، الذي يتوسط حالة التقليد وحالة الإلغاء، أي أنّ الفحص وسط بين نقيضين.
بناء على ذلك يخلص ابن رشد إلى خلاصة مفادها: أنّ تحصل آلة العلم هو تحصيل للصنعة، وهذه الأخيرة تقود إلى تعلم المصنوعات، ومنها المعرفة بالصانع، ولهذا لا يتمّ لنا الترقي إلى النظر الملكوتي إلا إذا توفر لدينا آلة ذلك، أي أنّ الاعتبار يزداد قوة إذا ما تمّ بعد فحص علوم الأقدمين الأخذ النقدي (الفحص) بآلتهم للمعرفة.
وإذا أردنا أن نستثمر فكر ابن رشد في زماننا هذا، فإنّ أول ما يتبادر إلينا هو الحداثة والتراث، فابن رشد عندما تحدث عن المتأخر فهو كان يحدثنا عن حداثة العالم الإسلامي في زمنه التي كانت تمتاز بحركة معرفية وعلمية نشط فيها الفكر عموماً، وتمّ فيها إحياء معارف الأقدمين لا إماتتها، كذلك يجب أن تكون حداثتنا لا أن تقتل الماضي والتراث تحت ذريعة القطيعة المعرفية، بل لا بدّ من فحصه، فإن كان صواباً أخذناه، وإن كان غير ذلك ذهبنا إليه، وبذلك نحييه ونتكامل معه لا أن نلغيه، أي نتعامل بمنطق التكامل.
وهذا ما يجسده ابن رشد عندما يقول: "يجب علينا أن نبتدىء بالفحص عنه، وأن يستعين المتقدم في ذلك بالمتأخر، حتى تكتمل المعرفة.. "وهنا عبارة الفحص التي تدل على ممارسة نقدية لا تؤول إلى ممارسة إقصائية بقدر ما أنها تؤول إلى ممارسة تكاملية بين القديم والحديث بين المتقدم والمتأخر.
وبناء على التكامل التفحصي الرشدي فإنّ حركة تطور المعرفة ستخطو خطوات أخرى تتحدد في:
1) زيادة رصيدهم إلى رصيدنا.
2) فحص أخطائهم واستكمالها.
وبذلك فهي عملية استرجاع نقدي تعمل على استيعاب القديم ضمن إطار جديد يعمل بدوره على تجاوزها وتجاوز أخطائها نحو مستوى معرفي أرقى.
القسم الثالث: التأويل وقانونه
والرابط بين هذا القسم وسابقه يتمثل في مستويات الخطاب القرآني الذي خاطب الناس على حسب جبلتهم، فمنهم من يقبل الأقاويل البرهانية ومنهم من يقبل الجدلية وآخرهم الخطابية، وعليه فنحن أمام ثلاثة مستويات، تعتبر الأقاويل البرهانية جزءاً منها، والتي يمثلها النظر الفلسفي، وبهذا فإنّ الخطاب القرآني يتوجه هو الآخر إلى الفيلسوف كما يتوجه إلى غيره.
وبذلك يضع ابن رشد الفلسفة أمام النص القرآني من جهة، ومن جهة أخرى أمام أشكال أخرى من الأقاويل، ويمكن أن نصطلح عليها بطرائق الفهم، وهنا نجده يحدد ثلاث طرائق للفهم السابقة الذكر، ولكن المشكلة هنا أحقية الـتأويل.
ولهذا ينتقل هذا القسم من الفلسفة إلى الشريعة على عكس ما كان عليه في القسم الأول، وعليه فإنّ هندسة الكتاب تحقق شكلها الدائري هنا، حيث بدأت من الشريعة لتعود إليها من وجهها الآخر، فالوجه الأول قام على أساس البحث في حكم الفلسفة من زاوية نظر الفلسفة، والعودة إلى الشريعة هي من حيث الدور الذي تقوم به الفلسفة بوصفها نظراً برهانياً في فهم مدلول الشريعة.
والمفهوم الناظم بين الفكرتين الأساسيتين الشريعة والفلسفة هو التأويل، ويضيف إليها مستويات الخطاب القرآني، أي أنّ هنالك فكرتين أساسيتين وفكرتين ناظمتين تمارسان فعل الربط بينهما وبذلك تحددان نظاماً من الأفكار يؤدي مقصداً محدداً، وسنبدأ بمفهوم التأويل: "ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية" (ص97)، ومعنى ذلك هو أننا لا نأخذ العبارة على صورتها الظاهرية وإنما بالمعنى المجازي لها، أي المعنى الباطني لها، فالتأويل هنا ينطلق من مسلمة أساسية مطروحة في التصور الإسلامي، والمتمثلة في أنّ للنص الشرعي ظاهراً وباطناً.
ولكن عملية استخراج دلالة اللفظ إلى الباطن تحتاج إلى قوانين، وأول قانون يحدده في قوله: "من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه... أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي" (ص97). وهو هنا لم يخرج عمّا حدده علماء أصول الفقه من خلال استخراج الحكم الشرعي من خلال الاستدلال بالمعطيات اللغوية على مقتضى اللسان العربي.
ويؤكد لنا ابن رشد سبب انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن، وهو مراعاة تفاوت مستويات الناس في قدراتهم على الفهم، ولهذا فإنّ الشرع ورد فيه المتشابه والمحكم، فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا أهل العلم أي أهل البرهان حسب ابن رشد، وهنا يسعى إلى تبيان أنّ أهل البرهان أقدر على التأويل من غيرهم ليقينية آلاتهم ومناهجهم، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى برهان، وهذا سيتجه إليه في كتاب آخر هو: "مناهج الأدلة في عقائد الملة".
ويظهر لنا ابن رشد ضرورة التأويل لعدة أسباب، هي:
1) لا وجود للإجماع بين المسلمين في المسائل النظرية
2) المسائل البرهانية خافية عن نظر الكثيرين لتلطف الرحمن عز وجل بهم، وهنا يحدد لنا ابن رشد ثلاثة أسباب وهي: إما لعجز فطري، وإما لعاداته ويمكن أن نصطلح عليه بأطر المجتمع للمعرفة، أو انعدام أساليب التعليم.
3) طبيعة الخطاب القرآني المتمثل في ضرب الأمثال، وهنا يقول ابن رشد "... إذا كانت تلك الأمثال يمكن أن يقع التصديق لها (بالأدلة (المشتركة للجميع: أعني الجدلية و(الخطابية)، وهذا السبب في انقسام الشرع إلى ظاهر وباطن"، ومعنى ذلك أنّ القرآن الكريم يضرب الأمثال للناس وقد حملها على أن تكون ذات مستويات دلالية تراعي مستوى عقول المخاطبين، وهنا يستخلص معنى الظاهر والباطن، إذ يقول: "فإنّ الظاهر هو تلك الأمثال المضروبة لتلك المعاني، والباطن هو تلك المعاني التي لا تتجلى إلا لأهل البرهان" (ص 109-110).
وبهذا المعنى للظاهر والباطن يذهب ابن رشد إلى أنّ أهل الفلسفة هم الأجدر بتأويل مدلول القرآن الكريم باعتبار أنّ باطنه متعذر فهمه إلا على أهل البرهان، ويزيد في تأكيد جدارة الفلاسفة على بلوغ باطن النص في فهمه يقينياً، عندما يتحجج بالدفاع عنهم في المسائل التي كفرهم فيها الغزالي خاصة مسألة علم الله بالكليات، لا الجزئيات والمعاد وغيرها، ويزيد فيلسوفنا دفاعاً عنهم بأن يضع لهم مبرراً لأخطائهم إن اجتهدوا، في حين أنّ غيرهم غير معذورين في أخطائهم، ويستدل بنص من الحديث النبوي الشريف.
وخلاصة القول في هذا القسم إنّ ابن رشد قد أعاد إغلاق الدائرة برد الفلسفة إلى الدين (الشريعة) وصلة الوصل بين هاتين الفكرتين الأساسيتين ترد إلى تحديد مفهوم التأويل وإلى تقسيم الشريعة إلى باطن وظاهر، وكذلك إلى تحديد مستويات الخطاب فيها، وكان قصده من ذلك كله هو تبيين أنّ أهل الفلسفة (البرهانيين) هم أحق بأن يتأولوا النص القرآني، وهنا نجد أنّ ابن رشد قد حوّل الفلسفة إلى آلة لفهم مقصود الشرع في باطنه بطريقة برهانية لا يقدر على تأويلها إلا أهل الفلسفة، لما لهم من أساليب برهانية في فهم مدلول النص، وعليه فالفلسفة هي آلة فهم الشريعة.
القسم الرابع: مرتبة الفلسفة في علوم الشريعة
ويمكن أن نسمي هذا القسم بـ: "إبستيمولوجيا العلوم الشرعية" باعتبار أنّ الإبستيمولوجيا هي علم العلم أي المبحث الفلسفي حول العلم، وفيها يسعى ابن رشد نحو توضيح مكانة الفلسفة ضمن نسق العلوم الشرعية، وهذا بعد أن أكد أنّ خطاب الشريعة موزع على الناس كافة متلطفاً بمراتبهم في الفهم، ولهذا فإنّ أعلى مراتبهم تتجلى في البرهانيين، ولكن علوم البرهانيين أين محلها في مراتب علوم الشريعة؟
ومن هنا تجد الفلسفة نفسها ليست أمام الشريعة أو خلفها كما كان الحال في الأقسام السابقة، القسم الأول كانت الشريعة أمام الفلسفة تسعى للحكم عليها بأحكامها، وأما القسم الثالث فإنّ الفلسفة كانت تقف أمام الشريعة لتعلن أحقيتها في فهم باطن مقاصد الشرع، لكن هنا الفلسفة أصبحت جزءاً من علوم الشريعة.
ولهذا فإنّ الفكرة الناظمة لن تكون سوى من طرف واحد، وهو الشريعة ذاتها، والتي تتجلى في تحديد مقصد الشريعة، إذ يقول ابن رشد: "وينبغي أن تعلم أنّ مقصود الشرع هو تعليم العلم الحق والعمل بالحق، والعلم الحق هو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي عليه، .. والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة". وبالتالي فإنّ العلم الشرعي له مقصد تعلم العلم النظري والعلم العملي لأجل بلوغ السعادة.
ومن هذا المقصد التعليمي انقسمت العلوم الإسلامية إلى علم نظري وعلم عملي، والقسم الأخير إلى عمل ظاهر يُعنى بالعبادات الظاهرة، وجواني يُعنى بالبواطن كالشكر والصبر وغيرها من الروحانيات.
وكلّ هذه العلوم تقع ضمن صنفين هما: التصور والتصديق، والأخير إما برهاني أو جدلي أو خطابي، أما التصور فهو: إما بالشيء نفسه أو بمثاله، ولهذا فإنّ نظام المعارف الإسلامية يقوم على هذه الموجهات؛ وهي التصديق ومستوياته وطرقه، والتصور بنوعيه، فهذه الموجهات تؤول إلى ضبط طرق الخطاب الشرعي ومستوياته.
ولهذا نجد أنّ ابن رشد قد حدّد هذه المستويات والطرق في التصديق ليحدد لنا منزلة الفلسفة في علوم الشرع، ومنه منزلتها في المجتمع، وعليه تجب الإشارة إلى التحديد الرشدي للمنزلة العلمية ثم المنزلة الإجتماعية:
- المنزلة العلمية للفلسفة: والتي تقع في إحدى الطرق الأربع وهي:
1) الأقاويل اليقينية في مقدماتها ونتائجها والتي لا تحتاج إلى تأويل وهذه مشتركة
2) المقدمات اليقينية والنتائج الظنية، وهنا يتطرق التأويل إلى نتائجه
3) والثالث هو عكس سابقه، أي ظنية المقدمات يقينية النتائج، فيكون التأويل في مقدماته لا في نتائجه
4) والأخيرة أن تكون المقدمات فيها ظنية والنتائج ظنية، يطالها التأويل في كليتها، وهنا يرى ابن رشد أنها تخص طرق البرهانيين، وهي فرض عليهم ويمنع أن تمر إلى العامة.
وعلى هذا تتحدد مشروعية الاقتدار على التأويل، والتي لا ينالها كل الناس، من حيث أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: الخطابيون الذين يشكلون الأغلبية، ثم المتكلمون الجدليون وفيهم المتكلمون خاصة منهم المعتزلة والأشاعرة مع أفضلية المعتزلة، وأخيراً أهل التأويل اليقيني، وهم هنا أهل الصنعة أو الحكماء.
- المنزلة الاجتماعية للفلسفة: يجدر بنا الإشارة إلى أمر هام في سياق الثقافة العلمية الإسلامية وخصوصاً الفلسفة منها، التي دأبت على تقسيم المجتمع لا على أساس سيكولوجي كما هو الحال في عصرنا المعاصر، بل على أساس إبستيمولوجي (بمعناه العام)، من حيث تفاوت الناس في القدرة على الفهم وتحصيل طرق الإدراك الصحيح، وهذا ما نجده عند الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة الذي قسم الناس بحسب تفاوتهم في تحصيل الحكمة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الغزالي وابن باجة وابن طفيل
وهذا ما نجده عند ابن رشد، فقد قسّم المجتمع إلى ثلاثة مستويات بحسب طرق الإدراك لديهم من حيث قربها من اليقين أو بعده، فنجد البرهانيين والجدليين والخطابيين، وأمّا المسألة الاجتماعية التي تستدعي العلماء لحلها فتتحدد في البحث عن شروط وحدة المسلمين ودرء عناصر تفريقهم، لذلك وجب مراعاة أولاً: الفاعل الاجتماعي الأكبر وهو الشريعة من حيث هي الناظم الأساسي لشبكة العلاقات الاجتماعية، وثانياً: مراعاة نسب الإدراك، فالتأويل البرهاني يجب ألا يعطى للجدليين لكونه عصياً على إدراكهم، والتأويل الجدلي لا يفصح به إلى الخطابيين لكونه يتجاوز حدود إدراكهم، ومن هنا يمكن أن تحفظ للأمة وحدتها.
رابعاً: مآلات فصل المقال
إنّ لكتاب فصل المقال حضوراً استشكالياً في الفكر العربي المعاصر، لهذا وجب النظر إليه في أمرين: الأول النقدي، والثاني كيفية استحضاره في سجالاتنا المعاصرة، فالممارسة النقدية تهدف إلى الوقوف على العناصر القابلة لكي تنمو والعناصر الميتة غير القابلة للحياة، ومن هنا نمرّ إلى البحث في كيفية الاستحضار بعد تقديم النقد، ونزيد على ذلك ضرورة التحذير من أشكال الاستحضار التعسفي.
1- تقويم فصل المقال:
إنّ تقويمه لا بدّ أن يراعي أمرين كل منهما ينقسم إلى قسمين: فالأمر الأول متعلق بالبعد المعرفي وهو ينقسم إلى الأفكار الحية والميتة، والعنصر الثاني وهو سيسيولوجيا المعرفة وأقسامه كسابقه، وهذا التأطير لعملية التقويم يسمح لنا أن نقف على هدفية التقويم الذي هو عبارة عن نقد إيجابي يسعى نحو الهدم قصد البناء.
أ) تقويم البعد المعرفي: إنّ أهم عنصر في أطروحة الفيلسوف ابن رشد يتجلى في تعريف الفلسفة، من خلال جعلها فعلاً وإخراجها من كونها علماً قارّاً ثابتاً، حيث يسمح هذا التعريف بتوسيع دائرة الفلسفة لتشمل الإنسانية جمعاء، فيكون لها حظ التفلسف كما لغيرها كإمكانية فعل، وتتفاوت بقدر الاجتهاد فيها، وكذلك سيمسح بأن تحيا الفلسفة فينا على مقتضى معطياتنا الفكرية والمعرفية.
لكن النقيصة التي وقع فيها ابن رشد تتمثل في أمر أساسي وهو جعل المنطق أعلى آلة للعقل في فهم النص الشرعي، وهنا تناقض بين تحويل الفلسفة إلى فعل متعدد الأبعاد وواحدية الآلة، فما دامت الفلسفة فعلاً متعدداً فهي في جوهرها آلات، والدليل على ذلك يتخذ صورة زمانية ومكانية، أمّا المكانية فإنّ تعدد فعل التفلسف يتعدد بتعدد المنابع الثقافية، وعليه وجب تعدد آلات الفكر، فكما لأرسطو آلته فللمشرقيين آلاتهم كما انتبه إلى ذلك الشيخ الرئيس ابن سينا، وأمّا من حيث الزمان فآلات الفكر قد تتطور بتغير الزمان فتتفاضل وتتطور من طور إلى طور أكثر نضجاً، لكن ابن رشد لمّا ضيق آلات الفكر في حدود المنطق الأرسطي فقد قضى على سعة الفلسفة وحيويتها.
ويضاف إلى ما سبق تأكيد أحقية الفلسفة في فهم مدلول النص الشرعي بل جدارتها في ذلك، وهذه نكتة مهمة، وهذا راجع إلى طبيعة فعل التفلسف، من حيث أنه يسعى في البحث في نظام الكون، والقرآن الكريم كتاب هداية إلى هذا النظام، ولكن العلوم الإسلامية أغلبها لم يبحث في القرآن بوصفه هادياً إلى الكون وطريقة التعامل معه، بل نظروا بأساليب تجزيئية، فعلم الكلام أخذ من العقائد والفقه التشريع وانتهى التفسير إلى عملية فهم شرح ألفاظه، لكن ما يشمل كلّ هذا ويتجاوزه نحو دلائل القرآن على العالم هي الفلسفة.
ولكن ابن رشد كاد يقتل الفلسفة عندما جعلها أختاً للشريعة، ووضعنا أمام مساواة بينهما، وهذا تناقض، حيث أنه طيلة الكتاب وهو يجعل من الفلسفة جزءاً من الشريعة من حيث أنها تدعو إلى الفلسفة إما ندباً وإما وجوباً، ثم جعل منها جزءاً من خطاب الشريعة الذي يمسّ أهل الخطاب والجدل والبرهان الذين هم أهل الفلسفة والمنطق، ويخلص في النهاية إلى جعل الفلسفة أختاً للشريعة، وهنا يجب أن نشير إلى أنّ مقصد ابن رشد هو ليس المساواة بقدر ما هو جعلها عضداً لها من زاوية أنها آلة للشريعة، وهذه فكرة حيّة.
ب) تقويم البعد السيسيولوجي المعرفي: ويتمثل في علاقة المعرفة بالبعد الاجتماعي، وهي كما سبق عند ابن رشد تتحدد بمراتب ثلاث حسب جبلة الناس في الفهم والتي تتفاوت من شخص إلى آخر، لكن مشكلة ابن رشد أنه لم يبرهن على ذلك خاصة وأنه جعله فطرياً، لهذا فإنّ التقسيم الذي وضعه ابن رشد لا يقود إلى وحدة الأمّة بقدر ما يقود إلى احتكارها لدى طائفة محددة وهم الفلاسفة، أي أنّه سيخلق كهنوتاً فلسفياً يحتكر الحقيقة، والتي كان من الواجب أن تكون متاحة للجميع، ثم سرعان ما يناقض نفسه، إذ يقر بأنّ الشريعة تخاطب الجميع ثم يجعلها تمنح الحقيقة لطرف دون آخر علماً بأنّ الحق واحد، لهذا فإن اختلفت طرائق الشريعة في التبليغ إلا أنها تبلغ حقيقة واحدة، لهذا لا احتكار فيها للحقيقة ولا كهنوت في نص القرآن الكريم.
2ـ استحضار ابن رشد واستئناف مشروعه:
إنّ لكتاب فصل المقال امتدادات في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي المعاصر، وهنا يجب أن نستكشف كيفية حضور أو امتداد هذا الفيلسوف الذي عاش في أطر زمانية تختلف عنا، ونريد في الآن نفسه أن نستحضره في وقتنا هذا بمعطياته المستجدة من معارف وأطر اجتماعية وغيرها من المحددات الضابطة لطرائق تفكيرنا.
وإنه لمن أكبر الأخطاء التي نقع فيها اليوم هو عدم التمييز بين نص الفيلسوف بمحدداته الداخلية وبين استثمار مدلولاته في معالجة قضايا عصرنا، وهذا ما وقعت فيه العديد من القراءات العربية المعاصرة لمدلولات النصوص التراثية، خاصة منها ابن رشد والغزالي وابن خلدون، بل يزيد اللغط خاصة عندما نبحث عن مادية ابن سينا وماركسية ابن خلدون وتفكيكية ابن تيمية وفينومولوجية ابن حزم، إننا نجعل من الغزالي إسلامياً متطرفاً، ومن ابن رشد علمانياً معتدلاً!
هذا ما يصدق على قراءة الجابري لابن رشد، من حيث عدم تمييزه بين ابن رشد في زمنه وبين استثمار الجابري له لحل مشكلات واقعة في حاضرنا، وسنأخذ نصاً للجابري ونسعى إلى تحليله، "وموقف القبول بتلك العلوم، خاصة الفلسفة منها، كمرجعية تفسير الدين وتقديم الحقيقة..... وتعطي البراهين لما تقرر فيه من غير برهان. إنها الحداثة كما طرحت نفسها في العصور الزاهية في ثقافتنا، باعتبار أنّ الحداثة لا تعترف بمرجعية أخرى غير العقل" (ص48).
لو سألنا ابن رشد عن الحداثة لأصابته دهشة واستغراب من معنى الكلمة، بهذا يجب أن نعيد النظر فيما يحمله نصّ الجابري من تعسف في القراءة أو الاستثمار، فهو لم يكن يسعى إلى التفسير بقدر ما كان يسعى إلى توظيف ابن رشد في مشروعه الحداثي، وهذا أمر مشروع لكن شريطة أن يستوفي شرط نضج التفسير، فإن لم يتحقق ذلك صار التوظيف تعسفياً.
والجلي في طرح الجابري أنه بدأ نصه بحقيقة الاعتراف للفلسفة بالأحقية والجدارة بفهم الدين، وهذا كلام له حضوره في نص ابن رشد قد جعل من الفلسفة آلة من آلات الشريعة، وليست حاكمة عليها، أي أنها جزء منها، وهذا ما يظهر في كونه لم يشكك في الشريعة بل وصفها بالحق ثم جعل الفلسفة حقاً يضاف إلى حق ليؤازره.
وبعدها تحدث عن حداثة تجعل من العقل مرجعية وحيدة له، وهذا توظيف تعسفي لابن رشد حيث أنه لم يجعل مرجعية المجتمع هي العقل، لأنه يؤمن أنّ الناس متفاوتون فيه، بل جعل من الشريعة مرجعية للمجتمع لما تحمله من مقدرة على توجيه خطاب نحو أصناف الناس بمستوياتهم التي تختلف بحسب قدراتهم الإدراكية، ثم تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف، وهم: الخطابيون والجدليون وأخيراً البرهانيون.
خاتمـة
في خاتمة القراءة نستنتج أنّ ابن رشد قد تجاوز عصره، من زاوية أنه انتبه إلى أنّ الفلسفة فعل، ما يسمح لها بأن تتعدد زمانياً ومكانياً، وهذا ما يسمح لها أن تلج إلى المجال التداولي فيكون للمسلم حظه من إنتاج الفلسفة، وهذا مدخل مهم لنقل الفلسفة من التقليد للموروث الفلسفي اليوناني إلى الإبداع الفلسفي، من حيث منح الفعل رؤية تؤسسه وهي الرؤية المعرفية التوحيدية الإسلامية، للتحول نحو عملية هندسة العقل، لينتقل من النظر فيه إلى الظواهر، ليصل إلى النظر الآياتي ودلالتها على الخالق عز وجل.
ويمكن أن نستثمر تحويل الفلسفة من كونها علماً إلى فعل في حاضرنا هذا، من خلال عمليتين: الأولى تتمثل في نقد العقل العربي المنتمي في مقولاته إلى مساحة الفكر الغربي، فالفلسفة العربية إلى يوم الناس هذا ما زالت ترزح تحت طائل التقليد، لكونها ما زلت تأخذ بالفلسفة بوصفها مجموعة معارف منتجة داخل سياق الثقافة الغربية، هذا ما يجعلنا عالة على العالم لا إضافة نوعية، لأنّ كل ما نقوم به هو ترديد للكثير من مقولات الغرب، وهذا لا يزيد الإنسانية علماً، وأمّا العملية الثانية فتتمثل في إدخال الفلسفة إلى عالم القرآن الكريم واستكشافه في متنه، حتى نرتقي إليه فلسفياً ونكون إضافة نوعية إلى الإنسانية بأن نضيف إليهم جديداً صالحاً.
أبو الوليد محمد بن رشد: "فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال"، تحقيق محمد عبد الواحد العسيري، تقديم محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 3، 2002.
[1] الذي لم يلغ الفلسفة وإنما آراء الفلاسفة، لأنه قد عمل على تركيب الفلسفة مع علم الكلام، وهذا ما قاد إلى تحويل وجهة الفلسفة.
[2]ـ طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي، الرباط، بيروت، ط2، 2009، ص 19






