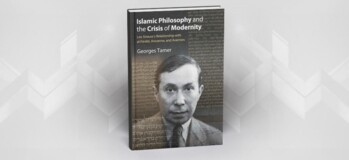فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي لــ: علي أمين جابر
فئة : قراءات في كتب
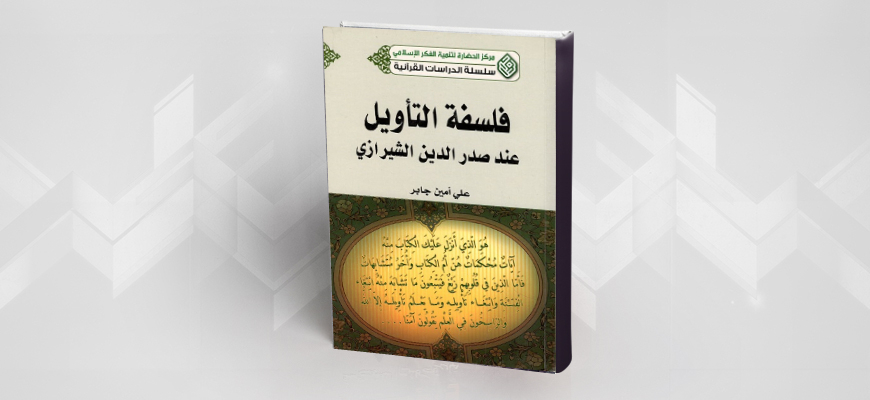
فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي[1]
لــ: علي أمين جابر
مراجعة: فتحي إنقزّو[2]
مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، سلسلة الدراسات القرآنية، بيروت، 2014، ط1، 592ص.
يأتي هذا العمل في أوان قد لا يكون متأخراً كلّ التأخير؛ فالمقام الذي بات للفيلسوف صدر الدين الشيرازي (المعروف بصدر المتألهين، أو المُلّا صدرا، ولد سنة 979/1571-1572، توفي سنة 1050/1640-1641) أغنى عن كلّ بيان، وفلسفته أشهر من أن تقدّم بكلمات معدودات. أما مذهبه في التأويل، فأمر حقيق أن تُعقد له المباحث والدراسات؛ ذلك ما اجتمع لصاحب هذا الكتاب وتيسر له: التأليف بين سيرة الرجل الفيلسوف العارف، وما لقيه من تصاريف الأيام، وتقلبات الأزمنة، وبين فلسفته التي امتزجت فيها مصادر الحكمة ومنابع العرفان من ميراث يونان إلى تعاليم فارس والحكماء المشرقيين، واستخلاص مقالته في التأويل من بعد ذلك، بمراتبها وقواعدها ومتونها، وما فتحت من الآفاق، وما هي بالمقالة الجزئية أو بالمنهج، وإنما هي فلسفة بالمعنى الأتم (ص13-14). خلاصة رؤية للإنسان والعالم والنفس والألوهية في تنضيد نسقي لا يتيسر إلا للقلة من العرفاء مّمن هم في رتبة حكيم شيراز، ولا سيما من معاصريه في الشرق من أبناء زمانه وحضارته، أو في الغرب ممن جرت العادة على مقارنته بهم: ديكارت، كانط، هيغل... من المحدثين؛ وديلتاي، هوسرل، هايدغر... من المعاصرين.
ذلك أنّ هذا الفيلسوف يكاد لا يُعرف اسمه إلا بالسماع، ولا تجد من قرأ متونه وتعرّف إلى فكره إلا القلة من المتخصصين، أو بعض من جاوز ذلك بقراءةٍ لنصوص من بعض أجزاء (الحكمة المتعالية)، وبعض الرسائل الفلسفية المتفرقة الأغراض المنشورة هنا أو هناك، في الوجود والمعرفة أو في النفس والعالم، أو بنظر في (تفسير القرآن الكريم) وقراءة خاصة لبعض السور والآيات تتخلّل عمله، أو لبعض التعليقات والشروح كـ(شرح أصول الكافي) (للكليني)، و(التعليق على شفاء ابن سينا)، أو على (حكمة الإشراق) للسهروردي، على عادة عصره في تدبيج النصوص على النصوص. ففي هذين المحورين تقع الإشكالية التأويلية بين مصادرها الفلسفية في التأسيس الأنطولوجي للتجربة العرفانية، ومصادرها القرآنية ذات النظم والقواعد والمطالب المعلومة. والحق أنه ليس بين الطرفين عند صدر الدين أيّة منافسة أو تدافع أو حاجة إلى التعديل؛ بل تماثل في البنية والمقصد، وتناسب في العناصر والمقومات، حيث ينتظم انقسام الوجود إلى ظاهر وباطن انقسام النص نفسه ومشاكلته للهيئة البشرية عامة: فالظاهر والباطن، والظهر والبطن، والسر والعلن؛ أمور تقع عندها المشاكلة بين القرآن وبين الإنسان، كما جاء في كتابه (مفاتيح الغيب) (ص15؛ وهو في الأصل مقدّمة تفسيره للقرآن)، وهي، في الوقت نفسه، مراتب معينة للفهم تقتضي ضرباً من التدرج والتوازي مما يحتاج إليه قيام التأويل، وكذلك ضرباً من الاستعداد الروحي لا يستقيم بغيره، هو استعداد من جنس التعلق «بروح القرآن ولبه وسره»، الذي «لا يدركه إلا أولو الألباب ولا ينالونه بالعلوم المكتسبة من التعلم والتفكر، بل بالعلوم اللدنية» (ص16 نقلاً عن مفاتيح الغيب، ص. 41). وهو موقف لا يقضي بالاستغناء عن المنهج وكأنه من أحوال النفس ومقامات الرّوح: فالتأويل عند صدر المتألّهين لا يستقيم بغير المنهج الأسلم له، «منهج الرّاسخين في العلم»، لا منهج الواقفين عند الظاهر من المشبهة، ولا منهج أرباب النظر والبرهان من المعتزلة والفلاسفة، ولا منهج التلفيق بين هذا وذاك، كالذي نجده عند الأشعرية، وبعض أهل الاعتزال (ص17-18)... هو منهج تتألف فيه عناصر ثلاثة: العنصر الفلسفي الحكمي والعنصر النصي الشرعي والعنصر العرفاني (ص19). وقد يكون هذا التألّف من الشرائط التي ترفع النظرية التأويلية عند صدرا إلى أفق كلي للفكر، تستجمع به ما تناثر من عناصر ومقومات لدى السابقين من الحكماء والمتصوفة والمتكلمين، وتنتظمه في قول علمي متين.
وقد يكون هذا الوجه، الذي قرأ منه المؤلف فلسفة الشيرازي، آيةً على أصالة الموقف الفلسفي الذي ينفرد به صدر المتألهين، ومكانة الغرض التأويلي منه؛ فقد جاء هذا الغرض في الدراسات الصدرية إما مبثوثاً في أغراض ومسائل أخرى، وإمّا مقصوراً على السياق القرآني دونما اقتضاء لأي أفق كلي. من هذه الجهة يمثّل هذا العمل استفادةً من الجهود التي اضطلعت بها الدراسات الكلاسيكية في فلسفة الشيرازي منذ أعمال هنري كوربان وتلامذته ورفاقه، وفي طليعتهم كريستيان جامبيه، وسيد حسين نصر، وكذلك أعمال باحثين مرموقين مثل العلامة طباطبائي وفضل الرحمن وجلال الدين أشتياني... والحق أنّ اتفاق هذه الطائفة من العارفين بفلسفة صدر المتألهين على مركزية الغرض التأويلي فيها أمر لا يرقى إليه الشك؛ فإنه غرض يتجاوز النطاق الصناعي لتطبيق القواعد في قراءة النصوص، ولا سيما النص القرآني، ليتصل برؤية عامة للوجود والكون والإنسان؛ ولعل مصادر فلسفة الشيرازي تشهد على ذلك: المصادر الشرعية في المقام الأول من كتاب وسنة (ص56-58)، وهي التي من شأنها أن تحرّر العقل من «ترهات المتصوفة» و«أقاويل المتفلسفة» على حدّ عبارته في (مفاتيح الغيب)، حيث ينتظم «علم الحديث» و«علم القرآن» آلية التمييز نفسها بين الظاهر والباطن، بين المجمل والمبيّن، بين المحكم والمتشابه؛ والمصادر الفلسفية، في المقام الثاني، الجامعة بين المشائين من الإسلاميين: الفارابي، ابن سينا، الخواجة الطوسي، وبين حكماء يونان: أفلاطون وأرسطو وفرفوريوس (ص61-67) وغيرهم من المتأخرين. أما في المقام الثالث فنجد التصوف والعرفان والإشراق (ص67-76): بين تنديدٍ ببطلان بعض الطرق والشطحات والمهاترات، وتمجيدٍ للتصوف النظري الرفيع، كالذي وجده عند محيي الدين بن عربي، وتعبيرٍ عن ثقة تامة بالمنابع العرفانية التي صدرت لدى أصحابها «عن معدن الحكمة ومشكاة النبوة ومنبع القرب والولاية» (ص70، نقلاً عن مفاتيح الغيب، ص 219)؛ يبقى المصدر الإشراقي في هذا المقام أعلاها مرتبة، ذلك الذي يمثله حكيم الإشراق شهاب الدين السهروردي، وقد وضع فيلسوفنا شرحاً شهيراً لكتاب (حكمة الإشراق) لعله مستلهمٌ من تعاليم الطوسي والمير محمد باقر الداماد، الشهير بالمعلم الثالث، وهو من شيوخ صدر المتألهين، وأعلاهم مقاماً. ولا يبعد أن تكون المسائل الإشراقية، ولا سيما المقالة المركزية في «نور الأنوار»، عمدة الميتافيزيقا الصّدرية، ومحورها العصبي.
أما المبنى الفلسفي لأثر الشيرازي، فلا يخلو من طرافة وابتداع محيرين في زمان متأخر كزمانه اعتقد فيه المؤرخون بأنّ باب الاجتهاد الفكري قد أغلق، وأن دورة الفلسفة قد خُتمت؛ فهو يتقوّم بأركان ثابتة تقوم عليها «الحكمة المتعالية» من أنحاء في النظر هي استكمال لطرائق المتقدمين، واستفادة من الجمع بين العنصر البحثي والعنصر الذوقي، بين التجريد العقلي والمكاشفة العرفانية (ص76-81)؛ ومن اصطلاح فلسفي مخصوص مناسب لهذا النمط من الحكمة ذات المنزع الأنطولوجي الصرف (ص81-84) المختلط بالمكاشفات والإشراقات؛ حتى لكأنّنا إزاء لغة يبتدعها صدر المتألهين هي «لغة متعالية» بعبارة المؤلف (ص92) تذكّر بحديث السهروردي عن «لسان الإشراق» في بعض كتبه، وإن تشكّلت من طبقات أو من درجات متفاوتة تصوراً واستعمالاً. ولعل هذه المطالب المنهجية واللغوية تجتمع في نطاق يوحّد بينها ما ذهب إليه الملا صدرا من «الممازجة بين طريقة المتألهين من الحكماء والمليين من العرفاء»، على حدّ قوله في (المبدأ والمعاد) (ص94)، فالكلّ عنده حاصل هذه الخلطة الطريفة بين عناصر ومواد يستنتج بعضها من بعض، ويتألف بعضها مع بعض في تركيب يراه مناسباً لمطالب الفلسفة المتعالية، وما تقتضيه من العبارة عن معانيها.
كلّ ذلك إنّما تبسّط المؤلف في عرضه على القارئ على سبيل التمهيد والتوطئة من أجل أن يتيسّر له الإقبال على الموقف التأويلي الأساسي في فلسفة الملا صدرا. فإذا هو موقف موزع منذ الفصلين الأول والثاني بين التفسير والتأويل: تفسير القرآن الكريم (ص107-136)، ومعاني التأويل التي من شأنه ووجوه الحاجة إليه وضرورته (ص141-235)؛ ليتفرغ المؤلف من بعد ذلك إلى بسط مقومات النظرية التأويلية: الأنطولوجية (ص237-367) والأنثروبولوجية (ص369-452)، لينتهي في ضرب من المسار الدائري إلى علاقة القرآن بالتأويل (ص453-531) هي بالجملة فصول مطولة وقراءات متأنية لمتن فلسفي محكم البناء من العسير على المرء أن يحيط بأطرافه، وأن يجمع لحاظه الإشكالية وأغراضه في دورة واحدة.
أما الابتداء بالتفسير فليس بمفروض من جهة السبق في الزمان، من أجل أنه انشغال فكري وروحي متأخر في حياة الملا صدرا في فترة اعتزاله وبعده عن الناس، وفي وقت اكتمل فيه نسقه الفلسفي، وتمتنت أركانه، فلم يبقَ له غير انتظار الإشارة ليقبل على «أمر عظيم وخطب جسيم» كما قال، هو «أمرٌ من آمر قلبي»، و«إشارةٌ من سرّ غيبي»... (ص109، نقلاً عن (مفاتيح الغيب)، ص. 2-3). ولا يخالف الشيرازي كثيراً من المفسّرين في التوطئة لتفسيره بمقدّمات نظريّة هي آلة منهجية تتعلق بما يسميه «مصادرات يتعاطاها علم التأويل، ومقدمات يعين فهمها على فهم معاني التنزيل» (م. م)؛ ولكنّ قارئ هذه التوطئة النظرية (التي يمثلها نص مفاتيح الغيب كمقدمة للتفسير الكبير. انظر: أسرار الآيات) سرعان ما يتبين له أنّ الأوليات، التي بسطها، ليست مجرد قواعد صناعية للتفسير، وإنما هي انعكاس لرؤيته الفلسفية، التي يتطابق فيها النص والوجود، الكلام الإلهي ونظام العالم في حركة دائبة مستمرة بين الأعلى (قوس الصعود) والأدنى (قوس النزول) شبيهة بالجدلية الأفلاطونية. ولا يخلو العمل التفسيري من استفادة من مصادر متنوّعة راجعة إمّا إلى الأدبيات التفسيرية نفسها (فخر الدين الرازي صاحب مفاتح الغيب، النيسابوري...)، وإما إلى الأخبار والروايات عن النبي وأهل البيت، وعن كتب السنة والشيعة سواء بسواء، ومقالات الفرق والنحل (الشهرستاني، الشيخ المفيد...)، ومصادر من الفلسفة والكلام والتصوف (ابن عربي، ابن سينا، الغزالي، الطوسي، السهروردي صاحب عوارف المعارف وسميه صاحب التلويحات...) في مزيج عجيب قلّ نظيره. ولا يقف تفسير القرآن عند نص بعينه، وإن كانت بعض النصوص معقودة له بأكملها؛ بل يتخلّل مؤلفاته كلها: (الحكمة المتعالية)، (المبدأ والمعاد)، (الشواهد الربوبية)، (المظاهر الإلهية)، وغيرها. فأمّا ما يتعلق بالمنهج فقد ضبط صدر المتألهين في نص من نصوص (مفاتيح الغيب) تصنيفية نموذجية لما سماه المقامات الأربعة «لأصحاب المسالك التفسيرية»: أولها «مسرف في رفع الظواهر كأكثر المعتزلة والمتفلسفة»؛ وثانيها «مقتر غال في حسم باب العقل كالحنابلة»؛ وثالثها «طائفة ذهبوا في الاقتصاد في باب التأويل ففتحوا هذا الباب في أحوال المبدأ وسدوها في أحوال المعاد [...] وهم الأشعرية أصحاب أبي الحسن الأشعري، وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا من صفات الله ما لم يؤوله الأشاعرة [...] ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد المتفلسفون والطبيعيون فأولوا كلّ ما ورد في الآخرة وردوها إلى آلام عقلية روحانية ولذات عقلية روحانية [...]»؛ رابعها هو خلاصة الموقف الذي يتبعه الشيرازي مخالفة للمقامات الثلاثة المذكورة: «أما الاقتصاد الذي لا يفوته الغالي ولا يدركه المقصر فشيء دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الراسخون في العلم والحكمة والمكاشفون الذين يدركون الأمور بنور قدسي وروح إلهي لا بالسماع الحديثي ولا بالفكر البحثي» (ص122 نقلاً عن مفاتيح الغيب، ص. 84-86؛ راجع: متشابهات القرآن) فالأمر، إذاً، مداره على الموازنة بين عناصر لا يجوز فيها الغلو ولا التقتير، لا من جهة الظاهر ولا من جهة الباطن؛ لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، وإنما هو كالحد اللطيف الذي يدقّ عن النظر، هو مقام الراسخين في العلم عملاً بالآية: "وَمَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ" [آل عمران: 2/7]، تلك الآية التي قرأها سلفه في المغرب، صاحب (فصل المقال)، القراءة نفسها، والتزم فيها الوقف نفسه بمعنى غير المعنى، وقصد غير القصد. على أنّ المؤلف ينبه، زيادة على هذا التوازن الدقيق بين عناصر المنهج التفسيري الصدري، إلى معنى رئيس يُراعَى فيه الاقتصاد في ربط الظاهر بالباطن ربطاً موزوناً بحسب نظريّة المطابقة بين العوالم: «فجميع ما في هذا العالم أمثلة وقوالب لما في عالم الآخرة، وما في الآخرة هي مُثل وأشباه للحقائق والأعيان الثابتة، التي هي مظاهر أسماء الله تعالى، ثمّ ما خلق في العالمين شيئاً إلا وله مثالٌ وأنموذجٌ في عالم الإنسان» (ص125، نقلاً عن التّفسير، ص. 154-155، انظر: ص. 138-139)، ويشبه أن يكون الاسم الصناعي لهذه المقالة هو «السنخية» في الاصطلاح الفلسفي للمشرقيين عامة، بوصفها قاعدة ضامنة لهذا التناسب الميتافيزيقي بين العوالم.
لذلك، تنبع الحاجة إلى التأويل من الحاجة الوجودية إلى حفظ الموازنة بين مراتب العالم، بين الظاهر والباطن، وبين قوى النفس: «العقل والقلب والخيال»، وبين مستويات العملية التأويلية: «الشريعة والطريقة والحقيقة»، في ضرب من التلازم بين معرفة «أسرار العبادات»، و«أسرار النفس»، و«أسرار الوجود» تباعاً (ص142). لذلك إنّ ضرورة التأويل قائمة من وجه على هذه البنية التناسبية الكونية، ولعلّها خليط من مأثورات المشرقيين والحكمة الفارسية العتيقة والأفلاطونية المحدثة، ومن وجه ثانٍ على لزوم التأويل من النص القرآني بوصفه ضرباً من التدبر الذي يدعو إليه وتدعمه الأحاديث والأخبار المنقولة؛ فالتأويل ليس مفروضاً على النص من خارج، وإنما هو جوهر النص نفسه من حيث تطلعه إلى المعنى ومخاطبته للنفوس واسترساله في ذلك مع الأزمنة بلا نهاية. إلى هذا الحدّ تبدو هذه الضرورة مبنيّة على مرجعيّة النص وحجيته المتعالية، حيث لا تظهر وجاهة التأويل في عمل الملا صدرا إلا بالقياس إلى تطبيقه على القرآن، ولا تُستخلص قواعده ومبادئه إلا من بنية النص وطبيعته والنصوص الحافة به من الحديث والخبر. على أنّ التوازن، الذي يحرص عليه صدر الدين، بين مختلف المقاربات وبين مختلف أوجه النص بناء على انقسامه الأصلي إلى ظاهر وباطن، أو ظهر وبطن، من حيث ضرورة حفظ الطرفين معاً بغير غلو ولا تقتير، لا يخفي ميل صاحب (الحكمة المتعالية) إلى طريقة العرفاء وأهل الكشف والمتصوفة، حيث يكون التأويل معراجاً يرتقي فيه العارف من مرتبة إلى مرتبة ومن عالم إلى عالم، ومن معنى إلى معنى، فإنّ الأصل في المعنى القرآني التكثر والتعدد والاختلاف دلالةً على معجزة الخلق، خلق الإنسان: «اعلم أنّ القرآن كالإنسان مقسم إلى سر وعلن، ولكلّ منها ظهر وبطن، ولبطنه بطن آخر إلى أن يعلمه الله، ولا يعلم تأويله إلا الله...» (ص145 نقلاً عن مفاتيح الغيب، ص. 39)، فلذلك حصل الانقسام بين التفسير الذي شأنه الظاهر من النص والتأويل الذي يختص بالباطن، وإن كان بينهما اشتباه وتداخل حيث يميل الموقف الصدري إلى اعتبار التأويل أشمل مصداقاً من التفسير لا من حيث يقف عند الدلالة المتداولة أي حمل الكلام على غير ما وُضع له، وإنما من حيث يفضي إلى الأخذ بالتأويل مأخذاً وجودياً، فهو لا يناقض الأخذ بالظاهر، وإنما يعبُر به إلى الباطن؛ كأنما الحركة التأويلية بهذا المنحى الوجودي الأنطولوجي استعادة للتجربة الصوفية للعبارة بوصفها عبوراً وجوازاً من طور إلى طور كما أبصر بذلك الشيخ الأكبر أحد الأعلام المبجلين عند الشيرازي. ولعل هذا المعنى قريب من التأويلية المعاصرة من حيث قيامها على تقدير العنصر اللغوي في بناء النص والمعنى (ص159-160)، وهو العنصر الذي لا يرى فيه صدر المتألهين مخالفة للطريقة الباطنية العرفانية التي يدعو إليها؛ فالتأويل كيفما قلبته إنما يؤخذ على جهة العبارة والتعبير (ص162). أما العُدّة اللازمة للعمل التأويلي، من حيث الشروط (ص169-179)، والأهلية اللازمة للقائمين به (ص179-187)، والأدوات (ص187-221)، والميادين (ص221-235)، فإنما مبدؤها ومنتهاها في النظام الكوني الشامل الذي تنضبط به المناسبة بين المقامات والجهات، وتتحدد به السبل والطرائق، وينتظم به شأن الناس عامتهم وخاصتهم.
والحقّ أنّ منعطف التحليل في هذا الكتاب لا يتبيّن إلا عند الفصل الثالث («الوجود والتأويل»)، الذي يختزن ماهيّة الموقف التأويلي ونواته الأنطولوجية الصلبة في فلسفة الملا صدرا، وما ينجم عنها من مصاعب ومشكلات لا نظير لها عند السابقين بوجه عام؛ ذلك أن العنوان نفسه موحٍ بهذه الصعوبة القصوى؛ بل كأنه يَعدُ بحديث عن أحد الفلاسفة المعاصرين ممن نجد عندهم تخريجاً أنطولوجيّاً طريفاً لمفهوم التأويل، ألم يُقارن الملاّ صدرا بهايدغر في مناسبات ومقامات عديدة؟ هل في مسألة الوجود عند صدر المتألهين ما يقتضي تأسيساً للتأويل؟ هل يعني ذلك خروجاً من نطاق النص وحدوده؟
تلك سؤالاتٌ قد تجول في خاطر قارئ هذا الكتاب وهذا الفصل منه بالذات، وهو الفصل المركزي بحجمه وأهميته، حيث يبدو الغرض التأويلي وكأنّه غير مستقلّ بنفسه مثلما كان الشأن لدى تطبيقه على النص القرآني، وإنّما هو متخلل لمفاصل نظرية الوجود بتقاسيمها وأبوابها ومكانتها التأسيسية من النسق الفلسفي للحكمة المتعالية ووجاهتها التي لا تنافسها فيها أي مسألة أخرى. فلذلك تظهر أولية مسألة الوجود في هذا المقام كما عبرت عنها مقدمة كتاب (المشاعر) بوصفها «أسس القواعد الحكمية ومبنى المسائل الإلهية والقطب الذي يدور عليه رحى علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح والأجساد» (ص237، نقلاً عن المشاعر، ص. 52). ولعلّ إسهام صدر المتألهين في هذه المسألة أعظم من أن يقدّر؛ فقد استخلص ما تناثر لدى المتفلسفة من قبل من أغراض أنطولوجية مفرقة لدى حكماء يونان، ولا سيما أفلاطون وأرسطو، ولدى الإسلاميين، ولا سيما ابن سينا والسهروردي، وطعمها بحدوس من ميراث العرفان والإشراق والحكمة الإلهية العتيقة، وخرّج مسائلها وأغراضها ونَظَمها نَظْماً شديد التماسك تتساوق فيه الحدوس والإشراقات مع المعاني والمفهومات. لذلك جاءت المباحث الفلسفية في الوجود في مطلع الرسائل والمؤلفات الكبرى لصدر المتألهين وكأنّها موضع البدء بإطلاق: في أول كتب (الحكمة المتعالية)، ومطالع (الشواهد الربوبية)، و(المبدأ والمعاد)، و(المسائل القدسية)، وغيرها من الرسائل. وقد جُمعت مسألة الوجود في مطالبها الكبرى في رسالة شهيرة هي (كتاب المشاعر) (التي نقلها كوربان إلى الفرنسية وقدمها إلى الجمهور الغربي). وبالجملة تدور هذه المطالب على تقرير معاني الوجود من حيث الحقيقة لا المفهوم؛ أي «المعنى الانتزاعي العقلي من المعقولات الثانية والمفاهيم المصدرية التي لا تَحَقّق لها في الأمر نفسه» (ص240-241، نقلاً عن الحكمة المتعالية، ج1)، وهو المعنى الذي يشير إلى الفعلية الخالصة والظهور والتحصّل بلا تقييد من كلية أو جزئية ومن عموم وخصوص وهي الحقيقة على الإطلاق؛ ثمّ الوجود على معنى التحقق العيني الذي يكون للماهية في الخارج بناءً على أصالة الوجود وتقدمه عليها، «... بمعنى أن الوجود هو الأصل في التحقق، والماهية تبعٌ له، لا كما يتبع الموجود للموجود؛ بل كما يتبع الظل للشخص والشبح لذي الشبح من غير تأثير وتأثر. فيكون الوجود موجوداً في نفسه بالذات والماهية موجودة بالوجود؛ أي بالعرض، فهما متحدان بهذا الاتحاد» (ص242-243، نقلاً عن الشواهد الربوبية، ج1، ص8).
هذه المعاني الأساسية للوجود تنتظمها في أنطولوجيا الملا صدرا جملة من المقومات التي اشتهرت بها وجعلتها مخالفة لتعاليم عموم المشائين من الإسلاميين، ولا سيما الشيخ الرئيس: منها البداهة والعمومية المطلقة، وأنه لا تعريف له؛ لأنه لا شيء أظهر منه وأجلى؛ ومنها كذلك «الاشتراك المعنوي» لا اللفظي الذي قال به بعض المتكلمين والفلاسفة، ومفاده «أن مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل تشكيك لا حمل تواطؤ» (ص246، نقلاً عن الحكمة المتعالية، ج1)؛ ومنها «أصالة الوجود» التي تُعدّ ركن الأنطولوجيا في فلسفة صدر المتألهين، وذلك في ضرب من الردّ على القول بنوع من أصالة الماهية عند أفلاطون والسهروردي وابن عربي، مستفيداً من إسهامات أرسطو والفارابي وابن سينا في الحدّ من غلواء التأويل الماهوي المثالي للوجود، رغم ميل الملا صدرا وانقياده إلى تجديد القول الأفلاطوني في المثل النورية تجديداً طريفاً على نهج شيخ الإشراق، وإن خالفه من قِبَل أخذه باعتبارية الوجود وتقدير الأصالة للنور، حيث يرى أنّ نظرية النور الإشراقية هي المرادف الحقيقي لنظرية الوجود (ص251)؛ ومن المقومات الفلسفية للوجود «التشكيك»، الذي يمثل صيغةً لحل معضلة الوحدة والكثرة وكيفية التعلق بينهما، ولا يتعين أن يؤخذ بالمعنى المنطقي المتداول، وإنما مفاده أن حقيقة الوجود ذات مراتب متفاوتة، وأن كل موجود في مرتبة أعلى يشمل المرتبة الأدنى منه، وهي مقالة استقاها الشيرازي من الحكمة الفارسية القديمة، ونجد بعض عناصرها في فلسفة السهروردي؛ ثم بعد ذلك «أقسام الوجود»، ومنها التقسيم إلى واجب وممكن، وإلى خارجي وذهني، وإلى مستقل ورابطي ورابط؛ يليها «وحدة الوجود» في موقف يمزج تعاليم صاحب الإشراق بتعديل نقدي لمذهب ابن عربي الشهير في هذا الغرض، حيث يحصل التساوق والجمع بين مقام الوحدة أو الحق ومقام الكثرة أو الخلق؛ وأخيراً «نظرية جعل الوجود»، وهي من تصرفات الشيرازي وابتداعاته التي تتعلق بنمط الصلة بين العلة والمعلول من حيث الخلق والإيجاد و«الجعلُ إمّا بسيط، وهو إفاضة نفس الشيء متعلقاً بذاته مقدس عن شوب التركيب، وإمّا مؤلف، وهو جعلُ الشيء شيئاً وتصييره إيّاه، والأثر المترتب عليه هو مفاد الهلية التركيبية الحملية، فيستدعي طرفين، مجعولاً ومجعولاً إليه» (ص272-273، نقلاً عن الحكمة المتعالية، ج1).
تلك هي البنية الصورية لمسألة الوجود بمقوّماتها وشرائطها وتقاسيمها الكبرى. أمّا مضمونها الميتافيزيقي، فيعقد له المؤلف القسم الثاني من الفصل نفسه، ويجعله تحت عنوانين اثنين: أوّلهما «الوجود الحق» من حيث هو الغاية القصوى من العلم الفلسفي وذروته؛ أي علم الربوبيات وعلم المعاد: معرفة الذات الإلهية، ومعرفة الأسماء والصفات (العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الحكمة، الكلام)، ومعرفة الأفعال؛ وثانيهما «العوالم والنشآت»، وترد بالضرورة في صيغة الجمع من أجل أنّ الأمر يتعلّق بمراتب ودرجات، وإن اختلف المتكلّمون والمتفلسفة في عدّتها، فقد وقف صدر المتألهين على ما استقرّ من تقسيم رباعيٍّ في المدرسة الإشراقية: العالم الربوبي، العالم العقلي، العالم المثالي، العالم المادي؛ يرجع في نهاية المطاف إلى تقسيم ثنائي: عالم الربوبية وعالم الإمكان. وهي ترتيبات دفعت الشيرازي إلى استعادة هائلة ومناظرة كبرى لميراث الفلاسفة القدامى وأتباعهم من المشائين خاصة وسائر الحكماء المشرقيين في نظام العالم، ولا سيّما في أساسه الأفلاطوني الأخير، وما يقتضيه من إصلاح واستئناف على ما تحكم به قواعد الكشف والعرفان. والحق أنّ هذه المادة الغزيرة، التي اجتهد المؤلف في قراءتها، وترتيب مسائلها ومواضعها لا تظهر دلالتها التأويلية للقارئ بما يكفي من الوضوح وهي الدلالة المحورية في مشروع الكتاب برمّته، ولو اقتفى أثر تحليلات عارفين مرموقين بالتراث المشرقي والصدري بالذات على ضوء فتوحات الفلسفة المعاصرة لظهرت له هذه الدلالة في مستوى فينومينولوجيا الخيال، وما تجعله لعالم المثال من الدور التوسطي العظيم في بناء الصور والأشكال العابرة للتاريخ، الأمر الذي يجعلنا نجد في فلسفة الملا صدرا فكراً حياً راهناً معاصراً لنا لا شك.
أما الوجه الإنساني أو الأنثروبولوجي -إن جازت العبارة- الذي يعقد له المؤلف الفصل الرابع من عمله، فيعبر عن جدلية الوجود البشري، أو عن ضرب مخصوص من التاريخية الواقعة بين نشأتين: نشأة أولى ونشأة آخرة. ولذلك انتظم القول في هذا الشأن على جهة المداولة بين حركتين شبه أفلاطونيتين هما «قوس النزول» و«قوس الصعود»، وبين مقامين يؤلّف طرفاهما حدود الوجود البشري في مبدئه ومعاده؛ أي «شؤون النفس» و«المعاد الجسماني». فالمبدأ الميتافيزيقي لهذه البنية هو التصوّر الدائري لنظام العالم: «... وكأن العالم كله كدائرة انعطف آخرها إلى أولها، إحدى قوسيه نزولية والأخرى صعودية، ولها نقطتان إحداهما نهاية أولاهما وبداية أخراهما وهي الهيولى، والثانية بالعكس وهو الإنسان الكامل، روح العالم، مظهر اسم الله وخليفة الرحمن...» (ص370، نقلاً عن أسرار الآيات، ص118). فالإنسان الكامل في قوس النزول يعني وجود نشأة أولى سابقة، وتَنزُّله إلى العالم الهيولاني، ثمّ اقتضاء الصعود والعودة إلى الأصل والعروج على المراتب كلّها، كلّ ذلك في استعادة لمنظومة التماثل والتناسب بين الكونين الأكبر والأصغر في التراث العرفاني والصوفي. على أنّ الإنسان يبقى في هذا التصور مركز الخلق وصورة الكون وغاية الكائنات جميعاً. أمّا «الإنسان الكامل»، المنحدر من تراث ابن عربي وصدر الدين القونوي وعبد الكريم الجيلي، فيمثل الأنموذج الأقصى لهذه الأنثروبولوجيا الإشراقية، التي أبصرت الدلالة الكونية للمقياس البشري لكلّ وجود بما في ذلك الوجود الإلهي، وهو المعنى الذي سيكون في قلب التأويلية الحديثة ومساعيها في تقدير الفهم على حسب ما يعطيه الوجود البشري من المعنى. وليس من دلالة لقوس الصعود غير هذه الحركة التجاوزية التي تكمن في باطن النفس البشرية وتحرّك تاريخها السري: من هبوطها من العالم الأعلى، وما يكتنفه من الرمزية البالغة إلى تشوفها الدائم إلى الجناب الأعلى والأوبة إلى الأصل. أمّا المضمون الفلسفي لهذه التجربة الواقعة بين التخوم والأطراف فمرجعه إلى النفس وشؤونها وتصاريفها، وقد صارت من أغراض العلم الإلهي لا العلم الطبيعي: فإنّ رأس هذه الشؤون «معرفة النفس» سبيلاً لمعرفة العالم والله، وذلك على نحو من الاستدلال الذي بادر إليه ابن سينا وأصّله السهروردي تأصيلاً عميقاً على إدراك الذات لذاتها بغير واسطة وثبوت وجودها بهذا الإدراك دون آلة من الجسم. ثمّ ما يقتضيه وجود النفس من التجرد والحدوث والبقاء واجتماع القوى لها، وغير ذلك ممّا يلتئم به العلم بها، وينتهي إلى غاياته القصوى -المعاد- وما حفّ به من الخصومات والمجادلات نجد آثارها ودلائلها في رسائل كبرى للشيرازي: (المبدأ والمعاد)، (الشواهد الربوبية)...
تنتهي هذه الدورة الطويلة، التي يعبر بها القارئ مقامات التأويل في فلسفة الشيرازي بما ابتدأت به: الحدث القرآني. وكأنّ البنية الدائرية مصير كلّ جهد تأويلي أصيل كما تنبّه لذلك أكابر العرفاء والمتصوفة قديماً وأعلام الهرمينوطيقا حديثاً. ولكنّ القرآن، في الفصل الأخير من هذا الكتاب، ليس هو قرآن الفصل الأول، وقد تكون المسافة الواجب قطعها بين التفسير بقواعده وشروطه وأهله وبين التأويل الذي ينتهي بعد المرور بالطورين الأنطولوجي والأنثروبولوجي إلى استعادة النظر في النص بوصفه الواقعة الكبرى، التي من شأن الإنسان والأفق الذي هو متطلّع إليه في أيامه وأعماله. كأنّما قدر العلاقة بالقرآن تأويلي كيفما أخذته؛ فهو منقسم، كما مرّ بيانه، إلى ظاهر وباطن، وحد ومطلع، وهو مُشاكل في بنيته العميقة للهيئة الإنسانية وللعالم بأسره، بما ينطوي عليه من التناظر مع المراتب والدرجات التي للوجود عامة، وللوجود الإنساني خاصة، وهو موزع بين «قرآن لفظي» في ظاهر شكله، وبين «قرآن آدمي» في حقيقته القصوى، بين قرآن وفرقان، أو بين جمع وفصل، بين صامت وناطق، بين كتاب وكلام. فالقرآن يجري على ما يجري عليه الوجود من وحدة وكثرة، من أسماء ومنازل، ومن مقاصد صارت بالتدريج من مداخل الفهم الكبرى للمعاني القرآنية لا على المستوى التشريعي كما هو شائع، وإنّما على المستوى التأويلي الأعمق المرتبط بنظرة قارئ الكتاب إلى الكون، وإلى نفسه، وهو الذي ينبغي للمرء أن يقرأه، كما قال شيخ الإشراق السهروردي، كأنّه نزل في شأنه.
لا شك في أن التأويلية الحقيقية للحدث القرآني إنما هي تلك التي تصيب جوهره؛ أي الكلام الإلهي، وأنحاء فهمه، والإقبال عليه، ودرك معانيه وحقائقه. لقد أبصر الشيرازي من مقامه أنّ «حقيقة التكلم إنشاء كلمات تامات، وإنزال آيات محكمات، وأخرى متشابهات في كسوة الألفاظ والعبارات»؟ (ص480-479، نقلاً عن المظاهر الإلهية، ص105)؛ فإنّ كلام الله، أو كلماته وكتبه إنّما هي الموجودات الصادرة عنه دون توسط أو استعداد على غير الصدور الذي يكون لكلماتنا بما بقتضيه من آلات ووسائط جسمانية، غير أن تجليات هذا الكلام وتنزلاته لا تكون إلا على مراتب ثلاثة: القرآن والفرقان والكتاب: الأول بسيط إجمالي، والثاني تفصيلي، وكلاهما من عالم الأمر. أما الثالث فمن عالم الخلق والتقدير وهو النازل على الأنبياء. وبالجملة، إنّ نظرية الكلام والكتاب والكتابة هي أنموذج لتصور الشيرازي لنظرية اللغة في بعدها التأويلي الكوني من حيث هي من سنخ الوجود عينه عاكسة للفرق الأنطولوجي الرئيس بين عالم الأمر وعالم الخلق، بين الوحدة الأصلية البسيطة وبين التكثر والتكوين والتفصيل. ولذلك كانت هذه البنية التأويلية للكلام قائمة على استنظام مقوماتها الأنطولوجية، التي تبتدئ «بتنزل الكلام الإلهي» وأطواره وأنحائه حتى يبلغ الزمان البشري الأرضي؛ ثم «مراتب الكلام الإلهي» من أعلاها إلى أدناها مروراً بالمرحلة الوسطى بحسب ما يكون الكلام مقصوداً بالذات أم لقصد آخر، الأمر الذي يحدد أنحاء الوحي وأنحاء تنزيله؛ وأخيراً «الحروف المقطعة»، التي في مطالع بعض السور، ما ينبغي لها من التأويل الذي يكشف أسرارها في منحى يتطابق فيه، عند صدر المتألهين، نظام الحروف في اللغة مع نظام الكواكب والأفلاك، لا يخفى انتشاره في أوساط كثيرة من تقاليد عُرفت بصوفية الحروف والأعداد في الشرق والغرب. كلّ هذه المعطيات أفضت بالمؤلف إلى استنتاج متوقّع مفاده أنّ ركن التأويل عند الشيرازي هو المطابقة بناء على التناظر الكوني-البشري بين الآفاق والأنفس، حيث تنتظم الحدود الثلاثة (القرآن، والإنسان، والعالم) بنية تماثلية عميقة هي من وجه موروثة عن تعاليم قديمة من التراث الفلسفي والروحي، ومن وجه ثانٍ مرتّبة بعناية وجهد كبيرين وأصالة فكرية مقارنة للأنساق الفلسفية الكبرى.
[1] - مجلة تأويليات العدد الأول
[2] جامعة سوسة – تونس.