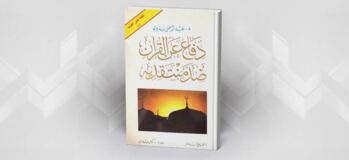فوزي البدوي: طروحات حول الاستشراق وتدريس المسألة الدينية في الجامعة
فئة : حوارات

الاستشراق نشأته وتطوره
د. نادر الحمامي: تسعى مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث إلى إجراء جملة من الحوارات مع أساتذة وباحثين مختصين في مجالات معرفية متعددة، وفي هذا السّياق العام يمكننا أن ننزل استضافة المؤسسة اليوم للأستاذ الدكتور فوزي البدوي، المختص في دراسة العلاقات الإسلامية اليهودية في العصر الوسيط، والأستاذ فوزي البدوي هو الآن أستاذ الدّراسات اليهودية والعربية بالجامعة التونسية، إذ أنّه يدرّس الدراسات اليهودية واللغة العبرية بقسم الأديان المقارنة بجامعة منّوبة، وهو صاحب أطروحة دكتوراه دولة، تصدر قريبًا، عن الجدل الإسلامي اليهودي باللغتين العربية والعبرية إلى حدود القرن العاشر للهجرة السادس عشر للميلاد، وبالإضافة إلى هذا الاختصاص المعرفي الدقيق فإنّ الأستاذ فوزي البدوي مهتم عمومًا بالدراسات الاستشراقية الكلاسيكية منها والجديدة، وقضايا دراسات الدين، وهو الآن رئيس تحرير مجلة الآداب العربية الصادرة عن معهد الآداب العربية (IBLA)، وهو عضو هيأة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية، وله في هذه المجالات العديد من المقالات والدراسات والترجمات حول تاريخ العلاقات الإسلامية اليهودية، وقد ترجم أيضًا أغلب النصوص المهمة التي كتبها المستشرقون أساسًا حول صحيفة النبي، أو ما يعرف اصطلاحيًّا بدستور المدينة، وانشغل أيضًا بقضايا تجديد المنهج في الدراسات الإسلامية ومسألة التعليم الديني في الجامعات، ونحسب أنّ هذه الاهتمامات تمثّل بالنسبة إلينا المحاور العامة التي سيدور حولها هذا الحوار مع الأستاذ البدوي الذي نرحّب به، ونستسمحه أثناء هذا الحوار بأن نقاطعه شيئًا ما حتى يكون في الحوار شيء من النقاش، ونحسب أنّ صدره سيكون متّسعًا لمثل هذه المقاطعات إن شئنا.
أستاذ فوزي البدوي مرحبًا بك
د. فوزي البدوي: مرحبًا
د. نادر الحمامي: كما كنت أقدّم الآن، من بين أهم المحاور أو الاهتمامات التي اهتممت بها كثيرًا، ترجمةً وكتابةً وبحثًا، مسألة الاستشراق بصورة عامة وإن شئنا في مسألة تقديمية، ربما، وتأطير عام، لو سمحت بتأطير عرض موجز حول تاريخ الاستشراق عمومًا وخاصّة فيما يتعلق بمراحله الأساسية.
د. فوزي البدوي: في الحقيقة يرجع اهتمامي بالاستشراق إلى مراحل تكويني الجامعي؛ حيث كنا نهتم بالاستشراق بحكم ما كنا ندرس من قضايا تهتم بالحضارة العربية الإسلامية، وتَبيّن لي حقيقةً أنّ هذا الاستشراق قد تغيرت ملامحه منذ السبعينات. الاستشراق الذي تربينا عليه تقريبًا هو الاستشراق الذي استمر إلى حدود الستينات، ويتميز هذا الاستشراق بخصائص على مستوى المنهج وعلى مستوى الاهتمامات والمضامين التي اهتم بها. هذا الاستشراق تربّى في مرحلته التي أسميها كلاسيكية، بالإسلام باعتباره حضارةً عظيمةً، ولكن هذا الاستشراق الذي تربى في أحضان المؤسسة الدّينية الأوروبية الوسيطة، وأيضًا داخل مؤسسة قليلاً ما اهتم بها العرب والمسلمون، وهي مؤسسة ما يسمى بدراسات علوم اليهودية؛ فجزء كبير من المستشرقين الذين عرفهم العرب والمسلمون كانوا من ذوي أصول يهودية بالأساس، وهؤلاء كانوا ينتمون إلى ما يعرف بحركة الأنوار اليهودية أو ما يعرف بـ "هاسكلا" (Haskalah)، وكانوا ينضمّون في ألمانيا وفي الدّول التي تتكلم اللغة الألمانية، مثل النمسا والمجر، فيما يعرف بــ "مدرسة علم اليهودية" يعني كل الأسماء التي نعرفها من جولد تسيهر (1850-1921م) وأبراهام جايجر (1810-1874م) وغيرهما. في الحقيقة هؤلاء هم سليلو مدرسة علم اليهودية التي ظهرت كنتيجة لحركة الأنوار اليهودية المتأثرة بحركة الأنوار الأوربية، طبعًا هناك مراحل مختلفة وطبقات مختلفة في هذه المدرسة.
د. نادر الحمامي: يعني هي ما يسمى، تحديدًا، اليهودية المصلحة أم شيئًا آخر؟
د. فوزي البدوي: هم جزء مما يسمى بالحركة اليهودية الإصلاحية؛ هؤلاء الذين اهتموا بالإسلام، أو بالدراسات الإسلامية، كانوا ينضمّون إلى ما يعرف بـ "علم اليهودية" أو ما يطلق عليه بالعبرية بـ "حكمة إسرائيل" أو الآداب اليهودية. هؤلاء، بحكم اهتمامهم الأصلي بتاريخ اليهودية، لأنّ اليهودية الإصلاحية أعادت النظر بتاريخ اليهود سواء بأوروبا أو بلاد المشرق والمغرب الإسلامي، وجدوا أنفسهم مهتمين، بحكم تخصّصهم في اليهودية، بأن ينظروا في تقبّل علاقتها بالإسلام، ومن هنا ظهر لنا هؤلاء المستشرقون الكبار ذوو الأصول اليهودية. إذن جزء كبير من هذا الاستشراق، الذي أسمّيه الاستشراق الكلاسيكي، تربّى في أحضان المؤسّسات الكاثوليكية أو البروتستانتية، ولكن، أيضًا، في جزء منه يعود إلى أصول يهودية، جمعت كثيرًا من المستشرقين ذوي الأصول اليهودية في هذا الإطار الذي أسميته بعلم اليهودية.
د. نادر الحمامي: أرجو المعذرة عن المقاطعة، ولكن، في الإطار الذي تحدثت عنه، هل هذا ما سيعطي لاحقًا هذا الصراع داخل الاستشراق نفسه حين يدرس تاريخ الإسلام ونشأة الإسلام بين اتجاهين كبيرين معروفين، سواء كانت في الدراسات القرآنية أو في محيط نشأة الإسلام، أي المحيط الديني تأسيسًا حول مسألة التأثيرات، هل كانت هذه التأثيرات أساسًا يهودية أو تأثيرات مسيحية؟
د. فوزي البدوي: بطيعة الحال هذا الاستشراق كانت إحدى مواضيعه الأساسيّة أو المفضّلة هي البحث في التأثيرات اليهودية والتأثيرات المسيحية أو النصرانية في الإسلام، وهذا جزء من عمل هذه المدرسة المتّسعة، ولكن، في الحقيقة، هذا الجزء الظاهر من الصورة. دعني أقول قبل كل شيء إنّنا مدينون لهذا الاستشراق بوجهيه المسيحي أو ذي الأصول اليهودية بالتعرف على الكثير من نصوصنا الإسلامية التراثية التي لم نكن نعرفها.
د. نادر الحمامي: تقصد مسألة التحقيق؟
د. فوزي البدوي: نعم التحقيق، فهذا الاستشراق الذي أسمّيه بالاستشراق الكلاسيكي له أياد بيضاء على الحضارة العربية الإسلامية من جهة التحقيق والترجمة والنشر، طبعًا هذا الاستشراق هو وليد الحركة الإنسانوية أو humaniste في أوروبا، واهتم بالنواحي الفيلولوجية وهذا ظاهر في الاستشراق الألماني؛ حتى أنّه من إحدى النوادر التي تروى عن المستشرق الألماني أوتو شبيز (1901-1981م) أنّه كان يقول: "لو أنّك سألت مستشرقاً ألمانيًّا عن عائشة من هي، كان سيجيبك على الفور بأنّها اسم فاعل مؤنث لفعل معتل العين"، وهذا دليل على غلبة هذه النّواحي الفيلولوجية على هذا الاستشراق. إذن من هذه الناحية فأنا لا أوافق الكثيرين ممن يهاجمون هذا الاستشراق، ويعتبرونه مرتبطًا بالاستعمار، فهذا جزء من الصورة في الحقيقة، ولا ينطبق على كل الاستشراق. فالاستشراق الألماني كان قليل الصلة بالحركة الاستعمارية، وأكاد أستعمل كلمة قليل هنا بمعنى "ليس" التي يستعملها الجاحظ عندما يصف أستاذه إبراهيم النظّام، عندما يقول إنّه كان قليل الزلل أي لا زلل له. إذن هذا الاستشراق الألماني انكب على الجوانب الفيلولوجية، وكانت له مساهمات كبيرة هذا الاستشراق الكلاسيكي؛ كانت له مسلمات كثيرًا ما تغافل عنها المسلمون والعرب بصفة عامة. صُوّر هذا الاستشراق على أنّه معاد للإسلام والمسلمين، وفي اعتقادي إنّ هذا الاستشراق لم يكن في جوهره معاديًا للإسلام والمسلمين، كما يُتصور ذلك، لأنّ الرجة الحقيقية ستأتي بعد ذلك. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقوله لأنّ هذا الاستشراق الكلاسيكي في الحقيقة كان يتقاسم والمسلمين الأطر الأساسية للمعرفة. كيف ذلك؟ هؤلاء المستشرقون الكلاسيكيون وسعوا من دائرة النقد لمسلمات الحضارة العربية الإسلامية، فوسّعوا دائرة النقد للحديث النبوي مثلاً، فإذا كان المسلمون قد أقروا بوجود كتب الصحيح وبعض الكتب الأخرى المتعلقة بالحديث والتي فيها الوضع، فهؤلاء راجعوا بعض القضايا وبعض الأحاديث وقالوا إنّ بعض الصحيح في القديم قد يكون فيه بعض الاعتراضات، فهم وسّعوا من دائرة النقد في باب الحديث النبوي ولكنهم قبلوا المسلمة التي تقول إنّ جزءًا من الحديث النبوي صحيح.
د. نادر الحمامي: ألا يتنزل هذا في إطار تقليد معرفي طغى في زمن الاستشراق الكلاسيكي، أقصد هذه الصبغة الوضعية أو حتى الوضعانية التي ربما يلتقي فيها التراثان أو الاتجاهان الاستشراقي من ناحية والإسلامي من ناحية، وهو ما أُوّل إلى الثقة بالكثير من الأخبار التي لا تصمد اليوم أمام النقد التاريخي في كثير من الأحيان، ثم من ناحية ثانية كتاب أبراهام جايجر مثلاً الذي ترجم إلى الإنجليزية ترجمة عجيبة، حيث ترجم تحت عنوان "الإسلام واليهودية" في حين أنّه في الأصل "ماذا أخذ محمد عن اليهودية؟" وهو الأصل الألماني، فإذا كانت هذه هي الترجمة فكأنّها غطت على هذا الاتّجاه، ثم إنّ هذا الكتاب لم يكن في الأصل بحثًا في الإسلام وإنّما هو في إطار هذه اليهودية الإصلاحية، وعرضيًّا تم الوصول إلى الإسلام.
د. فوزي البدوي: فعلاً، ولكن أردت أن أبين، أيضًا، أنّ المسلمين قليلاً ما انتبهوا إلى هذه المعطيات بمعنى أنّهم كانوا يهاجمون هذا الاستشراق دون أن يتفطنوا إلى أنّه، في العمق، يتقاسم الأطر الفكرية معهم، ووسع هذا الاستشراق نقده للنص القرآني، وأعاد ترتيب السور؛ فقد أعاد النظر في مسألة القراءات، لكنه لم ينف أنّ هذا النص القرآني هو نص معاصر للنبي، وأنّه نص حقيقي وصحيح ويعتمد عليه.
د. نادر الحمامي: إذن هذا هو ما سار عليه إنجيل الدراسات القرآنية يعني كتاب تاريخ القرآن لثيودور نولدكه (1836-1930 م)، الذي كانت نواته حول صدق نبوة محمد، وربما نجد أصلها في كتاب أبراهام جايجر.
د. فوزي البدوي: فعلاً، ولكن يجب أن يتذكر الجميع أنّ هذا الكتاب، الذي صدر في بدايات القرن ما قبل الماضي (1860م)، لم يترجم إلى العربية إلا مؤخرًا، على الرغم من أنّ هناك محاولات أولى لترجمته في مصر، ولكنها فشلت، ووجب انتظار حوالي القرن لكي نجد هذا النص مترجمًا إلى العربية عن طريق مؤسسة ألمانية وهي مؤسسة كونراد أديناور، وهذا دليل على أنّ هذا الاستشراق الكلاسيكي وجد صعوبات كبيرة في أن يتلقاه العرب والمسلمون، ولم يتفطنوا إلى أنّه في العمق لا يعارض تصوّرهم، وإنّما هو كما كان يقول القدامى يوسّع من دائرة العلّة، أو يوسّع من دائرة المباح.
د. نادر الحمامي: ثم إنّنا، بعد التأمل الدقيق في كتاب نولدكه، لا نجد اختلافات جوهرية فيما يتعلق بترتيب السّور ترتيبًا تاريخيًّا، وهو مشغل قديم عن الترتيب حسب النزول للسيوطي، أو كما بينه ابن النديم إلى حد أنّني أذكر أنّ باحثًا سمى نولدكه "الشيخ نولدكه" لأنّه في الحقيقة لم يأت بأشياء خارجة عن الأفق الإسلامي القديم.
د. فوزي البدوي: فعلًا، الكثير منهم لا يختلف جوهريًّا عما وضعه أبو بكر عبد الله السجستاني في كتابه "المصاحف"، أو غيره، يعني المهم أنّ هذا الاستشراق يتميز بهذا المعطى الأساسي، وهو أنّه ليس مناهضًا في جوهره لما استقر عليه رأي الإسلام والمسلمين من ناحية، ثم إنّ هؤلاء المستشرقين يتميزون بخصيصة أخرى وهي تضلّعهم في التّكوين العربي الإسلامي الكلاسيكي؛ فأغلب هؤلاء المستشرقين، وهو أمر سنفتقده بعد ذلك، درسوا اللغة العربية، ودرسوا لغات الإسلام الثلاث العربية والفارسية واللغة التركية، وجلسوا في الأزهر لدى شيوخ الأزهر، وفي الحوزات العلمية في إيران، وكانوا يتمتعون بتكوين كلاسيكي جيد، ويكفي أن نتذكر مسار لوي ماسينيون (1883-1962م) مثلاً، وريجيس بلاشير (1900-1973م) وكثير من المستشرقين الذين ينتمون إلى هذا التيار الكلاسيكي، فهذا التيار الكلاسيكي متشبع بالعربية، ومتبحر في لغتها، وهو أيضًا يقاسم المسلمين الأطر الأساسية للمعرفة، ولا يختلف عنهم إلا في توسيع دائرة نقد هذه المصادر الإسلامية، والأمر الثالث أنّ هذا الاستشراق قد انخرط في البحث عن الأصول، والبحث في مدى تأثير الإسلام وتأثير المسيحية في الإسلام، والبحث في ذلك سواء في مسائل اللغة أو مسائل الدين أو غيرهما، وهذا الأمر سيتوقف بعد ذلك...
د. نادر الحمامي: قبل هذا التوقف، لأنّنا سنصل إلى لحظة حاسمة لاحقًا، الاستشراق الكلاسيكي، وأذكر أرنست رينان (1823-1892) الذي جاء بعد هذه المرحلة، وهو ينكر، في الفصل الذي خصصه للإسلام، أن يكون الإسلام قد تأثّر فعلاً بالمسيحية أو باليهودية، وأنّ التوحيد الإسلامي هو توحيد ساذج وتطور داخلي في الإطار العربي... ربما تكون نظرته متأتية من استعلاء ومركزية غربية في ذلك الوقت، في حين أنّ هؤلاء الأعلام الذين ذكرتهم، من الذين أقرّوا بهذا التأثير المسيحي أو اليهودي، كانوا يضعون الإسلام في إطار هذه الدائرة الدينية الكبيرة، ومن حيث شعروا أو لم يشعروا لم يقوموا بعملية تهجين الإسلام، وإنّما قاموا بدراسته من زوايا ليست تقليدية، فقط بالنسبة إلى المسلمين في ذلك الوقت، على الأقل.
د. فوزي البدوي: بالنسبة إلى أرنست رينان، فالحقيقة أنّه ينتمي إلى جزء من الاستشراق الذي يتكلم بأكثر حدّة، لا ننسى أنّ أرنست رينان، وهو أحد رموز الاستشراق الفرنسي، هو بالأساس معاصر للفكرة التي كانت شائعة آنذاك؛ وهي فكرة التّطوريّة، وأنّه كان يستهدف الفكر السّامي بصفة عامة، ففي الواقع هو لم ينقد الحضارة العربية الإسلامية فحسب، وإنّما انتقد أيضًا اليهودية، وكان يعتبر الحضارة السّاميّة أقل درجة أو أحط درجة من الحضارة الأوروبية. وهذا جزء من الاستشراق ولا ينحصر فقط في الاستشراق الفرنسي. يُلام على الاستشراق أنّ جزءًا منه كان متمركزًا على أوروبا، وهذا صحيح وفيه نبضات عنصرية أيضًا، ونبضات استعمارية، وهذا مما لا شك فيه، ولكن يجب أن نذكر دائمًا أنّ هذا ليس كل الاستشراق. وليس هو ما يبقى من الاستشراق. إنّ ما يهمّنا أو ما يهمني شخصيًّا، على كل حال، من الناحية التقييمية ومن الناحية التاريخية، هو أنّ الاستشراق ترك لنا مسائل مهمّة من تحقيق التراث ونشره، وعرّفنا بنصوص كنا نجهلها؛ فمقدمة ابن خلدون هي إحدى النصوص التي نحن ندين فيها للاستشراق بأنّه أظهرها لنا. وهذا الاستشراق، كما قلت، في عمقه ليس مناهضًا لمسلمات الفكر العربي الإسلامي، فهؤلاء المستشرقون في جزء منهم كانوا من ذوي ثقافة إسلامية وعربية ولغوية تركية وفارسية متبحرة، وهو أمر سنفتقده في مراحل لاحقة من الاستشراق.
د. نادر الحمامي: وأنت تتحدث، خطرت لي فكرة تتعلّق بأنّ هذا الجزء من الاستشراق مهم فقد حقق لنا النصوص، وربما عديدة هي النصوص التي وصلتنا عن طريقه، ولكن في هذا الخط الثاني، الاستعماري التحقيري التهجيني، ألا يلتقي مع بعض الأفكار الإسلامية الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات المسيحية أو اليهودية أو غيرها التي تنكر تمامًا أن يكون الإسلام متأثرًا بمحيطه، فنظرة أرنست رينان لا أعتقد أنّها تختلف جوهريًّا مع نظرة العقاد على سبيل المثال؟
د. فوزي البدوي: لا، في الحقيقة يجب الحفاظ على جزء من الدقة في هذه المسائل، ليس الأمر على هذه الكيفية، ولكن أقول بأن هذا أمر لا يخص المسلمين التقليديين، ولكنه شاع تقريباً في كل أوساط المتدينين في كل ديانات العالم تقريبًا، وهو كيف يفهمون نشوء الأديان أو ظهور الأديان، فجزء كبير من هؤلاء التقليديين يفهمون نشوء الأديان على أنّه عملية انبثاق من لا شيء، تاريخ الأديان يعلمنا أمرًا أساسيًّا؛ وهو ما عبّر عنه لافوازيي في تاريخ العلوم عندما قال (Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.) "لا شيء يضيع، كل شيء يتحول"، إذن حتى في مجال الأديان يجب أن يفهم المتخصصون أو الذين يدرسون هذه المسائل للناشئة، أنّ الأديان تتناسل بعضها من بعض، وليس هذا عيبًا في الدّيانة، ربما في هذه الكيفية أفهم ما جاء في القرآن "هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى" أنّه لا يضير الدين (الإسلام أو المسيحية أو اليهودية) أن يكون إعادة نظر وتدبر للرصيد السامي المشترك، فكل هذه الأديان قد أعادت استثمار هذا الرصيد السامي المشترك، وهو ما حوّلها من الفرقة إلى الكنيسة، وهذا موضوع مهم في الحقيقة في تاريخ الأديان. ماهي الشروط التي تجعل بعض هذه الفرق الصغيرة تتحول إلى أديان، وبعضها الآخر يبقى في مستوى الفرقة، ولا يتطور إلى مرحلة أعلى، أي مرحلة الديانات. هذا مدخل مهم في علم اجتماع الأديان مارسه الألمان بتوفيق كبير منذ القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر بالخصوص، وبيّنوا أهمية أن ينظر تاريخ الأديان إلى هذه الدّيانات من زاوية النظر هذه.
د. نادر الحمامي: إذن ما يمكن تأكيده أنّه يجب التمييز في هذا الاستشراق الكلاسيكي بين صنفين كبيرين؛ من انتمى إلى هذه العقلية العامّة أو الرأي الشائع حول الاستشراق، من كونه نتيجة الإمبريالية الاستعمارية إلى غير ذلك، ولكن لا ينبغي أيضًا أن نغمط حق، أو استحقاق، هذا الاستشراق في العديد من النّصوص التي وصلتنا بفضل لغة هؤلاء المستشرقين وأبحاثهم التاريخية والفيلولوجية، وتحقيق النصوص إلى غير ذلك. هذا مهم بالنسبة إلى الاستشراق الكلاسيكي، ولكن هناك أمر، وأنت تحدثت عن الانتقال إلى المسألة الفرقية، وأنا أذكر تلك المقالات أو المباحث حول الوسط الفرقي، مما قد يحيلنا على نقطة أساسية وجوهرية أتت بعد هذا الاستشراق الكلاسيكي، وأقصد تحديدًا سؤالاً بصفة مباشرة؛ متى تم المنعرج الحقيقي في هذا الاستشراق الذي قام على أنقاض الاستشراق الكلاسيكي؟ ماهي اللحظة التي أخذ فيها الاستشراق اتجاهات أخرى أبعدته عن الناحية المعرفية التحقيقية الفيلولوجية؟ وربما سيكون هذا منطلقاً لنقطة ثانية في الاستشراق، أحسبها مهمّة، وتتعلق بما يسمى بالاستشراق الجديد، أي ما يسمى الاستشراق الأنجلوسكسوني تحديدًا.
د. فوزي البدوي: بقي أن نشير بعجالة، كما يقال، إلى أنّ هذا الاستشراق، في صنفه أو في قسمه المتعلّق بالناحية الاستعمارية أو الإمبريالية، قد دُرس بما فيه الكفاية، وأحسب أنّ ما كتبه إدوارد سعيد وما كتبه أنور عبد الملك وغيرهما، قد كشف آليات السّلطة والمعرفة، وصرف المسلمون والعرب وقتاً كبيرًا في هذا الجانب، وأحسب أنّ هذا ليس الجانب المهم أو الذي نحتاج أن نتدبره في المستقبل.
د. نادر الحمامي: إذن فالجانب المهم هو إشارتك الضمنية إلى هذا المنعرج الأنجلوسكسوني الذي سنتوسّع في الحديث حوله في المحور الثاني من هذا الحوار.
المنعرج الأنجلوسكسوني
د. نادر الحمامي: تشهد أواخر ستينات القرن العشرين كتابات تقوم بنقد الاستشراق، وتصل إلى الحديث عن أزمة الاستشراق، هنا أشير تحديدًا إلى كتابات أنور عبد الملك في موفّى الستينات، والذي سيليه الاسم الأشهر إدوارد سعيد (1935-2003) بكتابه "الاستشراق" (Orientalism)، في تلك الفترة نفسها سيحدث المنعرج الاستشراقي الأنجلوسكسوني، بظهور الاستشراق الجديد بأعلام سيكون لهم أثر كبير في تحول مسار الدراسات الاستشراقية، أقصد أعلامًا من قبيل مايكل كوك (Michael Cook 1940-)، وباترسيا كرون (Patricia Crone 1945-2015) من خلال الكتاب المشترك بينهما: Hagarism: The Making of the Islamic Word (1977)، وكتاب كرون Meccan Trade and the Rise of Islam (1987). هذا الاستشراق سيسبب الكثير من الإشكاليات في الدراسات العربية بالخصوص تجاهه نظرًا إلى ما طرحه من قضايا بمناهج أخرى غير المناهج التي دأب عليها الاستشراق الكلاسيكي، وسبّب ما يمكن أن نسميه عسر هضم لما طرحه هذا الاستشراق الجديد.
كيف تنظر أستاذ فوزي إلى هذا المنعرج الاستشراقي في سبعينات القرن العشرين بالخصوص؟
د. فوزي البدوي: فعلًا، هذا منعرج، وربما هو أخطر المنعرجات في تاريخ الدراسات العربية الإسلامية وتاريخ الاستشراق عمومًا؛ وكنت قد كتبت مقدمة لكتاب الباحثة آمنة الجبلاوي التي درست هذا الاستشراق الأنجلوسكسوني، وكتبت هذه المقدمة وأسميتها "من هنا نبدأ" استلهامًا من الكتاب الشهير لخالد محمد خالد، هذا الاستشراق الجديد يمثل قطيعة مع ما عهدناه، ولكن الضجة التي أثارها إدوارد سعيد والتي استمرت لسنوات ربما غطت على ما كان يحدث في بعض الجامعات. حقيقة لنقل منذ البدء إنّ الدراسات الإسلامية اليوم، أو أساس الدراسات الإسلامية، موجود فيما أسميته بمثلث الدراسات الاستشراقية، وهذا المثلث هو في ثلاث جامعات؛ وهي جامعة برنستون الأمريكية، وجامعة أكسفورد البريطانية، والجامعة العبرية في القدس المحتلة. فالدراسات الإسلامية، أو ما يسمى بالدراسات الجذرية أو الراديكالية، منحصرة في هذا المثلث. والجامعات الفرنسية والجامعات الألمانية، في جزء منها على الأقل، هي بصدد التأثر بهذا الإنتاج الذي بدأ في هذا المثلث الخطير إلى الآن. يعني أنّ الدراسات المعمقة في هذا المجال نجدها محصورة في هذا المثلث وتصدر عنها مجلتان أساسيتان في الدراسات العربية والإسلامية: المجلة الأولى هي (Bulletin Of School Of Orientalism And Asian Studies) والمجلة الأخرى هي مجلة تصدر في إسرائيل وهي بعنوان (Jerusalem Studies in Arabic and Islam). يعني أنّ هناك مثلثًا بحثيًّا، وهناك هاتان المجلتان وغيرهما لعرض الأفكار.
لماذا حدث المنعرج؟ لم تكن الجامعات العربية مؤهلة بما يكفي لقبول إنتاج هذه المدرسة، ولذلك نلاحظ رفضًا لدى كل الجامعات ولدى أغلب المختصين، لما كتبته هذه المدرسة، قليلاً ما تعرضت بعض النخب العربية، في مجال الدراسات الإسلامية التاريخية والفلسفية والدينية، إلى هؤلاء، واكتفى بعضهم بالإحالة عليهم في هوامش الكتب، أو أنّه اعترض على ما ذكرته هذه المدرسة جملة وتفصيلًا. فكيف نفسر هذا الإعراض؟
د. نادر الحمامي: ولكن رفض هذه المدرسة لم يأت فقط من المدراس العربية والإسلامية في المجال العربي والإسلامي، ولكن حتى في الجامعات الأوروبية الغربية أيضًا، فقسم من المدرسة الألمانية اليوم يرفض هذا الطرح الذي تقدمه الدراسات الأنجلوسكسونية، ويفند ما وصلت إليه من نتائج، بل إنّ كتاب باتريسيا كرون (Meccan Trade and the Rise of Islam) خاصة لقي العديد من المعارضات، وهنالك العديد من المقالات التي تسعى إلى تفنيد أطروحات كرون خاصة في هذا الكتاب أكثر من كتاب Hagarism)) مع مايكل كوك.
د. فوزي البدوي: فعلاً، كلنا يعرف الرفض الذي لقيته كتابات هذه المدرسة من مؤرخ مثل سيرجن (Sergeant) ومثل المستشرق الألماني فان اس (Van Ess) لسبب بسيط هو أنّ هؤلاء ينتمون إلى ما أسميناه منذ قليل بالاستشراق الكلاسيكي.
د. نادر الحمامي: إذن فالكلاسيكية ليست حقبة زمنية؟
د. فوزي البدوي: لا، الكلاسيكية هي طريقة في التعامل مع هذه النصوص الإسلامية، بعبارة أخرى أنّنا يمكن أن نجد اليوم وغَدًا، من مازال يسير وفق هذا التصور الكلاسيكي وهذا الاستشراق الكلاسيكي، المشكلة هي في كيفية النظر على مستوى المنهج إلى هذا التراث العربي الإسلامي، وهذا هو مظهر الجدة في المدرسة الأنجلوسكسونية التي سأحاول أن أبين ما هي الأسس التي تقوم عليها.
أولاً هذه المدرسة تعيد تذكيرنا بالبديهيات على مستوى المنهج، تلك البديهيات التي يتجاهلها الكثيرون وهي أنّ مصادرنا الإسلامية في الأعم الأغلب هي مصادر ترجع بالأساس إلى القرن الثاني ما بعد حركة التدوين التي يبدو أنّها بدأت حوالي سنة 127هـ قبيل سقوط الدولة الأموية، وعندما نذكر بالبدايات نقول: إنّ هذا التدوين ليس كتابة، التدوين هو حركة أشمل، حركة رسمية تحت إشراف الدولة، وهناك انتقال من الشفوية إلى الكتابة، ودخول مجموعة بشرية في مجال الفعل التاريخي، أو العقل الكتابي الذي تحدث عنه جاك غودي (Jack Goody)، وهو تمامًا ما تحدث عنه الجاحظ في "البيان والتبيين" عندما رصد هذا التحول في تاريخ العرب عندما قال "واللسان أكثر هذرًا والخط أبقى أثرًا"، فهم الجاحظ أنّ هناك تغيرًا في هذه الحضارة العربية الإسلامية.
د. نادر الحمامي: وربما نجد أثرًا لذلك فيما كتبه ابن عبد البر أيضًا في "جامع بيان العلم وفضله".
د. فوزي البدوي: هذا التدوين استنتجت منه هذه المدرسة مبدأً، أو فكرةً، يجب أن يتذكرها الباحثون دومًا وأبدًا؛ وهي أنّ المسلمين قد دونوا ما اعتقدوا أنّه وقع، أو هم دونوا ما أرادوا أن يعتقدوا أنّه وقع، أو هم دونوا ما أرادوا لأبنائهم ولغيرهم من الشعوب المحيطة بهم أن يعتقدوا أنّه وقع، وهذه الجملة مهمة جدًّا في فهم مظهر الجدة في هذه الحضارة، بمعنى أنّ هذه العملية هي عملية انتقاء وغربلة وتهذيب، وقُدت هذه النصوص وفق أغراض سياسية واجتماعية وتاريخية... هي مجال البحث التاريخي والديني.
د. نادر الحمامي: إذن هي في إطار نظريات ما بعد الحداثة في الكتابة التاريخية؟ أي دور المؤرخ في كتابة التاريخ وتدخله في تمثلات مخصوصة يريد من خلالها تثبيت عقائد ما أو فكرة ما أو صياغة التاريخ أو صناعة التاريخ؟
د. فوزي البدوي: من بعض الوجوه نعم، وفعلًا، هي صناعة التاريخ، المشكل أنّ بعض من قرأ للمدرسة الأنجلوسكسونية، توقف عند بعض النتائج الجزئية حول التجارة المكية وحول نقاط أخرى ولكن نسي الجوهر الأساسي في هذه المدرسة، فباتريسيا كرون في كتابها (Slaves on Horses) كانت تقول: "هذا كتاب كتبه كفار لكفار أمثالهم"، فهم يكتبون بلغة إنجليزية راقية، ولديهم روح استعلائية في الكتابة، وربما هذا الاستعلاء هو الذي نفر منهم الكثير من العرب. ولكن أقول إنّ هذه المدرسة أعادت التذكير بهذه النقطة الأساسية، لأنّها عظيمة الأثر في النتائج التي ستظهر بعد ذلك. المسلمون والعرب الذين قرأوا ذلك توقفوا عند نقاط جزئية، ولكن هذه النقاط الجزئية ليست هي المهمة، فقد تكون هذه المدرسة قد أخطأت في بعض الجوانب وفي تأويل بعض المعطيات، ولكن الأساسي هو الذي يظل صالحا، وهو ما قالوه بشكل صريح، وهو أنّ هذه المصادر العربية الإسلامية هي مصادر وكفى.
د. نادر الحمامي: يعني أنّ أهم ما قالوه منهجي؟
د. فوزي البدوي: نعم على مستوى المنهج، فتجديد هذه المدرسة ليس في النتائج التي توصلت إليها، وبعضها قابل للمراجعة بتطور المباحث التاريخية، ولكن ما يبقى مهمًّا هو ما قالوه بصدد المنهج، فالتغير الحقيقي هو التغير في المنهج. وهذا ما أردت أن أبينه بالنسبة إلى من يهتم بهذه المواضيع، فهؤلاء يقولون إنّ هذه المصادر العربية التي قدت ابتداء من القرن الثاني والتي لا تعكس ما وقع، وإنّما تعكس ما أراد المسلمون أن يعتقدوا أنّه وقع، أو ما اعتقدوا أنّه وقع، هي مصادر وكفى.
ما معنى مصادر وكفى؟ أي إنّه لا وجود لأي مبرر يجعل من هذه المصادر تتميز بمنزلة خاصة عن غيرها من المصادر، وأنّ هناك مصادر أخرى غير عربية وخارجية قد تسد ثغرات في مجال الكتابة التاريخية بالنسبة إلى نشأة الإسلام.
د. نادر الحمامي: (اسمح لي هنا بالنقاش) حين نطلع على كتابات كرون وكوك وممثلي الاستشراق الأنجلوسكسوني، تحديدًا، نلاحظ أنّهم حين يسعون إلى تبرير فكرة أو الاحتجاج بفكرة عندهم، فإنّهم يستعملون المصادر الإسلامية ولا يتورعون عن ذلك، حين تخالف المصادر الإسلامية ما هم بصدد البرهنة عليه، فإنّهم يرمونها بأنّها مصادر بعدية ومتأخرة ونتاج عصر التدوين وتمثلات ولا تعبر عن الحقائق التاريخية... فسمة الانتقائية واضحة في هذه الكتابات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إنّ الكتابات والمصادر الخارجية نفسها بينت دراسات أخرى أنّها بدورها كانت داخلة في إطار الجدل الإسلامي المسيحي بالخصوص، أذكر أساسًا كتابات سيبيوس التي نشأت في إطار الجدل الديني، فكيف يمكن الثقة بكتابات خارجية وهي بدورها منخرطة في هذا الصراع الديني؟
د. فوزي البدوي: فعلاً، هذا هو النقد الذي وجه إلى هذه المدرسة وهو نقد صحيح، فإحدى نقاط النقد التي وجهت إلى هذه المدرسة هي لماذا نعطي لهذه المصادر غير الإسلامية أهمية أعلى من المصادر الإسلامية، ونحن لم نقل إنّ هذه المدرسة هي مدرسة خالية من المطاعن، ولكن ما يهمني ليس التفاصيل، فما يهمني هو أن يقبل المسلمون فكرة أنّ هذه المصادر الإسلامية هي مصادر كغيرها من المصادر. فلا موجب، ولا مبرر، لإعطاء هذه المصادر أهمية على غيرها، خصوصًا إذا كانت هذه المصادر تتحدث عن منطقة فيها فراغات في ما يتعلق بالمعلومات. ولكن هذا لا يعني أبدا أنّ هذه المصادر غير الإسلامية هي مفضلة على غيرها، أو هي تتميز عنها، فيجب أن تخضع هي بدورها إلى الفحص التاريخي وإلى النقد وغير ذلك.
إنّ ما يجب أن نحتفظ به من هذه المدرسة الأنجلوسكسونية هو هذا المبدأ العام، أي إنّ هذه المصادر الإسلامية هي مصادر متأخرة، وأنّ الباحث يجب أن يتعامل معها على اعتبارها مصادر تاريخية تخضع لمقتضيات البحث التاريخي، ويتخلى تدريجيًّا عن هذه القدسية التي تتميز بها هذه المصادر. الأخطر من هذا في ما يتعلق بالمدرسة الأنجلوسكسونية هو أنّ هذه المدرسة اهتمت بالقرن الأول، وهذا وجه الخطورة الأولى، يعني أنّ الاستشراق الكلاسيكي اهتم بالدولة الأموية وبالدولة العباسية وبمراحل أخرى من التاريخ الإسلامي والعثمانيين... ولكن هؤلاء تخصصوا بالأساس في القرن الأول الهجري، فيما يسمى بالتأسيس، البدايات، وهذا مكمن الخطورة بالنسبة إلى الدراسات العربية الإسلامية، بمعنى أنّهم يتصورون خلخلة الأسس التي قام عليها الإسلام، وإعادة النظر في القرآن والسنة وغيرها من المصادر الأخرى والمغازي والسير إلى غير ذلك، وذلك قد يكون مؤذنًا بمشاكل نظرية خطيرة. وفي اعتقادي فإنّ هذا الرفض لهذه المدرسة يرجع إلى هذا الخطر بالذات حيث استشعر المسلمون، واستشعرت النخب التي هي في الجامعات العربية، مكمن الخطورة في هذا العمل، وقامت بعملية رفض مطلقة، لأنّ هذه النخب ولأنّ هذه الجامعات العربية في الحقيقة هي مدينة إلى الاستشراق الكلاسيكي على اختلاف الباحثين فيها، فخوف الجامعات العربية من هذه المدرسة هو خوف يرجع إلى طبيعة بناء الجامعات العربية إلى حدود الخمسينات، فنحن ندرّس أبناءنا ودرستنا هذه الجامعات من قبل، فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية، ما استقر عليه هذا الاستشراق الكلاسيكي إلى تلك الحدود، ولهذا نحن نفسر اشتراك هذه النخب العربية مع ممثلي الاستشراق الكلاسيكي في أوروبا في مهاجمة هذه المدرسة، هؤلاء هاجموا هذه المدرسة ولكنهم في الحقيقة لم يجيبوا عن الأسئلة الحقيقية التي طرحتها هذه المدرسة الأنجلوسكسونية والتي أقول إنّها تتمثل في بعض النقاط:
النقطة الأولى هي التذكير بعملية التدوين وتبعاتها ومعناها، وأيضًا –وهذا هو الخطر الأساسي- أنّ هذه المدرسة طبقت دون رحمة ما يعرف بالنقد الكتابي (critique biblique) الذي كان معروفًا في ألمانيا بالأساس، فهذه المدرسة لئن نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس، فإنّها، من حيث الأسس النظرية، تعود إلى بعض ما تتلمذ عليه جون ونزبرو (John Wansbrough) من التقاليد الجرمانية في البحث وخصوصًا التقاليد المتعلقة بالبحث الكتابي والتي قام عليها مبحث تاريخ الأديان بالأساس، بمعنى أنّ هذه المدرسة الأنجلوسكسونية أجابت عن سؤال خطير وهو التالي: يجب أن نطبق المناهج التاريخية بطريقة راديكالية بمعنى أن نأخذ الأمور من جذورها، أو كما يقول ماركس "أن نمارس النقد باللكمات"، وهذا هو مكمن الخطورة، فطه حسين عندما كتب كتاب "في الشعر الجاهلي" ورُفض هذا الكتاب وعُدّل "في الأدب الجاهلي" بسبب جملة بسيطة وهي التي تقول: "للقرآن وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ولكن مجرد ورودهما في القرآن والتوراة لا يقوم دليلاً على وجودهما التاريخي"، وقس على ذلك... فنحن نخاف من تطبيق المناهج التاريخية كما عرفها النقد الكتابي على نصوصنا المقدسة، وهذا بالضبط ما فعلته المدرسة الأنجلوسكسونية، نحن نخاف وذلك لسبب بسيط وهو أنّنا بنينا الإيمان على تصور معين للكتابة التاريخية، وكل نقد تاريخي جذري راديكالي سيؤدي إلى خلخلة تصور ما للإيمان. إنّ جوهر السؤال الذي وجهته المدرسة الأنجلوسكسونية للمسلمين هو التالي: طبقوا المناهج التاريخية الراديكالية على الإسلام وستجدون أنّ قرنكم الأول الذي أسستم عليه كل إيمانكم من قرآن وسنة وسيرة ومغازٍ سينهار.
د. نادر الحمامي: هل هذا الخوف الممزوج بالإيمان والعاطفة يفسر إلى حد كبير ما أنتجه مثلاً هشام جعيط في ثلاثية السيرة؟
د. فوزي البدوي: الأستاذ هشام جعيط أستاذ الأجيال في تونس، أو عبد الله العروي في المغرب هما قامتان أساسيتان في الدراسات التاريخية، ولكن كما يقول الإمام أحمد بن حنبل: "كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر"، فهشام جعيط هو من أفضل ما أنتجت المدرسة التاريخية الفرنسية الكلاسيكية، فهو سليلها وابنها الحقيقي فقد درس في دار المعلمين العليا في فرنسا، وهو يتقاسم الأطر المنهجية التي تربى عليها في الاستشراق الفرنسي وبالتالي عندما أنظر إلى ما كتبه أقول إنّه كان وفيًّا لهذه التقاليد وكل ما ذكره في ثلاثيته حول النبي وحول نشأة الإسلام، كل مطّلع على التقاليد الفرنسية والتقاليد الجرمانية -لأنّ الفرنسيين كانوا عالة على الألمان- سيجد أنّ أغلب ما أورده الدكتور هشام جعيط هو في الحقيقة استرجاع لأشياء معروفة عند المدققين والمتخصصين في هذه المجالات ويحسب له أنّه قدم للقراء العرب خلاصة هذه التجربة التاريخية التي عرفها الاستشراق الكلاسيكي خصوصًا في نسخته الألمانية أو الفرنسية.
د. نادر الحمامي: ولكننا حين نطلع على ثلاثية هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة، وتاريخية الدعوة المحمدية في مكة، أو مسيرة محمّد في المدينة وانتصار الإسلام، ألا ترى معي أنّ صاحبها يعمد إلى نوع من الانتقاء يربطه خيط ناظم لا يعلنه، ويمتزج بنوع من العاطفة الكبيرة، وكذلك فإنّه قد يمزج بين آراء باتريسيا كرون وجاكلين الشابي وتور آندري مثلاً وفق خيط ربما يمكن الوقوف عليه.
د. فوزي البدوي: طبعًا لا يمكن فصل ذاتية المؤرخ عما يعرف بالموضوعية في الكتابة التاريخية، فثمة نقاش داخل الكتابات التاريخية حول هل ذاتية المؤرخ هي عائق أمام الموضوعية أم هي مساعدة على الكتابة التاريخية. لا ننسى أنّ الأستاذ هشام جعيط هو سليل عائلة آل جعيط ممثلي الإسلام الحنفي في تونس وقد كتب بطبيعة الحال بشيء من الحميمية وشيء من العاطفة، وهو أمر لا أعتبره عائقًا في الحقيقة، ولكن العائق الحقيقي في نظري هو أنّه كتب وفق تصوّر معين ومسلمات معينة للكتابة التاريخية الاستشراقية الكلاسيكية التي هي ليست بالضرورة مسلمات المدرسة الأنجلوسكسونية.
أعود إلى هذه المدرسة الأنجلوسكسونية لأقول إنّها توجه لنا أسئلة حقيقية بقطع النظر عن التفاصيل وهي: كيف نستطيع أن نتشرب هذا النقد التاريخي، لأنّ أخطر ما تقوله هذه المدرسة هو في شكله المثير عند باتريسيا كرون هو أنّ هذا الإسلام مزيج من قوة خام بربرية عربية وتقاليد عربية وسامرية، وأنّ الإسلام الحقيقي لم ينشأ في مكة وإنّما نشأ في الشام...
هذه الأفكار صادمة ولكنها تبقى مسائل ثانوية، لأنّ المشكل الأساسي هو كيف نستطيع نحن العرب المسلمين أن نواجه السؤال التاريخي، أو الكتابة التاريخية، بمعنى إذا ما نحن واصلنا السير في هذا الخط، وهو رفض النقد التاريخي بأشكاله الراديكالية المزعجة للإيمان، فما الذي سيكون عليه مصيرنا؟
د. نادر الحمامي: وهنا تحديدًا سندخل في مسائل أخرى بعد هذا العرض في خطوطه الكبرى للاستشراق الأنجلوسكسوني الذي بينت أنًه يجب الاهتمام فيه بالجوهر لا بمجرد النتائج الصادمة لما استقر عليه الضمير أكثر منه في مستوى النقد التاريخي. أقصد تحديدًا كيف يمكن الاستفادة من هذه المناهج التاريخية القائمة على النقد التاريخي في مستوى الجامعة، وتدريس التاريخ العربي الإسلامي بغير المناهج التقليدية التي دأبت عليها الجامعة التونسية بالخصوص والجامعات العربية عمومًا، وهذا المبحث الذي يمكن أن يكون محورًا ثالثًا في هذا الحوار الذي نجريه معك أستاذ فوزي البدوي.
تدريس المسألة الدينية بالجامعات
د. نادر الحمامي: نواصل حوارنا مع الأستاذ الدكتور فوزي البدوي، وقد وصل إلى نقطة مركزية تتعلق بالمسألة المنهجية في الاستشراق الأنجلوسكسوني تحديدًا. ونود أن نتابع معه حول تبعات هذا المنهج فيما يتعلق بتدريس المسألة الدينية بالجامعة، وللأستاذ البدوي في هذا الأمر رأي، فلو يسمح بأن نسأله عن تبعات المنهج في دراسة الشأن الديني بالجامعات العربية عمومًا، ولكن انطلاقًا من الجامعة التونسية على وجه التحديد.
د. فوزي البدوي: قلت إنّ أخطر ما في هذه المدرسة هو القضايا المنهجية التي تثيرها بطريقة راديكالية. ما لم ينتبه إليه من درس هذه المدرسة هو أنّ هذه المدرسة بتطبيقها المنهج الراديكالي وقولها إنّ الإسلام ما هو إلا توليفة بين مادة خام وقوة خام "بربرية، عربية، وديانة سامرية يهودية" كما تقول باتريسيا كرون، إنّما تحاول هي وكل هذه المدرسة القيام بعمل على درجة كبيرة من الخطورة وهو محاولة إخراج الإسلام من الحضارة المسيـ - هودية (la civilisation judéo-chrétienne)، وهذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يهتم به المسلمون والعرب، فالإسلام في نهاية الأمر هو شكل من أشكال اليهودية، وهو وليد حركة انشقاقية داخل اليهودية، فبعضهم ممن يقرأ هذه المدرسة قراءة سطحية يتصور أنّها تواصل في مبحث قديم وهو مبحث التأثير والتأثرات. لا، فهذه المدرسة تنطلق من تصورات مختلفة وأعقد وأخطر، وقد بينت هذا على مستوى المنهج فيما يتعلق بعملية التدوين. والاستتباعات الخطيرة لذلك أنّه يؤدي إلى إخراج الإسلام من الحضارة المسيـ - هودية، وبالتالي إخراج الإسلام من الفضاء الإغريقي الروماني (espace gréco-romain) في ما يتعلق بالبحر الأبيض المتوسط؛ وهذا أمر خطير، وهذا ما تمّ التفطن له وما يكتب فيه وما تتواصل الكتابة فيه انطلاقًا من تيار انتبه إليه المسلمون والعرب بصفة عامة ابتداءً مما حدث مع فترة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وهو ما يعرف بالمحافظين الجدد وهؤلاء يدفعون بالفرضيات النظرية التي بدأت مع المدرسة الأنجلوسكسونية إلى أقصى مدى. السؤال الحقيقي الذي يجب أن ينتبه إليه القراء والباحثون العرب والمسلمون في تعاملهم مع هذه المدرسة ليس في القضايا الجزئية وإنّما في كيفية التعامل مع السؤال الراديكالي الجوهري، وأزعم وقد بينت هذا في بعض الدراسات أنّ هذا الإسلام هو الوريث الحقيقي لهذه المسيـ - هودية التي يحاول هؤلاء أن يقوموا بعملية إقصاء الإسلام عنها، وهذا يتطلب جهدًا نظريًّا كبيرًا في الحقيقة. والحق يرجع الفضل إلى بعض الباحثين الألمان المغمورين الذين ذهبوا هذا المذهب وبينوا أنّ هذا الإسلام، هذه الديانة الجديدة ناشئة عن اليهودية أو عن شكل معين من المسيـ - هودية، وأقصد بها تلك الحركة التي استمرت بعد المسيح حوالي 150 سنة؛ أي بعد حادثة "صلبه" أو "قتله" أو "رفعه"، في تلك الفترة تشكل نوع مما يعرف في تاريخ الأديان بالمسيـ - هودية، وهؤلاء كانوا طوائف متعددة إلى حدود ما يعرف بكنيسة أورشليم، وهؤلاء لم يكونوا يهودًا لأنّ اليهودية التقليدية رفضتهم، ولم يكونوا مسيحيين لأنّ المسيحية في شكلها البولسي، بعد ذلك لن تشترط أن يكون المرء يهوديًّا حتى يكون مسيحيًّا، لأنّ المشكل الذي اعترض القديس بولس في دعواته في حوض البحر الأبيض المتوسط هو دخول طوائف عديدة من الوثنيين إلى الدين المسيحي، هؤلاء رفضتهم اليهودية ورفضتهم المسيحية وتمت مطاردتهم، وانتشروا بعد ذلك في البراري وفي الصحاري، وتبين بعض الدراسات أنّ هؤلاء لهم صلة ما بالحركة الحنيفية.
د. نادر الحمامي: ولذلك كانت الآية: "ما كان إبراهيمُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولكنْ كان حنيفًا مسلمًا..."؟
د. فوزي البدوي: هذه الآية ظهرت في سياق الجدل، وفي إطار انشقاق الإسلام عن الحركة المسيـ - هودية، قلت إنّ هناك نقاشًا داخل تاريخ الأديان هو كيف تنشأ حركة انشقاقية داخل ديانة أسبق منها ثم تستقيم بعد ذلك ديانةً مستقلة الأركان. فالإسلام كان لا بد عليه أن يجد مكانًا لنبوة النبي محمد داخل مسار النبوة السامية القديمة، ولكن ذلك كان يحتاج إلى القيام ببعض الأمور الأساسية، من ذلك أولاً توضيح ما يسمى بعلاقة النسب الإبراهيمي، ما هي علاقة هؤلاء المسلمين بإبراهيم، والإسلام سينازع اليهود هذا النسب الإبراهيمي، "مَا كانَ إبراهيمُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولكنْ كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشْركين" (آل عمران3/ 67)، وكان على الإسلام حينئذ أن يبين علاقته بالتوراة؛ هل هو امتداد لها بكيفية معينة، ولكن التوراة التي يتحدث عنها الإسلام ليست هي التوراة اليهودية، ويجب أن يفهم هذا القراء أو المتابعون المسلمون، فتوراة القرآن هي غير توراة اليهود، والتوراة التي يتحدث عنها الإسلام هي الأسفار الخمسة الأولى بدون قسم الأنبياء والمكتوبات، وهذا أمر مقصود لأنّ التصور اليهودي القديم يشترط النسب الدّاودي في الذي سيأتي بعد المسيح المنتظر أو النبي المنتظر بعد ذلك، والإسلام بحديثه عن توراة ليس فيها إلا الأجزاء الخمسة الأولى، إنّما هو يقطع الطريق أمام كل زعم يهودي بهذا النسب الدّاودي. نجد حديثًا معبّرًا في سيرة النبي عندما جاءه عمر بن الخطاب وكان جذلاً فرحًا وقد أتى بجوامع من التوراة، فتغير وجه رسول الله - كما تقول السيرة - وقال له: "يا عمر والله لو بعث فيكم موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم"، هذا الحديث يؤرخ للفترة التي بدأ فيها الإسلام يسعى إلى الاستقلال ونشأة دين كامل الأركان، فهذا الإسلام وفق تاريخ الأديان لا يضيره أن يكون قد نشأ في خضم هذا الرصيد السامي المشترك، واستقل شيئًا فشيئًا دينًا، وهذا ما أريد أن أبينه، فعلى المسلمين اليوم ألا يخافوا من النقد التاريخي، الخوف هو أنّ الانخراط في هذا المسار قد يكلف المسلمين الثمن الغالي الذي لا يستطيع المسلمون أن يقدموه لكي يبقى هذا الإسلام حيًّا من الناحية التاريخية، وأزعم أنّنا لسنا أول سارٍ غرّه قمر، كما يقال، فالديانات الأخرى سبقتنا في معالجة هذا الموضوع وسبقتنا في النقد التاريخي؛ فالمسيحية مثلاً والبروتستانتية على وجه الخصوص وهي النبض الحي الذي بقي في تاريخ المسيحية تعرضت إلى النقد النيتشوي وإلى النقد الفرويدي وإلى النقد الماركسي التاريخي وعاشت هذه المرحلة وخرجت منها بأخف الأضرار، وهذا ما سيدفعنا للحديث عن مشاكل تدريس الإسلام في الجامعات العربية، فالمسلمون يخافون هذا النقد التاريخي لأنّه هو النقد الفنّي، كما يسميه أحد اللاهوتيين والفلاسفة والمؤرخين الألمان رودولف غولدمان (Rudolf Goldman) بالنقد المموضَع (objectivant)، يقول: "كنا نخرج من دروس التاريخ ونحن كائنات محطمة، كنا نشعر بوطأة هذا النقد التاريخي على نصوصنا المقدسة"، فالحركة المسيحية استطاعت في شكلها البروتستانتي بالأساس أن تجد حلولاً لهذا الموضوع، وأن أقول هذا الكلام على الرغم من أنّني من أشد المدافعين عن الإسلام فأنا أرى فيه قدرة على البقاء، وكل من درس تاريخ الأديان يعرف أنّه لا مجال لانقراض الأديان في المستقبل، وكل الأديان تستطيع أن تبقى وأن تجد حلولًا لمشاكلها، فأنا ليست من أولئك الذين يتبنون نقدًا نيتشويًّا للدين، والنقد التاريخي في شكله الراديكالي والجذري لا يمثل عائقًا أمام بقاء الإسلام، وهناك حل لكي يتمكن هؤلاء المسلمون من تقبل كل النقد الذي ظهر مع المدرسة الأنجلوسكسونية، والخروج منه بأخف الأضرار، وهذا ممكن، وهذا هو عمل الجامعات.
د. نادر الحمامي: هذا هو عمل الجامعات، ولكن هنالك فروق، فلو لاحظنا هذا النقد التاريخي - وأنت تحدثت عن البروتستانتية باعتبارها القلب النابض في المسيحية، خاصة إذا عدنا إلى الإصلاح البروتستانتي بداية من القرن السادس عشر -، فإنّنا سنلاحظ أنّ هذا النقد، وإن كان غير جذري في البداية، فإنّه قد انطلق من داخل المؤسسة الدينية نفسها، في حين أنّ هذا ربما قد يستحيل وقوعه بالنسبة إلى المجال الإسلامي من داخل المؤسسة الدينية في الإسلام، وربما على الجامعات اليوم ومناهج التدريس في الجامعات أن تضطلع بهذه المهمة، أليس كذلك؟
د. فوزي البدوي: نحن الآن ندخل منعرجًا على درجة كبيرة من الخطورة، وهو كان خطيرًا في الماضي ولكنه ازداد خطورة الآن مع الأوضاع التي نعرفها في البلاد العربية والتي تجعل من الجامعات متخمة أو هي مريضة بمشاكلها اليومية. أنا كتبت منذ التسعينات مقالاً ما زلت أصر على أنّه ذو راهنية كبيرة، وهو بعنوان "من أجل بوليتكنيك لتدريس الأديان" وكان العنوان مقصودًا في الحقيقة لأنّني وجدت أنّ هذه الدولة الحديثة والدول العربية لما بعد الاستقلال قد ركزت كل جهدها على المسائل التقنية والعلوم والرياضيات، ولم تهتم بما فيه الكفاية بالمسألة الدينية، وكنت دائمًا أعتبر أنّ مقتل الدولة العربية الحديثة هو في تهاونها بالمسألة الدينية، والنتيجة واضحة للعيان، نحن تقريبًا نعيش في كل البلدان العربية أزمات دورية، كل عشرين أو ثلاثين سنة تعود المسألة الدينية بقوة ونجد أنفسنا مثل بني إسرائيل في التيه أربعين سنة، نعود إلى نقطة البداية نفسها، لأنّنا لم نعد ترتيب علاقتنا بالدين، ولم تقم المؤسسة الجامعية بدور عميق في هذا، لأنّ دول الاستقلال أو الدولة العربية الحديثة لم تكن على وعي تام بأهمية هذه القضايا. التوازن الاجتماعي الحقيقي ومستقبل هذا الدين مرهونان بنوع النخب التي تكوَّن داخل الجماعات في المسألة الدينية، فالدولة الحديثة مقصرة في ذلك.
أنا من الذين دافعوا عن بقاء المؤسسة التقليدية، وفي تونس هي المؤسسة الزيتونية، ووجهة نظري هي أنّ النظام الجمهوري الذي قام في تونس كان عليه أن يبني مؤسساته الدينية الخاصة به وفق روح معلمنة، وهذه المؤسسات التي تشتغل على الدين وفق هذا المنطق يجب أن تجد الرعاية من النظام الجمهوري، ولكن هذا النظام الجمهوري كان عليه أن يترك أيضًا المؤسسة الزيتونية باعتبارها مؤسسة تقليدية راعية للكلاسيكية، تشتغل وفق ضوابط عامة هي مراعاة قيم النظام الجمهوري، ويترك التنافس بين المؤسسات، وهو الذي يؤدي إلى شعور هذه المؤسسة التقليدية بتأخرها التاريخي، مثلما تم الشأن في فرنسا، فالفرنسيون لم يغلقوا ولم يضعفوا المعهد الكاثوليكي في باريس، ظلّ المعهد الكاثوليكي يشتغل وأسست الجمهورية الفرنسية معهد الدراسات العليا التطبيقية وبعض المؤسسات التي تشتغل وفق قيم النظام الجمهوري.
د. نادر الحمامي: ولكن طبيعة المجتمعات مختلفة تمامًا، فالمجتمع الفرنسي له إرث من الثورة، وهو منذ بدايات القرن الثامن عشر بدأ يتخلى عن المحافظة، في حين أنّ المجتمعات العربية الإسلامية هي إلى اليوم مجتمعات محافظة، وتخشى حتى بنوع من النزوع الطبيعي نقد ثوابتها.
د. فوزي البدوي: لا أحبذ كلمة نزوع طبيعي، فليس هناك نزوع طبيعي، ولكن أقول إنّ هذه الدولة العربية الحديثة لم تكن واعية بأهمية المسألة الدينية، وهاجسها الأساسي الذي حركها في هذا الموضوع هو كيفية استثمار الدين لأجل الإبقاء على التوازنات السياسية التي تسمح باستمرار هذه الدولة، فلم تكن هذه الدولة بقادرة على مواجهة المسألة الدينية في أسسها، نحن أمضينا خمسين سنة من الاستقلال دون تكوين رؤية واضحة للمسألة الدينية، والرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة كان له تصور للمسألة الدينية وللجامعة الزيتونية في جزء منه كان خاطئًا في اعتقادي، لأنّه هو الذي كان سليل الجمهورية الثالثة وهذه الروح المعلمنة على النمط الفرنسي وهي علمنة مناضلة (une laïcité militante)، وكان يتصور أنّ هذا الدين بالإمكان ترويضه وبالإمكان استثماره، ولكنه لم يفكر بطريقة جذرية في أن يقيم مؤسسات دينية، فأضعنا ستين سنة من أجل تكوين مؤسسات تشتغل على الظاهرة الدينية في نطاق الجامعة التونسية وفق روح معلمنة، فالجامعة الزيتونية عرفت تاريخًا من الإصلاح منذ كتاب "أليس الصبح بقريب"، وتوقفت هذه العملية وظلت هذه المؤسسة رهينة حركات آتية من المشرق، أي إسلام آخر لا صلة له بالإسلام كما عرفته هذه المؤسسة التقليدية منذ القديم، وأنا والدي كان أحد خريجي هذه المؤسسة ودرست فيها لسنوات وكنت أعرف أنّ هذه المؤسسة هي في الحقيقة فريسة تجاذبات سياسية، فلا هي ظلت كلاسيكية وواصلت إنتاج العلماء بطريقة كلاسيكية، ولا الجامعة التونسية، التي كانت تنظر إلى الدين باعتباره "الموضع العفن من الفلسفة" كما يقول ماركس، اهتمت بالدين؛ فلا قسم التاريخ اهتم بعلم الأديان، ولا قسم الفلسفة اهتم بشيء اسمه فلسفة الأديان، فظل هذا الموضوع، موضوع الدين، محشورًا في قسم اللغة والآداب العربية لأسباب تاريخية.
د. نادر الحمامي: ومن هنا تبرز أهمية قسم لدراسة الأديان المقارنة.
د. فوزي البدوي: فعلاً، وتمت محاولات في آخر الفترة السابقة ولكنها أجهضت في عديد من المرات لأنّه كان يُنظر إلى هذا الموضوع في إطار تنافس جامعة الزيتونة وكلية الآداب، وفي إطار ما كانت تسير عليه هذه الدولة من ترك الأمور كما هي وعدم خلق توترات، ولكن هذه الدولة كلما تأخرت في معالجة المسألة الدينية وفي تدريس الأديان سواء في التعليم الثانوي أو في الجامعات ستدفع الثمن باهظًا في كل عشرين أو ثلاثين سنة، لأنّني أزعم أنّ هناك أزمات دورية ستعيشها تونس لأنّ القضايا الأساسية لم تُطرح بعد؛ وأخطر هذه القضايا هي كيفية تدريس الدين ومنزلة النقد التاريخي في معناه المموضع في سياق الدراسات الدينية في الجامعة التونسية، خصوصًا وقد انضاف شيء جديد ألا وهو هذه الثورة الرقمية، فالتونسيون، طلبة وتلاميذ، أصبحوا يتلقون المعارف لا من الجامعات ولا من التعليم الثانوي الذي يعاني بدوره من مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتدريس الدين، وإنّما يتلقونها من وسائط إعلامية أجنبية وفضائيات، وكنت شاهدًا عندما كنت أدرّس في دار المعلمين العليا أنّني بعد أن أدرّس مسائل دينية معيّنة، كان بعضهم يتسابقون، عند الخروج، إلى حضور دروس الشيخ فلان والشيخ علان، في المساجد القريبة من دار المعلمين العليا التي هي مسؤولة عن تكوين النخبة، وكنت أشعر آنذاك أنّ هناك خللاً ما في هذا التدريس الجامعي، وأنّ الجامعة التونسية لا تقوم بما يكفي من أجل النظر في هذا الموضوع، موضوع الأديان، وأنّ الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ووعي من سياسيي هذه البلاد، ويبدو أنّ هذا الأمر، بحكم المشاكل اليومية وبحكم ما عرفته البلاد منذ سنة 2011، قد جعل هذا الموضوع متأخرًا في اهتمامات السياسيين، وأعتقد وأزعم أنّنا ما لم نُصلح الجامعة، وما لم نصلح تدريس الدين في التعليم الثانوي وفق منطق تاريخ الأديان، فإنّنا سنظل نعيش أزمات دورية كل عشرين أو ثلاثين سنة، وما زلت أعتقد أنّ الأزمة قادمة لا محالة.
د. نادر الحمامي: إذن لا بد من إعادة النظر في منهجية تدريس الأديان والشأن الديني سواء في الجامعة أو ما قبل الجامعة، وهي دعوة ملحة الآن، وربما علّمنا تاريخ دولة الاستقلال أنّ المسألة تخفت في فترات معينة ثم تعود تحت ظرف أو آخر بإعادة إبراز هذه المشاكل التي لم نبرأ منها، وربما خفوتها في مرحلة ما لا يعني اندثارها، ولا سبيل للخروج منها إلا بإعادة النظر بصورة جذرية وهيكلية في تدريس الشأن الديني. سأعتبر كلامك دعوة لتركيز قسم لدراسة الأديان المقارنة بصورة تاريخية وأكاديمية، حتى نتفادى في فترة لاحقة مثل هذه المجالات.
د. فوزي البدوي: فعلاً، هذا جزء من المطلوب، على النظام الجمهوري أن يشيع جزءًا من لائكية العقول والنفوس، وأن يضمن للمشتغلين بالمسائل الدينية حق الكتابة، والحياة الكريمة، وحرية التعبير.
د. نادر الحمامي: أستاذ فوزي البدوي، لقد كان حوارًا ممتعًا، نشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به، ونأمل أن نتعامل مستقبلاً في مناسبات علمية ومعرفية وأكاديمية.