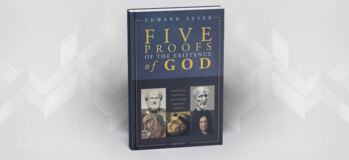في التماهـي بين الترجمة والفلسفة
فئة : ترجمات

في التماهـي بين الترجمة والفلسفة[1]
عبد السلام بنعبد العالي، كتابات في الترجمة، الأعمال، الجزء الرابع،
دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2014
عبد الرحيم رجراحي
تقديم
يجزم عبد السلام بنعبد العالي بأنّ قضية الترجمة هي قضية الفلسفة، على الرغم من كون موضوع الترجمة يتنازعه فاعلون تتعدد حقولهم المعرفية بين الأدب واللسانيات، فضلاً عن الفلسفة، وهو يورد على هذا الطرح حجتين: تتمثل الأولى في كون الترجمة تعكس سعي الفكر لإعادة قراءة تراثه وتجاوز مسلماته؛ وتتمثل الثانية في كون القضية الكبرى، التي شغلت الفلاسفة منذ أفلاطون، هي قضية النموذج والاستنساخ (ص 19).
بناء على ذلك، تُعدّ الترجمة، من منظور عبد السلام بنعبد العالي، سبيلاً من سبل مجاوزة الميتافيزيقا وتفكيك بنيتها وتقويضها، ما دام همُّ الفلسفة المعاصرة أساساً هو هم الترجمة في الأصل (م.س)؛ وهو ما تشهد عليه قصة برج بابل، حيث بلبل الرب على بني آدم لغتهم الواحدة التي كانوا يسعون من خلالها إلى الحفاظ على لحمتهم من جهة، وفرضها على الآخرين من جهة أخرى. غير أنّ مشيئة الرب حكمت عليهم بتعدّد اللغات؛ ومن ثمة بضرورة الترجمة (ص 19-20).
ولعل همَّ الفلسفة المعاصرة هو الهمُّ نفسه الذي نهضت به الترجمة؛ ذلك أنها لا تسعى للبناء، وإنما لتفكيك كلّ ادعاء للبناء، سواء تعلّق الأمر ببناء النسق الواحد أم اللغة الواحدة أم المعنى الواحد أم الهوية الواحدة. وإذ تعلن الفلسفة المعاصرة برمها من هذه الادعاءات الأحادية، فإنّها تنشد التفكيك والبلبلة والتعدد والاختلاف والترجمة. وعليه يخلص عبد السلام بنعبد العالي إلى أن قضية الترجمة هي بلا منازع قضية الفلسفة، من حيث إن استراتيجية الترجمة تتحد باستراتيجية التفكيك كإحدى استراتيجيات الفلسفة المعاصرة؛ فيصير الفكر بذلك ترجمة للميتافيزيقا، أي تفكيك لبنيتها، وتقويض لمسلماتها، وكشف عن التعدد والانفصال والاختلاف الحاصل فيها (ص 21).
فما وجه التماهي بين الفلسفة والترجمة؟ هل الترجمة مجرد موضوع للتفكير الفلسفي أم هل هي تنهض بمهمة الفلسفة ذاتها؟ وكيف يمكن للترجمة أن تنهض بهذه المهمة؟ أَبالحفاظ على الأصل والهوية والألفة أم بتكريس التعدد والاختلاف والغرابة؟
1- ميتافيزيقا الترجمة
يتجاذب مسألة الترجمة طرحان فلسفيان: الأول تقليدي أو قل ميتافيزيقي، والثاني طرح معاصر. يتأسس التصور الميتافيزيقي للترجمة على أنها مجرد نقل من لغة إلى أخرى، وهو نقل مهووس بالحفاظ على المعنى الأصلي، من خلال محو المسافة بين المنقول والمنقول إليه، سواء كانت هذه المسافة لغوية أم تاريخية أم ذاتية (ص 25).
الترجمة، إذاً، بحسب التصور الميتافيزيقي، متوقفة على مدى قهر الترجمان للمسافة بين الأصل والنسخة، بين النص وترجمته[2]، ما دام النص الأصلي يحظى بمنزلة الشرف من النسخة المترجمة عنه؛ وهذه الأفضلية هي، في الواقع، أفضلية ميتافيزيقية رسختها الأفلاطونية، ليس بما هي تمييز بين عالم المعقولات والمحسوسات أو بين النماذج والنسخ، بل بما هي كذلك «وقوف عند النسخ ذاتها وفحصها لإظهار ما ينتسب إلى الأصل وما لا علاقة له به» (ص 25-26)؛ ذلك أن النسخ نوعان: تلك التي تأتي بعد الأصل مباشرة، والتي تشبهه وتقترب منه؛ وتلك التي تأتي بعد هذه النسخة التي تحيد عن الأصل جملة، من حيث إنها مختلفة ومتناقضة ومتنكرة وماكرة، أو ما يصطلح عليه باختصار بالسيمولاكر (ص 27).
تؤسس الأفلاطونية إذن تراتبية ميتافيزيقية هرمية لمسألة الترجمة؛ حيث يتربع الأصل على عرشها، وتليه -من حيث الدرجة- النسخة الأيقونة، في حين يحتل السيمولاكر قاعدة الهرم؛ ويترتّب على هذا الطرح الميتافيزيقي للترجمة أنّ الترجمان مهما سعى ليرقى بالنسخة المترجمة إلى مستوى الأصل، فإنّه لا يستطيع إلى ذلك سبيلاً؛ حيث تظل كل ترجمة خيانة للنص الأصلي، من جهة أن له هوية خالصة تتحدد بكاتبه ولغته ومعناه، وهي المحددات التي ينبغي على الترجمان الحفاظ عليها من الضياع، وإلا عد مخلاً وخائناً وخارجاً عن دائرة الوفاء (ص 29)؛ وهو ما يعني أن التصور الميتافيزيقي للترجمة محكوم بتصور أخلاقي يجعل من الأصل أشرف من النسخة، ومن النص أشرف من ترجمته، ومن المؤلِّف أشرف من المترجِم، ومن الهوية أشرف من الاختلاف.
ونورد على هذا التصور الميتافيزيقي للترجمة مثالين: الأول قريب من عصرنا، والثاني بعيد، لكن كليهما مشروط ببنية ميتافيزيقية عن الترجمة، بنية تجعل من الترجمة على الحقيقة هي قهر المسافة بين النص وترجمته، وبين المؤلِّف والترجمان، من أجل الحفاظ على الأصل والهوية ومحو الاختلاف. يتعلق النموذج الأول بعبد الله العروي والثاني بالجاحظ.
فأما عبد الله العروي، فقد ألف كتاب (الإيديولوجيا العربية المعاصرة) باللغة الفرنسية سنة (1967)، وبعد ثلاث سنوات من هذه الطبعة، وتحديداً سنة (1970)، تمّت ترجمته من طرف محمد غيتاني إلى اللغة العربية. لكن في سنة (1996)؛ أي بعد ستّ وعشرين سنة من ترجمة محمد غيتاني، وتسع وعشرين سنة من تأليف الكتاب باللغة الفرنسية، سيعيد عبد الله العروي ترجمته، مقدّماً مبررين: الأول أنّ ترجمته تستدرك الأخطاء التي ارتكبها محمد غيتاني، والتي بلغ عددها، بحسب عبد الله العروي، (145) خطأ؛ ومن ثَمَّ فهي، على حدّ قوله، ترجمة جديدة؛ والثاني أنّ عبد الله العروي يرغب في إطلاع القارئ العربي لأوّل مرة على النص الأصلي لـ(الإيديولوجيا العربية المعاصرة) في طبعته العربية (ص 185-187).
لا شك أنّ هناك ما يشفع لعبد الله العروي هذين المبررين، مادام هو المؤلف الأول لكتاب (الإيديولوجيا العربية المعاصرة) باللغة الفرنسية؛ ومن ثَمَّ، يُفترض أنه المؤهل، أكثر من أيّ ترجمان آخر، لأن يترجمه إلى اللغة العربية، ما دام هو الأعلم بمضامينه، ما ظهر منها وما بطن، ولا تخفى عليه خافية.
الواقع أنّ عبد الله العروي، في ترجمته لمؤلَّف (الإيديولوجيا العربية المعاصرة)، ولو كانت ترجمة ذاتية، هناك على الأقل وسيطان بينه وبين مؤلّفه: الأول هو الزمن والثاني هو اللغة. فأمّا الأول فيكمن في كون المسافة الزمنية بين كتاب (الإيديولوجيا العربية المعاصرة) في طبعته الفرنسية سنة (1967)، وفي طبعته العربية سنة (1970)، وبين ترجمة عبد الله العروي لهذا الكتاب سنة (1996)، مسافةً تقارب ثلاثين سنة؛ أي ما يزيد على ربع قرن، مع ما تحيل عليه هذه السنون من أحداث بالغة الأهمية، أعادت النظر في كثير من المفاهيم التي يتضمّنها الكتاب، من قبيل مفهوم الإيديولوجيا ومفهوم الماركسية، فضلاً عن مفهوم الليبرالية والفكر الكوني (ص 187)، ولعل أبرز هذه الأحداث سقوط جدار برلين (ص 189). أما توسط اللغة، الذي لا يقل أهمية عن توسط الزمن، فيتمثل في لغة الترجمة التي تجعل من النص ينتقل من لغة إلى أخرى، وما يستتبع هذا الانتقال من اختلاف المجال التداولي واختلاف المتلقين.
بناء على هذين الوسيطين، ينفلت النص المترجم من سلطة الترجمان ومن رقابته، ولو كان النص نصه والترجمة ترجمته؛ ذلك أنّ للترجمة مفعولاً يتجاوز ذات المؤلف، وذات الترجمان، ويجعلهما مجرد قارئين من القراء ولا سلطة لهما على فعل القراءة وفعل التأويل، ولعل هذا ما يبرر استغراب عبد الله العروي من كون الترجمة الأولى لمؤلف (الإيديولوجيا العربية المعاصرة)، التي أنجزها محمد غيتاني، ما فتئت توجه قراءة الكِتَاب، على الرغم من استدراكات المؤلف وتنبيهاته وإشاراته فيما بعد (ص 189-191)، وهو ما يعني أن لا فرق بين الترجمة الذاتية والترجمة الغيرية، ما دام لا سبيل لاسترجاع النص الأصلي، ومحو مختلف التوسطات بيننا وبينه، وخاصة إذا علمنا أن هذا النص لا ينفصل عن مؤلفه وترجمانه فحسب، بل ينفصل عن نفسه أيضاً، عندما ينتقل من حقبه إلى أخرى، ومن لغة إلى أخرى (ص 195).
وإذا كان الشكل الأول من شكلي التصور الميتافيزيقي للترجمة مهووساً بالحفاظ على الأصل، وهو الذي ضربنا عليه مثال عبد الله العروي في ترجمته لكتابه (الإيديولوجيا العربية المعاصرة)، فإن الشكل الثاني للتصور الميتافيزيقي للترجمة هو الذي يقر باستحالتها أو على الأقل بحدودها، مهما بلغ شأوها، وهو التصور الذي نجد له مثالاً في كتاب (الحيوان) وكتاب (البيان والتبيين) للجاحظ.
نستفيد من كتابي الجاحظ المذكورين، ولا يُلْزِمُ هذا الموقف الجاحظ بالضرورة نظراً للطبيعة الحوارية لمؤلفاته، أنّ الأصل أشرف من الترجمة، وأنّ الترجمان محكوم عليه بالتقصير، ما دام يَعِزُّ عليه الإحاطة التامة بلغتين فأكثر، وهو ما يشهد عليه القول الآتي من كتاب (الحيوان): «إن الترجمان لا يؤدي أبداً ما قال الحكيم، على خصائص معانيه، وحقائق مذاهبه [...] وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها، والإخبار عنها عن حقّها وصدقها، إلا أن يكون في العِلم بمعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وتأويلات مخارجها، مثل مؤلف الكتاب وواضعه؟ فمتى كان -رحمه الله تعالى- ابن البطريق، وابن ناعمة، وابن قرة، وابن فهريز، وثيفيل، وابن وهيلي، وابن المقفع، مثل أرسطوطاليس؟ ومتى كان خالد مثل أفلاطون»[3]، وهو ما يؤكده كذلك ما جاء في كتاب (البيان والتبيين)، حيث يقول الجاحظ: «واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كلّ واحدة منهما الضيم على صاحبتها»[4].
يتبين من الاقتباسين السالفين، أن الترجمة تتراوح بين حالتين تصادران معاً على حدودها: فهي إما قاصرة، وإما مستحيلة؛ يكون محكوماً عليها بالقصور عندما يتعلق الأمر بترجمة النثر، سواء كان هذا النثر حكمة (فلسفة) أم كلاماً مقدساً (قرآناً)، وتكون مستحيلة عندما يتعلق الأمر بترجمة الشعر، بما هو كلام موزون ومقفى، حيث يفسد شكله، ويضيع معناه، عندما ينقل إلى لغة أخرى، وفي ذلك يورد الجاحظ القول الآتي: «الشعر لا يستطاع أن يترجم، ولا يجوز عليه النقل. ومتى حوّل تقطع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب»[5].
حاصل القول إنّ التصور، الذي يعرضه الجاحظ في كتابي (الحيوان) و(البيان والتبيين)، مشروط بخلفية أخلاقية للترجمة، تحاكم كل ترجمة، كيفما كانت، بمعيار الوفاء والخيانة، والأصل والنسخة، فيكون كل مقبل عليها مخلاً بها ضرورة؛ ما يعني أن النص الأصلي يحظى بمنزلة الشرف بالمقارنة مع النص المترجم، الأمر الذي يجعل من المؤلف يتربع على عرش المعنى بالمقارنة مع الترجمان الذي يظل محكوماً عليه بالدرك الأسفل، وهذا لعمري طرح ميتافيزيقي مشروط ببنية أفلاطونية جلية.
2- الترجمة ومجاوزة الميتافيزيقا
في مقابل الطرح، الذي يجعل من أمر الترجمة موضوعاً للشبهات، ويجعل من الترجمان متهماً وصاحب مسؤولية جليلة، لا يستطيع إلى النهوض بها على أكمل وجه، مهما بلغت كفاءته، نجد أن الطرح المعاصر للترجمة يرى أنّ هذه سبيل من سبل المثاقفة، التي هي بالتعريف ليست محواً للآخر أو التطابق معه أو استلابه أو استيعابه، وإنما هي الاعتراف باختلافه ومغايرته وفَرادته، الأمر الذي يجعل من الترجمة لا تستنكف من الغرابة محاولة القضاء عليها وإحلال الألفة محلها، وإنما تستحضرها، معتبرةً إياها في حُكْمِ ما لا يقبل الترجمة، أي ما يشهد على الاختلاف والمغايرة، باعتبارهما أُسَّي المثاقفة، وهي مطلب لا يمكنه أن يتحقق ما لم يتم الكفّ عن إلغاء الاختلاف بين الذات والآخر من خلال «جر الآخر نحو الذات، أو إذابة الذات في الآخر» (ص 103)، حيث تكون المهمة الأساس للترجمة هي «توليد القرابة واستبعاد الغرابة» (م.س).
إن اللغة، كيفما كانت، من منظور غوته، تستمد قيمتها من طابعها الخاص الذي يشهد عليه ما لا يقبل الترجمة، والذي يحيل على عدم إمكانية التطابق بين الذات والآخر، واحترام الاختلاف بينهما (ص 105)، وهو الاختلاف الذي بموجبه تتحقق المثاقفة، من خلال جعل الغرابة تجد موطئ قدم داخل اللغة المترجَم إليها (ص 109)؛ فيحدث، إذّاك، تعايش الذات والآخر، والألفة والغرابة، بدل محاولة كل منهما محو الآخر والقضاء عليه، وهو ما يوضحه عبد السلام بنعبد العالي مؤكداً أن الترجمة «إبداع متواصل، وأنها لا يمكن أن تكون الآخر ذاته (le même de l’autre). وأنها ليست هي النص الذي كان سيكتبه المؤلف لو أنه تكلم لغة المترجم. وأن المسافة بين الذات والآخر لا يمكن أن تلغى إلغاء تاماً، وأن النص المترجم ما يفتأ يعلق، وأن كل ترجمة تظل شفافة لا تستبعد النص المترجم ولا تصبح بديلاً عنه» (ص. 105).
وتجدر الإشارة إلى أن ما لا يقبل الترجمة يتخذ مفهومين متعارضين: يسلم المفهوم الأول بأن ما لا تقبل ترجمته هو ما تتوقف الترجمة عاجزة إزاءه؛ أي ما تتوقف عنده الترجمة إمكاناً؛ أي هذا الذي يمثل حدود الترجمة؛ بمعنى آخر، إن الأصل في المفهوم الأول للترجمة أنها ممكنة، لكن يحدث أن تعترضها عقبات وحدود، الأمر الذي يجعل الترجمة في بعض الأحيان متعذرة على الرغم من التسليم المبدئي بإمكانها (ص 173). في حين أن المفهوم الثاني للترجمة لا يرى أن ما لا يقبل الترجمة هو ما تقف عنده الترجمة إمكاناً فقط، وإنما ما لا يقبل الترجمة هو الذي ما ننفك من ترجمته بصفة لا نهائية (infiniment traduisible) (ص 175).
يترتب على هذين المفهومين للترجمة نتيجتان مختلفتان؛ ذلك أن المفهوم الأول للترجمة يقيم تقابلاً بين ما يقبل الترجمة وبين ما لا يقبل الترجمة؛ أي بين الترجمة إمكاناً والترجمة استحالةً، الأمر الذي يجعله يفاضل بين طرفي هذا التقابل، حيث يبقي على ما يمكن ترجمته، ويبعد ويهمش، بل يحط من شأن، ما لا يقبل الترجمة. وعلى خلاف المفهوم الأول عن الترجمة، نجد أن المفهوم الثاني يسلب التقابل بين ما يمكن ترجمته وما لا يمكن ترجمته، حيث يرى أنّ «ما ينبغي ترجمته هو بالضبط ما لا يقبل الترجمة» (م. س)؛ أي إن ما لا يقبل الترجمة هو الذي ما نفتأ نترجمه، نظراً لتمنعه وتنطعه وغرابته وعناده ومقاومته؛ إذ لا «استحالة -يقول عبد السلام بنعبد العالي- إلا عند الطلب والسعي، ولا تمنع إلا عند الرغبة والاشتياق، بل لا رغبة ولا شوق إلا حيث يغلب الصد والتمنع والإعراض» (ص 181).
يتبين إذن أنه، في مقابل المفهوم الأول، الذي يضع الاستحالة طرفاً نقيضاً للإمكان، نجد أنّ المفهوم الثاني يجعل من المستحيل إمكاناً (ص 173). وعليه، إذا كانت السياسة في نظر البعض هي «عمل يهدف إلى أن يجعل المستحيل ممكناً» (ص 181)، فإنه يجوز لنا الحديث عن سياسة الترجمة، من حيث إنها، بناء على الطرح الثاني، هي الترجمة اللامتناهية لما لا يقبل الترجمة؛ أي ما يجعل الترجمة ضرورة لا محيد عنها، وليست مجرد إمكان محكوم عليه بالاستحالة (م.س).
ويكمن جوهر الاختلاف بين الطرحين في تصورهما حول اللغة؛ إذ بينما يرى المفهوم الأول أن اللغة مجرد وسيلة للتواصل لا يتعدى دورها التبليغ والإخبار والتفاهم، فتصير بذلك الترجمة ليست إلا نقلاً من لغة إلى أخرى؛ ومن ثَمَّ إن كان هناك من سوء تفاهم أو تبليغ أو نَقْل أو وقوف عند ما تتعذر ترجمته، فإنّ مرده إلى عدم الاستعمال الجيد للغة (ص 177).
على خلاف مفهوم اللغة هذا، كما نجده في الطرح الأول بشأن الترجمة، نجد الطرح الثاني لا ينظر إلى اللغة باعتبارها مجرد وسيلة وأداة محايدة للتواصل، وإنما هي، في الواقع، لا تخلو من فعل، من حيث إنها تظهر وتخفي، وتوحد وتفرق، ولاسيما أنها تستعمل من طرف ذوات، وهذه بدورها مشروطة بأزمنة وأمكنة مختلفة، الأمر الذي يجعل من قضية المعنى ليس مردها إلى بنيات لغوية بسيطة وثابتة، وإنما مشروطة ببنية معقدة ومتغيرة، وتتداخل فيها أطراف متعددة تتراوح بين الكاتب والقارئ والمترجم، وهي ذوات محكومة بسياقات مختلفة من جهة الأزمنة ومن جهة الأمكنة، وهو ما يجعل الترجمة مجالاً لإنعاش الاختلاف والتعدد، وليس مجالاً للتطابق والوحدة.
وقد ترتّب على الوعي بخاصة الترجمة هذه ظهورُ مؤلفات مزدوجة اللغة تضع النص مقابل ترجمته وجهاً لوجه، وفي ذلك اعتراف باختلاف اللغات، ونأي عن المفاضلة القيمية بينها، فضلاً عن توسيع هامش التلقي، من خلال تمكين القراء من إنتاج نص ثالث، يمتح من النص وترجمته، ما دام كل منهما يظل شفافاً، ويحيلان على بعضهما ضرورة، ولعل هذا ما اهتدى إليه عبد السلام بنعبد العالي في مؤلفه الموسوم بعنوان (في الترجمة)؛ إذ بعدما ألفه باللغة العربية سنة (1998)[6] أعاد نشره سنة (2006) بلغة مزدوجة تتراوح بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، فضلاً عن نشره مؤلفه الموسوم بعنوان (ضيافة الغريب) سنة (2006) مزدوج اللغة كذلك[7]، وكأني بعبد السلام بنعبد العالي يتوسل بلغة مغايرة، وهي هنا اللغة الفرنسية، لكي يفجر إمكانات أخرى لا تستطيع إليها اللغة العربية سبيلاً.
بناء عليه، إن الطرح المعاصر للترجمة يستثمر الاختلاف بين اللغات ليس من أجل المفاضلة بينها والانتصار للغة على حساب أخرى، وإنما من أجل إخصاب المعنى والثقافة والذات والآخر على حد سواء، وتفجير الإمكانات المطمورة، وفي ذلك يقول غوته: «علينا أن نفحص ما تستشعره أنفسنا إزاء العمل المترجم، ونرى إلى أيّ حدٍّ يكون في إمكان هذه القوة الحية أن تستثير قوتنا وتخصبها» (ص 179)؛ وهو ما يعني أن للترجمة مفعولاً يجعل من لغة الترجمة تكشف عن إمكانات لم يكن لنا عهد بها (م.س)، وهو الشعور الذي يعبر عنه أمبرتو إيكو بالقول: «كنت أشعر بأن نصي يكشف عند لقائه بلغة أخرى عن إمكانات وطاقات تأويلية طالما ظلت خفية وغائبة عني» (م.س).
يتبين إذن أنه على خلاف التصور التقليدي الميتافيزيقي للترجمة المشروط بخلفية أخلاقية تقيم تفاضلاً بين الأصل والنسخة، من حيث إنه يعلي من شأن الأول، ويحط من شأن الثانية، نجد أن التصور المعاصر للترجمة يقوض هذه المسلمات الميتافيزيقية، جاعلاً بذلك من الترجمة فعلاً مبدعاً وخلاقاً، بل سبيلاً لمجاوزة الميتافيزيقا.
فإذا كان الطرح التقليدي للترجمة يتأسس على البنية الأفلاطونية، فإن الطرح المعاصر يتأسس على قلب هذه البنية (ص 41)؛ أي الانتقال من ميتافيزيقا الترجمة إلى ترجمة الميتافيزيقا؛ وهو ما يعني الانتقال من الانهمام بالحفاظ على الأصل والهوية والوحدة والثبات، إلى إعادة الاعتبار إلى النسخ والاختلاف والتعدد والتغير. وفي هذا الصدد، ينبهنا عبد السلام بنعبد العالي إلى أن قلب الأفلاطونية لا يعني، كما يزعم مارتن هايدغر، «إحلال عالم المحسوسات محل عالم المعاني، وإنما هو الإعلاء من النسخ السيمولاكر على حساب النسخ الأيقونة» (م.س).
بناء على ذلك، تصير الترجمة على الحقيقة، في نظر جاك دريدا ومارتن هايدغر، عملية تحويل (ص 35)، وهي عملية لا تتم في اتجاه واحد، وإنما في اتجاهين: ذلك أنها تحويل للنص المترجم، فضلاً عن تحويلها إلى لغة الترجمة على حد سواء[8]؛ إن الترجمة إذاً ليست خيانة للأصل والهوية، وإنما هي خلخلة لكل ادعاء من هذا القبيل، إنها خلخلة للمسلمات الميتافيزيقية التي تشلّ حركة الفكر، عن طريق الخلخلة وتوليد الفوارق والاختلاف والانفصال والغرابة، في الوقت الذي تسعى فيه الميتافيزيقا إلى الحفاظ على الوحدة والتطابق والاتصال والوحدة.
إن للترجمة إذاً أهمية لا تقل عن التأليف؛ ذلك أنها كتابة إبداعية (ص 33) تحتاج إلى إعمال الفكر؛ فأن نترجم إذاً ليس معناه أن ننقل معنى من لغة إلى أخرى، بل معناه أن نبدع وأن نفكر؛ أن نبدع في لغة الترجمة، وأن نفكر في المسكوت عنه، كاشفين عن الفوارق والخلل والنقص.
يتضح، من ثَمَّ، أن الطرح المعاصر للترجمة يسلب التقابل الميتافيزيقي بين المؤلف والترجمان؛ ذلك أنّ هذا بدوره مؤلف في لغة أخرى، مثلما أن المؤلف كذلك لا ينفك عن الترجمة، إذا علمنا أن النص الذي ينتجه هو في الواقع تناص أو ما يسميه موريس بلانشو «الترجمة الخاصة بالنص الأصلي» (ص 29)؛ وهو ما يعني أن الترجمة ليست عملاً ثانوياً يأتي بعد النص، بل يعني أساساً أنه في البدء كانت الترجمة، إلى الحد الذي يتساءل فيه جاك دريدا قائلاً: «ماذا لو بدأنا جملة (أساساً) بالترجمة»[9]، للتأكيد على أن فعل الترجمة ليس حدثاً طارئاً، بل إنه ضرورة حياتية نابعة من محدودية وجودنا أفراداً؛ ومن ثمة فهو فعل يقتضي منا وجوب الانخراط فيه[10]، ولعل الفلاسفة كانوا على وعي بأهمية الترجمة، بله ضرورتها، لذلك كان أعظم الفلاسفة تراجمة، وحسبنا الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى جاك دريدا ومارتن هايدغر وجيل دولوز وميشيل فوكو وغيرهم.
فضلاً عن ذلك، تجدر الاشارة إلى أن الترجمة، أو قل الترجمات بالأحرى، كما يؤكد والتر بنيامين، هي التي تشكل «تاريخ النص» (ص 291)، وهو ما يعني أن الترجمة هي التي تجعل النص ما يفتأ يبتعد عن أصليته، عن الأصل بمعناه الأول، الأصل المؤسس، أي عن «اللحظة الممتازة التي تتحدد فيها الخصائص وتتعين فيها الهوية، اللحظة التي تتخذ فيها الأشياء صورتها الثابتة التي تسبق كل ما سيعرض وسيتعاقب» (ص 289-291). وفي مقابل هذا الأصل، الذي تسعى الميتافيزيقا لتقديسه، حيث تعلي من شأن العلل الأولى والغايات القصوى، نجد الترجمة تعمل ضد هذا الأصل، من خلال إرباكها للثابت، وتحريكها للساكن، وتجزيئها للموحد، وتفكيكها للمتطابق (ص 291)، أو قل إن الترجمة ترفع صفة القداسة والطهرانية على الأصل، من خلال تفجير إمكاناته غير المتوقعة (ص 295).
إن الترجمة، بمعنى آخر، هي التي تكشف عن تاريخية النص، وتقوض سلطته الأصولية، وكل ادعاء للاكتمال؛ وهو ما أكد عليه والتر بنيامين، مبرزاً أن الترجمة هي التي «تزحزح الأصل عن موقعه وتجعله يفحص عن حنين إلى ما يتمم لغته ويكمل نقصها» (ص. 291)؛ أي أن الترجمة استئناف جديد للبدء، استئناف مبدع يجعل من الأصل ما فتئ يتأسس ويدوم ويرقى (ص 293). غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الارتقاء هنا ليس بالمعنى القيمي (ص 313)؛ أي ليس معناه أن النسخة أفضل من الأصل، وأن الترجمان أفضل من المؤلف، بل يعني أساساً أن الفاعل في الترجمة على الحقيقة هو التاريخ الذي يقوض سلطة المؤلف والترجمان على حد سواء، ويجعل من النص نصوصاً ما فتئت تكتمل، ومن الأصل أصولاً ما فتئت تتعدد، ومن البداية بدايات ما فتئت تستأنف وتتجدد.
يترتب على هذا الطرح المعاصر جعل الترجمة أداة للتحديث (ص 159)، ليس بما هو حركة اجتماعية تهدف إلى تغيير المؤسسات والأوضاع والبنيات، وإنما بما هو موقف معين من الكائن، ومفهوم مخصوص عن الزمان (ص 151)، يختلفان بشكل جذري عن التقليد؛ فإذا كان التقليد يتأسس على الاتصال والهوية والثبات، فإن التحديث يتأسس على الانفصال والاختلاف والصيرورة، ما يجعل التحديث موقفاً مغايراً للتقليد، موقفاً يجعل الاتصال انفصالاً، والهوية اختلافاً، والثبات صيرورة.
فأن تكون الترجمة وسيلة للتحديث معناه أنها وسيلة لإقحام الاختلاف في الهوية، والانفصال في الاتصال، والصيرورة في الثبات، والغرابة في الألفة، وليس وسيلة للحفاظ على الهوية، ومحو الاختلاف، والقضاء على المغايرة، والإبقاء على الأصل، وتحري الألفة[11]؛ وهو ما يعني تجاوز الطرح التقليدي للترجمة المشروط بفلسفة الذات والحضور والاتصال، نحو طرح معاصر للترجمة مشروط بفلسفة الاختلاف والمغايرة والانفصال.
خاتمة
يتحصل مما تقدم، أنّ الترجمة ليست فحسب موضوعاً من موضوعات التفكير الفلسفي، وإنما هي، تحديداً في الفلسفة المعاصرة، تنهض بمهمة الفلسفة ذاتها، من حيث إنها تفكك الأصول، وتقوض البداهات، وتخلخل الثوابت؛ الأمر الذي يجعل استراتيجيات الترجمة تتحد باستراتيجيات الفلسفة المعاصرة.
إن الفصل بين الترجمة والفلسفة فصل يصادر على المطلوب، من حيث إنه يرى أن مجال الفلسفة هو مجال الحقيقة والأصول والهوية، في حين أن مجال الترجمة هو مجال الوهم والنسخ والاختلاف؛ أي أن الفصل بين الترجمة والفلسفة هو فصل ميتافيزيقي محكوم ببنية أفلاطونية تقيم تقابلاً بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات، فترفع من شأن الأول وتحط من شأن الثاني.
إن التفكير الفلسفي في الترجمة هو من صميم الفكر المعاصر، الذي يسعى لمجاوزة الميتافيزيقا، متمثلةً في فلسفة الذات والحضور، باعتبارها فلسفة مهووسة بالحفاظ على الاتصال والوحدة والهوية والتطابق والنسق، نحو فلسفة تنشد الاختلاف والتعدد والمغايرة والمثاقفة التي صارت مطلباً كونياً؛ إذ لا محيد لنا عن الانفتاح على الآخر المخالف لنا والاعتراف بمغايرته وفرادته، وهو اعتراف من شأنه أن يعيد النظر في ذواتنا وفي العالم من حولنا.
يرجع إلى عبد السلام بنعبد العالي الفضل في التفكير في موضوع الترجمة، ليس باعتبارها موضوعاً للأدب أو اللسانيات، وإنّما باعتبارها موضوعاً فلسفياً بامتياز، موضوعاً لا يقع على هامش الفلسفة، وإنما هو مبدأ الفلسفة ومنتهاها، مادامت الترجمة ترفع القداسة والطهرانية عن الأصول والمعاني، فاتحة إياها على إمكانات لا عهد لنا بها، إمكانات تتعدى المؤلف والمترجم والنص واللغة.
تكمن جدة الطرح الفلسفي المعاصر للترجمة في كونه لا ينظر إلى الترجمة باعتبارها نقلاً من لغة إلى أخرى، نقلاً يتولاه مترجم يتحمل مسؤولية جليلة، مسؤولية لا يستطيع إليها سبيلاً مهما بلغت كفاءته، فيظلّ محكوماً عليه بالخيانة والإخلال، وإنما باعتبار الترجمة إبداعاً في لغة أخرى، بما يقتضيه الإبداع من تفكير خارج ثنائية الأصل والنسخة، والمؤلف والترجمان، والذات والآخر.
يفكر عبد السلام بنعبد العالي في الترجمة خارج الثنائيات المؤسسة للميتافيزيقا؛ أي الأصل والنسخة، الوفاء والخيانة، المعقول والمحسوس؛ أي أنه تفكير فلسفي معاصر يهدف إلى مجاوزة المتيافيزيقا، وليس تفكيراً إيديولوجيّاً ينظر في الترجمة باعتبارها نظرية في الاستلاب والاغتراب.
[1]- مجلة تأويليات العدد 3
[2]- يقول عبد السلام بنعبد العالي في هذا الشأن: «مهمة المترجم وقيمته تتجليان في مدى قهره للصعوبات التي يطرحها تعدد اللغات، وتباين الثقافات، وذلك بأن ينتج نصاً يكون طبق الأصل. مهمته أن يقهر المسافة التي تفصل النص الأصلي عن ترجمته، والأصل عن نسخته، وأن يمحو اسمه ليسمح لكاتب النص الأصلي أن يتكلم بلغة أخرى من دون أن يفقد هويته. يريد المترجم أن يكتب النص باسم كاتبه، أن يكتبه من دون أن يوقعه، يريد أن يتدخل من دون أن يتدخل، وأن يظهر ليختفي». المصدر نفسه، ص25
[3]- عبد الفتاح كيليطو، لن تتكلم لغتي، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2012، ص32
[4]- المرجع السابق، ص29
[5]- المرجع السابق، ص ص34-35
[6]- عبد السلام بنعبد العالي، في الترجمة، سلسلة شراع، العدد 40، فاتح تشرين الأول/أكتوبر، طنجة، 1998
[7]- تجدر الإشارة إلى أن كلاً من كتابي (في الترجمة) و(ضيافة الغريب) قد ترجمهما إلى اللغة الفرنسية كمال التومي، وراجع هذه الترجمة عبد الفتاح كيليطو، وقد صدرا معاً في الجزء الرابع من الأعمال تحت عنوان: (كتابات في الترجمة).
[8]- يقول عبد السلام بنعبد العالي في هذا المقام: «بفضل هذا التحويل، فإن كثيراً من المؤلفات تكتسب أهمية يعجب لها الأدب الذي كانت تنتمي إليه في البداية، وتتخذ خصائص لم يكن ذلك الأدب يعترف لها بها. وهكذا -كما يقول بلانشو- «يعجب الفرنسيون للتأثير الذي أحدثه كتابهم الواقعيون (وخصوصاً موباسان) في كتاب أجانب يظهرون أبعد ما يكونون عن الواقعية. وهكذا نتعجب عندما نعرف أن فلوبير كان معلماً لكافكا». المصدر السابق، ص35
[9]- محمد موهوب، ترجمان الفلسفة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط1، 2011، ص27
[10]- محمد موهوب، المصدر السابق، ص28
[11]- يقول عبد السلام بن عبد العالي في هذا المعرض: «ذلك أننا غالباً ما لا نعتبر الترجمة ناجحة موفقة إلا إن هي استطاعت أن تلغي الاختلاف الثقافي واللغوي فتنقل النص من لغة إلى أخرى من غير أن يبدو أنه انتقل. إننا لا نعتبر الترجمة ناجحة إلا إذا بدا النص وكأنه «نسخة طبق الأصل»، إلا إذا بدا و«كأنه لم يترجم»، إلا إذا بدا وكأنه ينطق لغتـ«نا»، ويفحص عن ذواتـ«نا»، وينتمي إلى ثقافتـ«نا». إننا نتوخى أن تكون الترجمة من التماهي بحيث تظهر أنها ما كان المؤلف سيكتبه لو أنه كتب باللغة المترجمة، ونطلب من المترجم أن يكتب النص باسم كاتبه، أن يكتبه من غير أن يوقعه، نطلب منه أن يمحو اسمه ليسمح لكاتب النص الأصلي أن يتكلم لغة أخرى دون أن يفقد هويته». عبد السلام بنعبد العالي، كتابات في الترجمة، مصدر سابق، ص153