في العلاقة بين الديني والسياسي لماذا استمرت المشكلة وتأخر الحل؟
فئة : مقالات
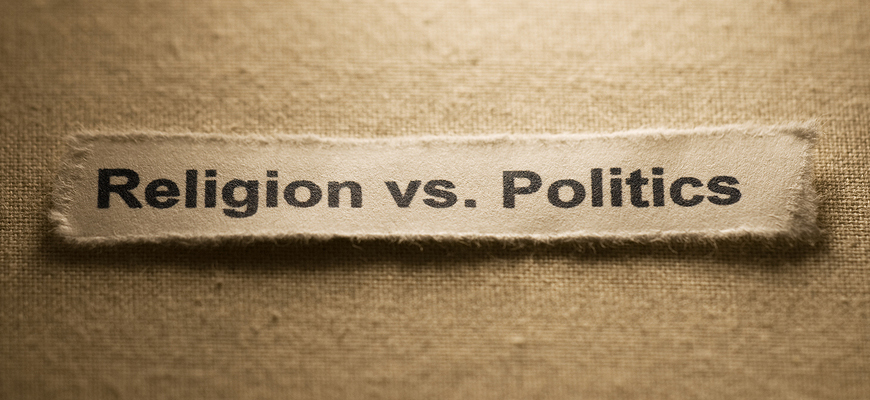
لماذا استمرت مشكلة العلاقة بين الديني والسياسي في التاريخ العربي الإسلامي الحديث في الوقت الذي ظننا فيه أنها قد حسمت، لاسيما بعد نشأة الدولة الوطنية الحديثة في بعض البلدان العربية الإسلامية على الأقل؟
ذلك لأن الواقع العربي الإسلامي قد كان في الحقيقة بخلاف ذلك بعيدًا عن منطق الحسم، لأنّ الشرعية السياسية الجديدة لم تكن محلّ إجماع في أيّة لحظة من التاريخ العربي الإسلامي الحديث، وحتى زعماء الإصلاح في القرن التاسع عشر لم يكونوا يجرؤون رغم تبنيهم لمقولات الفكر السياسي الحديث على التشكيك في شرعية الخلافة، كما أن الشرعية الوطنية الناشئة بعد سقوط الخلافة، لم تكن تمثل - رغم عجز الواقع السياسي العربي الإسلامي عن إعادة بعثها- سوى طيف واحد بين أطياف من الشرعيات التقليدية القديمة كالدينية والقبلية والعسكرية. وهكذا ظل الصراع قائمًا بين الشرعيتين الدينية والمدنية في مختلف مراحل ذلك التاريخ.
فبعد الانقسام المشهود إثر سقوط الخلافة بين المؤيدين والرافضين لها، كانت حركة الإخوان المسلمين بالمرصاد للدولة الوطنية الحديثة، كما كان أنصار الجامعة الإسلامية في تنافس مع دعاة الحركة القومية، ثم ما فتئت حركات الإسلام السياسي أن دخلت في مواجهة وصدام مع الأنظمة العربية القائمة، والصراع مستمر إلى يوم الناس هذا. هكذا ظلت العلاقة بين الديني والسياسي علاقة تدابر وتنافر طوال التاريخ العربي الإسلامي الحديث، مما يدعو إلى تدبر الأسباب والعوامل التي حالت دون الحسم في هذه المسالة ودون إرساء علاقة واضحة المعالم بين الديني والسياسي تستجيب لواقع المجتمعات العربية الإسلامية، وتتناغم مع تطور الأوضاع السياسية محليًا ودوليًا.
ظلت العلاقة بين الديني والسياسي علاقة تدابر وتنافر طوال التاريخ العربي الإسلامي الحديث
إن من أهم العوامل الحائلة دون الحسم في هذه المسألة ما ترسب في الذاكرة الجمعية من مخلفات الأنموذج القديم للعلاقة بين الديني والسياسي، وهو أنموذج العلاقة الاندماجية التي تواصل وجودها عبر التاريخ الإسلامي إلى سقوط الخلافة العثمانية، ذلك أن السلطة التي وقع تكريسها طوال عدة قرون قد قامت باسم الدين، ثم سرعان ما تقمصت شكل الملكية الوراثية المسنودة والمدعومة بالمسوغات والمبررات الدينية، وهو ما نظر إليه الفقهاء بنظام الخلافة. وقد ظل حلم العودة إلى ذلك النظام يراود الضمير العربي الإسلامي الحديث بين الفينة والأخرى، إذ لم يكن من السهل محو إرث عدة قرون في ظرف زمني لم يناهز القرن بعد، لاسيما أن ذلك النظام قد تزامن مع قوة الأمة الإسلامية وأهمية موقعها على الساحة العالمية، بينما كان الحلم ضربًا من الهروب من واقع الضعف والتخلف.
ومع ذلك، وجدت محاولات تتناول المراجعة لهذه العلاقة تحت ضغط الواقع المحلي والدولي وفي ظروف متأزمة. وقد أفرزت تلك المحاولات أطروحات لم تفِ بالغرض على الوجه المطلوب نظرًا لتأزم الأوضاع التي طرحت فيها، ولأنها كانت أطروحات منقوصة يغلب عليها الطابع السجالي والإيديولوجي، ولم تنبنِ على التدبر والتدارس المعرفي العميق، وإن كانت قد أحرزت فضل المبادرة بإثارة المشكل، وتقدمت بالوعي الجمعي إلى ملامسة الإشكال المترتب عن طبيعة الانتقال من علاقة موروثة إلى أخرى مستجدة.
وقد كان أول طرح لهذه المراجعة إبان عصر النهضة وقبيل سقوط الخلافة العثمانية على يد زعماء الحركة الإصلاحية، ولكنه كان طرحًا تلفيقيًا يهدف إلى الجمع والتوفيق بين مقولات ومؤسستين شرعيتين مختلفين؛ دينية قديمة، وسياسية حديثة دون اعتبار لأصولهماالتاريخية وللسياقات الحضارية التي أفرزتهما. فتجاورت الشورى في ذلك الطرح مع الديموقراطية وأهل الحل والعقد مع المجالس النيابية والبيعة مع الانتخاب، وغير ذلك من الأزواج المتشابهة في الظاهر والمتمايزة في حقيقتها وأصولها، مما نأى بتلك المفاهيم عن جوهرها وعن التمثل السوي، وازدادت به تلك العلاقة إشكالاً.
وقد شهدت تلك العلاقة طرحًا ثانيًا بعد سقوط الخلافة العثمانية، سواء من قبل المدافعين عنها أو المناصرين لفكرة الفصل بين الدين والدولة، ولكن ذلك الطرح قد اكتسى منذ انطلاقه طابعًا إيديولوجيًا وسجاليًا، وشكل استقطابًا بين موقفين، وتوظيفًا انتقائيًا للتراث الديني والسياسي دون تدبر معرفي وقراءة نقدية للتاريخ ودراسة لراهن المجتمعات العربية الإسلامية، مما تعذرت معه صياغة تصور ملائم لتلك العلاقة، تلتقي حوله مختلف وجهات النظر.
وهكذا لم يدرك كل من الطرحين الغاية المنتظرة منهما للأسباب التي ذكرنا أولاً، ثم بسبب الإطار الثقافي العام الذي أجري الطرح في كنفه ثانيًا، وهو إطار النخبة المثقفة والمشتغلة بمعزل عن الجمهور الواسع، مما ضاقت بسببه دائرة الجدل وتقلص فضاء الوعي وعمل على تأجيل الحسم في جوهر العلاقة موضوع النظر.
وقد استمر ذلك الطرح الإيديولوجي والسجالي، ليتخذ شكلاً ثالثًا مع ظهور حركة الإخوان المسلمين، وقد تمثل ذلك الطرح في تغليب الديني على السياسي من ناحية، وفي نشر الدعوة لذلك المنهج ترغيبًا وترهيبًا، وهو المنهج الذي توخته غالبية طوائف الإسلام الحركي في التاريخ العربي الإسلامي الحديث والمعاصر. وقد آل ذلك الطرح إلى المناداة بالحكومة الدينية استنادًا إلى نظرية الحاكمية. ومهما تفاوتت حظوظ ذلك الطرح من التكيف والتأقلم مع خيارات الفكر السياسي الحديث، فإنه قد ظل متمسكًا بالانغلاق على ثوابته مما أضحى معه قاصرًا عن إرساء علاقة موضوعية ومتكافئة بين الديني والسياسي، ومما استفحل معه انخرام تلك العلاقة وقوف تلك الحركات الإسلامية موقف المعارضة للسلطة المدنية القائمة.
إلا أن تلك العوامل النظرية والثقافية لم تكن لتتحمل وحدها مسؤولية استمرار المشكلة وتأخر الحل، وذلك لأن الدولة الوطنية الحديثة فضلاً عن أنها لم تكن نابعة من إرادة شعبية واعية بقدر ما كانت أشبه بالأمر الواقع، لم تكتس كل أبعادها الحداثية، وعطلت مؤسساتها عن الاشتغال بصفة طبيعية، ثم إنها لم تحسم مسألة العلاقة بين الديني والسياسي بشكل واضح؛ فحتى الدساتير المعتمدة لم تكن تخلو من التباس. هذا بالإضافة إلى فشل المشاريع التنموية الوطنية، سواء منها الليبرالية أو الاشتراكية وعجزها عن توفير الثروة والعدالة الاجتماعية في الوقت الذي كانت فيه الثروات البترولية تبدد لغايات أخرى، فلم تتمكن من القضاء على الفقر والأمية، إذ لم تراهن بصفة جدية على العلم والثقافة، ولم تبلغ بتحديث التعليم إلى مداه المطلوب، كما لم تتمكن هذه الدولة الوطنية من إرساء البدائل السياسية المدنية الأخرى كالبديل القومي، وانحصارها في كنف الحدود القطرية الضيقة، كل ذلك أسهم في زعزعة الثقة في أنموذج الدولة الحديثة.
إلا أن جزءًا مهمًا من مسؤولية تأخير الحل تتحمله مناورات القوى الدولية التي أسهمت في تعميق الإشكال وتأجيج الصراع الإيديولوجي الداخلي بين الفرقاء وتوتير العلاقة بين الديني والسياسي من أجل مصالحها المرتبطة بالهيمنة على الثروات العربية. فكانت ولا تزال تتوخى سياسة المكيالين وتصنع الشيء وضده؛ فهي التي دمرت الخلافة من ناحية وأوهمت الشريف حسين بإعادة بعثها من جديد في بلاد الشام، وهي التي أيدت الدولة الوطنية وآوت الحركات الإسلامية المناهضة لها، وهي التي ناورت وساومت، ولا تزال باسم العولمة وصراع الحضارات وباسم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان. وذلك علاوة على مساندتها اللا مشروطة للكيان الصهيوني، وعدوانها المتكرر على المجال العربي الإسلامي، مما أورث الشعور بالغبن والظلم وعدم الثقة بالمجتمع الدولي وشجع على الانغلاق والتعصب والإرهاب.
ومن الطبيعي أن تستفيد القوى الأجنبية من الأوضاع العربية المتصدعة، لتعمل على تنفيذ مخططاتها بتقسيم دول المنطقة ورسم خارطة لشرق أوسط جديد يضمن مصالحها ويكون ضمانًا لأمن إسرائيل. ولا عبرة لها بعد ذلك بأي لون من ألوان السلطة المحلية، سواء أكانت دينية أم سياسية دكتاتورية أم ديموقراطية ما دامت تجاري أهدافها وتخدم مصالحها.
كل تلك العوامل الداخلية والخارجية أسهمت في زرع ثقافة الإحباط، وفي تأزم العلاقة بين الديني والسياسي، إذ توخى الديني سياسة العنف، وتبني السياسي أسلوب الهيمنة والاستبداد، وأضحت المواجهة تهدد المجتمعات بالفتنة والانشطار. إلا أن الأزمة لم تكن مقصورة على تجلياتها الدينية والسياسية، وإنما هي في جوهرها وحقيقتها أزمة ثقافية تشي بما أصبح عليه الوعي الديني والسياسي من تدنٍّ واغتراب عن التاريخ وعن واقع العصر. كما تتمثل تلك الأزمة الثقافية في التصور المغلوط للأنا والآخر، وهو تصور انبنى على العديد من العقد النفسية والأوهام الفكرية التي لا نهوض إلا بالتحرر منها.
فمن المعطيات المتدخلة في التصور الوهمي للأنا ما وقع وصفه تفاؤلاً بالصحوة الإسلامية، لأن تلك الصحوة لم تكن في الحقيقة استفاقة كما كان مأمولاً ومتوقعًا، وإنما كانت عودة إلى غفوة، لأنها لم تبشر بمنوال جديد، بل اكتفت بالمزايدة على العقيدة والتفسير الأخلاقي للتاريخ، وطمحت إلى بعث الأنموذج القديم كما ترسب في المخيال بعيدًا عن حقيقته التاريخية، وعمدت إلى إحياء الماضي بكل تناقضاته ومشاكله باحثة فيه عن حلول لقضايا الحاضر والمستقبل، مما دل دلالة قاطعة على استلاب فكري يرتهن فيه الحاضر بالماضي، وعلى أن التراث قد أصبح حاجزًا وعائقًا دون التقدم، وعلى أن التدين مع الجهل لا يمكن أن يفضيا إلا إلى الانغلاق والتعصب. بينما كان بإمكان تلك الصحوة أن تكون استفاقة حقيقية تقترح من الحلول والبدائل ما يستجيب لمتطلبات الواقع الراهن، وما يساعد على دفع عجلة التقدم.
كما أن من المعطيات المتدخلة في التصور الوهمي للآخر الخلط المتواصل بين الغرب الحضاري والغرب الاستعماري، واللبس الحاصل بين إيجابية المثاقفة وسلبية الغزو الثقافي وعدم استيعاب قيم الحداثة في مفهومها الصحيح وفي سياقها التاريخي، واعتبارها نتاج الغرب وحده، ورفع شعار الخصوصية في مواجهة الكونية بدل إجراء التفاعل والتكامل بينهما، وهكذا لم يكن ذلك الاغتراب إزاء الماضي فحسب، وإنما كان اغترابًا إزاء الحاضر أيضًا، ومما زاد في غربة هذا التصور عن منطق العصر انعدام الحوار على جميع المستويات واستبداله بمنطق الصدام والدمار والسير بالمجتمعات العربية الإسلامية نحو مصير مجهول.
وقد بات من المؤكد اليوم أنه لا انفراج لهذه الأزمة الثقافية إلا بتكثيف الحوار حول ضرورة تطوير الطرح الإسلامي حول مسألة الحكم وتعميق الرؤية النقدية للتراث باعتماد المناهج الحديثة وتطوير مناهج التعليم، ولاسيما التعليم الديني في ضوء علم الأديان المقارن وتوظيف العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع والمعالجة المتأكدة للمسالة الثقافية، مما يجعل منها دافعًا لا كابحًا للتطور. كما تتعين المبادرة في ذلك الحوار بتصحيح العديد من المفاهيم الملتبسة، سواء لدى الإسلاميين أم الحداثيين بما من شأنه أن يخفف من حدة التوتر ويبدد من ضبابية العلاقة بين الديني والسياسي، وما يترتب عنها من خلاف وسوء تفاهم.
فمن تلك المفاهيم المركزية التي يتعين تصحيحها "مفهوم الهوية" الذي لا يعني بالضرورة العودة إلى الماضي والعمل على إحيائه، لأن التاريخ لا يعيد نفسه كما لا يمثل ذلك المفهوم معطى ناجزًا ثابتًا ونهائيًا، إنما الهوية كائن حي متحرك ومتطور ينطلق في بعض مكوناته من الماضي، ولكنه يتفاعل مع الحاضر والمستقبل ويتأثر بغيره ويؤثر فيه، ولذلك الكائن غاية يهدف إليها هي إثبات الذات في هذا الوجود عبر الصيرورة التاريخية، وبالتعاطي مع الآخر وليس بمعزل عنه، إذ لا وجود للأنا إلا في مرآة الآخر.
لا يعني مفهوم الهوية العودة إلى الماضي والعمل على إحيائه ، إنما الهوية كائن حي متحرك ومتطور
ولا بد من التذكير في هذا السياق التصحيحي بضرورة اعتبار الهوية بجميع مكوناتها، حتى تحقق لذاتها التوازن المطلوب، لأن تغليب بعض تلك المكونات على حساب سائرها يفضي إلى تسرب الخلل إلى جوهرها، ويعوقها عن رسم طريقها إلى المستقبل. ولا مراء في أن المعطى الديني يحتل موقعًا مركزيًا ضمن مكونات الهوية، وهو معطىً كان في البدء إضافيًا ومكتسبًا ثم أضحى من المعطيات الموروثة بالتقادم، ولكن لا يمكنه مع ذلك أن يستغرق كل مكونات الهوية المؤلفة أيضًا من معطيات طبيعية ومعنوية موروثة ومكتسبة.
ومن المفاهيم الأساسية التي يتعين تصحيحها أيضًا مفهوم الجهاد الذي التبس بمفهوم الإرهاب، وهو التباس قد تسبب في تكريسه عن جهل فريق من أهل الإسلام، كما تسببت في تعميمه دعاوى فريق من غير المسلمين؛ فعلاوة على الدلالات المتعددة لمفهوم الجهاد في الإسلام، والتي لا علاقة لها أساسًا بالعنف، فإن جهاد الذود والدفاع عماده الحق المغتصب، كما أن جهاد الطلب له شروطه وأوضاعه التي أفاض الفقهاء في تفصيلها، ولم يحترمها المنادون اليوم بالجهاد، بل إنهم تجاهلوا أبسط تلك الشروط التي تقضي بأن لا جهاد ضد مسلم، وبأن من كفر مسلمًا فقد كفر؛ فأن يحيد الجهاد عن سبيل الحق هو الإرهاب بعينه، ومن جانب قوة الحق من الطبيعي أن يجابه بحق القوة.
ومن المفاهيم التي كانت كذلك ولا تزال موضع التباس يتعين رفعه مفهوم العلمانية؛ ذلك المفهوم الذي غالبًا ما يعتقد في الأوساط الدينية أنه يمثل بالضرورة قطيعة مع الدين، حتى أن معظم المتكلمين باسم الدين قد ناصبوه العداء واعتبروه مرادفًا للإلحاد، وحتى أن بعضهم ممن راموا إساغته للأذهان قد نادوا بعلمانية "مؤمنة " تمييزًا لها عن علمانية "ملحدة "، مما دل في حد ذاته على الغفلة عن أهم الدقائق وعن الجهل بالحقائق، وذلك لأن العلمانية لا تقطع مع الدين، وإنما تجنبه مغبة الخضوع للأهواء السياسية المتقلبة، وتعمل على ضبط وظيفته ومجال اشتغاله، وليس معنى ذلك أنها تحظر عليه التدخل في الشأن العام كما يذهب إلى ذلك بعض الحداثيين؛ فكل الأديان تتدخل في الشأن العام وإن تفاوتت حظوظها من ذلك التدخل، ولكن المحظور هو انخراطها في العمل السياسي الذي من طبيعته أنيحيد بها عن وظيفتها الأصلية المتمثلة في ترسيخ قيم الحق والخير؛ ومعنى ذلك أن العلمانية تلتزم موقف الحياد السياسي إزاء الدين ضمانًا لحرية المعتقد، باعتبارها حقًا مشاعًا بين الجميع، فلا مزايدة باسم الدين كما لا مزايدة باسم الوطنية.
فلا مناص إذن من مناقشة هذا الموضوع المركزي المتعلق بموقع الدين في الدولة المدنية الحديثة، وتدقيق علاقة الديني بالسياسي في دستور تلك الدولة بما لا يدع مجالاً للغموض أو الالتباس، وهي علاقة في تصوري ما هي بالوصل ولا هي بالفصل، وإنما هي بلغة الطب أشبه بالمصل المنعش واللقاح المنشط لا المخدر والمثبط، الدافع نحو الرقي لا الجامح ولا الكابح، المترسم والمعاضد لخطى المنهج السياسي الحداثي والمستكنه لجوهر الدين الخالد ولقيمه السرمدية في غير استلاب لتجلياته التاريخية، ولما تجسد منه وتحنط في أطر الزمان والمكان، وهو أمر لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالعمل على التأسيس لرؤية دينية اجتهادية جديدة.






