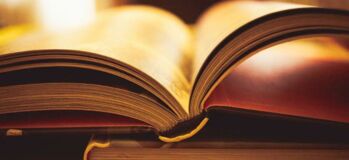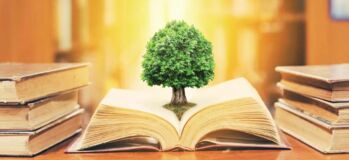في المسلسل النظري الذي طبع رحلة التسامح
فئة : أبحاث محكمة

في المسلسل النظري الذي طبع رحلة التسامح
ملخص موجز للبحث:
يتناول البحث دراسة حول السبل الكفيلة بإرساء قيم التسامح من وجهة نظر كونية، ويهدف إلى تقديم رؤى جديدة تسهم في إغناء البحث الفلسفي في هذا السياق؛ وذلك عبر استتباع المسلسل النظري الذي سطرت حلقاته أهم المرجعيات الغربية في القرن 17م؛ إذ تجري حلقات هذا البحث وفق منهجية تضمن الحفاظ التسلسلي الذي طبع مسار التسامح في أوروبا في فترة الحداثة، حيث كان لتحطيم المرجعيات الطبيعية واللاهوتية دور مهم في الانزياح بكل منابع القيم الإنسانية، فلم تعد الطبيعة قادرة على توجيه الإنسان بعد الثورة الكبرنيكية التي تداعى معها مفهوم الكوصموص بكل ما يحمله من قيم الخير والكمال والتناغم والانسجام، بل أصبح الكون عبارة عن فوضى عارمة في كل أرجاء المكان، وأصبح الإنسان مضطرا إلى البحث عن مصدر جديد للقيم الإنسانية، على نحو يجعلها نابعة من ذات الإنسان وتفكيره لا من الطبيعة. أيضا أدى تهافت فكرة العناية الإلهية إلى زعزعة بعض الأفكار التي كانت تفرضها سلطة الكنسية على أتباع الديانة المسيحية، فأدرك الإنسان أن الكون الذي نعيش فيه مختلف تماما عما تصفه الكتب المقدسة، ما جعله يدرك حاجته إلى تشييد عالمه الخاص الذي ينبغي أن يحكمه بقوانينه وتشريعاته. بالتالي كان لا بد من اتخاد موقف نقدي من الدين ذاته، وإفراغه من طابع القداسة التي تجعل منه مصدر تشريع متعال لا يمكن المساس به. في ظل توفر هذه الشروط استطاع الفيلسوف الإنجليزي "جون لوك" أن يفصل السلطة الدينية عن السلطة الكنسية، وأن يحدد الأدوار التي يجب أن يقوم بها كل طرف بمعزل عن الآخر، فالدين لا يجب أن يخرج عن المسائل الروحية. أما المسائل التشريعية، فهي وظيفة تنفرد بها السلطة السياسية، مما قد يتيح إمكانية القضاء على التعصب الذي كان يجد جذوره في الخلط بين هذين السلطتين. ومن خلال معرفة هذه الشروط الضرورية، يمكننا استنبات هذه الفكرة في مجتمعاتنا، ومعرفة مكمن الخلل وسبب فشلنا في أن نكون متسامحين، رغم ما نعرفه عن التسامح.
تمهيد:
إن انهيار المرجعية الدينية الذي ترتبت عنه منازعة الكنيسة الكاثوليكية في روما والمستقرة في الفاتكان، والتي كانت تدعي امتلاك الحقيقة القويمة وتقدم نفسها وريثا شرعيا وحيدا لكنيسة المسيح. من طرف الكنائس الأخرى وعلى رأسها البروتستانتية، نجم عنه تفتتها إلى مرجعيات وذوات متعددة الأشكال ومتساوية الحقوق والمشروعية، مع هذا الانهيار الذي طال وحدة الكنيسة، وأدى إلى انشقاق الكنائس وتعددها، وانحلال كل المؤسسات المتسمة بالوحدة. ظهرت هنا إشكالية جديدة تخص مسألة الحقيقة الدينية والمشروعية القانونية والسياسية، فبعد أن ضاع المرجع الوحيد والثابت، كان أن ترتب عن هذا فقدان معيار الحكم على الأشياء. لم يعد بمقدور النظام التقليدي حلها، بيد أنه كانت السلطة بين يدي رعاة الشعوب لزمن طويل: كانوا قد وعدوا أن يسيطر الرفق والعدالة والمحبة الأخوية على الأرض، فلم يوفوا بوعودهم، فكانوا أن خسروا رهانهم على الحقيقة والسعادة، مما نتج عنه إيجاد حلّ للكنائس المتناحرة في كراهية لا مثيل لها، والبحث عن سبيل لإقامة السلام.
ما كانت أن تحل هذه المشكلة خارج الإطار النظري الجديد، حيث تم تقويض سلطة البابا واقتسام السلطة مع الشعب، لتكف بذلك الدولة عن أن تكون لها مشروعية متعالية عن الذات الإنسانية. هذا فضلا عن النقد التاريخي للكتاب المقدس، الذي استطاع أن يطهر العقائد الدينية من كل أسباب الشقاق، والخلاف بين الديانات والمذاهب والطوائف. كل هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في التأسيس لتسامح الديني أخمد نار العنف المشتعلة بين الطوائف المتناحرة، والسماح بإقامة السلام بينهم.
فالرهان إذن الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا هو البحث في هذه الآليات التي جعلت قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر قابلة للتحقق الفعلي في المجتمعات الغربية، وعن سبب امتناعها في مجتمعاتنا العربية. وبعبارة أخرى، ماهي الأسباب التي أدت إلى نجاحها هناك؟ وامتناعها في مجتمعاتنا؟
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا