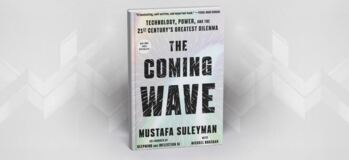في سوسيولوجيا الذكاء الاصطناعي هل هو ثورة أم ثورات؟
فئة : مقالات
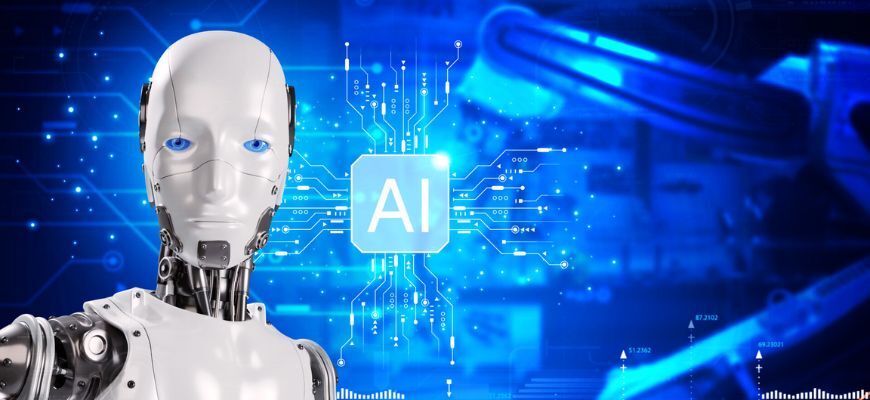
في سوسيولوجيا الذكاء الاصطناعي
هل هو ثورة أم ثورات؟
I - وقبل ذلك هل نعرف ما هو الذكاء الطبيعي
لن أهتم هنا بتعاريف الذكاء وأنواعه؛ ولا بالنظريات، والنفسية خاصة، التي حاولت الإحاطة بدلالاته، ومعانيه، ومجالاته، وكيفيات اشتغاله، وما يطرحه ذلك من إشكالات كلاسيكية مثل الفطري والمكتسب. مقاربتي هنا تدخل ضمن سوسيولوجيا المعرفة، حيث أحاول رصد كيف يشتغل ما تعارف عليه الناس على أنه ذكاء أو ذكاءات في المستويين اليومي والعالم؛ وذلك في الفعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية؛ أو الإدراك والتعلم الاجتماعيين، أو الذكاء في الإنتاج والتنظيم، أوفي السياسة، أو في المدرسة والجامعة، وعلاقة كل ذلك بمفاهيم أخرى مثل النجاح والمجد والجاه والسلطة والنفوذ.
I-1- الذكاء كفعل اجتماعي
يعني الذكاء اجتماعيا التصرف السليم، والملائم، والناجع، والنافع، الأمر الذي يستدعي معايير أحيانا خارج الذكاء، مثل القيم التي يتوافق عليها المجتمع، ليجعل سلوكا ما سليما غير متنافر مع الذوق العام، وحتى ما توارثه الناس على أنه مروءة، من إقدام وشجاعة وكرم، كقيم رمزية نبيلة، ومن هنا يمكن أن تتسرب المحافظة حتى تقيم سلوكا ما على أنه ذكي أم لا وفق مدى الوفاء للماضي والأقدمية، ونلمس هذا في كثير من المجالات حتى التي تبدو بعيدة عن هذه القيم مثل التجارة المعتمدة على الثقة، مستعملة قاموسا ثريا مثل "المعقول" و"الكلمة" و"المروة"...
غير أن وجها آخر للذكاء يرتبط هذه المرة بالملاءمة التي تعني حسن الفهم واتخاذ القرار المناسب في الزمن والمكان المناسبين، حتى يؤتي الفعل أكله ويصل إلى غاياته التي حددت مسبقا في قصدية تحديد الأهداف وحشد الوسائل.
تعني الملاءمة نوعا من النباهة واليقظة التي تحارب الغفلة والغباء كمتناقضات للكياسة وحسن التصرف، وهي من أهم الذكاءات الاجتماعية التي تروم النجاح في الحياة حتى دون الدخول إلى المدرسة أو الجامعة. الملاءمة هي السلوك النافع الذي لا يتناقض مع مصالح الذات و/أو من حولها، دون هذر الطاقات والوقت والانتباه، والاتجاه قدما نحو تراكم رأس المال المادي أو الرمزي نحو الاجتماعي، وهي رساميل متظافرة يساعد بعضها الآخر في جلب السعادة بالمفهوم الخلدوني. وهنا يمكن للنفعية أن تقود نحو نجاعة لا تهتم بأي قيم سوى امتلاك الرساميل التي تحدثنا عنها.
ويمكن مع تدخل العنصر المالي ومنطق الربح أن يتطور الأمر إلى فهم الذكاء على أنه النجاح بمعناه الضيق الذي يمكن أن يطحن الأخضر واليابس فقط من أجل الغاية التي تبرر كل وسيلة.
هذا التعريف الاجتماعي الأخير قلما يستدعي الأخلاق والفضيلة. إنه النباهة في رصد وتشخيص متقلبات الواقع، والعمل وفقها برسم أهداف وتشغيل أدوات توصل لتلك الأهداف. هو ما يقترب من التعريف الاجتماعي للنجاح في الحياة على أصعدة عدة منها بناء أسرة أو تنمية ملكية، أو الوصول إلى مكانة اجتماعية تسهل الحياة في إيجاد حلول ملائمة للمشاكل سواء بالاجتهاد الخاص أو بالاعتماد على آخرين.
للذكاء في الاستعمال الاجتماعي علاقة بالقوة، فهو آلية اجتماعية وإن كانت تبدو ذهنية خالصة، فالانتماء الاجتماعي يحدد الذكاء حتى قبل أن يشتغل في الدماغ، فما ننبت فيه وما نتلقاه كمحاكاة وكقدوة وكحقل ثقافي، يحدد شئنا أم أبينا كيف نتصرف، فليس كمن نشأ في بيت يستعمل الانتباه واليقظة المستمرين لأسباب أو لأخرى كمن نشأ في بيت يعيد إنتاج نفسه. ورغم ذلك فالمجتمع، والذي يحمل قيما إيجابية خاصة، يمكن أن يعرف الذكاء بأنه ذلك النجاح الذي يخرج من الحتميات نحو ابداع أسلوب شخصي في الحياة لا يتبع قوالب مسطرة من قبل، بل قد يصنع جديدة على الآخرين اتباعها، بل وأن الذكاء أيضا هو أن تخرج من السلبيات نحو الإيجابيات، ولو أن الحس المشترك يميل إلى الركود والتبعية والماضوية.
وعندما نفحص الفعل الاجتماعي عن قرب نجده ليس فعلا فرديا، ولا حتى بذي استراتيجية قارة وثابتة؛ وذلك ببساطة لأن الأفعال تكون مشتركة بشكل أو بآخر، وداخل دينامية جماعية، منها ما يشجع، ومنها ما يكبح، ومنها ما يثبت، ومنها حتى العنيف الذي يقمع. أمام هذا التعقد في الحياة والعلاقات يصبح الذكاء هو تلك القدرة على فهم وتحليل أفعال الآخرين بجمع المعطيات وملاحظتها ودراستها حتى يتسنى للفاعل أن يكون فعله ذي جدوى، ولصالحه وربما لصالح الذكاء نفسه. هذه العملية ليست بديهية، فهي تتم إما بالتعلم المنظم أو حتى بالمحاولة والخطأ وبالبحث عن اللذة واجتناب الألم.
I-2- الذكاء في الإدراك والتعلم الاجتماعيين:
الذكاء مثل جبل من ثلج لا ترى سوى نتائجه وآثاره. أما صيرورته، واشتغاله، ومحطات إعداده، وإخفاقاته، ونقط قوة التعلمات، ونقط الضعف، فهي ذلك الخفي الذي لا ينتبه إليه، وأحيانا حتى في المعارف التي تسمى عالمة.
الذكاء إذن صيرورة في الزمن وتاريخ وتعرجات، الحس المشترك وإن كان في مظهره يغفل ذلك نظرا لعفويته ولارتباطه بعوامل لحظية وتبريرية، ففحصه ينبئ عن وعي أو شبهه بأهمية التراكم الذي يحصل للإنسان الفاعل، والذي يكتسب الذكاء مع مرور الوقت على حساب القاعد الذي إن لم ينكص يركد ويتجاوزه الزمن. والسيرورة تعني الاشتغال مثل أي آلة يمكن أن تتأكسد بالعطالة، وفحص كيفية اشتغال الذكاءات سواء العملية أم النظرية من أهم المباحث الابستمولية التي أنتجت مفاهيم علمتنا كيف تبدع المفاهيم والبراديكمات، وكيف تتطور الاكتشافات والابتكارات.
وما تاريخ البشرية في عمق التقصي سوى تاريخ اشتغال الذكاء من اكتشاف النار حتى الثورة الرقمية، مرورا بما لا يحصى من أشكال المعمار الذهني والاجتماعي للإنسان.
الذكاء بكل ما سبق، هو القدرة على قراءة الواقع وفحصه وتحليل بنيته وتصنيف نقط القوة ونقط الضعف، ولا ينتهي الأمر سوى بالعمل على تغييره نحو الأفضل بإبداع الغايات وتحديد الأهداف وتوصيف الطرق واستنفار الوسائل.
لكن من يوقد الذهن، ومن يصنع الفضول، ومن يحفز نحو فعل الذكاء؟ هنا يحضر جزء خفي أيضا، وربما أعمق، هو الانفعال والعاطفة والوجدان.
I-3 - الذكاء والمدرسة
في المدرسة نشغل الذكاء الذي يطمح أن يكون عالما يتجاوز المعرفة العفوية اليومية، ومن هنا يمكن أن نفهم ما يحصل في المدرسة وفق ما يبدو نقيضه من المعرفة التلقائية العملية والمشتتة والشفهية واللحظية. الذكاء المدرسي هو ما ليس تلقائيا وعفويا، بل هو المبني على قواعد منقحة شيئا فشيئا من طرف عقول فذة تتحاور وتتوافق على ما ينبغي أن يعلم وعلى أساسه يتم التقويم من أجل امتلاك المهارات والمعارف والكفايات. المعرفة المدرسية معرفة منظمة وفق تصنيفات ومعايير وقواعد تجعل الذهن هو أيضا ينتظم سواء في بناء الحقائق النظرية أم العملية، ثم إننا عندما نكون في المدرسة يتدخل عامل حاسم هو الكتابة ينظم ويختزل ويثبت وينقلنا من العفوية الشفهية إلى جدية الكتابة وإمكانية الرجوع والفحص والنقد. أخيرا تعتبر المعرفة المدرسية صيرورة لها دوما سابق ولاحق في تراتبية صاعدة نحو الاقتراب أكثر من الدقة والصواب بعيدا ما أمكن عن الخطأ والوهم.
للذكاء المدرسي مصدران، الاجتماعي، رغم ما يبدو من التقابل بين الذكاءين؛ لأنه وببساطة لا توجد المدرسة خارج المجتمع الذي يصنعها ويحاول في الغالب تأبيد قيمه من خلالها، دون إغفال قدرة المدرسة نفسها في التأثير في المجتمع وتغييره. إلى جانب المصدر الاجتماعي للذكاء المدرسي هناك تراكم الذكاء العالم عبر الزمن وكذلك الكيفية التي يشتغل بها هذا الذكاء بمرافقة المعلمين وطرقهم في ذلك. الذكاء العالم مركب إذن من الاجتماعي ومن المعارف العالمة المعيارية، ومن كيفية اشتغاله، إما لتطوير المعرفة العالمة نفسها، أو العودة للاجتماعي.
من أجل ذلك تستعمل المدرسة أنواعا ستة للذكاء:
1. الصوري عبر الرياضيات، والمنطق، والموسيقى، والفلسفة، وعلوم اللغة؛
2. التجريبي عبر العلوم الطبيعية؛
3. المعلوماتي عبر التاريخ والجغرافيا والقانون؛
4. القيمي عبر الدين والأخلاق والتربية الوطنية؛
5. الجسدي عبر التربية البدنية؛
6. الجمالي عبر الأدب والفنون.
دون الحاجة إلى التذكير على أنها ذكاءات متكاملة ومتضافرة تعبر عن تعقد العالم الذي يجب محاولة إدراكه وفهمه معقدا، الأمر الذي يستدعي عدم الغلو في التخصص ومحاولة إدماج التخصصات بعضها ببعض الأقرب فالأقل قربا.
يحصل الذكاء المدرسي بالتدريج من الأبسط إلى المعقد، ومن التذكر إلى حل المشكلات، ومن العيني إلى المجرد. من تذكر الحروف والأعداد إلى حل المسائل الرياضية نحو التجريد الهندسي وحل المعادلات صعودا نحو المنطق الرياضي. وبذلك يحصل للمرء اكتساب ذكاءات عدة منها حل المشكلات، وتدبير الوضعيات، وفهم وتحليل المعطيات والنصوص نحو الابداع والابتكار.
الذكاء بكل ما سبق، هو القدرة على قراءة الواقع العيني والذهني، وعلى الملاحظة والفحص وتحليل البنيات والتصنيف وتشخيص مواقع القوة ومواقع الضعف، والعمل على التغيير والتحسين وفق الأفضل بإبداع الغايات والأهداف وتوصيف الطرق وانتقاء الوسائل.
لكن من يوقظ الدهشة؟ ومن يصنع الفضول؟ ومن يحفز على فعل الذكاء؟ إن ما قبل الذكاء لا يقل أهمية من الذكاء نفسه، ومن هنا أهمية فحص الانفعال والوجدان والعاطفة كذكاءات تمهد وتصاحب عقلانية الذكاء حتى يستطيع الاشتغال والاستمرار.
ولعل أقرب الألفاظ للذكاء هو التفكير والفهم وهما عمليتان معقدتان يمتزج فيهما الذهني الصرف بالانفعال. إن الخوف والغضب والتوتر والحزن والفرح والإقبال والنفور، كلها آليات بها تعبر الذات عما يعتريها من إحساس وشعور، ومن إدراك وتصور، ومن رغبة أو عزوف، أو من رد فعل بدءا بالدفاع عن الذات كغريزة بقاء، ثم عن اكتساب رساميل وتنميتها أو محاولة استدراك أو تصحيح مسار.
إن تدبير الانفعال وما يرتبط به من عواطف مثل الحب والكراهية والحسد والحقد والعطف والشفقة لا يقل أهمية من حل المشكلات بالعقل البارد. إن الانفعال والعاطفة هي تلك الطاقة التي تحيط بالكيان من أجل المحافظة والتنمية والسير نحو الأفضل، وأي أمر يعتري هذا المجال يؤثر في الشخصية برمتها ليس كسلوك فحسب، بل وكاتزان ومعرفة، هي ما انقسم إليه علم النفس، التحليل النفسي كعلم للوجدان، والسلوكية كدراسة لما هو قابل لها، ثم المعرفة على أساس أنها هي التي تدافع عن النفس بأعلى مستويات الاستراتيجيات.
II - الذكاء الاصطناعي
في الاصطلاح يبدأ الذكاء الاصطناعي بالآلة الحاسبة من أجل حل العمليات الكبرى وربح الوقت، لكن الاصطناع في عمق المسألة سبق ذلك؛ لأنه يكاد يكون هو الثقافة وتنقيل الحياة من الطبيعة إلى تحويلها عبر أشكال لا تعد من الأفعال منذ الصيد واكتشاف النار حتى الزراعة والصناعة. لكن المقصود هنا كل ما يرتبط باكتشاف ما يصطلح عليه بالحواسيب، وبعد ذلك الهواتف النقالة وكل الحاملات الذكية والأنترنيت، بل وبدقة أكثر لما بدأ الرياضيون والمعلوماتيون يبنون أنظمة تحاول تقليد الذكاء الإنساني في حل المعضلات والمعادلات الرياضية أو حتى لعب الشطرنج، أو التدخل في مجالات عدة مدنية مثل الصحة والفضاء وعسكرية في مجال الأسلحة الذكية.
ماذا يقوم به الذكاء الاصطناعي وما هي خصائصه؟
كما كل التقنيات يساعد الذكاء الاصطناعي الانسان في كثير من الأمور لعل أهمها تسريع البحث عن معلومة أو تخزينها أو تصنيفها، أو في حل المعادلات الرياضية والمنطقية أو انتاج محتوى، واتخاذ قرار.
السرعة هي الخاصية الأولى التي يمكن أن تجعل التفاوت بين من يستعمل الذكاء الاصطناعي ومن لا يستعمله، سواء في البحث العلمي الأساسي أم التنموي أم التدخلي أو في المقاولة أو حتى في التنمية الذاتية.
إلى جانب السرعة يساعد الذكاء الاصطناعي التعلم ولو بالممارسة بالمحاكاة والمحاولة والخطأ، سواء في اكتساب مهارات صلبة مثل اللغة والرياضيات أم المهارات الحياتية مثل التواصل والتفاعل.
إلى جانب السرعة يساعد الذكاء الاصطناعي على بحث وجمع المعلومات الكثيرة بالقدرة على التتبع الفوري للفعل الرقمي، ثم القدرة على تصنيفها وتحليلها، والمساعدة على استغلالها من توجيه الانتباه في البحث عن الأسواق مثلا، أو حتى في توجيه الرأي والذوق وصناعة التوجه.
مقاربات الذكاء الاصطناعي كثيرة مثل البحث في كيفية اشتغال الألغورتمات وأنواعها، أو البحث في مجالات التدخل الاجتماعي والاقتصادي وغيره، أو حتى كيفية التعلم الذاتي عبر تخزين المعطيات وتصنيفها وتقليد الذكاء الطبيعي، أو حتى المقارنة به وهو ما سنحاول أن نقوم به في هذه العجالة.
الذكاء الطبيعي هو الذي اهتدى لصناعة الذكاء الاصطناعي من أجل توسيع مجال الاشتغال وتقوية المعالجة عبر ما ينقص من سعة الذاكرة والقدرة على تتبع المتعدد والمختلف والمتغير من الظواهر، وهو ما حاولته كل الذكاءات، والمدرسية خاصة، حيث اهتم الإنسان بخلق أدوات ذهنية تستطيع اختزال العالم ابتداء باللغة التي ليست في الأصل سوى ذكاء غير طبيعي حاول به الإنسان التواصل والتعبير عن الحاجات المادية والذهنية والعاطفية، ثم الرياضيات التي جاءت لحل مشاكل مرتبطة أيضا بالحاجات مثل قياس المساحات والأحجام.
الذكاء الذي نسميه طبيعيا ليس في الأصل كذلك، بل هو صناعة إنسانية واجتماعية ترتبط بالحاجات والسياقات والتعلم. وكذلك الذي يسمى الآن اصطناعيا هو بالدقة ذلك الذكاء الذي بدأ بمحاولة الفعل في الطبيعة وتجاوز السلبية والانفعال، هو ثقافة إذا.
لتوسيع الفهم والتحليل ليس الذكاء الاصطناعي سوى ثقافة مستجدة اتكأت على التقدم التكنولوجي المعلوماتي لخدمة تلبية الحاجات مع اعتماد السرعة والقدرة على ربط المتغيرات الكثيرة والمتداخلة من أجل نجاعة وملاءمة أكبر لفعل الانسان في الطبيعة وفي العلاقات الاجتماعية.
لكن وكأي تقدم تقني لابد للعملة من وجه آخر غير النفعية بل وآثار قد تكون مدمرة إن لم تراقب كفاية ولم تدبر بما يحتاجه الأمر من حكامة وتبصر. لقد كانت النار أول ثورة تقنية ساعدت الإنسان على الطهي وربما التكاثر من خلال نقص البكتريات، لكنها صنعت إنسانا ربما بأقل مناعة إذا قورن بالحيوان. كما أن تدجين القمح والحيوان ساهم في بناء القرى وتنقيل الإنسان نحو بناء القرى والاستقرار، لكن الأمر ارتبط أيضا بظهور الملكية والصراع والحرب.
الذكاء الصناعي سهل الحياة في ميادين شتى لكنه قد يمس وبالعمق والقوة مجالات حيوية مثل فرص الشغل أو بشكل أكثر خطورة عندما يتدخل في تغيير الطبيعة كما في التدخل الجيني.
الذكاء الاصطناعي تقليد للذكاء الطبيعي عبر تتبع المعطيات وجمعها، ثم التعلم الذاتي منها للتعرف على الخصائص والتشابه والسابق واللاحق والسبب والنتيجة نحو التعريف، وعندما تكثر وتتعقد المعطيات يحاكي الذكاء الاصطناعي الدماغ البشري في عملية الربط والمقارنة وفق خوارزميات وضعت لتساعد على التجريد والنمذجة والتعرف والتصنيف والتوقع، وهذا كله من أجل القيام بمهام تشبه مهام الإنسان في اللعب أو التعليم أو الجراحة أو بناء أطروحة أو بحث في مختبر.
هل هو ذكاء أم تقليد فحسب؟
الذكاء الاصطناعي ليس ذكاء فحسب، بل هو مساهمة في إعادة تعريف معنى الذكاء الذي يحيلنا إلى كونه خبرة التعرف أكبر قدر من الحالات أو الدالة منها أو المساعدة على حل المشكلات، وهو ما يقوم به الذكاء الطبيعي لكن ببطء وفي صيرورات التراكم والمحاولة والخطأ، وهي نفس العمليات التي يقوم بها الذكاء الطبيعي لكن بشكل أنجب، هو إذا ذلك المتعلم النجيب الذي يسبق إلى إيجاد الحلول، ومن هنا الفائدة البيداغوجية العظمى وإمكانية حلول محل المعلم.
أكثر من ذلك، يعلم الذكاء الاصطناعي نفسه، ويستطيع تجويد الخوارزميات وحتى إنتاج أخرى أكثر دقة وملاءمة، وهنا يدخل في الابتكار المستمر نحو ثورات إبستمولوجية لا نهاية لها.
وما علاقته بالانفعال والعواطف؟ مادامت الانفعالات والعواطف تتعلم وتقاس، فهي تملك سمات وأوصافا يمكن أن يتعرف عليها الذكاء الاصطناعي، وقد يتخذ سلوكا ملائما للحالة الوجدانية الحالية أو المرتقبة.
في كل ما سبق، نكون أمام ذكاء منطقي لكنه بدون شعور، يبتكر لكن بدون حدس يجمع الإحساس بالإبداع دون خلفية منطقية. الذكاء الاصطناعي دون أحلام ودون لا شعور ولا طقوس له، ولا يحب ولا يكره. هو بذلك يوسع قدرات البشر، لكنه لا يحل محلهم إلا خداعا. الذكاء الاصطناعي استطاع أن يتجاوز قانون الهوية الأرسطي، وأن يتدخل في قضايا الاحتمال والمتغيرة المعطيات تجاوزا للحدية المنطقية الساذجة.
وعلى الرغم من كل ذلك، فحدود هذا الذكاء هو التعرف على كل المعطيات التي أنتجها وينتجها الإنسان نصوصا وصورا وغيرها، وهي معطيات منتهية بلا شك، لنصل إلى معطيات هو من ينتجها من تركيب المعطيات الطبيعية والأمر غير مؤمن في المصداقية وفي الأخلاق.
ما هو الحل؟ أقترح هنا بعض الأفكار العملية التي يمكن تقسيمها إلى:
مراقبة العلمية:
على الذكاء الطبيعي للباحثين في المختبرات ومراكز البحث في الجامعات، وحتى في المقاولات المعلوماتية نفسها، أن تقوم بفحص ومراقبة المعطيات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؛ وذلك وفق معايير صارمة ومفتوحة تتراكم نحو الجودة باستمرار.
مراقبة قانونية وإيتيقية:
على المشرعين الملمين بكيفية اشتغال الذكاء الاصطناعي وحيثياته والمجالات التي يتدخل فيه تقنين كل ماله علاقة به ووضع قوانين وتشريعات ومساطر وحدود تمتح بداية من حقوق الانسان واحترام الإنسية والكرامة الانسانيتين.