في قراءة الخطاب الديني: أعمال مهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي
فئة : قراءات في كتب
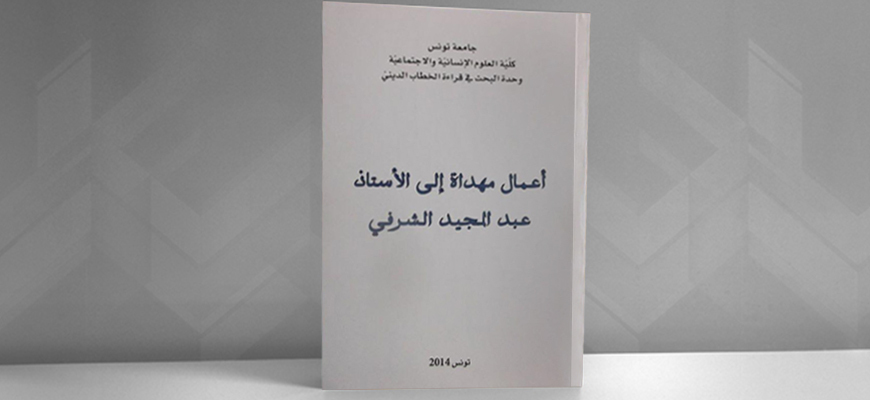
في قراءة الخطاب الديني
تقديم كتاب (أعمال مهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي)[1]
رأى عدد من زملاء الأستاذ عبد المجيد الشرفي وتلاميذه أن يهدوا إليه أعمالهم تقديراً منهم، واعترافاً بالجميل. وهي أعمال جُمِعَت في كتابٍ ضمَّ بحوثاً ودراساتٍ في اختصاصاتٍ معرفيّة مختلفة تمثّل صورة من بعض مشاغل الأستاذ المحتفى به، واهتماماته العلميّة والبحثيّة. وكان الجامع بين الأعمال المنشورة، على اختلافها، أنّها تتنزّل في إطار الإفادة ممّا وصلت إليه العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة الحديثة، سواء من جهة المنهج، أم من جهة المواضيع. وبهذا المعنى كانت الأعمال احتفاء (بالمعرفة الحداثة)[2]، ذلك أنّه من المعروف عن الأستاذ الشرفي، في الأوساط الجامعيّة التونسيّة وخارجها، أنّه وجه من وجوه الحداثة الفكريّة في قراءته للفكر العربي الإسلامي، تلك الحداثة التي ميّزت الجامعة التونسيّة، وأسهم الأستاذ بقسط كبير في ترسيخها.
يضيق المقام إذا ما رمنا التعريف بالأستاذ الشرفي أستاذاً، وباحثاً، ومؤطّراً[3]، وحسبنا القول إنّ مسيرته الفكريّة والبحثيّة تشهد على جمع صعب بين الالتزام الأخلاقي، والمسؤوليّة، والحريّة، والصرامة المنهجيّة، والوضوح الفكريّ، والتواضع العلميّ. وهو ما شاركه فيه زملاؤه المساهمون في الأعمال المهداة إليه، ويطمح تلاميذه إلى مجاراته فيه، دون أن يكونوا مقلّدين له، فمن بين ما زرعه الأستاذ الشرفي في مدرسته الّتي أسّسها، وتابعها، ويتابعها إلى اليوم، أنّ السؤال المعرفيّ الحرّ، والفكر النقديّ، والمسؤوليّة العلميّة هي ما تمثّل دعائم البحث العلمي وثوابته، بقطع النظر عن الاختلاف أو الاتّفاق في وجهات النظر، والنتائج التي يتمّ التوصّل إليها. وبذلك يكون، كما قدّمه الأستاذ عبد القادر المهيري، من بين أساتذة الجامعة الذين «نذروا حياتهم ونشاطهم للمؤسّسة الّتي يعملون بها، وأدّوا ما تقتضيه مهامّهم - بجانب الدروس الّتي يضطلعون بها- من تنشيط متواصل للبحث، وتأطير الباحثين الناشئين وغيرهم، في نطاق مشروع فكريّ واضح متكامل. فإذا ما غادروا التدريس؛ أي مجرّد القيام بالدروس في المرحلتين الأولى والثانية، لم يتوقّفوا عن النشاط العلميّ، ولم يكتفوا بما قدّموه للجامعة، ولروّادها»(ص 7).
جاءت الأعمال المهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي حمّالة لمشاغل شتّى، مبوّبة وفق مواضيعها العامّة، فكانت الثقافة، مفهوماً وتصوّراً، مشغلاً أوّل ما ضمّ ثلاثة أعمال مهمّة للأساتذة حمّادي صمّود، ومبروك المنّاعي، ورجاء بن سلامة. وممّا يُلاحظ في هذا المشغل (ونحن راغبون عن تقديم تلخيص مخلّ للدراسات المندرجة ضمنه) تقديم مفهوم الثقافة في صيغة الجمع، كذا جاء عنوان مقال الأستاذ صمّود (من مفاهيم الثقافة) (ص ص 43-48)، هذا إضافة إلى أنّ الجمع في العنوان لم يعنِ الاستغراق، وإنّما التمثيل فحسب، ذلك أنّ الثقافة «تعريفاتها كثيرة ومتنوّعة تنوّع القائمين بالتعريف، وأصول انتمائهم الفكري والفلسفي»(ص 43)؛ ولذلك فإنّ مفهوم الثقافة متعدّد، وغير ثابت، يتحوّل من معناه اللغوي المولّد للمعنى الاصطلاحيّ في العربيّة إلى معانٍ أخرى مغرقة في التفصيل والبسط ضمن اختصاصات معرفيّة عديدة كالأنتربولوجيا، والأنتربولوجيا الثقافيّة، وعلم الاجتماع، وعلم اجتماع الثقافة.
وعلى الرغم من تعدّد مفاهيم الثقافة، وتنوّع مقارباتها، فإنّ هناك ما يشبه الإجماع على أنّ كلّ ثقافة تحمل ضروباً من الخصوصيّة، وعوامل داخليّة تسمح لها بالتطوّر، بشرط الانفتاح على غيرها من الثقافات. وفي هذا السياق، يمكن تنزيل عمل الأستاذ مبروك المنّاعي (الاستشراف والوعي المستقبلي في الثقافة العربيّة، (بحث في التأصيل الثقافي))(ص ص 49- 63)، والمسألة، موضوع العمل، لم يتمّ الاهتمام «فيها باحتواء مفهوم الاستشراف، أو (تلبيسه) بدافع تمجيد التراث، وإنّما [...] تأصيل الفكرة في الثقافة العربيّة، وبيان ما لها من أساس معرفيّ يمكن أن تتأسّس عليه، والتدليل على كون ملابساتها موجودة واضحة تمام الوضوح في هذه الثقافة»(ص 63)؛ ولذلك إنّ البحث في الاستشراف والوعي المستقبلي، وهي من المفاهيم الحديثة، في تراث قديم لا ينبغي أن يؤخذ في هذا العمل على أنّه مندرج ضمن إخراج «الماضي إخراجاً عصريّاً، فيقع في الخلط، والإسقاط، والاغتراب التاريخي»(ص 49). إنّ هذا الاستشراف يمكن أن نقف عليه، بعد الاستقراء، في مجالات مختلفة كاللغة، والمخيال، والأدب، وهي المجالات الّتي نظر من خلالها صاحب العمل في موضوعه.
والاستشراف، من جهة أخرى، من بين مهمّات المثقّف ووظائفه الأساسيّة، ولكن هذه المهمّات والوظائف غير محدّدة الملامح اليوم؛ بل إنّ «هناك صعوبة راهنة في فهم وظيفة المثقّف وتقبّلها؛ لأنّ النظام الإعلامي والثقافي السائد يخضع [...] إلى إغراءات صور (الخبير)، و(المحلّل السياسي)، و(الناشط الحقوقي)، وكأنّ المثقّف ينتمي إلى عصر غير عصرنا»(ص 65).
كذا قدّمت الأستاذة رجاء بن سلامة مقالتها حول (المثقّف والغيريّة، هوامش على كتاب «في المثقّف والسلطة» لإدوارد سعيد) (ص ص 65-70)، وهي مقالة تقرأ فيها صاحبتها كتاباً هو جمع من محاضرات سعيد التلفزيونية، في بداية التسعينيات من القرن العشرين، إلّا أنّها رأت فيه ما ينبغي الانتباه إليه اليوم إثر التحوّلات السياسيّة، التي شهدتها بعض الدول العربيّة، ومن بينها تونس، بداية من سنة (2011م)، في ما يتعلّق بدور المثقّف وصورته، وما يجب أن يضطلع به؛ إذ إنّ المثقّف يقع «خارج السلطة، وخارج الملّة»(ص 66). ومن هنا كانت «غربته وبرّانيّته»، ولكنّه، في الآن نفسه، هو ذلك «البرّانيّ الغريب القريب: داخل (المعترك)، بمعنى ضرورة وعيه، هو أوّلاً، وقبل غيره، بضرورة انخراطه في الشأن العام، وبصورة مباشرة، وفي علاقة عضويّة مع مجتمعه، كاسراً مقولات غدت ثقافيّة من قبيل (عدم اختلاط الحابل بالنابل)، وثقافة (لجم العوام عن علم الكلام)، فينزل من عليائه (باحثاً عن المطبخ)؛ مطبخ المجتمع الّذي يقصي فيه (الخصم) (خصمه) لفظاً، وصورةً، ومادّةً، فلا يبقى أمام المثقّفين إلا أن يكونوا أولئك (الغرباء الأليفين)(ص 60)، الذين عليهم أن يكونوا (حرّاساً للفراغ)؛ «أي لكلّ المواقع الّتي يجب أن لا يحلّ فيها أحد موقع الإله؛ ولذلك، فهو يدافع عن العلمانيّة، وموقع الدوالّ الكبرى، الّتي ترمز إلى العيش معاً؛ ولذلك فهو يدافع عن الديمقراطيّة، وعن عدم التباس أيّ شخص بالدولة وإرادة الشعب، وموقع الحقيقة؛ ولذلك فهو يدافع عن الفنّ، والخيال، والفكاهة، والهزل. إنّه حارس للغيريّة المطلقة؛ ولذلك لا يكاد يحتمل أصحاب السّلطات المختلفة صورته ووظيفته، فيختزلونه في كونه (مثيراً للجدل)»(ص 70).
إنّ ما يَعدّه صاحب السلطة (إثارة للجدل) هو وظيفة المثقّف عينها عبر إعادة النظر، والسؤال، والنقد لمختلف أشكال الخطاب، سواء كان خطاباً سياسيّاً، أم فنّياً، أم دينيّاً، أم فلسفيّاً، أم تاريخيّاً، أم لغويّاً، أم أدبيّاً، وهذا ما تنزّلت ضمنه الدراسات التّي ضمّها الباب الثاني من كتاب (أعمال مهداة إلى الأستاذ عبد المجيد شرفي)، الوارد تحت عنوان: (في مناهج النقد وإشكاليّات الدلالة). إنّ (إثارة الجدل) المُشار إليها آنفاً هي، لدى الباحث، مساءلة للسائد في كلّ مستوياته، ومن ضمنها المستوى اللغوي والدلالي، وهو أمر يمكن الوقوف عليه في ما انتهى إليه الأستاذ توفيق العلوي حين نظر في (المسالك الدلاليّة عند ملشوك) (ص ص 127- 143)، فقد انتهى بعد التحليل، والمقارنة، والمراجعة، إلى أنّ «اللّافت في كتابات ملشوك مساءلة السائد الدلالي وتعديله، في محاولة منه لتأسيس سائد قوامه جهاز من المتصوّرات الدقيقة... ومن اللاّفت، أيضاً، ما أسّسه ملشوك من لغة شكليّة واصفة شكلنت القضايا الدلاليّة شكلنةً منطقيّة رمزيّة أخرجت المتصوّرات المجرّدة إخراجاً ماديّاً مجسّداً»(ص 142).
ولعلّ هذا الإخراج المادّي المجسّد يقترب، في بعض نواحيه، من عمليّة (مسرحة المعنى)، التي اعتُبرت (ضعيفة وغير ثابتة) في إحدى نتائج بحث الأستاذ عبد السلام عيساوي: (مقاربة دلاليّة لبنية حركة النقل في الفعل) (ص ص 145- 165). وهي نتيجة مرتبطة وثيق الارتباط بنتائج أخرى لهذا البحث، من بينها ما علاقة التأويل باللغة. فالتأويل «رؤية مشهد، أو فضاء متصوَّر، وهو مبدئيّاً عمليّة تقبل أن تمّحي طبيعيّاً مقارنةً بنتائجها المثبتة باللغة، ولهذا يكون التنوّع في وجهات النظر، فباللغة ندرك القضايا، ونؤوّلها، ونعيد بناءها، ولهذا يعسر الفصل بين اللغة الحدث، واللغة الوظيفة». وبناءً على هذه الملاحظة، لم تستطع اللسانيات العرفانيّة أن «تنفكّ عن النظام الرمزي في اللغة»(ص 164).
إنّ اللغة، بوصفها نظاماً رمزيّاً، تتجاوز المباحث اللغويّة واللسانيّة إلى مجالات أخرى، من بينها مجال النقد الأدبي، وهذا ما يمكن أن نلمسه في ثنايا مقال الأستاذ حسين واد: (ما الّذي بقي من الخطابات النقديّة الحديثة؟) (ص ص 73-87)، وهو عنوان في صورة سؤال مشكل؛ لأنّه يخفي السعي إلى النظر في علاقة النقد النظريّ والمنهجيّ (الصارم) بالأدب، وهو وجه من وجوه الفنّ المستند، أساساً، إلى (اللغة)، وهي أكثر الأنظمة الرمزيّة استعمالاً، وانتشاراً، وتكييفاً للإدراك (ص 85). ثمّ إنّ الأدب، وهو مجال الفنّ، «حيّز حرّ لا يُسيّج بالنفع، ولا بالغائيّة، ولا بالخطأ والصواب، ولا بالمنطق وانعدامه. تظلّ جميع السلطات حياله عاجزة عن وضع اليد عليه»(ص 87)، ولمّا كان الحال كذلك استعصى الأدب على سياج التنظير والحدّ، وكسّر سؤال الماهية والتعريف.
كذا هو الأدب، تماماً كما كانت الأسطورة من قبلُ، وقد نظر فيها الأستاذ محمّد عجينة ضمن مقاله (الأساطير وتحوّلاتها: الأساطير والأدب)(ص ص 107-128)، فقد كانت الأسطورة، بدورها، عصيّة على التعريف، تشهد بذلك كثرة التعريفات في اختصاصات معرفيّة متعدّدة، وقوربت مقاربات كثيرة، من بينها علاقتها بالأدب، فجاء المقال بحثاً (في الأساطير وتحوّلاتها، أو تشكُّلاتها، وعلاقة ذلك بأشكال الأدب، أشكالاً تستحيل إليها الأسطورة، بصفتها قصّة أو حكاية، ليست كياناً جامداً، أو بنية ثابتة؛ بل كياناً حيّاً، ويكون ذلك عندما تُهاجر الأسطورة في الفضاء، فإذا هي تتحوّل إلى خرافة، أو مسرحيّة، أو حكاية شعبيّة عجيبة، أو رواية، أو أيّ شكلٍ آخر من أشكال الفنون. كما تُهاجِر في الزمان، وأنّ سمة التحوّل والتشكُّل لا تفارقها في كلٍّ من طوريها الشفويّ والمكتوب»(ص 107).
ولكن، قلّب الأساطير والأدب ترَ فيها رؤية للعالم، ومعالجة للراهن، واستشرافاً للمستقبل، وهذه وظائف وقف عليها الأستاذ محمود طرشونة، وهو يبحث في (وعي الراهن واستشراف الآتي في الرواية التونسيّة) (ص ص 89-106)، منطلقاً من عدد من الروايات التونسيّة، التي صدرت بين سنتي (2000 و2011م) (الهامش 2، ص 89)، وهي روايات رأى فيها الأستاذ طرشونة تحوّلاً جذريّاً عرفته الرواية، بموجبه تحوّل هذا الجنس الأدبي، وقد تجاوز وظيفته التقليديّة المختزلة، في إظهار التغيّر الاجتماعي إلى إظهار وعي المجتمع بتغيّره (ص 90). وهذا الوعي بتغيّر الراهن هو ما يمكن الوقوف عليه من النماذج الروائيّة المختارة في هذا المقال. وتذهب الرواية إلى أبعد من ذلك، فنقف في ثنايا نصوصها على أنّ الوعي بالراهن لم يكن سوى خطوة أولى تسبق استشراف المستقبل، ودوننا رواية عبد الجبّار العشّ (وقائع المدينة الغريبة)، (الصادرة سنة (2000م))، التي تعي راهنها آنذاك، وتتصوّر أحداثاً قريبة ممّا حدث سنة (2011م) في تونس، على المستويين الاجتماعي والسياسي.
وغير بعيد عن معالجة الراهن وقضاياه، تنزّلت أربعة بحوث ضمن الباب الثالث من الأعمال المهداة إلى الأستاذ الشرفي، وكان النظر في الراهن فيها موزّعاً بين محورين كبيرين، محور أوّل تعلّق بجوانب من الاستشراق المعاصر. أمّا المحور الثاني، فكان قائماً على تحليل الخطاب الاجتماعي والسياسي.
يندرج ضمن المحور الأوّل عملان؛ أوّلهما للأستاذ العادل خضر: (من هو الأوروبّي؟ أو الاستشراق والمنظور الإمبريالي) (ص ص 170-183)، والعمل الثاني للأستاذ فوزي البدوي: (الدراسات العربيّة والإسلاميّة في إسرائيل) (215-230). يقوم العمل الأوّل على قراءة مكتنزة لكتاب إدوارد سعيد (الاستشراق: الشّرق وقد ابتدعه الغرب)، واللافت للنظر عنوان المقال الذي يخبر عن نظره في الاستشراق، ولكنّه يقدّم ذلك بسؤال عن الأوربّي، وقد يبدو هذا لقارئ متسرّع سؤالاً مقلوباً؛ إذ الأوربّي هو المستشرق الباحث في موضوعه، وهو (الشرقيّ). هنا تحديداً يصبح الفاعل موضوعاً للبحث. فيتحوّل السؤال من كيف ينظر المستشرق الآخر إلى الشرقيّ (نحن)، إلى سؤال آخر يكافئه هو: «كيف يصنع المستشرق خطابه عن (الشرق) والإنسان (الشرقيّ)؟» (ص 174)، وبذلك جاز سؤال/ جواب آخر: «ألا يكون (الشرق) والإنسان (الشرقيّ) هذه المرآة العظيمة، الّتي ابتدع بفضلها (الأوربي) آخره (اللا أوربيّ)، إنّما هو ذاك الآخر الّذي ابتدع، بدوره، وبوجه من الوجوه، (الأوربيّ)، وعثر عليه، ووجده، وكشفه، واكتشفه، وسوّاه واخترعه؟» (ص ص 174-175). وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التحليل المعمّق قد يقود، في نهاية المطاف، إلى نقطة مركزيّة تلخّصها عبارة «التضامن التاريخي بين العلم والاستعمار»(ص 179).
هذا الارتباط بين العلمي والسياسي الاستعماري له مظاهر وتجلّيات مختلفة ألحّ عليها الأستاذ فوزي البدوي القولَ في عمله المشار إليه آنفاً؛ إذ ختم مقالته بضرورة «التذكير بأنّ الصراع السياسي العسكري الحالي كان، بالنسبة إلى الأوساط الأكاديميّة الإسرائيليّة، حافزاً على مزيد الاهتمام بالعرب والمسلمين في جميع المجالات، ولا يخفى، اليوم، عن المتخصّصين أنّ أشدّ الدراسات تأثيراً في الأوساط الأكاديميّة العالميّة في ما يتعلّق بالإسلام تُنتَج داخل المثلّث الأمريكي الإسرائيلي البريطاني، وبين مؤسّسات ثلاثيّة الأضلاع هي: جامعة برنستون، وأكسفورد، والجامعة العبريّة في القدس»(ص 230). ونرى أنّ هذه الخاتمة مهمّة جدّاً بعد عرض تاريخيّ وتوثيقيّ دقيق يكون مدخلاً لاستدراك قلّة «الدراسات العربيّة حول ما يمكن تسميته، مجازاً، بـ (الاستشراق الإسرائيلي)، أو المتخصّصة في متابعة ما يُنشر داخل إسرائيل حول اللغة، والآداب، والثقافة العربيّة الإسلاميّة في القرون الوسطى على وجه الخصوص» (ص 215).
أما بالنسبة إلى المحور الثاني، ضمن باب قضايا الراهن، فإنّه اشتمل، بدوره، على عملين؛ الأوّل للأستاذة آمال قرامي تحت عنوان (تمثّلات الرجولة في المجتمع التونسي بعد ثورة 14 جانفي) (ص ص 185-213)، وهو عمل يدرس «التغيّرات الحاصلة على مستوى تمثّل الرجولة في المجتمع التونسي، بالاعتماد على نماذج من الخطابات: خطابات الدعاة، وبعض أتباع حزب النهضة، والأحزاب السلفيّة، ولاسيما خطابات شباب النهضة، والشباب السلفي في المواقع التواصليّة: فيس بوك»(ص 185). وهذا البحث يأخذ في الاعتبار «دراسة السياقات الاجتماعيّة، والثقافيّة، والسياسيّة، والإيديولوجيّة، التي أفضت إلى ظهور مثل هذه التصوّرات، واضطلعت بدور مهمّ في بناء الرجولة اليوم»(ص 185).
إنّ هذه السياقات نفسها هي التي تشكّل، في خطابات أخرى، ضروباً من المرجعيّات التي يمكن البحث فيها، وهذا هو مدار عمل فريدة التهامي طراد (الخطاب السياسي في تونس اليوم -في المرجعيّة-) (ص ص 230-246)، وهو عمل يحلّل المنطوق به، والمسكوت عنه، والمكتوب الصادر عن بعض وجوه الحكم، والمقرّبين منهم، في حدود سنتي (2012 و2013م) أساساً، من خلال قسمين؛ قسم يتعلّق بالمفقود في الخطاب؛ أي غياب المرجعيّة في الخطاب السياسي، ما جعله عاجزاً عن فهم خطابات أخرى. أمّا القسم الثاني، فتعلّق بالمرجعيّة الموجودة في الخطاب السياسي، وهو خطاب أبان «عن بحث أصحابه عن سند يتجاوز شرعيّة القانون، إلى بناء شرعيّة تُستمدّ من السير على المنوال والوفاء إلى الأصل أو المرجعيّة. وقد توخّوا، لتحقيق ذلك، التوسُّل بعلامات تمكّنهم من الدعاية، وأن يتجلّوا عبرها [...]، إلاّ أنّ هذا البحث أو السعي يبقى محاولات غير مجدية للسيطرة على الإدراك والوعي، وتشكيل الواقع وتوجيهه في ظلّ ضياع الشفرة القديمة الّتي تُقرأ بها هذه العلامات»(ص ص 245-246).
إنّ العلامات وشفرتها المُتحدَّث عنها هنا هي، في الأصل، رموز لها أصول تراثيّة وكونيّة، وتاريخيّة، ودينيّة، قابلة لأن تكون موضوعاً مستقلّاً للبحث، وهو ما كان موضوع المحور الكبير الرابع من الأعمال المهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي، الذي جاء تحت عنوان (في التمثّل الديني)، وقد ضمّ خمسة بحوث ذات علاقة، قرُبت أو بعدت، بالمتخيّل الديني الّذي خصّص له الأستاذ بسّام الجمل فصلاً تنظيريّاً يحمل عنوان (في المتخيّل الديني)(ص ص 287-312)، لم يخلُ من أمثلة دالّة على ما ذهب إليه، تعريفاً وخصائصَ ووظائفَ، خلص، بعد تحليلها وبيانها، إلى نتيجة جديرة بالاهتمام، والمتابعة، والإضافة إليها، وتتلخّص في تحديد «الأصول المرجعيّة المولّدة لهذا الضرب من المتخيّل»، وهذه الأصول المرجعيّة هي: (الكسل)، و(البخل) و(الأمل) (ص 309)، فما المتخيّل الديني المرتبط بنيل التوبة والشفاعة، دون جهد أو عمل، إلّا دليل على ذلك الكسل، وليست الأدعية الكثيرة المحيلة على ضنّ الإنسان الديني حتّى بجثّته بعد موته على ديدان القبر، ما يحقّق شرط الإمساك، وطمعه في أن تكون حسنته بعشر أمثالها ما يحقّق شرط الاستثمار، إلا من دلائل على أصل البخل. وما صور الجنّة، والنعيم، والنجاة، والخلاص، إلّا دليل على أصل الأمل(ص ص 311-312).
كانت هذه الأصول المرجعيّة الثلاثة نتيجة أدّى إليها تحليل وظائف المتخيّل الديني، وهي الوظيفة التعليليّة التفسيريّة، والوظيفة التأسيسيّة، والوظيفة الجداليّة، ووظيفة تثبيت العقائد، ووظيفة التلطيف، ولعلّ استقراء النصوص ذات العلاقة بالمتخيّل الديني والتاريخي يكشف عن وجود هذه الوظائف، بعضها أو كلّها؛ إذ يمكن الوقوف عليها في العديد من الأخبار والتفسيرات المرتبطة بالتاريخ الديني الإسلامي، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، (خبر آيات الإفك في المصادر الشيعيّة)، وهو عنوان مقال الأستاذ المنصف بن عبد الجليل (ص ص 249-264)، وفيه معالجة تاريخيّة إناسيّة تنطلق من نظر في قضيّة مهمّة في الدراسات القرآنيّة، ونقصد انتظام الآيات في السور، وهي هنا آيات الإفك ضمن السورة التاسعة، وذلك قبل التعرّض لخبر الآيات في المصادر الشيعيّة أساساً، للوصول إلى وظائف الخبر الشيعي. وبناءً على تحليل دقيق يضيق المقام بتفصيله، أو حتّى الاجتزاء منه اجتزاءً لا شكّ في أنه مخلّ لترابط الفكرة في هذا العمل، يتمّ الوصول إلى استنتاجين على غاية من الأهميّة، أوّل الاستنتاجين «أنّ القرآن في بنية المصحف الإمام مازال يثير إشكاليّة هامّة هي تكوّن النصّ؛ ودون دراسة تاريخيّة - نقديّة لمسألة التكوّن جمعاً وترتيباً، فإنّ استقراء بنية الآيات، وتعالقها، ومواضعها من السور وسائر المصحف، سيبقى رهين الأخبار الّتي تمثّل حاجباً إضافيّاً يستر ذهنيّة خطاب الوحي ومحاضنه الإناسيّة؛ لأنّ الأخبار تصوّرات لأحداث، لا إنباء بها كما هي» (ص 263). وعلى هذا الاستنتاج الأوّل يقوم الثاني المتعلّق، بدوره، بمنهج في قراءة الأخبار: «على هذا النحو من استقراء العلامات الإناسيّة تخوّل –باجتهاد- تحديد النواة المعاصرة لمحمّد، وغيرها من الإضافات اللاحقة، كما تساعد على فهم الشخصيّة المحمّديّة بين مقالات المتجادلين في شأنه»(ص 264).
لقد أثار طرح الأستاذ المنصف بن عبد الجليل قضايا تتعلّق بمنهج استقراء الخبر (التاريخي) في تعلّقه بالعقائد، الذي يربط العقيدة بتمثّل التاريخ، وهو مبحث اندرجت ضمنه مقالة أخرى من الأعمال المهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي، ونقصد مقالة (العقيدة والتمثّل، الحسين في المتخيّل الشيعي) للأستاذ نادر الحمّامي (ص ص 311-334). وهي على علاقة، أيضاً، بوظائف المتخيّل الديني الموظّف لما عُدَّ أخباراً تاريخيّة لدى المؤمنين بها، تتحوّل فيها الشخصيّات، والأحداث، والألوان، والكائنات، والأزمنة، والأمكنة، إلى رموز تؤسّس العقائد وترسّخها، وتحقّق انسجام المجموعة الدينيّة وتماسكها، وتعبّر عن آمالها، وكلّ ذلك كان عبر البحث في «محورين أساسيّين: يتعلّق المحور الأوّل بجملة من عناصر الصورة الّتي رُسمت للحسين بن عليّ، وبالتمهيد لمقتله. ويرتبط المحور الثاني باستحضار ذلك المقتل دوريّاً أثناء مواكب العزاء الحسينيّة، ودلالات ذلك»(ص 317).
إنّ ما يُعَدّ عين الحقيقة التاريخيّة لدى المؤمن هو مدخل للبحث في المتخيّل التاريخي بالنسبة إلى الباحث، الذي قد يوصله البحث إلى النظر في العلاقة بين الكتابة التاريخيّة، وما تحمله من وظائف إيديولوجيّة وعقائديّة، وهو ما كان مدار مقالة الأستاذة جيهان عامر، حين بحثت في (صوت المرأة في الإسلام: بين الإيديولوجيا والتاريخ) (ص ص 335-355). وتقوم هذه المقالة على ضروب من المقارنة الطريفة بين أخبار سنّيّة وشيعيّة واردة في شأن أصوات أربع نساء وقع اختيارهنّ من بين نساء بيت النبوّة. ونقدّر أنّ الانطلاق من جزئيّة صوت المرأة وتمثّلاته في الخطاب التاريخي الإسلامي مكّن من التوصّل إلى نتائج مهمّة، من قبيل «أنّ قضيّة تمثيل المرأة في الثقافة الإسلاميّة ترتبط بقضيّة أشمل هي مسألة الحقّ في التمثيل. ويبدو أنّ هذا الحقّ قد اقتصر، في وجهه الغالب، على الرجال الذين نظروا إلى المرأة على أنّها صورة للآخر الّذي يمثّل خطراً على [...] (ثقافة الفحولة)، الّتي يهدّد تغييرُ وجهة النظر إلى التاريخ هيمنتَها على الثقافة العربيّة الإسلاميّة، عبر محاولة لتأسيس (تأنيث الذاكرة»(ص ص 354-355).
كذا يتحوّل (صوت المرأة رمزاً) على علاقة وطيدة بالمتخيّل التاريخي، وبالتمثّلات الاجتماعيّة، وهي من القضايا الّتي يمكن التطرّق إليها استناداً إلى رموز كثيرة تستعصي على الحصر، ذلك أنّ الشيء قد يصبح في الخطاب رمزاً، فيخرج من ماديّته، ووجوده الفعلي، إلى حمّال لتصوّرات عديدة. فهذا الشجر، مثلاً، في خطابات مختلفة، يصبح رموزاً دينيّة وحضاريّة، ودوننا الكرمة والنخلة في الكتابات المقدّسة، وفي كتب المفسّرين، والإخباريين، وغيرهم، غدت ثيمة فارقت الأرض إلى عوالم أخرى، وكذا كانت (الزيتونة) عنوان مقالة الأستاذة سهام الميساوي الدبّابي (ص ص 265-285)، التي يقترن ضمنها المتخيّل اليوميّ بالدينيّ المفارق للزمن، وقد «ضرب الله في سورة النور بزيت الزيتون مثلاً لنوره»، والمفارق، أيضاً، للمكان، فالزيتونة شجرة (لا شرقيّة ولا غربيّة) (ص 267). وبذلك وغيره «تنتصب الزيتونة شجرة كونيّة وسط العالم ظاهرة في الماء الّذي يظهر منه كلّ شيء حيّ» (ص 273)، وهي شجرة «على تخوم عالمين؛ عالم الأرض تضرب فيه أصيلة، وعالم الهواء، تنتشر فيه لتتنفّس ريحه ويغذّيها روحه»(ص 274). ولذلك «أثّرت منزلة الزيتونة القديمة، والمنزلة التوحيديّة، عموماً، والصور القرآنيّة خاصّةً، في المتخيّل الإسلامي»(ص 275).
يقوم البحث في التمثّلات الدينيّة والتاريخيّة، في قسم كبير منه، على آليّات تحليل الخطاب، والنظر في اللغة، واستعمالاتها الرمزيّة، تلك الاستعمالات الّتي من بين وظائفها ما هو اجتماعيّ يحدّد العلاقات داخل مجتمع ما، وهي علاقات متعدّدة، قد تتّسم بالتعايش، أو التكامل، أو النزاع، أو الجدل، فتؤدي اللغة دوراً مزدوجاً ينتقل من الفعل اللغوي إلى الفعل غير اللغويّ. وهذا أمر يمكن الوقوف عليه في صنوف عديدة من الخطابات، والوقوف ضمنها على عدد من العلاقات من بين تلك الخطابات، نجد ما انتمى إلى ما عُرف بالعلوم الإسلاميّة؛ كالتفسير، وعلوم الحديث، والتصوّف، وعلم الكلام، والفقه، وأصول الفقه. وفي هذه السياقات العامّة، تندرج أعمال الباب الأخير من الأعمال المهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي، وهي خمسة أعمال جُمِعَت تحت عنوان (من قضايا الاجتهاد)، واشتغلت على قراءة في النصوص الفقهيّة والأصوليّة، وحلّلت خطابها، بغاية تبيّن جوانب من تصوّرات تفصح عنها تلك النصوص أحياناً، وتسكت عنها أحياناً أخرى.
ومن العلاقات الاجتماعيّة، الّتي يمكن الكشف عنها من خلال لغة بعض الخطابات الدينيّة، قضيّة الهيمنة، وهو ما توجّهت إليه الأستاذة ناجية الوريميّ بوعجيلة، من خلال مقالها حول (اللغة والهيمنة في خطاب أصول الفقه) (ص ص 453- 465)، الذي انطلقت فيه، أساساً، من خطاب أصول الفقه، وإخضاعه «للتفكيك والحفر في طبقاته، بهدف الكشف عمّا وراء الدلالات الّتي يقدّمها على أنّها جملة حقائق بديهيّة، من أبعاد سلطويّة تترجم عن أشكال الانتظام السائد وتشريعاته»(ص 454). ووُجّه هذا التفكيك والحفر إلى الكتاب المؤسّس لعلم أصول الفقه (رسالة الشافعي)، ذلك الكتاب، الّذي سيؤثّر في كلّ ما سيأتي بعده ضمن المنظومة الأصوليّة. وكان التفكيك والحفر موصلين إلى أمرين جوهريّين؛ يتعلّق الأمر الأوّل بالتوصّل إلى الآليّات اللغويّة الداعمة لاختيارات اجتماعيّة، وثقافيّة، وسياسيّة، أُريد لها أن تُكرَّس تاريخيّاً، وهذه الآليّات هي: «آليّة التداخل بين الفواعل الذين يمكن أن يصدر عنهم الخطاب، وهو تداخل يضمنه اختفاء الذات المنتجة للخطاب فعلاً –وهي هنا الشافعي- وراء فواعل آخرين ذوي سلطة مرجعيّة مفارقة؛ الآليّة الثانية: التحديد النهائي للجهاز الاصطلاحي والمفاهيمي الّذي يتأسّس عليه علم الأصول، بما هو معيار العلاقة بين (النصّ) والتاريخ؛ الثالثة: إعادة تشكيل الماضي بطريقة تحوّله إلى سند (واقعيّ) لجملة الاختيارات المرجّحة؛ وتتمثّل الرابعة في الإيهام بالجدل، وبإفحام المخالف (المصطنع)؛ لإسدال الستار نهائيّاً على المخالف الحقيقيّ والخطير أحياناً»(ص 455). وبناءً على هذا الأمر الأوّل المتعلّق بالآليّات اللغويّة تتأسّس «سلطة خطاب أصول الفقه، وإرادة الهيمنة على الواقع». وهي سلطةٌ نجح الخطاب الأصولي في تحقيقها عبر «فرض طريقة معيّنة في فهم النصّ، والتعامل معه، وقدّمها على أنّها وحدها تمثّل الحقيقة، لكنّها [...] حقيقة تكلّس فيها (السلطويّ)، وظلّ حاضراً في واجهتها (المقدّس والمتعالي)، ومن هنا، اكتسبت قدرتها على التأثير في الواقع وتوجيهه»(ص 465).
يبرز التخفّي في الخطابات الدينيّة وراء (المقدّس والمتعالي) للتأثير في الواقع، وتوجيهه في مسائل عديدة ذات علاقة بتصوّر العلاقات في المجتمع وتنظيمها، وهو ما بدا لنا واضحاً من خلال عمل الأستاذة نائلة السليني الراضوي، الّذي قدّمته تحت عنوان (ملاحظات في مكانة الصبيّ في التراث الفقهي) (ص ص 359-372). وتأتي أهميّة هذا المبحث وأسئلته من راهنيّته، على الرغم من انطلاقه من الموروث الفقهي؛ إذ إنّه نابع، بالأساس، ممّا يواجه «من نيّة كامنة في مقالات الإسلام السياسي من نزعة إلى التراجع في قوانين هي من مكاسب بعض البلدان العربيّة، ومن أهمّها قانون التبنّي». فاستوجب أسئلة عن مكانة الصبيّ في القرآن، وهل حرّم القرآن التبنّي صراحة؟ ثمّ السؤال عن كيفيّة تعامل الفقهاء مع المرجعيّة النصيّة. لقد قادت مثل هذه الأسئلة إلى قراءة الأحكام الفقهيّة في تاريخيّتها، وأوصلت إلى نتائج مهمّة تخصّ موضوع البحث، ولكنّها تتجاوزه، في الآن نفسه، لطرح نظرة يمكن تطبيقها على الموروث الفقهي برمّته، ذلك أنّه «يمكن اعتبار الأحكام الفقهيّة، في تطوّرها التاريخي، وتفاعلها مع المجتمع في ديناميكيّته، نقاطاً إيجابيّة من منظورنا المعاصر تعين من سكنه هاجس الالتزام بالماضي في فهم الظاهرة الثقافيّة، مثلما تمكّنه من الاقتناع بأنّ الأحكام الفقهيّة، في مجملها، غير ثابتة، وإنّما تتبع الهاجس الاجتماعيّ ضماناً لانسجام المجتمع»(ص 372).
تشير هذه الملاحظة المركزيّة إلى عدم الثبات، وتاريخيّة الأحكام، وتلبّسها بالاجتماع وإكراهاته، غير أنّها إن كانت كذلك فإنّها في خطابات الفقهاء في حاجة أكيدة إلى شرعيّة نصيّة، سواء تعلّق الأمر بالقرآن أم الروايات عن النبيّ، وهذا ما بدا لنا واضحاً في بحث الأستاذة هنيدة حفصة، وهي تقلّب ما شُرّع به أخذ الجزية من المجوس في مقالها: (حول مصادر التشريع الإسلامي لجزية المجوس، قراءة في حديث أخذ الجزية من المجوس) (ص ص 415- 452). ففي غياب المرجعيّة القرآنيّة في هذا الأمر، تمّ اللجوء إلى السنّة النبويّة تشريعاً لهذا الحكم. وقد جاء هذا العمل تقليباً في الحديث المتعلّق بجزية المجوس أسانيد ومتوناً، ما استوجب المقارنة من داخل منظومة المحدّثين أنفسهم في ما عُرف بعلوم الحديث، وهي مقارنة أدّت إلى الوقوف على النظر في ظرفيّة رواية الحديث التاريخيّة والاجتماعيّة؛ إذ تمّ تأكيد أنّ عدداً من الأحاديث، في هذا الموضوع، لها سياق تاريخيّ غير معلن «واكب مرحلة تدوين الحديث النبوي بدءاً من النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، وعبّر عن نظرة إسلاميّة جديدة للمجوس حاملي الثقافة الإيرانيّة، مالت، آنذاك، إلى التشدّد معهم، ومعاملتهم كسائر (الكفّار)». وهذا الأمر حريٌّ بأن يكشف أنّ الحديث النبويّ «كان في جدليّة واضحة مع الأحكام الفقهيّة من ناحية، ومع الظرفيّات التاريخيّة، الّتي ميّزت مرحلة تدوين الحديث، من ناحية أخرى»(ص 452).
لعلّ الوعي بتاريخيّة الفقه، وأصوله، وتفاعله مع التاريخ، ومقتضيات الاجتماع، كان من بين محرّكات التركيز على الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر من داخل المنظومة الدينيّة، أو القريبين منها فكريّاً. غير أنّ الاجتهاد، بدوره، ليس واحداً؛ بل هو متعدّد من جهة مرجعيّاته ومنطلقاته، ومشاغل أصحاب الداعين إليه، والمنظّرين له، ومن هنا، أمكن تصنيف الاجتهاد وفق منهجيّاته وبنيته. وهو ما يمكن أن يكون إطاراً لعملين في الأعمال المهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي، ونقصد بحث الأستاذة زهيّة جويرو: (محاولات تجديد علم أصول الفقه بين الترميق والتفجير) (ص ص 373- 399). أمّا العمل الثاني، فيمثّله بحث الأستاذ حمّادي ذويب: (الاجتهاد ومراعاة المصلحة في الفكر المغربي الحديث) (ص ص 401- 414).
ذهبت الأستاذة جويرو إلى إمكانيّة تصنيف محاولات تجديد أصول الفقه من داخل المنظومة الفقهيّة التشريعيّة إلى صنفين كبيرين، اعتبرت «كلّ واحد منهما بنية قائمة بذاتها: بنية الترميق، وحكمتها تصوّرات سعت إلى أن تعيد النظر، ولكن من داخل المنظومة التقليديّة الراسخة [...]، وبنية التفجير [وتعني] كلّ الأعمال الّتي حاولت أن تخرق السياج الّذي أحاطت به المنظومة التقليديّة نفسها، متوسّلة، في خرقها ذاك، بوسائل وأدوات تقع مرجعيّتها خارج حدود تلك المنظومة، وتنتمي إلى منظومة المعرفة الحديثة»(ص 377). ولكن، على الرغم من هذا التصنيف القائم على تمايز منهجيّ، فإنّ النتيجة كانت «أنّه لا الصنف المحكوم ببنية الترميق، ولا ذاك المحكوم ببنية التفجير، توصّل إلى صوغ الحلول المناسبة [...]، ويعود جانب كبير من هذا المأزق [...] إلى الانفصال التامّ؛ بل التعارض بين المنظومة العامّة، التي ينتمي إليها التشريع الديني عامّةً، والإسلامي بصفة خاصّة، والمنظومة الّتي ينتمي إليها، بطريقة أو بأخرى، ويفكّر في نطاقها [...] أصحاب هذه المحاولات. هذا فضلاً عن سيطرة الموجّهات الإيديولوجيّة، الّتي فرضت على أكثرهم توجيه تصوّراتهم نحو ما يخدم مواقفهم الإيديولوجيّة أكثر ممّا كانوا ملتزمين بمقتضيات المعرفة الموضوعيّة»(ص 399).
وقد يكون التصنيف إلى صنفين كبيرين (المشار إليهما آنفاً) محلّ تصنيف داخليّ يرى فيه بعض الدارسين خصوصيّات أخرى أكثر تفصيلاً، فعلّال الفاسي، وقبله الحجوي، في المغرب الأقصى، قد مثّلا علمين بارزين في المدرسة الأصوليّة، واعتُبِرا مثالين على ما عُدَّ (فكراً مغربيّاً صميماً)، في ما يتعلّق بالاعتماد على المصلحة، باعتبارها من أهمّ وسائل الاجتهاد في العصر الحديث، وكان ذلك هو منطلق بحث الأستاذ حمّادي ذويب. وعلى الرغم من إعلان هذا الفكر بإيمانه «بقدرة الفكر الاجتهادي في العصر الحديث»(ص 412)، وعلى الرغم، أيضاً، من أنّ المطّلع «على كتابات المجتهدين المغاربة يدرك بوضوح أنّهم كانوا توّاقين إلى تجديد فتوّة المجتمع الإسلامي بكلّ مناحيه، ومنها المنحى التشريع، وأنّهم اتّخذوا، في سبيل ذلك، سبلاً متنوّعة يجمعها مسمّى المصلحة والضرورة. إلّا أنّ اجتهاداتهم المصلحيّة اقتصرت على مجال المعاملات، والأحوال الشخصيّة، وكانت محكومة بحدود النصّ، والمتواتر من السنّة والإجماع»(ص 414).
لم يتعدَّ ما أسلفنا ذكره في هذه الورقة حدود التقديم، فلا ندّعي، مطلقاً، أنّه تجاوز العرض إلى القراءة، والنقد، والمراجعة، والنقاش، وهو أمر مقصود، فلم يكن تقديمنا، هنا، سوى مواصلة للاحتفاء بالأستاذ عبد الشرفي، من خلال الأعمال المهداة إليه، فاقتبسنا منها الكثير، وهي أعمال تشهد بمضامينها ومناهجها، على اختلافها وتنوّعها، على أمر مهمّ يتعلّق بما قدّمه تلاميذه أساساً، وهو أنّ الأستاذ الشرفي استطاع أن يُسهم بقسطٍ وافرٍ جدّاً في تأسيس مدرسة في الجامعة التونسيّة لا تعترف بعقليّة (الشيخ والمريد)، وتسعى إلى أن تقدّم معرفة لا تستلهم من الأستاذ مقولاته فتتبنّاها، وإنّما تستلهم منه العمل الدائم على الإنتاج العلمي بوضوح في غير إسفاف، وفي تواضع في غير ابتذال، وفي صرامة في غير تعقيد، وفي دقّة دون تكلّف، وفي جرأة في غير تجرّؤ، وفي ثقة في غير ادّعاء، وفي موضوعيّة في غير استقالة، وفي حريّة في غير اعتباط، وفي مسؤوليّة دون حسابات؛ لذلك، وغيره، لم نرد لتقديمنا أن يكون نقديّاً هذه المرّة، وأردناه احتفاءً متجدّداً بالأستاذ المعلّم.
[1]- جامعة تونس، كلّيّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة في تونس، تقديم الأستاذ عبد القادر المهيري، جمع الأعمال وتنسيقها ناجية الوريمّي بوعجيلة، تونس، 2014م، 469 صفحة، وعلى هذه الطبعة نحيل في متن النصّ على الصفحات الّتي أخذت منها الشواهد.
[2]- هذا ما جاء في عنوان التصدير، الذي وضعه الأستاذ وحيد السعفي، رئيس وحدة البحث (في قراءة الخطاب الديني)، التي جمعت، في إطار أنشطتها، الأعمال المهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي.
[3]- تضمّن الكتاب في أوّله تعريفاً مستفيضاً بالأستاذ الشرفي، وسيرته العلميّة والأكاديميّة، ص ص 9- 39






