فيلسوف اليَسار حين يفكِّر في الإسلام
فئة : قراءات في كتب
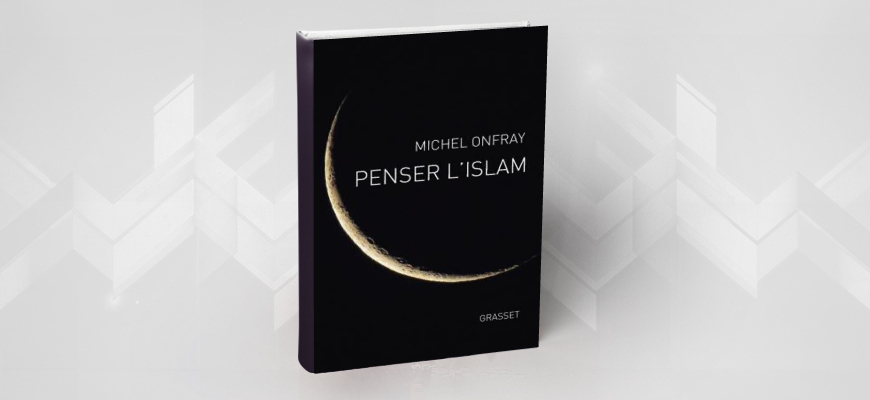
فيلسوف اليَسار حين يفكِّر في الإسلام[1]
نجم الدين خلف الله[2]
عودة الفلاسفة الفرنسيين التَّأمُّلية إلى التراث الإسلامي هي تقليد ثقافي فرنسي، يضرب بجذوره العميقة في جدالات القرون الوسطى ونقاشات عصر الأنْوار؛ فقد كَتب عن الإسلام، ديانةً وحضارةً، العديدُ من مُفكِّري فرنسا وعلى رأسهم: فولتير (1694-1778)[3]، مونتسكيو (1689-1755)[4] وفيكتور هيجو (1802-(1885[5]، وقد خاضوا جميعهم غمارَ البحث في نصوص هذا الدين وثقافته، تأويلاً وتحليلاً. وآخِرُ العائدين إلى نصوص الإسلام، في أيامنا (2016)، المفكر الفرنسي ميشال أنفري Michel Onfray (ولد في غُرَّة يناير/كانون الثاني 1959)، وقد شغل منصبَ أستاذٍ للفلسفة في التعليم الثانوي لسنواتٍ، ثمَّ استقالَ لِيُؤَسِّس "الجامعة الشعبية"، والهدف منها تبسيط المعارف وإشاعتها بين العموم، دون ارتباطٍ بالمنظومة الجامعية الرسمية. كما اشتهر أنْفري بتوجهه اليساري، فيما يتصل بمواقف السياسة، وبدفاعه المستميت عن الإلحاد، فيما يتعلق بعالم الفكر، وتبني مبدأ اللذة (hédonisme) في مجال الفلسفة الجسدية، متأثرًا في ذلك بتيارات الفَوضوية وفلسفات القوة والذاتية كما تبلورت في أنساق سبينوزا (1632-1677) ونيتشه (1844-1900). ولذلك، بات الرجل يمثل وَجهًا إعلاميًّا دائمَ الحضور في وسائل الإعلام الفرنسية.
وفي الأشهر الماضية، أصدر كتابًا يختلف عن كل ما أصدره من قبل، ولا يمت بصلةٍ واضحة إلى تكوينه الفلسفي، وسمَه بـ "التفكير في الإسلام"، وهو يقعُ في 168 صفحة. ويتألف هذا "البيان" الجريء من تمهيد ومقدمة، هما في الأصل مقالات كتبها للصحف الفرنسية، تعقيبًا على الأحداث الإرهابية الدامية التي طالت فرنسا سنَتَيْ: 1915 و2016، ثم مقدمة ثانية، مُطوَّلة صَدَّرها بقولة للفيلسوف سبينوزا: "لا نَضحك ]من الأحداث[، ولا نبكي، ولكنْ نَفهمها"، تعبيرًا عن منزعه لتفكيك العالم وفهمه، بعيدًا عن الأحكام المعيارية. وخَصَّص القسم الأكبر من عمله لمحاورة "فلسفية"، أنجزها مع صحافية جزائرية لحساب جريدة "الجديد". ويبدو أنه حوَّل هذا الحوار الشفوي إلى نصٍّ مكتوبٍ، في شكل كُتَيَّب، تحدَّث من خلال صفحاته لا باعتباره: "متخصصًا في الإسلام، بل مواطنًا يمثل له الإسلام مسألة فلسفية، وباعتباره فيلسوفًا يشكِّل له الإسلام قضيةَ مُواطَنَةٍ"، (التفكير في الإسلام، ص. 17). وهكذا صاغَ محاورته بوصفه مفكرًا حرًّا، ومواطنًا ينتمي إلى بلدٍ يسعى إلى التأثير في سياساته وآراء مواطنيه؛ فما هي أهم الأفكار الواردة في هذا الكتاب؟ وكيف يمكن تقييمها على ضوء المعارف الراهنة؟
كتاب "التفكير في الإسلام"، في حقيقته، سلسلة من الأجوبة والآراء والمواقف حيال الإسلام، كما يتَصوره الفيلسوف اليساري، من خلال المتخيَّل الفرنسي المعاصر، وهو يستعرض هذه العناصر بشكل تلقائي دون ترتيب نسقي صارمٍ، ولذلك، رأينا من اللازم أن نعيد تنظيمها بإيجاز من خلال هذه المحاور الأربعة:
أ- العلمانية: وينطلق الكاتب من رفض اعتبار العلمانية، السائدة رسميًّا في الدستور والمجتمع الفرنسيَيْن منذ إصدار قانون 1905، بمثابة عقيدة كليَّة غير قابلة للنقد، بل يعتبرها نظامًا فكريًا تاريخيًا، يمكن، بل ينبغي، إعادة التفكير فيه، دون تأخرٍ، فقد صيغت هذه المنظومة في ظروف سياسية دقيقة، وأسَّسَت لمبدأ الفصل التام بين الدين والدولة، في فرنسا، البلد الذي كان خاضعًا لسلطة الكنيسة الكاثوليكية. وآنذاك، لم يكن ثمة من وُجود عددي ملحوظ للمسلمين، طبعًا إذا استثنينا ساكنة المُستعمرات. أمَّا وقد صار المسلمون يشكلون أغلبية ديموغرافية مَرئيَّة، فلا بد من تحيين مَبدأ العلمانية وإعادة التفكير في مكوناته بعمقٍ. ولذلك، صاغ ميشال أنفري هذه المُعادلة على النحو التالي: تؤدي الجمهورية الفرنسية واجبَها كدولة لحماية المواطنين المسلمين، وهم مثل سائر أقرانهم الفرنسيين. ويَحترم المسلمون واجبهم الوطني، إزاء الجمهورية، بِنَبذ التعاليم الدينية والممارسات "القبَليَّة" المُعارضة لمبادئها، وذلك بهدف "بناء إسلام جمهوري" على المدى المتوسط والبعيد (التفكير في الإسلام: ص. 72)، ولاسيما أنَّ الإسلام يتمتع اليوم "بمَوفور الصحة"، حسب عبارة الفيلسوف الألماني نيتشه التي أوردها الكاتب مراتٍ.
وعليه، يقترح المفكر الفرنسي إعادة ترتيب العلاقات بين الدولة الفرنسية والمجتمع، بين السلطة السياسية والضمير الذاتي، وبين القانون الوضعي والشعائر التعبدية؛ ذلك أنَّ الطبيعة الاجتماعية الظاهرة والانتشارية للإسلام (التي تتجسد مثلاً من خلال صلاة الجمعة في المساجد والمصليات المكشوفة، والصيام أثناء أوقات العمل، الامتناع الواضح عن أكل بعض المأكولات المحرمة دينيا في المدارس والشركات...)، تفرض تعاملا، من نوعٍ جديدٍ، مع هذه الديانة التي تحضر بقوة رمزية وشعائرية كبيرة ضمن مشهد الحياة اليومية. والإسلام، - في هذه النقطة بالذات - يختلف اختلافًا جوهريا عن الطبيعة الانطوائية للديانة المسيحية بما أنها باتت - وبعد عقود طويلة من العَلمنَة التي مورست على المجتمع الفرنسي - مجرد قيم مستبطنة أو جذورٍ وذاكرة. وتتأكد ضرورة هذا التعامل الجديد بسبب الانفجار الديموغرافي الحاصل في أوساط المهاجرين وأبناء الجيل الثاني والثالث، (من كل الجنسيات الإفريقية والعربية والباكستانية والتركية...)، وهو ما يجعل الحضور البشري للإسلام كثيفًا، يملأ المشهد الإعلامي، ويجبر على تطوير ليس فقط مقولات السياسة، بل وأدوات التحليل السوسيولوجي للمجتمع الفرنسي، الذي لم يعد هو ذاته، كما كان عليه من عقود مضت.
ب. الثنائية الضدية في القرآن: من جهة ثانية، بنى الكاتب تصوراته عن الإسلام حول ثنائية ضِدِّيَةٍ، لا تخلو من سطحية، تَحكم النص القرآني، الذي يَتَضَمَّن، في رأيه، وفي ذات الآن، آياتٍ تحث على السَّلام، وآياتٍ أخرى تحرِّض على العنف. ويستنتج من ذلكَ أنَّ التناقض عام وبنيوي في هذا النص، بل إنَّ هذا التناقض هو المصدر الرئيس الذي وَلَّد ضَربيْن من ممارسة الدين الإسلامي وتأويله: القراءة الحَرفية التي تفضي ضرورةً إلى استخدام العنف والقتل تطبيقًا لآيات معينة، نَزَعها من سياقها. والقراءة الروحية-الأخلاقية التي تقرُّ بحرية الوعي وإمكانية استخدام العقل، وتدعو إلى تزكية الضمير. ففي رأيه، يقتصر القرآن "على آيات تدعو إلى الذَّبْح، وثمةَ سُوَرٌ]ويعني: آيات[ أقلُّ عددا، ولكنَّها موجودة، تَدعو إلى المحبة والرحمة ورَفض الإكراه في الدين"، (نفس المرجع، ص.55). فالتعارض حاصل في مضمون النص وفَحواهُ، ولذلك دعا الفيلسوف أنفري إلى الإقرار أولاً بهذا التعارض، قبل إنتاج خطاباتٍ تبريرية عنه، لأنَّه لا يمكن إنكار تلك النصوص الإسلامية التي تدعو، في رأيه، صراحة إلى العنف، كما لا يمكن ادِّعاءُ أنها لا تمتُّ إلى الدين بصلةٍ، وإلا سقط النصُّ بِرمته، وهو بذلك يُدين كلاُّ من التوجهيْن: الحَرْفي والسياقي في تـأويل التراث، ويعتبرهما قاصرَيْن عن استيعاب التباسات النص القرآني وفكِّ غموضه وتناقضاته.
وتجدر الملاحظة أنَّ ميشال أنفري هنا - شأنه في ذلك شأن أغلب المثقفين الغربيين - يهمل أهمية المجهود التأويلي الذي اغتنى بفضل علم أصول الفقه بما هو شبكة هرمينيطيقة herméneutique متكاملة عملت على "تدبير" المعنى في النصوص الدينية، ولاسيما المُعضلة منها، وَجهدت في وضع حدود وشروط تلطف الحدة الظاهرة في بعض الآيات، وتنزع عنها مظاهر اللبس والإشكال. وكل قراءة للقرآن - في يومنا - تغفل إسهام أصول الفقه وما فيه من قواعد التخصيص والتعميم والتقييد والإطلاق، إنما هي قراءةٌ قاصرة. ولا يستقيم ردُّ أنفري - وغيره - القائل إنَّ نص القرآن كافٍ بذاته، وإن ما عَداه وصيغ عنه هي نصوص بشرية؛ لأنَّ التأويل - ولاسيما في المجال الفقهي - هو الذي يصنع القيمة ويعطيها كل دلالتها.
ج. التعارض بين الحداثة والديانات: من جهة ثالثة، يعتقد المفكر الفرنسي أنَّ النصوص المقدسة، التي ارتبطت بها الديانات التوحيدية الثلاث (اليهودية، المسيحية والإسلام)، متضمنة لبذور العنف والرَّجعية، ولذلك لا تصلح أن تكون مصدر إلهامٍ أخلاقي، يضيءُ دروبَ التربية الروحية للمواطنين. بالإضافة إلى كون الأديان، وفقًا للتصور الماركسي- المادي[6]، الذي يتبناه الكاتب وينافح عنه، تَتَعارض صراحةً مع القيم الجمهورية، وتتضمن مبادئ لا تتطابق مع الحرية والعدل والمساواة بين الجنسيْن، ومَوضوعية القواعد القانونية. فقد رأى هذا المفكر - دون التركيز على الإسلام وحده - أنَّ الديانات الثلاث بطبيعتها معارِضة لمبدأ اللذة، مناهضة لمتعة الجسد، ولمقولات التفكير النقدي - ولذلك دعا صراحةً إلى تبني الإلحاد بوصفه موقفا فلسفيا ومجتمعيًا، يُواجَهُ من خلاله تناقضُ الديانات، التي تدعو في ظاهرها إلى التسامح والمَحبَّة، ويَرتكب أتباعها باسمها أبشع الجرائم. كما يلحُّ على ما في هذه الديانات جميعًا من معاداة للمثليين وكراهية للمرأة واعتبارها كائنا قاصرا...في طرحٍ فكري يقابل بين منظومتين: الحداثة والدين، أو القيم الوضعية العقلية من جهةٍ وتعاليم الوَحي، الحاكمة في الأفراد والجماعات بدعوى بسط النظام ومحاربة الفتن، مَع أنَّ المستفيد الوحيد هو السلطان وذَووه. وهنا، لا يخرج أنفري عن الخط العام الذي رسمه فلاسفة الأنوار - وإليهم ينتمي وباسمهم ينافح - من حيث تركيزهم على سلبية الدين، وتكبيله للعقل الحرّ والتفكير النقدي المجرّد، بل وينادي بتطبيقه على الإسلام حتى يتخلص من مظاهر الرجعية فيه، وهو ما جعله ينحو باللائمة على اليسار الفرنسي، الذي تساند بعض أجنحته الإسلامَ، بما هو قوة ثورية تعين على التغيير ورفع الظلم العالمي، بل ويصمه بالخيانة والتنكر للمبادئ اليَسارية والجمهورية.
ويركز أنفري، في نهاية تحليله، على فكرة مفادها أن ظهور الحركات المتشددة في الإسلام ناتج عن السياسات الغربية (الفرنسية) الخارجية، وبسبب مشاركة الدول العظمى فيما يسمى، زورًا عنده، "بالحَرب على الإرهاب"، في حين أنَّ المسألة تجارية بحتة، تسعى من خلالها هذه الدول المهيمنة إلى بيع أسلحتها وتسويقها. وعليه، يجب ألاَّ يلام الإرهابيون وحدَهم على أعمالهم الفظيعة، ما داموا يَرُدُّون، بسلوكهم العنيف ذلك، على الإهانات المتكررة، التي لا تفتأ القوى الغاشمة واللوبيات المتكالبة توجهها إلى شعوبهم. والكاتب يساوي هنا بين الحرب على الإرهاب والإرهاب ذاته، ويفسرهما بنفس الأسباب، وهي غياب الفكر النقدي والعيش على أوهام العَظمة، والرغبة في التحكم بمصير الآخر، إلى جانب استشراء الثقافة الاستهلاكية، وهو بذلكَ يقترح تصورا تـنسيبيًّا (relativiste) لا يعلل الإرهابَ فقط بالطبيعة الذاتية الجوهرانية للإسلام ونصوصه، وإنما بمدى العنف العسكري الذي ما فتئ الغرب يمارسه على البلدان والشعوب العربية الإسلامية، منذ العهد الاستعماري إلى يوم الناس هذا، وهو بذلك يخرج الأعمال الإرهابية في صورة ردود فعلٍ يقوم بها "مضطهدون" يقاومون الهيمنة الغربية وسياسة "الكيل بمكيالين"، ويرمي بجزءٍ من المسؤولية على عاتق السياسات الغربية (الأمريكية والأوروبية) المتعنتة، بل إنه يشدد - بحقٍّ وبداهة - أنَّ قبائل أفغانسان، وعشائر العراق وفقراء مالي وأطفالهم لم يفعلوا شيئا للفرنسيين القابعين أمام أجهزة حواسيبهم وتلفزاتهم.
د- أقلية فاعلة وأغلبية صامتة: يلاحظ الكاتب وجود نمطين متقابلين من كيفيات الحضور الإسلامي، ضمن الجمهورية الفرنسية: فمن جهة أولى ثمةَ أقلية فاعلةٌ تتسم بالعنف وتشغل المشهد الإعلامي برمته، بما ترتكبه من أعمالٍ دامية باسم الإسلام، ومن جهةٍ ثانية هناك أغلبية صامتةٌ، تمارس شعائرها وقناعاتها بشكلٍ خفيٍّ، في المجال الخاص، بعيدا عن أنظار الإعلام والساسة. على أنَّ مَن يصنع التاريخَ، ليس هذه الأغلبية الصامتة التي لا تفيد في حسابات الحملات الانتخابية وتصريحات السلطة، بل تلك الأقلية الصغيرة التي تقيم الدنيا ولا تقعدها بمجرّد اقترافها ما لا يَفهمه الآخر. وعليها تنصبُّ الآلة الإعلاميَّة فتضخم أخطاءها، وتركِّز عليها، مُغذيَةً خطاب الخوف من الإسلام والكراهية للمسلمين، في حين لا يحظى المنتمون إلى الأغلبية الصامتة بأية تغطية إعلاميَّة، لأنها خَطرة، وقادرة على كسر هذه الصورة النمطية التي تجهد بعض اللوبيات على تمريرها والإبقاء عليها.
وهكذا يتضح أنَّ هذه الأفكار التي شيدها الفيلسوف الفرنسي لا تخرج، في مُجملها، عن التصور السلبي الذي ساد عن الإسلام منذ القرون الوسطى[7]، تصورٍ تَحكمه المركزية الأوروبية وعقدة تَفوُّقها على سائر الأنظمة القيمية، ويغذيها الجهل التام بتراث هذا الدين وحضارته[8]. ولكنَّه، مع ذلك، تصور يقوم على مفهوم الحرية المطلقة التي يعبر صاحبها عن أفكاره دون قيدٍ أو شرط، من حيث إنه "مفكر حرٌّ" يستلهم عصر الأنوار، ويمارس حقه الكاملَ في النقد، نقد أيٍّ موضوعٍ إذ لا قداسة تمنع النقد، والاستكشاف دون أدنى تحديد مسبقٍ، من شأنه، - في رأيه - أن يقيدَ العقل ويكبله، بل إنَّ الكاتب ينادي بتسليط النهج الإلحادي على مادة الإسلام حتى يكون النقد في كامل انطلاقه وحريته. فما هي ثغرات هذا التصور وما هي مُسَلَّماته؟
إنَّ القراءة المتأنية لفصول هذا الكتاب تظهر لنا العديد من الهِنات المعرفية التي شابت بناءه، وسنسعى إلى إيجازها في النقاط التالية:
أ- فمن جهة أولى، يتسم الكتاب بانتقائية كبيرة في ذكر مجموعة من الآيات المتصلة بالفترة المَدَنيَّة (622-623) التي تتطرق إلى الغَزوات وصفًا، ولكنه يوردها، مُحرِّفًا لطبيعتها الخطابية، كما لو كانت حثًّا على التقتيل، بعد أن يفصلها عن سياقاتها النصية والتاريخية، وعن الفهم الأنثروبولوجي للبنية القبلية التي كانت تحكم إنتاج المعنى آنذاك[9]. أضف إلى ذلك التشويهَ المقصود للترجمة، والتحريف المتكرر لمعاني الآيات والأحاديث، وقد حصلت هذه التشويهات في العديد منها، نذكر بعضها للأمانة العلمية، لأنه استشهد بها أكثر من مرة، وبَنَى عليها العديد من خلاصاته:
- الآية السابعة من سورة "الأنفال" وقد وردَ فيها: "وَيَقطعَ دابرَ الكافرين"، فترجمها: "اقضوا عليهم عن آخرهم"، بأسلوب الأمْر مُوجَّهًا إلى المؤمنين، في حين أنَّ الفعل يتصل بالله في قالب وعيد أخرويٍّ.
- وكذلك، "وما رَميتَ إذ رَميتَ" (الأنفال: 17) فَحوَّلها: "وما قَتلتَ إذ قتلتَ"، مع أنَّ العبارة صورةٌ ومجاز.
- إقحام فكرة الزيجة الإجبارية في آية "النساء" في حين أنها لا تعدو كونها ذكرًا لِنُصح الأهل لدى اختيار الزوج.
- تشويه الآية النازلة في لوط وقومه من المِثليين القائلة: "أتأتونَ الذُكران من العالمين وتَذرونَ ما خَلقَ لَكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون" (الشعراء: 165 166)، واعتبارها تنديدًا بهم.
- اختلاق مصطلح الذبح في القرآن (بمعنى تقتيل الكفار)، مَعَ أنَّه لم يرد فيه أبدًا بهذا المعنى[10].
وكلُّ ذلك في إهمالٍ تام للتراث التأويلي- التفسيري الذي امتدَّ على قرون، فصار جزءًا من النص القرآني: يوضح إشكالاته، ويبيِّن أسبابَ نزوله، ويظهر علاقاته بعضها ببعض، ويَشرح ما فيه من "تشابهٍ" وغموض، أيْ: ما يعتبره هو تناقضًا، وما هو كذلك. وحتى وإن تباينت مدارس التفسير تباينًا صارخًا، فإنها تظل جزءًا من النص لا يتجزأ، تجبُ العَودة إليه حتى يفهم النصُّ الذي كان ينزل آياتٍ مُنَجَّمة حسب أسبابٍ للنزول ومناسباتٍ تاريخية محددة تقتضيها، فبعضها خاص وبعضها عامٌّ... كما تجدر الإشارة إلى أنَّ الفيلسوف أنفري اعتَمد أكثر ترجمات القرآن رداءة، تاركًا تراجم مشهودًا لها بالدقة مثل ترجمة المستعرب جاك بارك (1996)، وترجمة محمد حَميد الله (1989)، واقتصر على مواطن الإشكال والالتباس فيها، حيث تثير بعض اختيارات المترجمين جدلاً واختلافًا.
كما أنه اقتَصَرَ على بعض السير النبوية أو دواوين الحديث، دون أن يَذكر أصحابَها، واستدلَّ بأمشاجٍ من التواريخ العامة التي لم يتجشم عناء توثيق كتَّابها. وهذا ما يؤكد غيابًا تامًا للصرامة العلمية، ولأدنى قواعدها، الأمر الذي يَجعل حديثه مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي الذي طالما انتقده، يغيب فيه العقل النقدي والروح العلمية اللذيْن طالما نادى إلى التحلي بهما.
ب- وأما سائر إحالاته على معلومات ثقافية مثل الخلاف الذي احتدم بين المعتزلة والأشاعرة، في القرن العاشر للميلاد، حول قضية خلق القرآن، (نفس المرجع، ص. 112) ومثل نظرية ابن رشد حول وجوه الحقيقة وطرائق إدراكها بحسب مناهج المعرفة الثلاثة: الخطابة والبرهان والجدل[11]، (نفس المصدر، ص. 117-119)، ومثل مسألة جمع القرآن بقسميْه المدني والمكي، وبعض أحداث السيرة النبوية...، فهو كلامٌ خاطئ تمامًا، ولا صلةَ له بالمشهور من المعارف. وكان الأحرى به أن يطالعَ، على الأقل، "موسوعة الإسلام"، وهي متاحةٌ للباحثين، للتأكد من فحوى تلك المعلومات وتوثيقها. ولكنه اكتفى بعرضه المتَسَرّع لها، وهو ما يشي بازدراءٍ للقارئ. ولا بد من الإشارة إلى سطحية معارفه عن الحضارة الإسلامية، وهو يقولها دون مواربة: (ص. 52)، حين يعترف أنَّ اطلاعه اقتصر على بِضعة ترجمات القرآن للفرنسية، مشهورة بأخطائها، وكتبٍ عن الحديث والسيرة وبعض التواريخ الفضفاضة. والكلُّ يعلم أن الفكر الإسلامي لا يمكن فهمه من خلال النصَّيْن التأسيسيين وقراءتهما بمعزل عن الإطار المعرفي الهائل المحيط بهما، مثل علوم الشريعة والبلاغة والتفسير وأسباب النزول ومذاهب الفقه وأصوله... والتي ولئن كانت علومًا بشرية، نشأت وتطورت عبر التاريخ، فَإنَّها جزء لا يتجزأ من تراث tradition الإسلام، وعلى ضوئه يدرك تعقد هذا التراث وتعدد مستوياته وتياراته، كما أنه اعتمد على زيارات شخصية خاطفة لبعض البلدان الإسلامية، تمكن من خلالها من لَمس "تعددية الإسلام في حَركته التاريخية" (نفس المرجع، ص. 22)، ونعلم أنَّ فهم سوسيولوجيا هذه البلدان ومدى تأثرها بالظاهرة الدينية يحتاج إلى دراسات معمقة، وليس مجرد "لمسٍ". علاوةً على أنَّ تطبيق مقولات الفلسفة الفوضوية والنيتشوية على ثقافات الإسلام، في تعدديتها وتعقدها، لمما يزيد مقاربته سطحية، لأنها تتحول إلى مجرد مغالطات تاريخية ومعرفية، إذ لا ننسى أنَّ النيتشوية مثلاً نشأت لنقد شطط الممارسات الكَنَسيَّة في العصر الوسيط، ولا صلة لذلك بواقع الإسلام اليوم في فرنسا.
ت- وأما فيما يتعلق بنقده السياسي لتوجهات اليسار الفرنسي، فأحاديثه عامة عمومية، ضمَّنها نقدًا أخلاقويا لهيمنة الثقافة الاستهلاكية وغياب الروح النقدية، وتكاد دعواته تستوحي فوضوية برودون السطحية[12]، فتنفيَ دورَ الدولة، وتكيل الشتائم للمعارضين. فَابتَعَدَ كلامه عن الرصانة العلمية وأغرق في الذاتية والتعميم، ومن ذلك حملاته الدوغمائية على كل وسائل الإعلام وكلِّ الشركات الرأسمالية والمجتمع، دون أدنى تخصيص أو نسبية، (ص. 92-93). وشتَّانَ بين الإسفاف والتفكير الفلسفي.
والخلاصة أنَّ كتاب "التفكير في الإسلام" من نماذج الرؤى السطحية في المشهد الثقافي الفرنسي الذي تسيطر فيه المقاربات المتهورة، وتغيب عنها صرامة المؤرخين، كما أنه من قبيل الخطابات الاستهلاكية، التي تُنتَجُ قيدَ اللحظة، وتُوَجَّه إلى جمهور المناسبة، فتصير من أكبر العوائق المانعة من التفكير والنقد، ولاسيما في ظواهر التاريخ المعقدة، مثل تعقد الظاهرة الإسلامية، هذا فضلا عن كون الكتاب "تفكيرًا"، مورس ضمن "مقابلة صحفية"، بما في آلياتها من التسرع والارتجال والتكرار. ويظل هذا التفكير، في خطوطه العريضة، محكومًا بالمسلمات الثقافية التي طالما هيمنت على العلاقة بين الغرب والإسلام منذ قرون، يؤسسها التفوق الأوروبي على ثقافات العالم، دون أن يلحظ تغيرات التاريخ وتحولاته العميقة، فيفقد بذلك كلَّ مقومات التفكير.
وكحصيلة ختامية، نقترح تعميق التفكير في الإسلام من خلال المناحي التالية:
أ- التركيز على تطعيم المرجعيات الدينية الكلاسيكية من خلال العلوم الإنسانية التي تصبح رافدًا لها، ومن ذلك إغناء علوم التفسير وأصول الفقه بما وصلت إليه فلسفة اللغة والقانون والسوسيولوجيا واللسانيات ....اليوم في تصور حداثي- إنسانيٍّ، ومن جهةٍ ثانية للمساهمة في كشف مواطن التضخيم والأسطرة والتلاعب، ولكن دون القطع الجارف مع تلك المرجعيات.
ب- التركيز على حوار الأديان من أجل تطوير المفاهيم المشتركة دون شنّ حرب عليها بسبب ما اقترفه البعض ويقترفونه من أعمال عنفٍ.
ت- دعم تدريس الإسلام والإسلاميات التطبيقية في المدارس والمعاهد الفرنسية (والغربية عموما) حتى تترسخ معرفة الفرنسيين بالدين الثاني، من حَيث عدد معتنقيه والأول من حيث الممارسة، في بلدهم.
[1] مجلة ذوات العدد 37
[2] أستاذ وباحث تونسي، جامعة لوران فرنسا
[3] Voltaire, « Remarque pour servir de supplément à l'Essais sur les Mœurs » (1763), dans Oeuvres complètes de Voltaire, éd. Moland, 1875, t. 24, chap. IX-De Mahomet, p. 588
[4] Montesquieu, De l'esprit des lois (1748), , éd. Firmin Didot, 1864, p. 372
[5] Victor Hugo, « L’An neuf de l’Hégire », in Victor Hugo, Légende des siècles, t. I, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, p. 207
[6] تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الفكرة عبَّر عنها بالضبط، المفكر اللبناني، شبلي شميل في كتابه "فلسفة النشوء والارتقاء"، دار مار عبود للنشر، 1884، (المقدمة).
[7] Hichem Djaït, L'Europe et l'Islam, Paris, Le Seuil, coll. « Esprit », 1978
[8] Youssef Seddik, Nous n’avons jamais lu le Coran, 2006
[9] انظر تحليلات:
- مكسيم رودنسون، سيرة محمد، 1964
- وجاكلين الشابي، أركان الإسلام الثلاثة، 2016
وإن كنا لا نشاركهما العديد من أطروحاتهما.
[10] انظر: عبد الباقي، المُعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، طبعة دار صادر – بيروت. ص. 331،
[11] أبو الوليد محمد بن رشد: "فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال"، تحقيق محمد عبد الواحد العسيري، تقديم محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 3، 2002
[12] F. Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ? Ou Recherche sur le principe du droit et du Gouvernement, Paris, 1840






