قراءة في كتاب : "الأشعري والأشاعرة في التاريخ الديني الإسلامي" لجورج مقدسي
فئة : قراءات في كتب
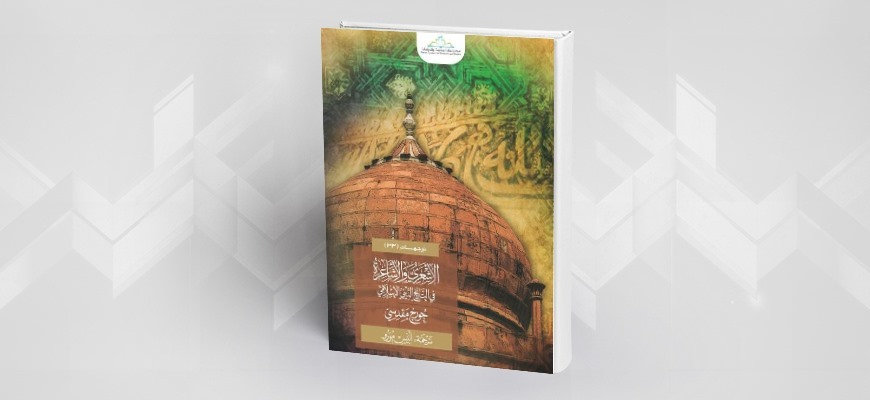
صدر سنة 2018، عن مركز نماء للبحوث والدراسات في بيروت، ترجمة لكتاب "الأشعري والأشاعرة في التاريخ الديني الإسلامي" للمستشرق الأمريكي جورج مقدسي.
مؤلف الكتاب نال درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1964م، وعمل في حقل الدراسات الإسلامية، وكان تخصصه الدقيق متمثلاً في حقل دراسة المذاهب الإسلامية والتأريخ لها، ولا سيما المذهب الحنبلي، وقد اشتغل بالتدريس بصفته أستاذاً للغة العربية والدراسات الإسلامية في مجموعة من أهم الجامعات الأمريكية، ومنها هارفارد وبنسلفانيا. من أهم أعماله البحثية، عدّة كتب حققها للفقيه الحنبلي ابن عقيل (ت513هـ)، فضلاً عن بعض الكتب المتميزة، مثل "نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب"، "الإسلام الحنبلي"، وقد توفي مقدسي في عام 2002م.
فيما يخص ترجمة هذا الكتاب، فقد اضطلع أنيس مورو بمهمة نقله إلى اللغة العربية، ومورو هو باحث ومترجم تونسي، متخصص في ترجمة الأبحاث الخاصة بعلم العقائد والمذاهب الإسلامية، ويعّد كتاب المستشرق المجري إجناس جولدتسيهر "الظاهرية"، من أهم الكتب التي حمل مورو عبء نقلها إلى اللغة العربية.
يناقش مقدسي في الكتاب مسألتين متعلقتين بالمذهب الأشعري؛ المسألة الأولى، هي المكانة العظيمة التي تبوأها هذا المذهب في ديار الإسلام في العصور الوسطى. أما المسألة الثانية، فهي طرح السؤال حول حقيقة المذهب العقائدي للإمام أبي الحسن الأشعري (ت324هـ)، وإذا كانت العقيدة الأشعرية تتفق فعلاً مع مذهبه، أم إنها تختلف كليةً عن أفكار الأشعري واعتقاداته.
هيمنة المذهب الأشعري
في الجزء الأول من الكتاب، يناقش جورج مقدسي تلك المسلّمة الشائعة في الأوساط البحثية الإسلامية، والتي يذهب أصحابها للقول إن العقيدة الأشعرية كانت هي العقيدة الممثلة لمذهب أهل السنة والجماعة، بدءاً من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي.
تعتمد تلك المسلمة بالأساس على المعلومات التاريخية التي تؤكد أن الأشاعرة قد لاقوا التأييد والنصرة من جانب السلطة السلجوقية، ولا سيما من الوزير الشهير نظام الملك الطوسي (ت485هـ)، والذي قدم كل المساعدات المادية والمعنوية للأشاعرة، فقدمهم، وعينهم في المدارس النظامية التي أسسها في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري في كل من بغداد ونيسابور والموصل وأصفهان وبلخ، وفي معيته ظهر أهم متكلمي القرن الخامس من الأشاعرة، ونقصد بهم إمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت478هـ)، وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت505هـ).
بحسب ما يذكر مقدسي، فإن تلك المسلمة لا يمكن الموافقة عليها، ويستند في ذلك إلى المعلومات التاريخية التي تؤكد أن التيار الأشعري قد انحسر في بغداد وترك مكانه للحنابلة، وانتقل مركز ثقله الرئيس إلى الشام، والتي عانى فيها الأشاعرة الأمرين في سبيل نشر مذهبهم، وإثبات تفوقه على بقية المذاهب العقائدية. ومن هنا، فإن المستشرق الأمريكي ذهب إلى أن كل ما قيل عن المنزلة الكبرى للعقيدة الأشعرية "ما هو إلا محض مبالغة"([1])، فالأشعرية -بحسب مقدسي- لم تكن هي التيار الرئيس في الفكر العقدي الإسلامي كما حاول أتباعها تصويرها، بل كانت "منهج من جملة المناهج السائدة. فأما من رام التقصي في شأن أهم تيار عقدي، فينبغي أن يولي وجهه شطر مذهب أهل الحديث"([2]).
أطوار التنافس بين التيار العقلي والتيار النقلي
في سياق سعيه لإثبات وجهة نظره، يعود مقدسي إلى مراجعة الأدبيات السائدة حول مراحل الصراع والتنافس بين المذاهب السنية العقائدية، فيذكر أن الرأي الشائع في الأوساط البحثية، يذهب إلى أن الصراع قد دبّ بين أهل الحديث من الحنابلة من جهة، وأهل العقل من المعتزلة من جهة أخرى، وأن التيار الأشعري قد ظهر في سياق هذا التنافس، وتمكن من أن يتخذ لنفسه طريقاً وسطاً بين الطريقين.
ذلك التنافس قد مر بثلاثة أطوار متمايزة؛ الطور الأول، وقد "شهد خلافاً متواصلاً بين أهل الحديث وأهل العقل"([3])، وتمتع فيه التيار العقلي ممثلاً في المعتزلة بتأييد السلطة السياسية العباسية، وذلك في عهود ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية، وهم المأمون والمعتصم والواثق بالله، واشتهر في تلك الفترة الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ)، بوصفه الفقيه الذي صمد في زمن محنة خلق القرآن، وتمكن من الثبات على موقفه، رغم كل المتاعب التي تعرض لها.
الطور الثاني من التنافس، شهد انقلاباً في الأوضاع بعدما غير الخليفة المتوكل على الله من سياسة الدولة، ومال إلى أهل الحديث، فأنهى المحنة ونصر السنة، وفي هذا السياق ظهرت شخصية أبي الحسن الأشعري، والذي بدأ حياته العلمية على المذهب المعتزلي، ولكنه "انقلب على المعتزلة، وصار من أهل الحديث، واستخدم المناهج العقلية التي تتلمذ فيها على المعتزلة خدمة لأهل الحديث، لتنشأ بذلك وضعية مثالية قوت فيها شوكة العقيدة السنية"([4]).
أما الطور الثالث من التنافس، فقد شهد ازدهار المذهب الأشعري؛ وذلك بعد دخول السلاجقة لبغداد واستيلائهم على مقاليد السلطة بها، إذ تمكن الوزير السلجوقي نظام الملك من تقديم يد المساعدة للأشاعرة، ومنح مكانة كبيرة لأبي حامد الغزالي، مما أتاح الفرصة لانتشار المذهب الأشعري، بينما تم الإجهاز على المعتزلة، في حين بقي الحنابلة وأهل الحديث على "مواقفهم المستميتة في الدفاع عن منهج السلف"([5]).
لماذا نسب الأشاعرة أنفسهم لأبي الحسن الأشعري؟
في محاولته لتفكيك تلك الصورة الذهنية النمطية الشائعة، يطرح مقدسي سؤاله الأول، وهو الذي يسأل فيه عن السبب الذي حدا بالأشاعرة إلى نسبة مذهبهم لأبي الحسن الأشعري.
يرى مقدسي أنه على الرغم من أن الإجابة المباشرة عن هذا السؤال، تتمثل في القول بأن الأشاعرة قد تسموا بهذا الاسم؛ "لأنهم يتبنون آراء الأشعري ومواقفه المطابقة لعقيدتهم"([6])، فإن المستشرق الأمريكي يقدم طرحاً مختلفاً بقوله إن "الصورة المنقولة عنه -أي أبي الحسن الأشعري- غير مطابقة للصورة التي يرسمها هو عن نفسه"([7]).
يوضح مقدسي تلك النقطة، فيقول إن الأشعري في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة"، يبدو أثرياً خالصاً، وتابعاً مخلصاً لأحمد بن حنبل، فهو يظهر وكأنه مجرد عالم من علماء أهل الحديث الذين يتبعون المنهج النقلي، ولا ينتهجون النهج الكلامي، وقد تأكدت تلك الصورة في الجزء الأول من كتاب الأشعري الأشهر المعروف باسم "مقالات الإسلاميين".
يستشهد مقدسي هنا بواحد من كبار المستشرقين المتخصصين في مجال العقائد الإسلامية، وهو المستشرق المجري إجناس جولدتسيهر -وهو من أوائل المستشرقين الذين درسوا أعمال ومؤلفات أبي الحسن الأشعري- الذي كان "أول من أعرب عن دهشته من مضمون الرسالة التي حملها كتاب الإبانة وأثرها، واستخلص من الكتاب، أن الأشعري كان أثرياً حنبلياً صرفاً... وخلص في النهاية إلى حقيقة صادمة على ما يبدو: وهي أن الأشعري لا علاقة له بالعقيدة الأشعرية".([8])
بعد ذلك، وضح مقدسي آراء مجموعة من الباحثين الغربيين الذين تصدوا لدراسة هذا الأمر، وتوصل في النهاية إلى أن "المفهوم النهائي للأشعرية لم يكن صنيعة الأشعري، بل جهد اشترك الأشاعرة في صياغته على مر القرون"([9])، وأن الأشاعرة لم يميلوا للانتساب إلى الأشعري، إلا لمجموعة من الأسباب، ومن أهمها انتزاع الإقرار بشرعية مقولاتهم، والقبول بهم في الوسط السني، هذا فضلاً عن الانتساب إلى المذهب الشافعي.
ما العلاقة بين عقيدة أهل السنة والمذاهب الفقهية السنية؟
إذا كان مقدسي قد قرر أن أحد أهم الأسباب التي دعت الأشاعرة إلى الانتساب لأبي الحسن الأشعري، يتمثل بالمقام الأول في محاولة الانتساب إلى المذهب الفقهي الشافعي، فإن تلك المسألة تحديداً تحتاج إلى تفصيل وتوضيح.
يذكر مقدسي أن التمذهب بأحد المذاهب الفقهية السنية كان أفضل طريقة يفصل بها بين من ينتسب إلى العقيدة السنية من جهة، ومن ينتسب إلى غيرها من العقائد من جهة أخرى، بما يعني أن الانتساب لمذهب فقهي سنّي كان بمثابة جواز مرور إلى الدائرة السنية العقائدية.
ويرى المؤلف أن الازدهار العظيم الذي لحق بالمؤسسة التعليمية في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، كان بالأساس منصبّاً ومتركزاً على المذاهب الفقهية، لا المذاهب العقائدية كما هو شائع "إذ تبوأ الفقيه المكانة العليا، وحظي بالتقدير الأكبر وخُصصت له كراسي التدريس دون غيره، وأما علماء الكلام، فلم ينالوا هذه الحظوة، ولم تُخصص لهم كراسي التدريس".([10])
ومن هنا، كان من اللازم على كل منظومة فكرية/ كلامية تبحث عن البقاء والانتشار، أن تنضم لأحد المذاهب الفقهية السائدة، خصوصاً وأن المذاهب الفقهية قد تمتعت بوجود مدارس وقفية تابعة لها، وهو الأمر الذي لم يتحقق للمذاهب العقائدية.
للأسباب السابقة، فإننا نجد أن المذاهب العقائدية السنية الثلاثة؛ أهل الحديث والمعتزلة والأشاعرة، قد عملوا على التدثر بالعباءة الفقهية، ولذلك ارتبط أهل الحديث بالمذاهب الفقهية الأربعة، وإن كان تمركزهم الرئيس داخل الدائرة الحنبلية. أما المعتزلة، فقد سعوا إلى الاندساس في المذهب الحنفي، أما الأشاعرة، فقد دخلوا المذهب الشافعي، بعد أن فشلت محاولتهم للتدثر بالعباءة الحنفية عقب وقوع النزاع فيما بينهم وبين المعتزلة، وهو النزاع الذي تفجر في عام 445هـ/ 1053م، حينما لُعن الأشعري على المنابر بأمر من السلطان السلجوقي طغرلبك، بناء على نصيحة وزيره المعتزلي الحنفي عميد الملك الكندري (ت456هـ).
التبيين والطبقات: أهم مصادر تاريخ الأشاعرة
بعد أن عرض مقدسي لوجهة نظره في وجود اختلاف واضح وعميق بين منهج ومعتقد الإمام أبي الحسن الأشعري من جهة، ومعتقدات الأشاعرة الذين انتسبوا إليه من جهة أخرى، فإنه -أي مقدسي- يعمل على محاولة العثور على شواهد وتأكيدات لوجهة نظره من خلال دراسة بعض المصادر المهمة التي تطرقت لتاريخ الأشاعرة، وأهمها كتاب "التبيين" لابن عساكر (ت571هـ)، وكتاب "الطبقات" لتاج الدين السبكي (ت771هـ).
فيما يخص كتاب التبيين، وهو الاسم المختصر للعنوان الأصلي للكتاب "تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري"؛ فقد خُصص القسم الأول منه كاملاً لترجمة أبي الحسن الأشعري وتبيان مناقبه وأفكاره ومعتقداته. أما القسم الثاني من الكتاب، فقد خُصص لإعطاء شذرات تعريفية عن بعض أعلام الأشعرية، وعددهم واحد وعشرون، بحسب تاريخ ظهورهم بدايةً من زمن أبي الحسن الأشعري وحتى زمن المؤلف في القرن السادس الهجري، في حين خصص ابن عساكر الجزء الثالث من كتابه لمناقشة الأدلة المثبتة لجواز الاشتغال بعلم الكلام وللرد على خصوم الأشعرية من أهل الحديث.
بحسب ما يذكر جورج مقدسي، فإن تخصيص ابن عساكر قسماً مطوّلاً من كتابه عن جواز الاشتغال بالكلام "كان غايته أن يبين للأثريين ممن يشتركون معه في المذهب الشافعي، سبب اعتناقه للمذهب الأشعري...إذ عمد ابن عساكر إلى إعادة النظر في أقوال السلف وتأويلها تأويلات مختلفة على نحو يبرئ السلف من معاداة علم الكلام... وصرف معظم جهده إلى إعادة تأويل أقوال الشافعي"([11]).
أما فيما يخص طبقات تاج الدين السبكي، فقد قسمها صاحبها إلى ثلاث نسخ متفاوتة في الطول، وهي الطبقات الكبرى، والوسطى، والصغرى، وتبنى فيها السبكي كافة الآراء التي وردت في كتاب التبيين لابن عساكر.
يرى مقدسي أن تاج الدين السبكي كان أفضل دعاة الأشعرية المشهورين بعد زمن ابن عساكر، بل إننا لو قارنا بين الرجلين -ابن عساكر والسبكي- لألفينا السبكي أكثر براعة "فإذا كان ابن عساكر محدثاً شافعي المذهب... فإن السبكي، فعلاوة على كونه محدثاً فذاً ذا مكانة بين المحدثين، فقد كان فقهياً أريباً ذا مكانة بين الفقهاء... وبينما توجه ابن عساكر في تبيينه إلى علماء الحديث في المذهب الشافعي أساساً، توجه السبكي في طبقاته إلى علماء الفقه والحديث كليهما"([12]).
من أهم الجوانب التي تميز فيها كتاب طبقات السبكي، أنه قد حمل كنزاً من الوثائق التاريخية والأدبية المهمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالفقه والحديث، من هنا فإن كتابه لم يكن مجرد مصنف من مصنفات علم الكلام التي يستعصي فهمها عن الكثير من الفقهاء والمحدثين، بل على العكس من ذلك، جاء كتابه بالأساس للتأريخ للمذهب الشافعي وطبقات فقهائه، وتم استثمار ذلك المحتوى بشكل مستتر في تقرير المذهب الأشعري والتأكيد على تفوقه على جميع المذاهب العقائدية السنية.
ويؤكد المستشرق الأمريكي على الطريقة المميزة التي استخدمها السبكي في كتابه للإعلاء من المذهب الأشعري، إذ لجأ الأخير للعديد من السبل المتنوعة في سبيل تحقيق هدفه؛ وذلك بحسب ما تقتضي الحاجة، ففي حالة أن لزم التطرق لوقائع أو أحداث تاريخية تسيء إلى الأشعرية، فإن تاج الدين السبكي يقوم بتقديم تلك الوقائع بصورة مغلوطة أو محرفة عن صورتها الأصلية، وأما إذا كانت تلك الوقائع مشهورة، ولا يمكن كتمانها، فإن السبكي كان يقوم بتمرير وإيرادها في كتابه دون أن يقوم بالتعليق عليها أو مناقشتها.
بالنسبة إلى الحنابلة الذين تعرض لهم السبكي في مؤلفه، فقد رماهم بكل نقيصة، ولم يتورع عن توجيه الشتائم لهم، وكذلك فعل مع خصومه من الشافعيين الرافضين للمنهج الأشعري، إذ اتهمهم السبكي بأنهم من المتعاطفين مع الحنابلة، وكانت غايته من ذلك "عزل من كان ذا سطوة من أهل الحديث، وإقامة حاجز نفسي بين هؤلاء وبين الشافعية، ممن وقفوا على الحياد أو كان رجوعهم عن موقفهم وارداً"([13]).
ويلخص مقدسي تجليات الدعاية الأشعرية في كتاب طبقات السبكي، إلى ثلاثة أوجه؛ الأول، الدفاع عن الاشتغال بعلم الكلام، والدفاع عن الأشعرية، باعتبارها منهج أهل السنة والجماعة الحقيقي، دوناً عن غيرها من المذاهب والعقائد المطروحة على الساحة، والثاني، فيتمثل في السعي الحثيث نحو استمالة الشافعية لاعتناق المذهب الأشعري، أو -على الأقل- الوقوف على الحياد وعدم مهاجمته، أما الوجه الثالث، فيتمثل في التهجم المستمر على خصوم المذهب الأشعري على اختلاف مذاهبهم الفقهية، ولا سيما الفقهاء الحنابلة مثل أحمد بن تيمية (ت728هـ)، وشمس الدين الذهبي (ت748هـ).
كيف أثبت السبكي جواز الاشتغال بعلم الكلام؟
لما كانت مسألة جواز الاشتغال بعلم الكلام هي إحدى النقاط المهمة، التي لطالما وقفت كمانع أمام تقبل جماهير أهل السنة للمنهج الأشعري، فإن تاج الدين السبكي قد حرص في طبقاته على التأكيد على مشروعية الاشتغال بعلم الكلام بشتى السبل المتاحة.
السبكي الذي لم ينكر المقولات السلفية التي تقدح في علم الكلام وتطعن في مشروعيته، لجأ إلى الاستعانة ببعض المقولات المعارضة، والتي يُفهم منها جواز الاشتغال بهذا العلم، وفي سياق آخر، عمل على تأويل بعض المقولات الرافضة لعلم الكلام، ومن هنا لم يجد غضاضة في الاعتراف والتسليم بخطورة الجدل الكلامي "لكنه سرعان ما يتدارك أمره ويشدد على الحاجة الماسة إلى علم الكلام على الرغم من جسامة الاشتغال به"([14])، ولذلك فقد خصص شرطين للخوض في علم الكلام، أولهما هو الأهلية، وثانيهما هو الضرورة.
في سياق متصل، وسع تاج الدين السبكي من دائرة الأشعرية، لتشمل العديد من العلماء الأثريين، وليصف بها الكثير من أهل السلف، فصار المتكلم عنده هو "كل من نافح عن عقيدة أهل السنة والجماعة"([15]). أما الأشعري عنده، فقد صار "هو كل من دافع عن الأشعري"([16])، وكانت حجته في ذلك أن الأشعري لم يبتدع منهجاً جديداً، بل إن كل من استخدم المنهج العقلي في إثبات عقائد السلف، فهو أشعري.
من جهة أخرى، حرص السبكي في مؤلفه على استمالة الشافعية نيابةً عن الأشاعرة، فلم يترك فرصة للإشارة إلى علو كعب بعض الشافعية في الفقه والحديث إلا واغتنمها، ولكنه سرعان ما يستدرك ليشير إلى "أن هؤلاء لم يكونوا محدثين وفقهاء فحسب، بل إنهم أيضاً كانوا في عداد المتكلمين"([17]).
في السياق نفسه، فإن السبكي أورد بعض القصص التي تدل على علو قدم علم الكلام عن الفقه، ومن ذلك ما ذكره في ترجمة أبي بكر ابن فورك (ت406هـ) -وهو من أعلام الأشاعرة في القرن الرابع الهجري- أنه استفسر في بداية طلبه للعلم من أحد أساتذته من الفقهاء في أصبهان، عن معنى أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، ولكن الفقيه لم يستطع أن يجيب على هذا السؤال، ومن هنا فإن ابن فورك قد توجه بسؤاله إلى أحد المتكلمين، وحصل منه على إجابة شافية، فقرر حينها أن لابد من معرفة علم الكلام، فاشتغل به.
وقد عمل السبكي على عقد مقاربة بين كل من الشافعي وأبي الحسن الأشعري، فإذا كان الأول قد تخصص في الفقه والحديث، ومع ذلك عمل بعلم الكلام، فإن الثاني قد تخصص في علم الكلام، ومع ذلك فقد اعتنق المذهب الشافعي.
ما أراد السبكي أن يقرره هنا، التأكيد على العلاقة الوطيدة المنعقدة بين المذهب العقائدي الأشعري من جهة، والمذهب الفقهي الشافعي من جهة أخرى، ويرى السبكي تبعاً لذلك "أن بين الشافعية والأشعرية وشائج قربى لم تنفصم عراها منذ البداية، وأن الأشعرية نشأت في كنف المذهب الشافعي، ومنذ ذلك الزمن سارت العقيدة الأشعرية والمذهب الشافعي جنباً إلى جنب، وأصبح لهما مصير مشترك"([18]).
ويوضح مقدسي أن محاولة السبكي الرامية لعقد حالة من الدمج والتماهي بين الأشعرية والمذهب الشافعي، قد تعرضت في مسعاها إلى مجموعة من العقبات الصعبة، وكان أهم تلك العقبات هم أولئك الفقهاء الشافعية الذين رفضوا المنهج الأشعري بمنتهى القوة، ومالوا إلى منهج أهل الحديث، وكان شمس الدين الذهبي (ت748هـ) أهمهم على الإطلاق.
السبكي عمل على الحط من قيمة ومكانة الذهبي من خلال الطعن في شهادته، والنيل منه في أكثر من موضع من مواضع مؤلفه، ولكن رغم ذلك فإن جهود السبكي لم يكتب لها النجاح؛ لأن معظم فقهاء الشافعية وقفوا بجوار الذهبي، وعدلوه، وأبدوا امتعاضهم من خوض السبكي في سيرة الذهبي، خصوصاً وأن الذهبي كان شيخ السبكي، وأنه -أي الذهبي- قد ترجم لتلميذه في معجمه، وهو أمر -أي ترجمة الأستاذ لتلميذه- لم يكن شائعاً في تلك الفترة التاريخية، ونظر له معظم فقهاء الشافعية على كونه دليلاً على عقوق التلميذ لأستاذه من ناحية، وعلو قدر الذهبي من ناحية أخرى.
ومن بين النقاط المهمة التي أشار لها مقدسي فيما يخص منهجية السبكي في طبقاته، أن الأخير قد عمل على الاستناد لبعض المبادئ الفقهية، لتفسيره بعض المسائل العقائدية الإشكالية عند الأشاعرة، ومن ذلك المبدأ الذي قبلت به المذاهب الفقهية عندما أجازت قبول رواية قولين للفقيه الواحد؛ أي أن يُنسب إليه قولان في المسألة الواحدة، وقد استخدم السبكي ذلك المبدأ في مهمتين؛ الأولى، نقض كافة الآراء المروية عن الشافعي في رفض علم الكلام، والثانية، في تبريره ظهور الأشعري بمنهجين عقديين مختلفين.
وفي ختام تناوله لطبقات السبكي، يقرر مقدسي أن لجوء ابن عساكر في القرن السادس الهجري ومن بعده تاج الدين السبكي في القرن الثامن الهجري، إلى الدعاية للمذهب الأشعري "لهو الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن الأشاعرة كانوا يناضلون من أجل نيل الاعتراف بمنهجهم... فقد بذلا قصارى جهدهما من أجل النجاح في إقناع أهل السنة بالجذور السلفية للمنهج الأشعري"([19]).
إشكالية الأشعري: أثري أم متكلم؟
يعود جورج مقدسي في الجزء الثاني من كتابه لمناقشة حقيقة مذهب أبي الحسن الأشعري، وإذا ما كان أثرياً من أهل الحديث أم متكلماً من أهل العقل؟
للإجابة عن هذا السؤال الإشكالي، يشير مقدسي إلى أحد المؤلفات المهمة التي تُنسب للأشعري، وهو المعروف باسم "استحسان الخوض في علم الكلام"، وقد نُشر في حيدر آباد للمرة الأولى في 1323هـ/ 1905م، وهذا المؤلف، رغم صغر حجمه إلا أنه قد تضمن العديد من المعلومات التي تؤكد على عقيدة مؤلفه البعيدة عن اتجاه أهل الحديث.
في البداية، يذكر المستشرق الأمريكي إلى أن هذا المؤلف لم يرد في قائمة جولدتسيهر لمؤلفات الأشعري، والتي وردت في كتابه "العقيدة والشريعة في الإسلام"، ثم يذكر بعد ذلك أن هناك مجموعة من الاعتراضات المنطقية التي تمنع نسبة رسالة الاستحسان إلى الأشعري.
أول تلك الاعتراضات، أن الشخص الذي ألف كتاب "الإبانة عن أصول أهل السنة والجماعة"، لا يمكن أن يكون هو الشخص نفسه الذي ألف كتاب الاستحسان، وذلك لأن الكتابين قد تضمنا وجهات نظر متعارضة في المسائل نفسها.
ثاني الاعتراضات، أن الأشاعرة أنفسهم لم يذكروا شيئاً عن رسالة الاستحسان، فلم يتكلم عنها ابن عساكر في التبيين، ولم يذكرها تاج الدين السبكي في الطبقات، بل إن ابن فورك، والذي عاش في فترة زمنية قريبة من الأشعري، لم يذكر شيئاً عن تلك الرسالة على الإطلاق، ولو كان للأشعري رسالة يستحسن فيها الخوض في علم الكلام، لكان من المؤكد أن يحتج بها الأشاعرة في سياق مجادلتهم المستمرة مع أهل الحديث.
ثالث الاعتراضات التي يبديها المقدسي، أن الأسلوب الذي كُتبت به رسالة الاستحسان، لا يتوافق مع المنحنى التصاعدي للجدل بين الأشاعرة وأهل الحديث. فبحسب ما يلاحظ المستشرق الأمريكي، فإن الأدبيات الأولى التي دونت في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجري، للدفاع عن الخوض في علم الكلام، قد اتسمت بنبرة من الهدوء والمحاولة للتوفيق والوصول لحلول وسيطة، وهو الأمر الذي لا يتوافر في رسالة الاستحسان، إذ تميزت تلك الرسالة بنبرتها العدائية الواضحة، والتي تظهر بأوضح صورها في العنوان نفسه "استحسان الخوض في علم الكلام"، وهو ما يستنتج منه مقدسي، أن الرسالة قد دونت في فترة متأخرة، وبعيدة كل البعد عن زمن أبي الحسن الأشعري.
أما الاعتراض الرابع، فهو يتعلق بسند الكتاب، إذ يؤكد المستشرق الأمريكي على وجود انقطاع في سند الكتاب، ولكنه يعود ليقلل من أهمية هذا الاعتراض تحديداً؛ لأن "السقط في سلسلة الرواة ربما كان عائداً إلى تقصير بعض نساخ الكتاب"([20]).
التساؤلات التي طرحها مقدسي بخصوص رسالة الاستحسان، يعود ويكررها للمرة الثانية، ولكن في سياق الحديث عن كتاب آخر مشهور لأبي الحسن الأشعري، وهو كتاب "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين".
يرى مقدسي أن هناك اختلافاً واضحاً وظاهراً بين جزئي هذا الكتاب، ففي حين يأتي الجزء الأول منه متسقاً مع أفكار ومبادئ أهل الحديث، فإن الجزء الثاني من الكتاب يتماشى مع الأفكار الشائعة في الاتجاه الأشعري، إذ ورد فيه الحديث عن مجموعة من المسائل الفلسفية التي لا يمكن أن يخوض فيها من كان مقرراً لمذهب السلف، ومن تلك المسائل الكلام في الحركة والحدوث والذرة... إلخ.
أحد الأدلة التي يسوقها مقدسي للتأكيد على أن الجزء الثاني من كتاب مقالات الإسلاميين، ليس من تأليف أبي الحسن الأشعري، أنه قد عثر على إحدى النسخ المخطوطة لكتاب المقالات، وهي المخطوطة رقم 145 الموجودة بحيدر آباد، وقد كُتب على صفحة غلافها الجزء الأول من "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وآخر هذا الجزء هو آخر الكتاب، ويعقب مقدسي "استناداً إلى هذا التعليق، يمكننا أن نستنتج أن كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين مشتمل على الجزء الأول فحسب، وأما الجزء الثاني، فيظل البت في أمره مُعضلاً"([21]).
ويختتم مقدسي حديثه عن كتابي الاستحسان ومقالات الإسلاميين، بفقرة فضفاضة واسعة الدلالة نوعاً ما، إذ يقول: "وعلى الرغم من افتقارنا إلى حجج دامغة تنفي نسبة جزأي المقالات إلى الأشعري، فإننا لا ننكر فرضية أن يكون الأشعري قد ألفهما على فترات متباعدة من حياته بوصفهما كتابين مستقلين".([22])
ويعود جورج مقدسي في نهاية كتابه إلى توسيع نطاق الإشكال، إذ يقول إن الإشكالية المرتبطة بتحديد عقيدة أبي الحسن الأشعري، يمكن أن نجدها أيضاً وقد ارتبطت بمجموعة من أعلام المنهج الأشعري عبر تاريخه الطويل، ومنهم على سبيل المثال كل من الباقلاني (ت403هـ)، والجويني (ت478هـ)، والغزالي (ت505هـ)، والشهرستاني (ت548هـ)، والرازي (ت606هـ).
يستند مقدسي في طرحه هذا إلى ما نُقل عن هؤلاء الأعلام في كتب التراجم والتاريخ، فبحسب ما ورد في تلك الكتب، فإن جميعهم قد أعلن في نهاية حياته عن رجوعه عن الاشتغال بعلم الكلام، "وبهذا المعنى، يُصور لنا هؤلاء الأشاعرة من خلال الحكايات المروية عنهم سالكين مسلك الأشعري ذاته، فكما الأشعري، انتهج هؤلاء في البداية منهجاً عقلياً، ليرجعوا عنه في نهاية المطاف، ويعتنقوا مذهب أهل الحديث عملاً بوصية السلف"([23]).
ويضرب مقدسي مثالاً على رفض أعلام الأشاعرة للخوض في علم الكلام، بموقف أبي حامد الغزالي من هذا العلم، إذ اشتهر عنه مناصبته علم الكلام العداء، إلى حد تصنيفه لكتاب "إلجام العوام عن علم الكلام"، وهو الكتاب الذي أحجم الأشاعرة عن التعرض له أو مناقشته، لما له من دلالة واضحة على إضعاف المنهج الأشعري، بحسب ما يذكر جورج مقدسي.
تقييم نقدي للكتاب
من المؤكد أن المستشرق الأمريكي جورج مقدسي قد بذل جهداً كبيراً في هذا الكتاب، وأنه قد تمكن من سبر أغوار التطور التاريخي للعقيدة الأشعرية من خلال رحلة سريعة تعرض فيها لعدد من اللحظات المهمة والأكثر تأثيراً في تأسيس وتشكيل ذلك المذهب العقائدي المهم. مع ذلك، تغافل المؤلف عن بعض النقاط المتصلة بموضوع الدراسة في بعض الأحيان، كما أنه لجأ في أحيان أخرى لانتقاء بعض الروايات التاريخية دوناً عن غيرها، لما فيها من تأكيد على فرضياته البحثية المسبقة، ومن بين النقاط التي يجوز لنا فيها نقد أطروحة مقدسي:
1- أنه قد أورد في غير موضع من الكتاب أن التيار الأشعري قد تعرض لانتكاسة كبرى في بغداد، وأن الأشاعرة قد خرجوا من عاصمة الخلافة العباسية منهزمين على يد أهل الحديث. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو ذلك الذي يتساءل عن خصوصية وأفضلية بغداد، إذ إنه لو سلمنا جدلاً بهزيمة الأشاعرة فيها، فإن هذا لا يعني بالضرورة انهزامهم في مختلف البلاد والأقاليم الإسلامية، ونرى أن تركيز المؤلف على بغداد تحديداً قد جاء متسقاً مع فرضياته القائلة إن أهل الحديث -لا الأشاعرة- قد مثلوا التيار العقدي الغالب في الأمة الإسلامية، ومن هنا فقد ركز مقدسي على بغداد بالذات؛ لأنه من المعروف أن أهل الحديث كانوا يشكلون الأغلبية بها.
2- أن المؤلف قد بنى بحثه بعيداً عن سياق الأحداث التاريخية، فعلى سبيل المثال تقف أغلبية المصادر التاريخية لتقدم طرحاً يؤكد أن التيار الأشعري، كان هو التيار العقائدي الأقوى في معظم لحظات المحن والأزمات الفكرية في القرون التي أعقبت وصول الوزير نظام الملك إلى الحكم في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري.
من الشواهد التاريخية التي تؤكد على ذلك، الرعاية التي حظي بها كل من الجويني والغزالي في نهايات القرن الخامس وبدايات القرن السادس الهجريين، والتأييد الذي لاقاه علماء الأشاعرة في الدولتين الأيوبية والمملوكية، فضلاً عن النفوذ الواسع الذي تمتع به العلماء الأشاعرة تحديداً، ونجاحهم في تضييق الخناق على منافسيهم من أهل الحديث (ابن تيمية وابن القيم الجوزية كنموذجين)، هذا بالإضافة إلى انعقاد تحالف متين بين التيار الأشعري والتصوف الطرّقي تحديداً، كل هذا يدفعنا دفعاً إلى القول بأن التيار الأشعري كان هو التيار الأكثر تأثيراً والأوسع نفوذاً في الساحة العقائدية السنية.
3- جانب مقدسي الصواب في محاولته الأخيرة لتهميش التراث الأشعري ككل من خلال التشكيك في مواقف أعلامه الكبار (كالجويني والغزالي والرازي) قُبيل وفاتهم، إذ اكتفى المؤلف بذكر أمر رجوع هؤلاء عن علم الكلام دون تحقيق أو تثبت، ومن المعروف أن أكثر المصادر التي تنسب لهؤلاء الأشاعرة رجوعهم عن الأشعرية، هي بالمقام الأول مصادر لأعداء الأشعرية من أهل الحديث.
ولو افترضنا جدلاً، أن هؤلاء الأشاعرة قد نطقوا في لحظاتهم الأخيرة بما يفيد ندمهم على الخوض في علم الكلام، فهل يصلح الاستدلال بتلك الكلمات على اشتراك هؤلاء في توجه علمي فكري عقائدي متماسك الأركان يصلح كبديل عن التوجه الأشعري؟ أم إنه من الأصح أن ننظر إلى تلك الكلمات في سياقها الموضوعي، على كونها مجرد عبارات تلفظ بها أصحابها وهم على فراش الموت، خوفاً وإشفاقاً مما ينتظرهم من حساب في الدار الآخرة؟
المصادر والمراجع
([1]) جورج مقدسي، الأشعري والأشاعرة في التاريخ الديني الإسلامي، ترجمة: - أنيس مورو، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، 2018م، ص117






