قراءة في كتاب "التداوي بالفلسفة" / سعيد ناشيد
فئة : قراءات في كتب
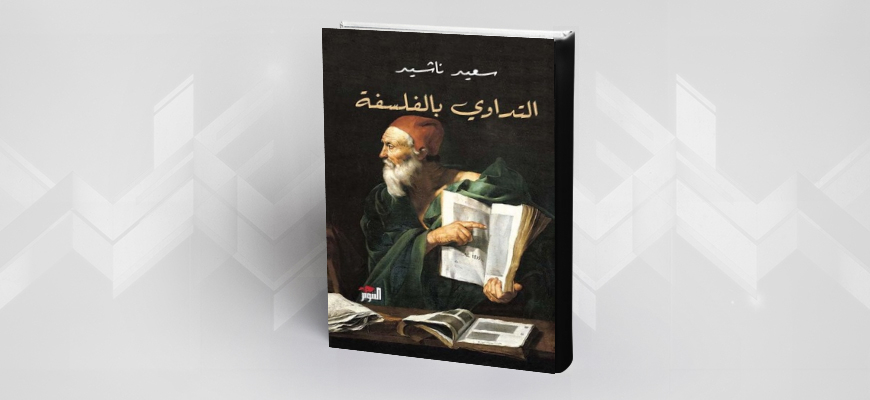
يُطل علينا الكاتب والباحث المغربي سعيد ناشيد، من خلال كتابه الطريف والمعنون بـ"التداوي بالفلسفة"، وهو من منشورات دار التنوير للطباعة والنشر، سنة الطبع 2018، عدد الصفحات: 176، بمواضيع فلسفية، ترجع بنا إلى الغاية الأولى التي ظهرت من أجلها الفلسفة مند سقراط الحكيم بالساحة العمومية، "الأغورا"، كأسلوب وفن للعيش المشترك، وإلى اتخاذ سبل العودة للحياة البسيطة، باستحضار ما قاله فلاسفة فن العيش (أفلاطون، ديوجين، زينون الرواقي، أبيقور، شيشرون، سينيكا الأصغر، بوثيوس، جلال الدين الرومي، مونتين، اسبينوزا، شوبنهاور، نيتشه، آلان، لوك فيري، سبونفيل، ... إلخ)، فما الحياة البسيطة كما تمثّلها هؤلاء؟
تُؤثث صفحات الكتاب عُدة مفاهيمية، بنوع من السلاسة في التحليل وإعطاء الحجة والدليل، في تقبل الفكر الفلسفي كخلاص دنيوي قبل أخروي، وفي تداوي وشفاء لعدد من المشاكل التي تقضُّ مضجع الأعماق البشرية، بعيدا عما يسمى بتمارين "تطوير الذات"، وقريبا من أدوات، التفكُّر والتعقل والتأمل، في عيادة "التداوي بالفلسفة".
وقد جاءت محاور الكتاب على الشكل التالي، بعد التقديم وملحق في الأخير:
- الفلسفة والحضارة.
- الفلسفة كأسلوب للحياة.
- الوظيفة العلاجية للفلسفة.
- لماذا نشعر بالملل؟
- التفكير بالجسد.
- قد لا نحتاج إلى الأمل.
- كيف نتعامل مع المرض؟
- لماذا نفشل في الحب؟!
- الرضا بالقدر كمفهوم فلسفي.
- الفلسفة كخلاص دنيوي.
- الحكيم من يحكم نفسه.
- تمارين في خداع الذات؟
- الشيخوخة كفرصة للحياة.
- الموت والأسلوب.
- الوصايا العشر للفلسفة.
- العلمانية كسوك مدني.
- رهانات الفلسفة.
- ما التفكير؟
- مصائر النوع البشري.
- اليوتوبيات الأخيرة، أو من أجل خلود النوع البشري.
- ملحق، عبارة عن مداخلة في المنتدى الدولي للإصلاحات الدينية، بتونس، في 2017، تحت عنوان: وما الذي تمنحه الفلسفة لإصلاح الخطاب الديني لدى المسلمين؟
في مقدمته للكتاب، يرى سعيد ناشيد أن مهمة الفلسفة، هي أن تمنحنا أسلوبا مُعقلنا في العيش لمواجهة الظروف الصعبة، وهو ما ابتعدت عنه الدراسات الأكاديمية اليوم بطابعها النظري والتقني، لتساهم بذلك في نسيان المفاهيم الأساسية لهذا الفكر الأصيل، من قبيل، "الحكمة"، و"التأمل"، و"التفلسف"؛ الشيء الذي يجعل المتعلم للفلسفة يسقط في وهم امتلاك المعرفة.
ينطلق الباحث، منذ البداية، في التأسيس للفلسفة كضرورة وجودية للحضارة الإنسانية وبنائها. متسائلا، كيف لنا أن نفكر اليوم من دون التفكير الفلسفي؟ وكيف لعلاقتنا أن تكون تجاه عدد من المفاهيم، مثل، الدين، والحلم، والأسطورة، والخيال، والحب، والجمال؟ يقول، إن "تاريخ الفلسفة هو تاريخ المفاهيم الكبرى التي بواسطتها يستطيع عقل الإنسان أن يفكر في العالم والحياة، وفي الحضارة والسياسة، ..." (ص18). إنها سلم الحضارة المعاصرة لمواجهة قيم الانحطاط والهمجية، والقدرة على التعايش في مواجهة العنف. وأنه من جانبنا كمثقفين نحن المنتمين إلى بلدان الجنوب، أن نواكب هذا التحول الفلسفي المعاصر روحياً، بتوظيف التصوف الفلسفي في إحداث نقلة نوعية في خطابنا الديني بموجبه يمكن أن يتغير فهمنا للدين، إلى جهة دعم الأهواء المبهجة وغرائز الارتقاء، "لكي تتحول الأديان من عامل شقاء للإنسان إلى عامل لسعادته" (ص24).
وإذا كانت الفلسفة هي أسلوب الحضارة في التدرج والرقي، فهي كذلك منهج الحياة في مواجهة صعوباتها اليومية المرتبطة بالفشل، والإحباط، والمرض، والموت، وغيرها، فما السبيل إلى تجاوز هاته العثرات؟ يجيب ناشيد، مستلهما تجارب الفلاسفة، والمفاهيم التي تنتجها الفلسفة كأداة لفهم الحياة. والتجربة هنا للفيلسوف إمانويل ليفناس أثناء فترة اعتقاله في المعسكرات النازية، جعلته يُطور مشروعه حول الحياة. والاعتراف البليغ لنيتشه بأن الوقوع في وطأة المرض وقسوته، يجعلنا أكثر إقبالا على خوض الحياة بقوة أكثر منه، ونحن بصحة جيدة. والسبيل إلى هذا هو التفكير؛ لأنه "أداة تحرير الإنسان من الانفعالات السلبية والغرائز البدائية (الغضب، الخوف، الكراهية، الغيرة، الإحباط، إلخ)، والتي هي العامل الأساسي في تعاسته وشقائه" (ص29). والدليل على هذا يضيف، أن أبقور في "رسائله" اعتبر الاستدلال العقلي في حد ذاته لذة وبهجة وسعادة، وأن الحياة الفلسفية، هي الحياة الأكثر سعادة حسب أرسطو، كما جاء في كتابه "علم الأخلاق إلى نيقوماخوس".
لكن، وفي نظر الكاتب، هل بوسع الفلسفة أن تمارس دورها العلاجي في شفائنا من الشقاء الاعتيادي وتحويله إلى سعادة اعتيادية؟ يشير إلى أن المشرق قديما دأبوا على نعت الطبيب بالحكيم، وفي أسطورة الكهف لدى أفلاطون يؤكد أن الشفاء هو الوسيلة التعبيرية لخروج الإنسان من جهله (الكهف في الأسطورة)، وهذا الخروج لا يتأتى إلا بالتحكم والسيطرة على الخوف والجهل لعالمنا الداخلي كما يقول ابكتيتوس، والذي تغلب على سيده أثناء تعذيبه، وهو عبد، حتى كسرت ساقه دون أن يبدي أي تذمر أو أنين، "فهِم ابكتيتوس أن المرء في أسوأ ظروف القهر والاستعباد يظل ممتلكا لمساحة لا يتحكم فيها سواه، اللهم إذا تخلى عنها من تلقاء نفسه" (ص36). الرجوع إلى الذات إذن، هو سرُّ معرفة الشقاء الذي يلاحقنا حتى في الظروف العادية. وبهذا، فإن السعادة لا تتحقق حسب الأشياء التي لا أملكها، والتي لا سلطان لي عليها، بل بما أملكه من أفكار ورغبات وأذواق ومشاعر، بتعديلها وتغيير فهمي لها، هنا تتجلى الوظيفة العلاجية للفلسفة؛ أي "أن نعيش الحياة معناه أن نعيش تأويلنا للحياة" (ص40).
هذه الوظيفة العلاجية للفلسفة، تساعدنا أيضا، على تحمل الملل كمأزق حقيقي للذات، وذلك بالعمل على تحويله إلى قوة إبداعية، وليس بالهروب و"قتل الوقت "وضياعه، والأمثلة كثيرة لدينا من هذا القبيل. نجد عند الرواقيين في هذا السياق قاعدة تقول: "لا تسوء الأشياء ولكن تسوء أفكارنا حول الأشياء"، "هكذا يمكن للشعور بالملل أن يكون دافعاً إلى أن نصنع، وأن نبدع ما لم يبدع، وأن نكتشف ما لم يكتشفه السابقون، ونذهب إلى حيث لم يذهب الآخرون، ونقتحم أقصى مناطق المجهول" (ص45). حسب هذا التعبير، تكون القدرة على مواجهة الملل أمام الكم الهائل للوسائل المتطورة للتقنية اليوم، ووسيلتنا النقدية، للتحرر من قبضة الإعلام الذي يُحكم سيطرته علينا بمسلسلاته التلفزيونية، التي تنشر "ثقافة الكسل والتفاهة"، وتُذهب كل حسّ إبداعي، وتسلبنا أثمن ما لدينا، وهو الوقت.
إن التفكير الفلسفي في الإنسان حسب ناشيد، يفرض علينا البدء بالتفكُّر بالجسد، من السطح بدل العمق، فالعقل والجسد سيّان؛ لأن الجسد بكامله يشارك في عملية التفكير، ولو بنسب متفاوتة. ومن هنا، التأثير الواضح للبطن على الجسد، كما تؤكد ذلك المقولة الطبية بأنه دماغنا الثاني، ولا غرابة في أن نجد تأييدا لها في الحديث النبوي، "البطنة تذهب الفطنة". كل التفاصيل الصغيرة التي تحرك جسدنا، هي، من الأولويات التي يجب أن نعطي لها قيمة في حياتنا اليومية، يقول: "صحيح أن العقل هو أداة التحكم في الانفعالات التي يفرزها الجسد وتعيق الفكر، غير أن العقل بالتعريف هو الجهد الحسّي الذي يبذله الجسد لكي يحمي نفسه من الانفعالات الداخلية السلبية". (ص52)
التفكير بالجسد إذن، وبواسطته، هو فرصة الإنسان للإقبال على الحياة وبكثافة، كما يقول نيتشه، وهنا يرى ناشيد، أن الأمل واحد من أكثر الأهواء البشرية التي تعطل من قدرة الإنسان على الاستمتاع بالحياة؛ لأنه يسقطنا في جحيم الانتظار، الذي عادة ما يرسمه لنا الآخرون، وذلك بالرجوع إلى لحظات الحاضر واليومي المُعاش، بعيدا عن عقد الأمل على غـد لا يقيني، قد يأتي أو قد لا يأتي، يقول: "كثيراً ما تدفعنا الآمال العِظام إلى نسيان الحياة لأجل وعد بالحياة كاذب في كل أحواله، حتى وإن صدق في الأخير" (ص58). يشير هنا، إلى أن الروائي اليوناني الشهير نيكون كازانتزاكيس، كتب على شاهد قبره العبارة التالية: "لا آمل شيئا، لا أخشى شيئا، أنا حرّ"، بهذا المعنى، أليس الأمل خطراً على الحرية؟
بالمقابل، وفي سياق حديثه عن الجسد ودوره في التفكير، يتساءل، كيف يكون تفكيرنا عندما تكون أجسادنا مريضة؟ مؤكداً أن الانشغال بالبحث عن سبب المرض، وعدم تقبله كضرورة طبيعية، هو الخطأ الذي نرتكبه. فما الخطأ في أن يكون الإنسان مريضا، سوى أنه يعمل على تحريك للانفعالات المدمرة (الذنب، التعاسة، الإحباط، الألم، إلخ)، وإقصاء لدور الطبيعة في القيام بعملها، والأكثر من ذلك أنه يبعدنا عن فرصة التعايش مع المرض، فـ "القاعدة الأساسية التي ينبغي تجنبها لدى المريض هي تجنب السخط والتشكي والضغينة؛ لأنها تغذي غرائز الانحطاط" (ص65)
ومما لا ريب فيه، أن الجسد له شعور بالبهجة والسرور، أعلاها حينما يقع في الحب، والسؤال المركزي الذي يوجه الكاتب في هذا المضمار، لماذا نفشل في الحب؟ وما الداعي للحزن حينما نقع في الحب؟ يُجيب، إنه "الخوف من أن نكون إزاء عملية خداع لأنفسنا حتى في حالات الاعتقاد بأننا صادقون. أليس "الحب كذبتنا الصادقة" كما قال محمود درويش؟!" (ص70). هكذا، فإن ما يجعل الحب مدعاة للحزن، هو قابليته للخداع والانخداع كأصل جوهري. لكن، إذا كان الحب كذبتنا الصادقة، فإن الحبّ حسب شوبنهاور، هو كذبة الطبيعة ومكرها؛ لأنها هي من تختار لنا، ولغاية نسل مناسب، ولسنا نحن من نختار. وفي كتابه "عزاءات الفلسفة"، يرى بوثون، أن الشخص المغرم يسعى إلى إلغاء نقط ضعفه وعيوبه، حتى لا تبدو على نسله (أطفاله). والسر هنا، هو ضمان نسل مناسب ولو على حساب الطرف الآخر. في المقابل، فإن الحب في زمن التقدم العلمي ضمن لنفسه الانفلات من قبضة الطبيعة والتحايل عليها، بالاعتراف بالزواج المثلي كحق في الزواج للجميع، وفي ظهور موانع الحمل، وتطور ثقافة القبلة العميقة.
وإذا كان الحب هو قدرنا الجميل الذي لا مبرر له، فما القدر في حد ذاته؟ وكيف نتعامل معه؟ في بعض الأحيان، هناك لحظات معقولة لتقبل القدر، لكن ليس إلى حد المقاومة دائما، فالعبرة تكمن في اكتشاف الأسلوب الأمثل والطريق الأنسب لمواجهة القدر، وهذا لا يتأتّى إلا بالتأمل والفهم الجيد للأحوال السيئة، للتخفيف من الشعور بها. يرشدنا الكاتب هنا، إلى ثلاثة مفاهيم أساسية لدى نيتشه للخروج من هذا المأزق؛ أولها، مفهوم "الاستسلام الروسي للقدر"، ومفاده، أن نحتال على الظروف القاسية بعدم استنزاف طاقتنا؛ ثانيا، مفهوم "أن يُحب المرء قدره "، ويقضي، أن نتصالح مع ذواتنا ونتقبل قدرنا الخاص؛ ثالثا، مفهوم "العود الأبدي"، ويعني، تقبل القدر بكل ما يحمله، والرغبة في عودة اللحظات الماضية بكامل تفاصيلها وأحداثها، حلوها ومرها. يقول: "عندما يتصالح المرء مع قدره الخاص كما يوصي زينون، وسينيكا، وشوبنهاور، ونيتشه، عندما يكُفُّ عن مقارنة نفسه مع أيّ قدر آخر مدركاً بأن لكل امرئ صراطه وسبيله، عندما يدرك بأن المقصود بعبارة "اعرف نفسك بنفسك" أن يرضي كل امرئ بقدره الذي يخصُّه من دون سواه، ساعتها يمكن للقدر أن يخضع لبعض التحسين والإبداع أيضا" (ص79).
هكذا تكون الفلسفة قبولا بالقضاء والقدر عن طريق مسايرته بكل حكمة وتأمل، وبهذا تكون الفلسفة كما يقول في عنوان آخر، "كخلاص دنيوي"؛ لأنها لا تملك أوهاما تبيعها للناس، بل أدوات نستعملها لإيقاظ العقل من سباته العميق. يضيف، "لكن الفلسفة -بقليل من الصبر والتبصر- تقترح أسلوب عيش يجعل الحياة في كل الظروف، ومن دون حاجة إلى أوهام بالضرورة" (ص81). وهنا يستلهم، من تاريخ الفلسفة عشر مبادئ أساسية لتحمل الظروف الصعبة، أهمها عِبرٌ وقواعد تركز على أن السعادة هي سعادة الحاضر، واتباع طريق التأمل، ونبذ التذمر، وعدم التشبث باليقين، والتحكم في مدى الحياة وأفقها واتساعها. أما طولها، فـ، "ما تدري نفس ماذا تكسب غدا" (سورة لقمان، الآية 34).
والتحكم في الحياة هو تحكم بالأساس في الذات، قبل التحكم في شؤون الجماعة، وهنا إشارة إلى ما هو سياسي يخص الدولة وشؤون المدينة، بأن يتصف الحاكم بالقدرة على لجم انفعالاته وتوجيهها لما هو خير للناس. إن "القدرة على التحكم في الذات لا تتوافر في مستوى القرارات العامة ما لم تتوافر في مستوى القرارات الشخصية" (ص81)، وهو ما يؤكد عليه نيتشه، في أن الافتقار إلى التحكم في النفس في الأمور الصغيرة يجعل القدرة على التحكم في الأمور الكثيرة تتلاشى، وهو تحكم لا يتحقق إلا بالتعقل والتفكر. بالمقابل، عدم القدرة على ضبط الذات يعني، التعاسة والضياع؛ لأنه استسلام للمزاج الصادر عن رغبة الجسد في الكسل والخمول.
إن وجودنا هو وجود عرضي إذن، وهو ما يتطلب منا العودة إلى اتباع الحياة البسيطة والعودة إلى طلبها، وليس خداع أنفسنا بعبارات وهمية لا نملُّ من سماعها في كل حين، يطلق عليها تمارين في خداع الذات. لهذا نحن بحاجة إلى من يعطينا تمارين في اكتساب أهمية وجودنا، والاعتراف بنا لجعل الحياة مقبولة ومعقولة، فنبتعد بذلك عن قبول الكسل والفشل. "إن بناء الذات يجب أن ينطلق من الذات نفسها، وليس من الرغبة في النماذج التي قد تعجبنا، ولا من الاستحسان الذي نطلبه، ولا من شتم الظروف التي وضعنا فيها...بل هو إدراك للرغبات الأصلية فينا" (ص، 100-101). غاية هذا البناء إذن، هو بناء ذاتي عملي وحقيقي، وليس وصفات الخداع الزائفة التي يقدمها لنا الغير.
واكتساب هذه التجارب والحِكم والأساليب في الحياة، هو ما يؤدّي بنا إلى أن نشيخ بسعادة وارتياح، والعيش في هدوء وجودة. فبالرغم من أن أغلبنا لا يريد أن يشيخ، إلا أن الشيخوخة هي تحرر من الغرائز التي تكبلنا، وفرصة لاستكشاف أبعاد جديدة من الجسد نفسه، وراحة له من الجشع والطمع. هكذا تصبح الشيخوخة فرصة لعيش الحياة السعيدة، ملء الحب والصداقة.
كما يتعمق الكاتب أكثر في التحليل بطرحه لمفهوم الموت، وكيف أن الفلسفة تعلمنا أن نتقبل فكرة الموت حسب تعبير جاك دريدا. ومنتهى الحكمة والتعقل بهذا المعنى، ألا نقع في براثن الخوف تُجاه الموت، لكي لا يكون فهمنا سطحيا لهذا الحدث الطبيعي. وهنا نجد أن بعض مجتمعاتنا المشرقية على مرّ التاريخ عملت على تقديس ثقافة الموت (تحنيط الجثث)، عكس الثقافة اليونانية مثلا، التي لا نجد فيها حديثا عن القبور، ولا من طقوس لتضخيم هذا الحدث (حرق الجثث)، ولنا في تجربة سقراط، خير دليل في تقبله العادي للموت بتجرعه للسم. الحياة إذن، "عبارة عن ميتات متتالية. فلا شيء فيها يعود كما كان، كل الحفلات تنتهي، كل الأعياد تنتهي، كل القصص تنتهي، كل حكايات الحب تنتهي. إننا في كل لحظة نموت في عالم بكل معالمه وذكرياته، ونولد في عالم آخر بكامل مخاوفه وآماله" (ص108). بالمقابل، فإن الخوف من الموت، يجعل الحياة لا تطاق، وذلك، لما تحمله من شقاء ومعاناة على النفس. هكذا تكون الفلسفة هي السبيل الوحيد في تعليمنا أسلوب التفكير والتفلسف، واكتساب المهارة في أن يموت المرء وفق أسلوبه الخاص.
لا تفوته الفرصة أيضا أن يوصينا، بأن الفلسفة تدعو إلى معرفة النفس بذاتها واكتشاف خباياها، وذلك، باستعمال العقل واختيار الأنسب لميولاتنا البدنية حتى يتحقق نموها. لكن، بشرط التحكم فيها، انطلاقا مما تمليه الفطرة حسب روسو، ومن الضمير بحسب دوركهايم، أو من العقل كما يؤكد كانط، حين يقول: "فلتكن لديك القدرة على استعمال عقلك"، وهو استعمال مصحوب بالشك كما وظفه سقراط في مجاراة محاوريه، ومع ديكارت في قوله بالشك في الآراء والمعتقدات السابقة ومساءلة القناعات الذاتية. إنه السبيل الوحيد إلى تحرّرنا من الخوف الذي يسكننا.
وفي معرض حديثه عن العلمانية كسلوك مدني، يعتبر أنها من المفاهيم التي تقوم على مبدأ واضح وواضح في أن النقاش العمومي المتداول هو الشرط الأساسي في قيام وبناء دولة سلمية وسليمة. وهنا يوجه سهام نقده إلى الحجج الدينية، في طبيعة الغيبيات التي تتميز بها، وفي أننا لا نستطيع أن نبني عليها أيّ شيء، سواء في السياسة، أو القضاء، أو العلم، أو غيرها من مجالات الحياة المدنية، فـ "لا يمكن تقديم المسلٌّمات غير البرهانية كدليل، من قبيل المسلمات الدينية على سبيل المثال" (ص129)؛ لأنها لا تقوم على البرهان والقابلية للتكذيب، وإنما على التسليم والتصديق. وبالتالي، فهي لا تخاطب العقل، بل تخاطب الوجدان والعواطف. ومن هذا الجانب يكون الرهان على الفلسفة أن تعلمنا أدوات التفكير، اقتداءً بسقراط بالدعوة إلى التحرر من الأفكار المسبقة، وفي التحرر من الأفكار الحسية مع أفلاطون، ومن الاغتراب مع فيورباخ، ومن الاستلاب مع ماركس، ومن الميتافيزيقا مع هايدجر، ومن آليات الدعاية مع حنة أرندت، ومن آليات السلطة مع ميشيل فوكو، يقول: "إن تاريخ التفكير نفسه هو تاريخ صراع طويل بين العقل والأوهام التي ينتجها العقل ذاته، تحت مسمى "الحقائق"، حتى ولو كانت تلك الحقائق تتخذ صفة العلم أو الحرية أو الحداثة" (ص147).
يحافظ الكاتب على أداته المنهجية بنسج خيوط تاريخ الأفكار، وصولا إلى العصر الحالي، وإلى وما يشهده من تقدم علمي وصلت إليه البشرية، من إعمار للفضاء الخارجي، ومن تطوير للدماغ وراثيا واصطناعيا وبرمجيا. الشيء الذي يقوده إلى البوح، أن مصائر النوع البشري تنحو في اتجاه أقوى اليوتوبيات، وهي خلود النوع البشري، يقول: "هناك على الأرجح، أو في مكان قريب من هناك، سيواصل المتحدرون من نسل البشر رحلة خلود النوع البشري" (ص156). وهذا يعني أن مسيرة العقل البشري في رحلة استكشاف جدلية مثيرة نحو الألوهية.
يتطرق الباحث في الأخير، في مداخلة له بالمنتدى الدولي للإصلاحات الدينية، بتونس، تحت عنوان، "ما الذي تمنحه الفلسفة لإصلاح الخطاب الديني لدى المسلمين؟" إلى مساءلة ونقد الخطاب الديني، باعتباره خطابا يرجع بنا إلى الوراء في زمن التقدم والتطور، ولهذا الغرض يستدعي استراتيجيات فلسفية ثلاث، من أجل تنمية القدرة على التفكير وإعمال العقل، أولها تدبير الانفعالات التي ينمِّيها الخطاب الديني السائد كالخوف، والغضب، العقاب، والشعور بالذنب والكراهية. ثانيا، تمثُّل المفاهيم الفلسفية، كأداة منهجية للتواصل والتعبير والنقد وإنتاج الأفكار، لإدراك العالم وصناعة الحضارة، بدل المفاهيم التي يعتمدها الخطاب الديني، والتي تقود إلى ضمور العقل وتجميد ملكة التفكير. والاستراتيجية الثالثة والأخيرة، مساءلة القيم التي يكون فيها العقل هو الموجه القيمي للعقل نفسه، وليس الخطاب الديني.






