"مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة" لويل كاميلشكا (ترجمة الدكتور منير الكشو)
فئة : قراءات في كتب
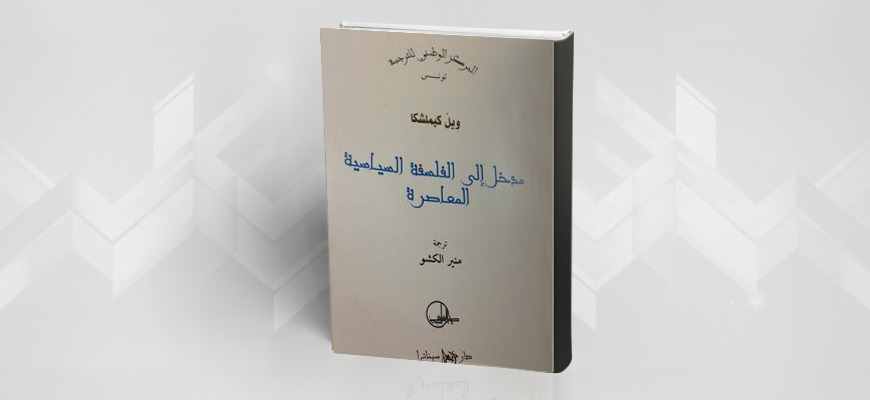
قراءة في كتاب "مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة"
لويل كاميلشكا (ترجمة الدكتور منير الكشو)[1]
تمهيد
يُعدّ كتاب ويل كاميلشكا "مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة" الصادر عن المركز الوطني للترجمة بتونس 2010 ترجمة الدكتور منير الكشو أحد أهم المراجع الأساسية لفهم الجدل الأنغلو- أمريكي المعاصر حول الديمقراطية الليبرالية، وما يدور في فلكها من مبادئ أساسية مثل حقوق الفرد وتكافؤ الفرص والمواطنة والديمقراطية، حيث حاول الفيلسوف الكندي أن يقدم ملخصاً للنقاش الدائر حول مدلولات هذه المفاهيم ومفاعليها والمسوّغات التي تقوم عليها.
يتكون الكتاب من تسعة فصول، نورد ذكرها مرتبة كما جاءت في الكتاب:
الفصل الأول: مقدمة يحدد فيها كاميلشكا المشروع والنهج المتبع في الكتاب. إذ يقول محدداً الغرض من إنجاز الكتاب "ينشد هذا الكتاب تقديم مدخل للمدارس الفكرية الكبرى المسيطرة على الجدل المعاصر في الفلسفة السياسية والقيام بتقديم نقدي لأطروحاتها"[2]، ومن هنا يتضح أنه سيعتمد أسلوب عرض النظريات السياسية وما يعتمل داخلها من جدل حاد ثم يقوم بنقدها عبر حجج محددة.
الفصل الثاني: "المنفعية"
الفصل الثالث: "المساواة الليبرالية"
الفصل الرابع: "الليبرتارينية"
الفصل الخامس: "الماركسية"
الفصل السادس: "الجماعتية"
الفصل السابع: "نظرية المواطنة"
الفصل الثامن: "التعددية الثقافية"
الفصل التاسع: "النسوية"، وهو موضوع بحثنا. حيث يطرح كاميليشكا في هذا الفصل كموضوع: الاعتراضات النسوية تجاه الفلسفة السياسية المحافظة من خلال ثلاثة أقسام رئيسة، وهي التالية:
القسم الأول يعالج جدل المساواة / الاختلاف من زاوية الطرق التي من خلالها تصبح القوانين مصدر ضرر للنساء، وما يرافقها من سياسات عمياء تجاه الجنس.
القسم الثاني: يركز على مسألة التمييز بين العمومي/ الخصوصي، والطريقة التي تمّ توظيفها تاريخياً لإحداث الضّرر بواقع النساء وفرض تهميش أدوارهن التاريخية والسياسية.
القسم الثالث: يهتم بالتمييز بين أخلاق الرعاية وأخلاق العدالة والعلاقة المثارة بينهما، ومدى وجاهتها الأخلاقية والسياسية والواقعية، وهل يمكن أن تمثل البديل الأخلاقي؟
من خلال هذا التقديم لأقسام الفصل التاسع المعنون بـ"النسوية" يمكن أن نفهم استراتيجة كاميلشكا وهدفه من تحرير هذا الفصل الذي يمتدّ من صفحة 465 إلى حدود صفحة 522، إذ يهدف كاميلشكا من خلال هذا الفصل تعريفنا بثلاثة أنواع من النقد النسوي الموجه إلى الطريقة التي تعاملت بها النظريات السياسية التقليدية مع قضايا ومصالح النساء وشواغلهن، وما تم تجاهله من قبل هذه النظريات التقليدية وإسقاطه ضمن دائرة النسيان والمسكوت عنه، فكأنّ منهجهم يتعمّد استراتيجياً الإهمال، ويعاني من عدم الجدية الكافية في الاهتمام بقضايا المرأة. ولا يتوقف هدف كاميلشكا في هذا الفصل على مستوى العرض للنظريات النسوية، بل يتبعها بفحص للحجج المقدمة يحصرها كاميلشكا في ثلاثة أنواع، هي التالية:
الحجة الأولى: تخص تصور اللامساواة بين الجنسين "محايداً تجاه الجنس".
الحجة الثانية: تتعلق بالتمييز بين العمومي والخصوصي، وكيف وظف هذا التمييز ضد المرأة.
تدافع الحجة الأولى والثانية عن فكرة مفادها أنّ التصور الليبرالي الديمقراطي للعدالة يظل منحازاً في أغلبه إلى الذكور.
الحجة الثالثة: إنّ التشديد في حدّ ذاته على العدالة يعكس مثل هذا الانحياز، وإنّ نظرية تشدد بالمقابل على الرعاية بدل العدالة هي وحدها الكفيلة بخدمة مصالح النساء والعناية بتجاربهن.
ولأنّ النسوية حركة تحررية تهدف إلى تخليص النساء من تبعية الرجال والسعي نحو تحقيق الاستقلالية الذاتية، فإنها قد تميزت بتنوع كبير على مستوى المنطلقات وعلى مستوى الاستنتاجات، ولئن وحدتها المنطلقات والأهداف، حيث "تنطلق الحركات النسوية في القرن العشرين على اختلافها من قناعة أنّ المرأة تحتلّ مكانة أدنى من تلك التي يحتلها الرجل".[3] بمعنى أنّ الحركات النسوية تنطلق من المفهوم المعياري للدونية والشعور بالظلم، وتضع هدفاً لها النضال ضد كل أشكال الضيم المسلط عليها، فإنها تختلف جميعاً من حيث تحديد أسباب التبعية وآليات التخلص منها، يقول كاميلشكا: "تتميز النظرية النسوية بتنوع كبير على مستوى المنطلقات والاستنتاجات... لكن هذا التنوع يبلغ درجة أكبر في النسوية، لأنّ كل نظرية من النظريات الأخرى لها حضور وتمثيل داخلها، لهذا نجد نسوية ليبرالية وأخرى اشتراكية وحتى ليبرتارينية. وما وحّد مختلف اتجاهات الفكر النسوي، وفق آليسون جاغر، هو تطلعها جميعاً إلى تخليص النساء من التبعية.
غير أنّ هذا الإجماع بينها ما فتئ أن انفرط عقده، كما تلاحظ هي نفسها، بفعل التباين الجذري في تفسير هذه التبعية، وفي تصور كيفية التخلص منها".[4] (Jaggar 1983: 5)
لا شك أنّ الحركات النسوية متعددة ومتنوعة في داخلها، وسبب هذا التنوع هو نشأتها في بيئة معقدة ومشحونة بالنظريات السياسية، ما فتح لها المجال لتكون الأهم والأقوى إسهاماً في الفلسفة السياسية المعاصرة، ولئن اكتفى كاميلشكا بذكر ثلاث نظريات سياسية نسوية معاصرة وهي:
"نسوية ليبرالية": تستند إلى مبادئ المساواة والحرية والمطالبة بحقوق نسائية مساوية لحقوق الرجل، وتنطلق من أسس فلسفية هي مبدأ الفردية ومبدأ الحرية ومبدأ العقلانية لفهم طبيعة المرأة. ترى حركة النسوية الليبرالية أنّ حل مشكلة المرأة يكمن في تغيير القوانين والسياسات بصورة إصلاحية. لذلك فمن الممكن حل المشاكل المتعلقة باضطهاد المرأة وهضم حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية دون إحداث أي تغيير جذري في المجتمع، فكل ما نحتاجه هو تغييرات إصلاحية، وعلى هذا فإنها تؤمن بأنّ كل امرأة قادرة على النضال بمفردها من أجل انتزاع حقوقها، حتى وإن كانت تعيش ضمن مجتمع ذكوري. فكانت مطالبتهم بمجموعة من الإصلاحات المدنية والاقتصادية تحدياً لفرضية تقوم على قناعة بعجز المرأة عن التكيف مع الطبيعة التي تحكم الحياة السياسية وبيئة العمل وتحدياً لتصور يختزل المرأة وكينونتها في الإقامة المنزلية الجبرية تحت وصاية رجل يدّعي بهتاناً حمايتها ورعايتها.
"نسوية اشتراكية": تنظر إلى قضايا المرأة كجزء من مشاكل المجتمع الرأسمالي ونتيجة له، ترى هذه الحركة أنّ ظلم النساء وقهرهن مرتبط بالاستغلال عن طريق تحقير المجتمع لعمل المرأة المدفوع الأجر أو العمل المنزلي غير المدفوع الأجر، ويكمن الحل حسب هذا الاتجاه في العمل على تغيير المجتمع بصفة كليّة ممّا سيترتب عليه حتماً التغيير في وضع المرأة.
"نسوية ليبرتارينية" يتجه هدفها صوب تحقيق المساواة، وما يميز الليبرتارينية أنها تقوم على مبادئ تمجيد الحرية الفردية وملكية الذات لذاتها، وبالتالي الحق في امتلاك كل ما تنتجه هذه الذات، والتشديد على أولوية الحقوق والدفاع عن اقتصاد السوق، لأنّه ينتج مجالاً أوسع للحرية الشخصية.
من خلال استعراض كاميلشكا لبعض الحركات النسوية نتبين أنّ النسوية ليست حركة واحدة متجانسة، رغم طموحها نحو المساواة وإلغاء تبعية المرأة للرجل ونبذ التمييز والخضوع القانوني لسلطة الرجال بسبب الوضع البيولوجي أو الطبيعي الذي يسوغ المعاملة اللامتساوية لهن. لذلك يفرض هذا الزخم في مستوى الفكر النسوي علينا كشف بعض أفكاره وحججه في مستوى مقاربته لمبدأ المساواة بين الجنسين وفق التمشي الذي اتبعه كاميلشكا في فصل "النسوية"، من كتابه "مدخل للفلسفة السياسية المعاصرة".
1) المساواة بين الجنسين والتمييز الجنسي أو الحياد الجنسي والمساواة المستحيلة:
لم يحد أغلب المفكرين عن ذلك التصور الإيديولوجي الذي يضع المرأة في مرتبة متدنية عن الرجل، والتي تبيح له دون خجل ومهما علت منزلته الفكرية والثقافية أن يتبنى قرار حصر وظيفتها في مجال الأسرة حيث لا مشاريع سيادية أو استقلالية ذاتية تنتظرها هناك سوى الخضوع لرجل آمن عن سبق إصرار وترصد أنه لا غرابة ممّا يقوله ويفعله بحق النساء ما دامت الطبيعة أرادت ذلك، فالذنب ليس ذنبه وإنما ذنب الطبيعة التي اختارت له أن يكون صاحب السيادة والريادة واختارت لها أن تكون جاريته المطيعة، فالطبيعة منحت الرجل القوة وسلبتها من المرأة، ولهذا فهي الكائن الضعيف غير المؤهل للأنشطة الاقتصادية والأنشطة السياسية التي يمارسها الرجل خارج المنزل. من هنا فإنّ حصر المرأة ضمن منزل تخضع داخله لزوجها لم يكن بدعة بقدر ما هو مبرر من وجهة نظر تستمد مشروعيتها من الأساس الطبيعي. وقد دعمت القناعة بهذا الموقف حين كان بعض النسوة يبحثن عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظلمهن واضطهادهن وقد وجدن ضالتهن في كتاب سيمون دي بوفوار "الجنس الثاني" الصادر سنة 1949 الذي ترجم للإنجليزية سنة 1953 وأعيد نشره سنة 1972. حيث شرحت سيمون دي بوفوار في هذا الكتاب أسباب سيطرة الرجل على المرأة وهيمنته عليها. ورغم أنّ السيطرة تبدو مسألة هشة وغير دائمة فإنّ المرأة قد استسلمت طويلاً لهذه الوضعية التي اتسمت بالعبودية والخضوع في العديد من الثقافات"، من هنا يبرز السؤال التالي: ما مصدر هذا الخضوع؟ لتجيب عن هذا السؤال تستنجد دي بوفوار بجدلية السيد والعبد عند هيجل وشرحه للعلاقة بينهما، حيث أنّ في الوعي نفسه يكمن العداء لأي وعي آخر، فما يجعل العبد عبداً هو أنّ السيد نصب نفسه الأعلى والأهم في مواجهة غير المهم ـ العبد (سيمون دي بوفوار 1972 ص 17)، ولكي يصبح السيد سيداً فإنه يحتاج إلى آخر يسيطر عليه ويتحكم فيه ويحوّله إلى عبد أو تابع، في المجال العام يناضل الرجال ليصبحوا سادة عن طريق الحرب. بيد أنّ هناك شكلاً آخر يجعل من كل رجل سيداً ألا وهو تسيّده على المرأة، التي تسمح له بامتلاكها والسيطرة عليها، بل تساعده على ذلك، وبامتلاكه لها تصبح تابعة له".[5]
لكن رغم تخلي المفكرين في مرحلة متقدمة عن مثل هذه التصورات التي تحط من قيمة المرأة اجتماعياً وسياسياً حسب كاميلشكا، وسعي كل الديمقراطيات الليبرالية إلى تبني تشريعات ضد التفرقة الجنسية وتبني دفاعهم عن جملة من الحقوق الأساسية، فإنها لم تحقق المساواة المطلوبة، إذ يقول ويل كاميلشكا في هذا السياق: "وقد تخلى المفكرون المعاصرون تدريجياً عن فرضية الدونية الطبيعية للمرأة. وهم يقولون اليوم إنه لا بدّ من معاملة النساء والرجال كـ"كائنات حرة ومتساوية" قادرة على التحديد الذاتي وتمتلك حس العدالة. ممّا يجعل النساء مهيآت لدخول المجال العام. وقد تبنت تدريجياً كل الديمقراطيات الليبرالية تشريعات ضد التفرقة الجنسية لضمان تمتع النساء بالحق في التعليم والشغل والنفاذ إلى الوظائف السياسية... لكن لم تأت هذه التشريعات المناهضة للتمييز من حيث المنزلة بالمساواة بين الجنسين"[6]. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن سبب استمرار هذا الوضع اللامساواتي بين الرجل والمرأة وعدم قدرة التشريعات على ضمان المساواة الفعلية بينهما؟
يرجع كامشليكا هذا الفشل في تحقيق المساواة إلى اعتماد النظرية الليبرالية على مقاربة "التباين"، فما المقصود بمقاربة التباين؟
أولاً: المقاربة وفق "قاعدة التباين"
تعني المقاربة وفق "قاعدة التباين" القبول بالمعاملة التمييزية ليس على أساس الميز العنصري أو الجنسي وإنما على أساس تبرير الاختلاف الجنسي الذي يعتبر مثل هذا التمييز مقبولاً، بل أكثر من ذلك هو مشروع. وهو ما يجعلنا نستنتج أنّه رغم إيمان قاعدة التباين بالمساواة بين الجنسين فإنها تنظر لهذه المساواة من زاوية تحددها سلطة الرجال وتصورهم للعالم.
لذلك يعتبر كاميلشكا رغم ما لهذه المقاربة من بعض المزايا والمتانة الأخلاقية المتأتية من منحها للنساء الامتيازات نفسها الممنوحة للرجال، والتي ساهمت إلى حد ما في تحقيق نسبة من الحياد على مستوى الوصول إلى بعض المواقع والحصول على امتيازات اجتماعية والمنافسة من أجل الفوز، يعتبر أنّ نجاحها يظل محدوداً، لأنها تجاهلت مظاهر اللامساواة الجنسية عند تحديد كل تلك المواقع، فخوض السباق من أجل الفوز يخضع للعبة رجالية تحدد ما الذي تقدر المرأة على الوصول إليه وما الذي لا تقدر عليه، إذ يقول كاميلشكا في هذا السياق: "المقاربة وفق قاعدة التباين تنظر إلى المساواة بين الجنسين حسب قدرة النساء على خوض السباق من أجل الفوز بأدوار حددها الرجال من خلال قواعد يعتبرونها محايدة تجاه الجنسين".[7] لو أردنا أن نلخص سبب اعتراضات النسويين على قاعدة التباين فإنّ ما ردّ اعتراضهن عليها يعود حسب تصورهن إلى أنّ توزيع الأدوار التي تتم تحت غطاء ادعاء الحيادية الجنسية ليس سوى خدعة رجالية للمحافظة على أكبر قدر من مكتسبات الهيمنة الذكورية، سنكون مخادعين لأنفسنا لو اعتقدنا للحظة أننا قد تحررنا فعلاً من عباءة الرجل ونحن نعيش في عالم صممه الرجال من ألفه إلى يائه وفق تصوراتهم الرجالية.
فهل يستطيع أن ينكر أحد أنّ الرجال هم من يعهد لهم بناء المؤسسات وفق مصالحهم وتصوراتهم وشروطهم، وهم من يحملون مفاتيح هذا النظام الكوسمورجالي، يهندسون ويصممون وفق احتياجاتهم ورؤاهم الخالية من أي استحضار للأنثوي، فكل شيء يتم وفق مقاييسهم الرجالية في تجاهل تام لتوزيع تشاركي لرؤية العالم. لذلك سيظل الخلل قائماً، وكذلك اللامساواة، حتى وإن زعم هؤلاء الحياد تجاه الانتماء الجنسي، لأنّ اللامساواة متأصلة في ذهنية الرجل التي وفقها يبني نظام العالم الذكوري. يقول كاميلشكا: "المشكل يكمن في أنّ مقتضيات الشغل قد حددت من البدء من الرجال على أساس أنّ الرجال هم من سيشغل الوظيفة"[8]، ولتوضيح هذه الفكرة نستعير مثالاً أورده كاميلشكا في كتابه، والذي يوضح فيه كيف تتم عملية تكريس اللامساواة غير المباشرة بين الجنسين وفق قاعدة التباين التي تستند للاختلاف الجنسي، حيث يشترط مثلاً في معظم الوظائف أن يكون الشخص المرشح لها ليس في كفالته رعاية أطفال صغار"، صحيح أنّ قاعدة التباين لا تعير اهتماماً لجنس المترشح عند انتدابه في العمل، لكن في مقابل ذلك فإنّ عقبة الحياد تمّت مداراتها بوضع شروط محددة للوظيفة، فبما أنّ مهمة تربية الأطفال توكل عادة للأم، يكون الرجال أوفر حظاً من النساء في الحصول على الوظيفة، وهو ما يوحي بأنّ ثمة استمرارية ممنهجة لممارسة أسلوب إقصاء النساء من عدة مهام ووظائف، ومن البدهي أن ينتج عن هذا الإقصاء حرمان المرأة من فرصة تنمية مهاراتها في الفضاء العمومي، وبالتالي قصورها وتخلفها عن تقلد المناصب ولعب الأدوار الهامة.
فإذا كانت المواقع الاجتماعية المهمة محتكرة من طرف الرجال، وإذا اشتغلت المرأة فإنها تشتغل في الوظائف ذات الأجر الأدنى وفق نظام نصف الحصة، وأنّ نسبة كبيرة من النساء في تبعية اقتصادية شبه تامة للرجال، وحدث ولا حرج في مستوى العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة بمفردها ويلتهم كل وقتها وجهدها، علاوة على كونه عملاً لا تتقاضى عليه أجراً رغم مشقته، فهل مازال لدينا أدنى شك في أنّ تصميم الأدوار وتوزيع المهام وتقاسم المنافع يتمّ حقاً دون استحضار للهويّة الجنسية؟ هل من المشروعية في مثل هذا الوضع الذي تعيشه النساء أن نتحدث عن الحياد تجاه الجنس؟ وعن أي حياد نتحدث إذا كان أمر تصميم وتوزيع الأدوار يحدث منذ البدء حسب احتياجات وتصورات الرجال ومصالحهم؟
يبدو أنّ مسألة "الحياد الجنسي" التي تتضمنها المقاربة وفق قاعدة التباين ليس سوى أمر مخادع، لأنّه من الواضح أنّ الأهداف ترسم وفق مصالح الرجال وقيمهم، ومن البدهي أنّ مجتمعاً يهندسه الرجال أن تأتي مواقفه محابية له منحازة إليه، إذ من غير المعقول أن يضع الرجال قواعد العالم وتكون هذه القواعد في الوقت نفسه ليست في صالحهم، وهو ما عبّر عنه كاميلشكا قائلاً: "وبالفعل، كلما ضبطت المواقع الاجتماعية وفق اعتبارات الجنس كان مقياس التباين قاصراً عن الكشف عن أي مظهر من مظاهر عدم المساواة".[9] فهل من حل للتصدي لكل أشكال الظلم الذي يمارس تجاه المرأة؟
إنّ محدودية المقاربة وفق قاعدة التباين حسب كاميلشكا هي التي دفعت بالنسويين نحو إعادة صياغة مفاهيمنا للامساواة بين الجنسين بوصف أنّ المشكل الحقيقي لا يتعلق بمجرد تمييز اعتباطي، وإنما هو أعمق من ذلك بكثير، وإذا لم نفكر في إعادة صياغة المشكل فقد تكون كل الجهود هباء منثوراً لا يتعدى كونه مجرد هذيان بمساواة مستحيلة، وهنا يستشهد كاميلشكا بمقولة إحدى النسويات (ماكنون) لتظهر الدهاء الذكوري في تعطيل مسألة المساواة بين الجنسين: "تقول ماكونين أن نطلب من امرأة أن تتطابق مع المقياس السائد - أي مقياس قد وضعه وكرّسه أولئك الذين تتحدد هويتها اجتماعياً باعتبارها مغايرة لهم ـ يعني ببساطة أنّ المساواة بين الجنسين قد صيغت على نحو تكون فيه غير قابلة للإنجاز (ماكونين 1987: 44)[10].
فما هي المقاربة البديلة إذن في هذا السياق لتتحول المساواة من فكرة مستحيلة إلى واقع ملموس؟
ثانياً: المقاربة وفق فكرة الهيمنة
إذا كانت المقاربة من خلال قاعدة التباين تجعل من الاختلاف الجنسي مصدراً لتبرير اللامساواة بين الجنسين وجعله مشروعاً في حالة وجود اختلافات حقيقية بين النساء والرجال، فإنّ المقاربة من خلال "فكرة الهيمنة" ترفض تبرير التفاوت واللامساواة تحت أي مسمّى، حتى وإن كان بسبب الاختلاف الجنسي، بهذا المعنى تهدف هذه المقاربة حسب ماكنون إلى ألا يتسبب الاختلاف الجنسي في أضرار تجعل من المرأة ضحية هذا الاختلاف. فلماذا تدفع المرأة دوماً وحدها ضريبة اختلافها عن الرجل؟ إذا كان لا بدّ لأحد من دفع ضريبة الاختلاف، فلما لا يدفعها هو كنتيجة اختلافه عن المرأة؟ ولماذا ننظر دوماً إلى كون المرأة مختلفة عن الرجل وليس الرجل هو المختلف عن المرأة؟ هل لأنّ الرجل هو مركز العالم والمرأة هامشه؟
إنّ رأس الداء هنا يتمثل في مشكل الهيمنة الذي لا يمكن محوه بمجرد إخفاء الميز أو إزالته، وإنما بإعادة توزيع النفوذ. إنّ المساواة الحقيقية ليست مجرّد تجميل لوجه اللامساواة القبيح عبر تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الترشح لأدوار صممت لتكون على مقياس الرجال القيمية والمزاجية والمعيارية، لأنّ الحديث عن تكافؤ الفرص ضمن هذه الشروط ما هو إلا مجرد لغو. فالمساواة الحقيقية لن تتحقق إلا بخوض المرأة معركة تقاسم النفوذ عبر مساهمتها الفعلية والجدية في خلق أدوار اجتماعية جديدة تحددها هي، أو أدوار محايدة جنسياً، وليس الاكتفاء بانتظار العروض التي تقدم لها فرص الانتماء لمؤسسات صممها الرجال. هكذا تتمكن المرأة من تحصيل حقها في التوزيع العادل للنفوذ بما يتيح لها فرصة إعادة ترتيب الأدوار داخل المجتمع بصفة متساوية. ومن هنا ترى "غروس" حسب كاميلشكا "أنه لا بدّ من أن تكون للنسويات الحرية في إعادة تعريف الأدوار الاجتماعية وتحديد مشروعهن، باعتباره سياسة تنشد "الاستقلال الذاتي" أكثر منه مشروعاً لسياسة "مساواة"[11].
فهل مردّ ذلك إلى المفكرين التقليديين الذين عجزوا بيمينهم ويسارهم عن تأول القصور الذي يحيط بتصورهم لمعنى المساواة كما تعتقد العديد من النسويات؟ ما الذي يجعل غروس تفضل الاستقلال الذاتي على المساواة؟ وما المعنى الذي تتقصده من وراء فكرة "الاستقلال الذاتي"؟
النسوية من المساواة إلى الاستقلال الذاتي:
يعني "الاستقلال الذاتي" أن تمتلك الذات حقاً في أن تدرك ذاتها وفق ما تبنيه من رؤى وتصورات ذاتية - حسب غروس- أمّا المساواة فتعني أن يقاس وضع الفرد وفق مقياس ما. فالمساواة هي تناظر حدين أو أكثر يكون أحدهما يحتل دون جدال دور المعيار أو النموذج بالنسبة للآخر. أمّا الاستقلال الذاتي فهو يعني، على العكس، أنّ لنا الحق في قبول أو رفض تلك المعايير أو النماذج اعتباراً لمدى خدمتها لمقتضى تحديدنا لهويتنا بأنفسنا".[12]
فحسب غروس إذا كنا نناضل من أجل المساواة فإننا مجبرون على قبول المعايير السائدة والانسجام مع مقتضياتها ومتطلباتها، أمّا إذا كنا نناضل من أجل استقلالنا الذاتي فإنه من حقنا رفض المعايير السائدة وابتكار معايير أخرى بديلة.
من خلال هذه المقاربة نستنتج أنّ المساواة هي مساواة منقوصة، لأنها لا تحمل في طياتها ولا في أولوياتها ثورة على التمييز المبرر اجتماعياً بين النساء والرجال، بما أنّ مفهوم المساواة ذاته يخضع لمعايير ونماذج وتصورات يسطرها ويسيطر عليها الرجال تبعاً لمصالحهم واحتياجاتهم. هذه المساواة ستظل ينقصها كمال تحقيق المساواة الحقيقية طالما لم ندعمها بمطلب الاستقلال الذاتي الذي يحمل في مقاصده وجوهره معنى المساواة الفعلية لا الوهمية. فالمطلوب من الحركة النسوية ليس القبول بمساواة مغشوشة حاكت معانيها تصورات ذكورية بل خوض معركة "الاستقلال الذاتي" التي هي معركة وضع معايير وقيم وإعادة توزيع الأدوار الاجتماعية وفق تصور ورؤى نسوية، وعندها فقط يمكن الحديث فعلاً عن ذات نسوية حرة ومساوية للرجل مبدعة وفاعلة ومبتكرة لقيمها، وليس مجرد متقبلة ومستهلكة لقيم موضوعة ومفروضة من قبل الرجال.
فلا حديث عن مساواة حقيقية بين الجنسين حسب غروس إلا إذا تمّ إزالة كلّ تمييز اعتباطي، أي ذلك الذي فرضه الرجل لأنّه الأقوى حسب اعتقاده، وليس له ما يبرره سوى وهم يحمله في ذهنه بأنّ الأمر يجب أن يكون على هذا النحو وليس على نحو آخر.
نستنتج إذن أنّ دراسة قضية التمييز بين الجنسين من وجهة نظر "الهيمنة" تتضمن رؤية للمساواة تصبح من خلالها الاستقلالية الذاتية عنصراً هاماً من نظرية المساواة تكون أفضل من سابقتها، فكل تصور للمساواة الحقيقية يجب أن يكون معتمداً ومتضمناً لفكرة الاستقلالية الذاتية. يذكر كاميلشكا في هذا السياق قول إيزنشتاين حول التمثل للمساواة الحقيقية بين الجنسين، إذ يقول: "تعني المساواة وفق هذا الرأي أنّ للأفراد جميعاً القيمة نفسها ككائنات بشرية. ووفق هذه الوجهة تعني المساواة أن تكون النساء على شاكلة الرجال كما هم اليوم، لا أن يحصلن على المساواة مع المضطهدين لهن".[13]
نستنتج أنه رغم النقد المقدم من قبل الحركة النسوية لمفهوم المساواة وفق النظريات التقليدية فإنها لا تتخلى عن مبدأ المساواة، وإنما تعيد صياغته مع الأخذ بالاعتبار مبدأ الاستقلالية الذاتية التي تضفي تحسيناً ومعنى حقيقياً للمساواة. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن السبب الذي منع الرجال من اعتمادهم مقاربة لمسألة المساواة بين الجنسين تعتمد مبدأ الهيمنة، هل لجهلهم وعدم تفطنهم لأهمية مثل هذه المقاربة، أم لغاية في أنفسهم؟
أليس في رفض الرجال لمثل هذه المقاربة ما يمثل تواطؤاً خفياً ضدّ كل حركة تنشد مراجعة المواضعات الاجتماعية التي تبرر سيادة الرجل وتبعية المرأة وخضوعها لتقسيم الأدوار التقليدية القائمة على التمييز بين المجال الخاص والعام؟
2) العام والخاص بوصفهما مجالين لإعادة إنتاج اللامساواة بين الجنسين:
إنّ تناول مسألة "المساواة بين الجنسين" وفق المقاربة النسوية "للهيمنة" كشف عن حقيقة اللامساواة بين الرجل والمرأة حين يتعلق بالتوزيع غير المتكافئ للعمل المنزلي وللمسؤوليات الأسرية والمهنية، وكشف كاميلشكا أنّ نظرية الليبرالية الكلاسيكية لا تعير اهتماماً لتطبيق العدالة داخل المجال الخاص، كما هو الحال بالنسبة للأسرة التي تنظم وفق معطيات الغريزة الطبيعية لا وفق مقتضيات العدالة، لأنّ العدالة حسب اعتقادهم تتعلق بإدارة الشأن العام، وقد ترتب عن ذلك وجود نوع من اللامبالاة تجاه ما يحدث في الأسرة سواء من قبل نظريات العدالة، مثلما هو الأمر عند رولز الذي يعتبر أنّ الأسرة في شكلها التقليدي عادلة، أو حتى لدى جزء هام من النسويات الليبراليات اللاتي "يقبلن القسمة بين كوكبة عامة وأخرى خاصة، ويبحثن عن تحقيق المساواة في المجال العام أولاً".[14] إنّ البحث عن أولوية المساواة في المجال العام وتجاهلها داخل المجال الخاص هو الخطأ الذي وقعت فيه النظريات الليبرالية بما فيها النسوية، وهو ما جعلها قاصرة عن إحداث تغيير جذري في مستوى نظرية المساواة بين الجنسين"، إذ سيظل من غير العدل أن تجبر المرأة على الاختيار بين رعاية عائلتها أو الانصراف للعمل، في حين يعفى الرجل من مثل ذلك الاختيار".[15] فإذا كان كل من المرأة والرجل يتزوجان، فلماذا تأتي نتائج الزواج متباينة على كليهما وفي صالح الرجل دوماً؟ لماذا لا يتحمل الاثنان النتائج المترتبة عن تكوين أسرة على حياتهم الخاصة والمهنية بالدرجة نفسها"؟
فضلاً عن هذا إذا أضفنا إلى التمييز بين تقسيم العمل والأدوار ومسألة الحط من شأن قيمة العمل المنزلي ذاته فإنّ المرأة ستجد نفسها ضمن سياق ثقافة آثمة تضعها في سياق اجتماعي يفقدها قيمتها الإنسانية والثقافية، ويكرّس مبدأ تبعيتها الاقتصادية.
في هذا السياق ترى بعض النسويات ضرورة خوض نضال المساواة من داخل الأسرة، حيث المواجهة الحقيقية مع النماذج التقليدية السائدة للعمل في البيت أو المجال الخاص، وألا يتوقف هذا النضال على المطالبة بالمساواة داخل المجال العام، ويذكّر كميلشكا هنا بقول كارول باتمان التي ترى أنّ "الفصل بين العام والخاص (...) هو في آخر الأمر الشغل الشاغل للحركة النسوية" (1987-103).
فإذا كان قصور النظرية الليبرالية عن مجابهة أشكال اللامساواة بين الجنسين الناتج عن رفضها التدخل في المجال الخاص واعتبار العدالة مسألة تهم المجال العام ولا تنطبق على مجال الأسرة الخاص، إذا كان ذلك يُعدّ خيانة لمبادئ الليبرالية التي قامت على تطبيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحظوظ فإنّ هذا الأمر يدفعنا للتساؤل عن سبب رفض الليبراليين في المجال الخاص، العائلي منه خاصة، إذا كان هذا التطبيق يمكن أن يحفظ ماء الوجه للمبادئ التي قامت عليها الليبرالية المساواتية؟
لا شك أنّ التصور الليبرالي التقليدي يجعل من الأسرة مركز الحياة الخاصة، ويرى أنّ كل محاولة ليبرالية للتدخل في الحياة الأسرية باسم العدالة في المجال الخاص يمثل قطيعة نهائية مع التصور الليبرالي التقليدي للأسرة بوصفها مركز الحياة الخاصة، كما أنّ تأكيد النسويات الليبراليات على أولوية العدالة داخل المجال العام وتجاهل ما يحدث داخل الأسرة يدفعنا إلى الحديث عن مدى انسجام القيم الأساسية للّيبرالية فيما بينها، ومهما يكن نوع التصور الذي نحمله تجاه التمييز بين العام والخاص، سواء ذلك الشكل الأول من التمييز المتعلق بين كوكبة اجتماعية وكوكبة سياسية ذات المرجعية الأرسطية التي أثنت على المشاركة في الحياة السياسية بوصفها الإطار الأفضل للحياة الخيرة، وفضلتها على كوكبة المنزل أو الشكل الثاني من التمييز بين الدولة (بوصفها تمثل المجال العمومي) والمجتمع المدني (الذي يمثل المجال الخاص) الذي هو محل تمجيد ليبرالي بوصفه مجالاً للاتحاد الواعي والحر فإنّ هذا تمييز لا يفرد مكانة للأسرة، حيث تلاحظ النساء أنّ ما يقدمه الليبراليون من توصيفات للحياة الاجتماعية وكأنها حياة لا تضم سوى عوالم من الرجال، وترى باتمان أنّ الليبرالية في صياغتها لمفهوم المجتمع المدني تتغاضى عن الإكراهات التي تفرضها طبيعة الأدوار داخل الأسرة، لدرجة يتم فيها إقصاء الحياة المنزلية من كوكبتي الدولة والمجتمع المدني، فلماذا لم تتجسد المبادئ الليبرالية على صعيد كوكبة الحياة المنزلية؟
يبدو أنّ طرح مسألة التقسيم الجنسي للعمل يتعارض مع مصلحة الذكور ما داموا يستفيدون من هذا التمييز، ويقع تبريره على أساس قاعدة الاستعداد البيولوجي الطبيعي للمرأة، وكأننا أمام استعادة للفكر الأرسطي الذي استند في مرجعيته على تحقير كوكبة المنزل بوصفة شأناً نسوياً، واعتبر الانصراف إلى المشاركة السياسية شأن الرجال الأحرار.
ولئن كان معظم النسويين المعاصرين يقبلون بأهم سمات التصور الليبرالي للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني حسب كمليشكا فإنهم يرفضون دعوات الأرسطيين الجمهوريين لمنح السياسة مقاماً لأنها المسؤولة عن التردي الثقافي لقيمة النساء في المجتمع، إذ تنظر للعمل المنزلي وإنجاب الأطفال وتربيتهم كعمل بيولوجي طبيعي من درجة دنيا، في حين يكون عمل الرجل المتجه نحو الفعل السياسي تأميناً له ضد التفاهة كما ترى حنا أرنت، فالسيطرة على الحاجيات المنزلية بإيكالها للمرأة هو شرط حرية الرجل.
إنّ تفضيل السياسة على المجتمع تقوم على كونية مفترضة وعلى المشتركات بين الناس، حيث تفترض حماية الكونية فصل السياسة عن المشاغل المنزلية الجزئية، ويستعرض كمليشكا لتوضيح هذا الأمر موقف أريس يونغ المتمثل فيما يلي: "الاحتفاء بمجال عمومي تسوده فضائل فحلة ومواطنية تكون تعبيراً عن معاني الاستقلالية والعمومية والمعقولية البعيدة عن الأهواء يقتضي استحداث مجال خاص للعائلة تنحصر فيه الانفعالات والمشاعر الجسدية، فشرط عمومية المجال العام هو استبعاد النساء منه (يونغ 1989: 253 فليبس 2000: 6-285).
ورغم التعديلات التي طرأت على مفهوم الحياة الخاصة مع الليبرالية المعاصرة الذي اتخذ صبغة قانونية تمثل "في الحق في حياة خاصة" فإنها لم تسلم أيضاً من النقد النسوي حيث إنّ هذا الحق الذي منح في الولايات المتحدة الأمريكية صفة دستورية كان ينظر في بدايته كانتصار للنساء، لأنه قضى بأنّ كل تشريع يمنع النساء من استعمال مضادات منع الحمل ينتهك حرمتهن الخاصة، لكن اتضح فيما بعد أنّ هذا الحق في الحياة الخاصة وفق التأويل الذي وضعته المحكمة العليا يمكن أن يعرقل جهود مقاومة اضطهاد النساء في البيت باعتباره تعدياً على الحياة الخاصة حتى ولو كانت غايته نبيلة، وهو الارتقاء بوضع النساء وحمايتهن من العنف الأسري أو الاعتراف الرسمي بقيمة عملهن المنزلي. وهو ما عبرت عنه ماكنون بقولها: "يرسخ الحق في حرمة الحياة الخاصة القسمة بين العام والخاص على نحو (...) توضع فيه الكوكبة الخاصة في مأمن... وينزع عن إخضاع النساء وجهه السياسي" (ماكنون 1987: 102) حتى أنه باتت نظرية الخصوصية التي تتذرع بها الدولة واجهة تستخدمها في المزيد لإخضاع النساء، لذلك يعتبر كمليشكا أنّ ادعاء حماية الحياة الخاصة للأسرة هو حق أريد به باطل، وأنّ المحكمة العليا حسب رأيه تخلط بين معنى "الحق في الحياة الخاصة الفردية" والحياة الخاصة الجماعية للأسرة، لأنها تمنح الأسر من حيث هي كيانات جماعية هذا الحق في الحياة الخاصة، وتسلبه من أعضاء تلك الأسرة كأفراد وخاصة المرأة، هذا الفهم للأسرة حسب كمليشكا يعود إلى تصور تقليدي ما قبل ليبرالي يرى في الأسرة امتداداً لرب الأسرة، والنساء فيها متاع لأزواجهن فاقدات للشخصيات القانونية، أليس بهذا المعنى "الحق في حياة خاصة" هو في نهاية الأمر حق الرجال في اضطهاد النساء دون الشعور بالذنب أو وهم "مرتاحو البال" كما تقول ماكنون؟ لذلك ينادي كمليشكا بضرورة تدخل الدولة في فضاء المنزل لفرض الاحترام وتطبيق العدل ومنع كل اعتداء يحدث داخل الكوكبة الخاصة (المنزل)، ويعتبر أنّه لا شيء في التمييز الليبرالي سواء بين الدولة والمجتمع المدني أو في نظرية الحق الليبرالي في الخصوصية ما يمنع مثل هذا التدخل أو يتعارض معه، مستحضراً في هذا الإطار ما قاله راولز: "إذا كان المجال الخاص يفترض منه أن يكون فضاء معفياً من العدالة فلا وجود عندئذ لمثل ذلك المجال، لأنّ حقوق النساء المساوية لحقوق غيرهن من الرجال والحقوق الأساسية لأطفالهن بما هم مواطنو المستقبل حقوق غير قابلة للتصرف، ويجب أن تصان أينما وجدوا" (راولز 1997: 791).
نستنتج إذن أنّ استخدام فكرة نقاوة المجال العام من كل حضور نسوي واقتصار تواجدهن في الفضاء المنزلي الخاص ما هو إلا بدعة ذكورية، وفرض التعارض تاريخياً بين الكوكبة الخاصة والكوكبة العامة ما هو إلا من أجل تسويغ فكرة الهيمنة الباطرياركية، وكأنّ المرأة حسب هذا التقسيم الذكوري لا يهمها الشأن العام، وأنّ اهتماماتها لا تتجاوز المسائل البيتية الخاصة، وهو ما اعترضت عليه النسويات، حيث بيّنت إحدى رائدات الفكر النسوي ماري ولستونكرافت أنه إذا كانت النساء لا يولين عناية بالشأن العام ويركزن عنايتهن على الأشخاص المحيطين بهن فإنّ ذلك يعود إلى حرمانهن من تنمية ملكاتهن الفكرية ومنعهن من الحصول على المسؤوليات العامة. وهو ما أدى إلى التمييز أيضاً على المستوى الأخلاقي بين "أخلاقية ذكورية" و"أخلاقية نسائية" بوصفها إحدى الأساطير التي أنتجتها الثقافة الذكورية، وكأننا أمام "جنسنة" للأخلاق.
لقد دفع ذلك كاميلشكا إلى تخصيص الجزء الأخير من مبحث النسوية للحديث عن "أخلاق الرعاية" بوصفها نتيجة للتمييز بين الكوكبة العمومية والكوكبة الخاصة، والاعتقاد في وجود فرق بين النساء والرجال على مستوى القدرة على الإحساس والتفكير كما يقع تقسيم العمل الأخلاقي حسب الهويّة الجنسية، فما المقصود بأخلاق الرعاية؟ وما الذي يميزها عن أخلاق العدالة؟ وهل توجد فعلاً مقاربة للمسائل السياسية من منظور أخلاق الرعاية؟ وهل يمكن أن تطبق خارج إطار المجال الخاص للعائلة وعلاقات الصداقة، خاصة إذا ما تعلقت بالمسؤوليات التي نتحملها بفعل علاقتنا الشخصية الخاصة، وليس بفعل الواجبات المتبادلة التي نلتزم بها من حيث أننا أطراف مشاركة في الفضاء العمومي؟
3) أخلاق الرعاية وأخلاق العدالة، أو: في جنسنة الأخلاق
يبدو أنّ القناعة بأنّ المجتمع الليبرالي مجتمع ذكوري بشكل ضمني لأنّ اكتساب المرأة لحق المواطنة فيه هو في نهاية الأمر اكتساب لحقوق كانت حكراً على الرجال تفسر وفق قدراته وظروفه، وبالتالي هي حقوق وفق شروط الرجل وليس وفق شروط المرأة، إذ هي مساواة بالمحاكاة، يبدو أنّ ذلك هو ما دفع النسويين لتفحص أحد جوانب الفلسفة الليبرالية المعاصرة المتمثل في الزعم القائل إنّ الهدف الأسمى للدولة هو ضمان العدالة. وقد تساءلوا ما إذا كان التوصل إلى مبادئ العدالة التي نادى بها رولز ستنجح حقاً في التعامل دون تحيز مع مصالح الرجل والمرأة؟ وهل العدالة منزهة عن التحيز لأيّ من الجنسين أم أنها عدالة متحيزة للرجال، وأنّ رهان الدولة عليها في تحقيق المساواة بين الجنسين رهان خاسر؟
يؤكد الفكر النسوي المعاصر على ضرورة الأخذ على محمل الجد فكرة أخلاق نسائية قائمة على منطق التميز وليست مجرد إحساس حدسي حيث تبدو الأخلاق أرقى أخلاقياً من التفكير المحايد الذي يعتمده الرجال في الكوكبة العامة، أمّا غليغن فقد رأت أنّ الحس الأخلاقي لدى كل من النساء والرجال ينزع نحو التطور على نحو مستقل ومختلف عن الآخر. وقد فسّر هذا الاختلاف بين التصورين بالتباين في الرؤى بين "أخلاق الرعاية" و"أخلاق العدالة"، إذ تعتبر أننا إزاء رؤيتين للأخلاق "متنافرتين في الجوهر"، ليس لأنّ تفكيرهم مختلف حقاً وإنما لأنّ الرجال يقدرون أن عليهم الاهتمام بمسائل العدالة والحقوق، في حين تشعر النساء أنهن معنيات بسبل صيانة العلاقات الاجتماعية، وترى فريدمان "أننا نصنف دون جدال أي انشغال أخلاقي يبديه رجل على أنه يندرج ضمن مسائل العدالة والحقوق في حين نصنف الانشغالات الأخلاقية التي تعبر عنها النساء في خانة فاقدة للقيمة وهي الرعاية والعلاقات الشخصية" (فريدمان 1987 -96 باير)[16]. ورغم أنّ أخلاق الرعاية تبدو ممّا تتقدم أنها تطورت في مجال العلاقات الخاصة فإنها حسب بعض النسويات أخذت بعداً أشمل، وامتدت إلى الشأن العام، فهل يمكن أن نعتبر أخلاق العناية هي البديل الأخلاقي لأخلاق العدالة؟
تختلف أخلاق العناية عن أخلاق العدالة من ثلاث زوايا كما حددها كاميلشكا في كتابه مدخل للفلسفة السياسية المعاصرة:
أ- زاوية المؤهلات الأخلاقية: حيث تؤكد ترونتو أنّ أخلاق الرعاية تفترض أنّ التساؤلات الكبرى للأخلاق لم تعد تتمحور حول السؤال التالي: ما هي أفضل المبادئ؟ وإنما حول سؤال: كيف يمكن أن يكون الأفراد مؤهلين للتصرف على نحو أخلاقي؟ فلكي يكون الفرد شخصاً أخلاقياً لا يكفي أن يعرف المبادئ على مستوى نظري، وإنما يلزمه أن يكتسب أهليّة في التصرف الأخلاقي تؤهله للاستجابة السريعة لاحتياجات الأفراد والاهتداء للأجوبة الملائمة، وهو ما انتقده كاميلشكا، إذ رأى هاجس التثبت من صلاحيات المبادئ يؤدي حتماً إلى الاهتمام بأهلية التصرف الأخلاقي، فالأمران حسب رأيه متلازمان.
ب- الزاوية الثانية هي القياس الأخلاقي: بمعنى أن يصبح الفعل الأخلاقي محدداً بمدى قدرته على الاستجابة لأوضاع معينة وليس بتطبيق مبادئ كونية على حالات خاصة، فأمام شح الموارد التي لدينا لرعاية الناس علينا تحديد ترتيب من هم أشد حاجة للرعاية من غيرهم، وبالتالي نحن في حاجة إلى وجهة أخلاقية نرتب وفقها الأولويات التي تتطلبها أخلاق الرعاية. ولئن رأت غليغن أنّ وضع ثقتنا في مبادئ عامة سيجعلنا نتغاضى عن خصوصية الأوضاع والملابسات فإنّ غريمشو يعترض على ذلك بدعوى أنّ هذه المبادئ لا تأمرنا بتجنب فحص الحالات الخاصة وإنما تقدم لنا توصيات حول ما يتعين الانتباه إليه، فهي ليست شبيهة بقواعد الوصايا العشر التي نطبقها دون عناء التفكير بل تعمل لتحفيز التفكير، وهو ما يجعلنا نستنتج مع فريدمان أنه مثلما لا يمكن لأي نظرية أخلاقية أن تستغني عن المبادئ العامة حتى تلك التي تستأنس بها نظرية العدالة لا تقصي الاهتمام بالجزئيات الصغيرة لوضع محدد بل هي تقتضيها.
ج- زاوية المفاهيم الأخلاقية: ويتعلق المشكل هنا بمعرفة ما إذا كانت هذه المبادئ تخص مجال الحقوق والإنصاف أم مجال المسؤوليات والعلاقات؟
في هذا السياق يحدد كاميلشكا ثلاث طرق متمايزة لصياغة الاختلاف بين المفاهيم، هي التالية:
أولاً: الكونية أم علاقات الشخصية؟ إنّ ما يميز الرعاية عن العدالة هو أنّ العدالة تتطلع للكونية وتلزم الحياد، أمّا الرعاية فهي تطمح للحفاظ على نسيج العلاقات القائمة حيث تقفز الصلة الشخصية للواجهة. غير أنّ ترنتو ترى أنه لتجنب الانحياز للقريب نحن في حاجة إلى مبادئ العدالة كرافد لأخلاق الرعاية. وبالرغم من ذلك يظل ثمة توتر داخل أخلاق الرعاية حسب طريقة تأويله بين المحلية والكونية وهو ما لاحظته أوكين في كتابات غيلغن التي عابت عليها كونها لم تتطرق إلى مسألة "كيف تتصرف النساء في مواجهة مآزق أخلاقية تتعلق بنزاع بين حاجات أفراد من العائلة نفسها ومصالحهم أو أصدقاء حميمين وحاجات أناس غرباء عنهم ومصالحهم" (أوكين 1990: 158)، وهو ما يجعل من هذه المآزق عصية على الحل داخل إطار وجهة أخلاق الرعاية.
ثانياً: احترام الإنسانية أم احترام الأفراد؟ إذ ينتقد بعض منظري الرعاية نظرية العدالة في بعدها الأخلاقي لأنها لا تهتم بالآخر الجنيس، والآخر العيني. تعتبر سيلا بنحبيب أنّ الآخر الجنيس هو تمثل الفرد ككائن عاقل له الحقوق نفسها وعليه الواجبات نفسها، وهو ما يؤدي إلى التّغاضي عن فردية الآخر وهويته العينية، واعتبار أنّ أساس الكرامة متأتٍ ليس من التمايز وإنما من التشابه. أمّا الآخر العيني فهي ترى أنها تفترض تمثّل كل كائن عاقل كفرد متعيّن يحمل معه تاريخاً وهويّة واستعدادات وجدانية وانفعالية خاصة به، وهي بالتالي تسقط المشترك الإنساني. وهو ما يعني أنّ نظرية العدالة الأخلاقية تحجب الاختلاف وتركز على التماثل والتشابه على الكليّة والعمومية وتسقط العنصر العيني المميز للفرد.
وفي تعليق كالميشكا على هذا التمييز الذي تقيمه سيلا بنحبيب بين "الآخر الجنيس" و"الآخر العيني" أنها محقة، لكن لا ينفي عنها ما تتصوره من كونهما وجهتين مكونتين لما تسميه "كونية الإحلال" و"كونية التفاعل". وإنما الاختلاف يظهر من حيث أنّ الرعاية على خلاف العدالة تلائم اختلافاتنا العينية أكثر من إنسانيتنا المجرّدة. كما اعتبر أنّ هذه الاختلافات أخذت أبعاداً مبالغاً فيها، من حيث أنّ أخلاق الرعاية تستدعي عندما يقع كوننتها تلك الصفة الإنسانية المشتركة من جهة، ومن جهة أخرى لأنّ نظريات العدالة لا تقف عند حدود احترام الآخر الجنيس، وهو ما يتجلى حسب كاميلشكا في نظرية المنفعة مثلاً التي ينبغي أن تأخذ في الحسبان تمايز الأفراد لتستطيع معرفة ما هي السياسة التي بإمكانها أن ترضي التفضيلات الفردية المختلفة، وإن لم يبدُ الأمر بالوضوح نفسه في نظرية رولز عن العدالة.
ثالثاً: القبول بالمسؤولية والمطالبة بالحقوق: يعتبر كاميلشكا أنّ كلاً من أخلاق الرعاية وأخلاق العدالة كونيّان، وأنهما يحترمان فرديتنا مثلما يحترمان صفتنا الإنسانية المشتركة، وإن وجد اختلاف بينهما فإنّه يظهر في التدقيق الذي أدخلته غليغن حين اعتبرت أنّ أخلاق العدالة تعامل الآخر من خلال مقتضى احترام الحقوق، في حين أنّ أخلاق الرعاية تعامل الآخر من خلال مقتضى تحمل المسؤولية. فتحمل المسؤولية تجاه الآخر معناه أخذ موقف إيجابي يعبر عن انشغالنا برفاهيته. في حين أنّ الحقوق هي آليات لتوفير الحماية الذاتية يمكن أن تحترم في الوقت الذي يترك فيه الآخر لمصيره بمفرده، فهو يعبر عن شكل من الفردية والأنانية.
لكنّ كالميشكا ينتقد هذا التصنيف الذي يقول عنه: "قد ينطبق على النظرية الليبرتارينية في الحقوق، أمّا كل النظريات الأخرى في العدالة التي فحصتها إلى حد الآن فهي تعترف بوجود واجبات بالمعنى الإيجابي نحو رفاهة الآخرين"، [17] وهو ما يعني أنّه حتى إن شددت مبادئ العدالة على الحقوق الفردية فهي في الوقت نفسه تفرض علينا واجبات تجاه الآخرين، وهو ما يعني أنّ مبادئ العدالة تقوم هي أيضاً على ثنائية الحقوق والواجبات.
لهذا حسب كاميلشكا فإنّ الجدل الدائر بين العدالة والرعاية ليس جدلاً بين نظرية في الحقوق وأخرى في المسؤولية؛ لأنّ المسؤولية موجودة في لبّ أخلاق العدالة. لأنّ لأقراني مسؤوليات تجاهي تكون واجباتهم الأخلاقية نحوي تقف عند مقتضيات العدالة، وقسط من مسؤولياتي تجاههم يتمثل في تحمل مسؤولية تطلعاتي وتكاليف ما ينجرّ عنها، فالقول إنّه يتولد عن المعاناة الشخصية واجب أخلاقي حسب كاميلشكا ليس أمراً خاطئاً فقط بل قد يوظّف للتّستر على بعض ظروف الحيف والقهر، ومثال ذلك اعتقاد الرجل أنّ من واجب المرأة خدمته، ولذلك يشعر بالألم كلما ألزم بتقاسم إكراهات العمل المنزلي، ويفهم وضعه كفقد للرعاية. ففي الوقت الذي يراقب فيها من يمارس الاضطهاد على غيره تقلص امتيازاته فإنّ المتلقي لفعل الاضطهاد يكيف احتياجاته ورغباته بطريقة يقلع فيها عن الرغبة في الحصول على ما يرغب في الحصول عليه.
يعتبر كاميلشكا أنّه إذا كانت أخلاق الرعاية النسوية التقليدية تشجع النساء على التضحية بذواتهن وتفرض عليهن مسؤولية لا حدود لها في تقديم الرعاية في مقابل تمتعهن بسيطرة محدودة على الظروف التي يقدمن فيها الرعاية، فإنّ أخلاق الرعاية النسوية الجديدة تتقاسم القدرة على تحديد الظروف الاجتماعية التي تقدم فيها الرعاية.
صحيح أنّ منظري العدالة حسب كاميلشكا قد شيدوا صروحاً مذهلة من خلال إعادة حبك المفاهيم التقليدية حول الإنصاف والمسؤولية، ولكن بإهمالهم المشاكل الأساسية التي تطرحها مسؤولية رعاية الأطفال ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تظلّ هذه المنجزات الفكرية قائمة على مقدمات متهافتة، إذ لا بدّ لكل نظرية في المساواة بين الجنسين أن تجابه هذه المشاكل والتصورات التقليدية للحياة الخاصة، وما تحتويه من تفرقة جنسية تعمل على إخفائها بدل معالجتها وبدل إعادة التوزيع للعمل المنزلي فحسب، لا بدّ من إعادة صياغة التمييز بين العام والمنزلي مثل إدماج أدوار الأمومة داخل الفضاء العام بدل جعلها وظيفة منزلية خاصّة بالمرأة.
المصادر والمراجع
- مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 17
ـ سوزان جيمس، موسوعة كمبريدج للتاريخ، الفكر السياسي في القرن العشرين، المجلد الثاني، تحرير تيرنس بول، ترجمة مي مقلد المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2010، ص 233
- مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 465
ـ سوزان جيمس، موسوعة كمبريدج للتاريخ، الفكر السياسي في القرن العشرين المجلد الثاني، تحرير تيرنس بول ترجمة مي مقلد المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2010، ص 246- 247
ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010
[1]- تم الاقتصار فقط على قراءة الفصل التاسع المعنون بـ"النسوية" من كتاب "مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة".
[2] ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 17
[3] ـ سوزان جيمس، موسوعة كمبريدج للتاريخ، الفكر السياسي في القرن العشرين، المجلد الثاني، تحرير تيرنس بول، ترجمة مي مقلد، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2010، ص 233
[4] ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 465
[5] ـ سوزان جيمس، موسوعة كمبريدج للتاريخ، الفكر السياسي في القرن العشرين المجلد الثاني، تحرير تيرنس بول ترجمة مي مقلد المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2010، ص ص 246- 247
[6] ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 466
[7] ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 468
[8] ـ المصدر نفسه، ص 469
[9] ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 472
[10] ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 473
[11] 11ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 474
[12] 12ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 474
[13] ـ مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة: الفصل التاسع، ترجمة منير الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2010، الطبعة الأولى، ص 475
[14]ـ المصدر نفسه، ص 478
[15]ـ المصدر نفسه، ص 478
[16]ـ المصدر نفسه، ص 495
[16] ـ المصدر نفسه، ص 507






