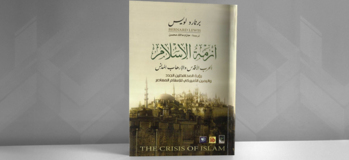"معضلات العدالة الانتقالية في التحوّل من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية"
فئة : قراءات في كتب

قراءة في كتاب: "معضلات العدالة الانتقالية في التحوّل من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية"
الكتاب: معضلات العدالة الانتقالية في التحوّل من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية[1]
الكاتب: نويل كالهون. ترجمة ضفاف شربا.
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، بيروت 2014
عدد الصفحات: 304 ص.
إذا كانت قضيّة العدالة قد طرحت في الخطاب المطلبي لحركات الاستقلال الوطني، ثم في خطاب الأنظمة والمعارضة على حدّ سواء طيلة النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحالي، فإنّها لم تعرف التباسا وغموضا مثلما تعرفه اليوم في بلدان ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" إلى الحدّ الذي يتبادر فيه إلى الذهن أنّ الجدل يدور حول قضية "هلامية" و"ميتافيزيقية" يصعب تقنينها أو الحسم فيها. ولعلّ من الأسباب الكامنة خلف ذلك "التوتّر" ضآلة التنظير الفلسفي لمفهوم العدالة وقلّة الاطلاع المعمّق على تجارب الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية بالبلدان التي مرّت بتجارب مشابهة للأوضاع الحالية بالبلدان العربية وتداعيات ثقافة التقليد والاستبداد...
يعد كتاب الباحثة الأمريكية نويل كالهون Noel Calhoun في هذا المضمار من المراجع المهمّة التي يمكنها أن توجهنا إلى أقوم مسالك العدالة الانتقالية وتكريس الديمقراطية لما يتضمّنه من بحث دقيق وإلمام عميق ببعض التجارب الدولية في هذا المجال. يتألف الكتاب من خمسة فصول أساسية تجمعها عناصر متعدّدة منها الفكرة العامة: فكرة العدالة الانتقالية ومعضلاتها، ووحدة المنهج الوصفي والمقارن المستند إلى تحليل المضمون والإحصاء. ويمكن اعتبار الخاتمة فصلاً سادساً، لأنّ المؤلفة لم تكتف فيها بالتأليف والاستنتاج، وإنّما طرحت رؤيتها النقدية في حدود الديمقراطية الليبرالية، ممّا يفتح آفاقا رحبة للتفكير والتدبير في هذه المسألة بما يناسب المجال التداولي والظرفية التاريخية لكلّ حالة على حدّة. يتعلّق الفصل الأوّل بـ"سياسة العدالة الانتقالية". بينما يهتم الفصل الثاني بـ"العقيدة الديمقراطية الليبرالية والعدالة الانتقالية". أمّا الفصل الثالث، فمخصّص للتجربة الألمانية بعنوان صيغته أدبية نصّه "ألمانيا تتصالح مع ماضيها مرّة أخرى". وارتبط الفصل الرابع الموسوم بـ"بولندا تفتّش طويلا عن العدالة" بالتجربة البولندية. أمّا الفصل الخامس، المخصّص للنظر في التجربة الروسية فعنوانه "ماضي روسيا الدفين". وقد ذُيّل الكتاب بملحق مهم موضوعه محاكمة المسؤولين الشيوعيين السابقين البولنديين، وتمّ فيه إنجاز مسح شامل للمحاكمات وأحكامها، ممّا يتيح للقارئ تقييم نجاح الباحثة في استخلاص استنتاجات صحيحة في دراستها للتجربة البولندية خاصة.
لئن كنّا لا نستطيع الإتيان على جميع القضايا المهمة التي طرحها هذا الكتاب الذي يستمد أهمّيته من طبيعة موضوعه ومتانة بنائه لغةً وأفكارا وتوثيقا ومنهجا، فإنّه يمكننا الإشارة إلى أهمّها في صياغة تأليفية تفيد القارئ ولا تثقل كاهله. وفي ما يلي أهمّ تلك القضايا.
• في معنى العدالة الانتقالية: لم يكن بحث الكاتب في معنى العدالة الانتقالية من منطلق نظري أو فلسفي غايته ضبط حدودها وتأصيل معناها، وإنّما كان منطلقه بحثا عمليّا عن أنسب السبل الضامنة لإرساء نظام ديمقراطي عادل على أنقاض نظام استبدادي شمولي. وقد اختزلت الباحثة هذه القضية في التساؤل التالي "ما الذي يعقب حقبة شهدت تورّط الدولة بارتكاب الجريمة وحمايتها من العقاب؟ هل يجب على النظام الجديد الأخذ بالثأر، عبر إعدام زعماء النظام السابق دون محاكمة أو تنظيم محاكمات علنية؟ أم أنّ من الأنسب غضّ الطرف عن الماضي برمته مادام الانتقام قد يحرّض على ردّ فعل عنيف أو يجرّ البلاد إلى هاوية الفوضى؟ أما من سبيل للوصول إلى حلّ وسط بين هذين النقيضين المكروهين؟".[2]
يعتبر ذلك السؤال الإشكالية الأساسية التي انبنت عليها مختلف مفاصل كتاب "معضلات العدالة الانتقالية". فعمليات الوصف والتحليل والتقييم لمختلف تجارب الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية ببعض دول العالم (ألمانيا، بولندا، روسيا، إسبانيا، جنوب إفريقيا)، لم تكن سوى تفريعاً وتجزئة وتفكيكاً وتركيباً لتلك الإشكالية المطروحة.
لعلّ الملاحظة البارزة في هذا السياق، أنّ حديث الباحثة عن العدالة الانتقالية لا يخلو من ارتباك واضح، سواء عند عرض مختلف مستويات العدالة وأنواعها أو عند ضرورة الحسم النهائي في المصطلح الواجب اعتماده لهذا الغرض. يتجلّى ذلك الارتباك في أنّ الباحثة تتحدّث عن مستويات مختلفة للعدالة مثل "العدالة الجزئية"[3] و"العدالة السياسية"[4] و"العدالة الترميمية"[5] و"العدالة الإجرائية"[6] و"العدالة الجنائية"[7]. كما تلمّح إلى أنواع أخرى من العدالة، مثل "العدالة التوزيعية" التي يتمّ فيها توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل على ضحايا مرحلة الاستبداد. لكن من المهمّ التنبيه إلى أنّ ذلك الارتباك لا يعني غياب الرؤية العلمية الموضوعية لدى الباحثة وإنّما حرصها على ترك كلّ الخيارات متاحة لدى قارئها سواء أكان مختصّا أو غير مختص للمقارنة المجدية بين مختلف الأشكال. وبالتالي مشاركة الباحثة في عملية التقييم ليس لبحثها ونتائجه فقط، وإنّما للتجارب الانتقالية التي اهتمت بها سواء أكان الأمر مجرّد فضول معرفي (الاستزادة في العلم) أو لغاية الاستفادة المباشرة من تلك التجارب بالنسبة إلى البلدان التي تمرّ أو قد تمرّ بتلك المراحل السياسية والحضارية.
لقد ألمعت الكاتبة إلى أنّ مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم "زئبقي" يستعصي على الضبط والتقنين بسبب ارتباطه بمنعطفات تاريخية حاسمة تشهد غالبا زخما في الأحداث المتسارعة وتحوّل في المصطلحات ودلالات المفاهيم والتشريعات والمواقف، بل بروز أشكال جديدة في التصوّر والطرح والفعل مثل آليات العمل السياسي الديمقراطي التي تشترط احترام حقوق الإنسان دون تمييز و"العقد الاجتماعي" ومبدأ الحرية للجميع...
لا يكتسي الحديث عن العدالة الانتقالية معناه إلاّ في ضوء الاحتكام إلى عقيدة سياسية معيّنة. تكون بمثابة الإطار المرجعي للعملية الانتقالية كلّها سياسيًّا وقانونيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وقبل ذلك أخلاقيًّا. بيد أنّ هذا لا يعني أنّ العقيدة السياسية مجرّد ايديولوجيا تُرفع هنا وهناك وفق توازنات معيّنة، وإنّما هي تجارب متراكمة ثبتت فعاليتها ونجاعتها. [8]
لعلّ هذا من الأسباب التي جعلت الباحثة تشدّد على التمييز بين أمرين غالبا ما يقترنان في ذهن الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وهما التسوية بين عملية الظفر بالسلطة وإحلال العدالة، إذ يعنّ بخلد الطبقة السياسية المستلمة لزمام الحكم أنّ مجرّد اعتلائها لسدّة الحكم يعتبر نصرًا كبيرًا للعدالة، بل هو العدالة عينها. وفي الحقيقة يعتبر هذا الاعتقاد الساذج المخادع من أفدح الأخطاء التي قد تتسبّب في نكسة كبرى للعملية الانتقالية برمتها، لأنّه وكما تقول نويل كالهون: "يبقى الظفر بالمعركة على السلطة أيسر بكثير من إقامة العدل بعدها بالنسبة إلى النظام الجديد".[9] فسياسات العدالة الانتقالية تظلّ منفتحة على ثلاثة احتمالات متباينة متمثّلة في العنف والنسيان وسياسات الحق والعدل[10]، وهو ما تعانيه اليوم بلدان ما يسمّى بالربيع العربي التي تشهد تراجعاً بيّنا في مساراتها الثورية، بل إنّ بعض تلك الدول قد دخل في دوامة استنزاف الجهود المنبّئة بالاستغراق في دوامة الإفلاس والعنف التي لا قرار لها. ولئن كان الأمر يرجع إلى مجموعة أسباب متشابكة فإنّ السبب الجوهري متعلّق بتذبذب خيارات من وصلوا إلى السلطة بطريقة انتخابية شرعية بعد سقوط "رؤوس" الأنظمة السياسية السابقة، إذ لم يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية وشروطها. فبدل الانخراط في تفعيل الاستحقاقات الثورية وفق رؤية استراتيجية متكاملة تمت عملية إحياء شعارات "هلامية" لا قيمة لها سوى الترويج الإعلامي والسلوان العاطفي، وهو ما وفّر أرضية ملائمة لقوى عديدة داخلية وخارجية لا مصلحة لها في نجاح المسارات الثورية العربية.
لا يفوت الباحثة كالهون اتخاذ موقف صريح وحاسم بخصوص آليات العدالة الانتقالية، إذ ألحّت على أنّ الاحتكام إلى العنف أمر مرفوض تماما لتنافيه مع مواثيق حقوق الإنسان ومع مبادئ الحرية والعدالة والكرامة التي ثارت لأجلها الشعوب المتعطّشة للانعتاق والتحرّر. كما أنّ الانتقام لن يؤدّي إلاّ إلى الوقوع في سلسلة لا تنتهي من دوائر التشفي والكراهية. أمّا ادعاء "النسيان"، فهو هروب أو تهرّب من معالجة القضايا. ولذا، فهو ليس سوى تأجيل مؤقّت لها قد يؤثّر بأكثر حدّة في المستقبل فيزداد الأمر تعقيدا والتباسا، "فمن ينسى ماضيه يحكم عليه بتكراره"[11]. لذا فقد ركّزت كالهون على التذكير بـ"سياسات الحق والعدالة" المتّبعة في عدد من النماذج الناجحة التي يمكن النسج على منوالها. ومن بين تلك السياسات: المحاكمات والمصارحة وإعادة تأهيل الضحايا والتعويض المادي والمعنوي والتطهير وفق ضوابط القانون والعدالة[12]...
• العدالة والعقيدة والسياسة والخطاب: تعتبر هذه النقطة امتدادًا منطقيًّا وموضوعيًّا للنقطة السابقة بما أنّ مفهوم العدالة[13] متعدّد الأبعاد إلى حدّ أنّه يرتبط جدليًّا بالمجال السياسي والخطاب الذي أسهمت في صياغته عناصر الوعي والمخيال معا. وفي هذا الصدد تنقل الباحثة تعريفًا مهمًّا للعقيدة متبايناً عن التصوّر التبسيطي السائد في ثقافتنا العربية الذي يجعلها مقترنةً اقترانًا غريبًا بالدين لآن سويدلر Anu Suidler يقول فيه: "العقيدة منظومة معان واضحة المعالم، جزلة الصياغة، فائقة التنظيم"[14]. وتضيف شارحة هذا التعريف قائلة: "...وتعود كلّ ثقافة موئلا لعدد محدود من العقائد في حقبة زمنية معينة، بالرغم من أنّ ظهور العقائد في المشهد السياسي وأثرها فيه قد يكون فجائياً، إلاّ أنّها تتبلور تدريجيا بمرور الزمن، إذ تنتج عن عدد هائل من العقائد الفكرية التي سبقتها، ثم تنمو في سياق مؤسّساتي محدّد. ولا يمكن للفرد - وإن كان من الساسة المحنكين- أن يبدع عقيدة جديدة كلّ الجدّة، بل عليه أن يجمع ثقافات عقائدية متناثرة هنا وهناك وينسجها معا في نموذج بديع متناسق".[15]
يبدو أنّ هذا التصوّر للعقيدة الذي يجعلها عبارة عن بنية متناسقة من مجموعة عناصر متباينة يتجاوز تصوّر محمد عابد الجابري على سبيل الذكر الذي صاغه في كتابه العقل السياسي العربي، واعتبر فيه العقيدة سمة من سمات العقل السياسي العربي إضافة إلى سمتي القبيلة والغنيمة. بهذا المعنى العقيدة عنصر ملازم لكلّ فعل سياسي واجتماعي، وهي ليست من خصائص الشخصية القاعدية لمجموعة إثنية معيّنة. ومن هناك، فإنّ تأثيرها بيّن في عمليتي التمثّل والتفعيل سواء للعدالة أو للسياسة أو في النظر للعالم والوجود بأسره.
يعتبر تفصيل نويل كالهون لوظيفة العقيدة وأثرها في الخطاب السياسي الذي يدّعي نشدان العدالة من أهم صفحات الكتاب، على الرغم من أنّها كانت ناقلة للأفكار والمواقف أكثر من كونها مبدعة لها. فلا شكّ أنّ هذه العملية ليست سهلة بالمرّة وبمقدور أيّ كان باعتبارها تحتاج إلى مثابرة ومكابدة وقدرة على الانتقاء بعد حسن التقييم والتمحيص. ويتلخّص موقفها في هذا المضمار في إقرارها بأنّ العقيدة لا تعدو أن تكون سوى آلية للتعتيم على أهداف غير معلنة يتستّر عليها السياسي، فيعمد إلى التضليل مسايرة للظرفية التاريخية والاجتماعية أو رغبة منه في الاستقواء بجهات داخلية وخارجية تعدّ الراعي الأساسي لعقيدة معيّنة وتستثمر رأسمالها الرمزي.[16] لكن تبقى أهمّ وظيفة وأخطرها على الإطلاق، دورها في صياغة خطاب سياسي متماسك أو هكذا تعمل البروبغندا Propaganda على إظهاره. وتستند الباحثة في موقفها إلى رأي آن سويدلر، فتصرّح بأنّ "العقيدة تضفي على الخطاب السياسي بنية متماسكة، وكما جاء على لسان سويدلر تعدّ العقيدة بمثابة 'صندوق الأدوات' الذي تستخدمه ثقافة معيّنة لمناقشة قضايا السياسة، في ما يشير الخطاب السياسي إلى استراتيجيات العمل؛ أي كيف يستخدم السياسيون 'صندوق أدواتهم' على أرض الواقع في المجال السياسي. فالعقيدة تصنّف الأفكار في مجموعات وترسم حدود التضامن وتوضّح نطاق المشكلات وتثبت أدوار العديد من الفرقاء السياسيين"[17].
تقدّم نويل كالهون مثالا على تأثير العقيدة في الخطاب السياسي للعدالة والديمقراطية، فتشير إلى أنّ العقيدة الديمقراطية الليبرالية توفّر خمسة أدوات تعدّ عصارة الثقافة الغربية برافديها التنويري والحداثي. من بين تلك الأدوات "العقد الاجتماعي"، و"سيادة القانون"، و"المصارحة" بما هي حريّة الفكر والتعبير، وضمان "مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية" بما فيهم المسؤولين السابقين، و"التعبير عن الرغبة في العيش المشترك تحت سقف نظام ديمقراطي ليبرالي، لأنّه يبشّر بإقامة العدل".[18] لكنّها تنبّه إلى أنّ ذلك لا يعني ضرورةً أنّ تلك العقيدة الليبرالية تتضمّن وصفات جاهزة لكلّ الحالات الانتقالية، وإنّما ينبغي تكييفها أو على الأصحّ التكيّف معها بما يتوافق وخصوصية كلّ حالة انتقالية على حدة.
ليس مبالغة إذا أقررنا أنّ فكرة العدالة تستحوذ في السياقات الانتقالية على النصيب الغالب في الخطاب السياسي لمختلف التشكيلات السياسية إلى حدّ يمكن اعتبارها بمثابة العنصر المهيمن على بقية العناصر المشكّلة له. وبذلك، فإنّ العلاقة وثيقة بين الخطاب والعقيدة والسياسة والعدالة. وبعيداً عن جميع التنميطات أو التصنيفات بمقدور المقاربات الأنثربولوجية والسوسيولوجية والتاريخية والحضارية بصفة عامة أن توسّع أفق النظر بخصوص ملف العدالة الانتقالية بدل حصرها الضيّق في التناول القانوني والقضائي.
• نماذج من تجارب الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية: استحوذ تحليل بعض نماذج الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية على نصيب غالب من كتاب كالهون. يأتي ذلك في سياق الانتصار للعقيدة الديمقراطية الليبرالية والدعاية لها. لكن ليس بطريقة سياسوية أو إعلامية، وإنّما في إطار ضوابط البحوث الأكاديمية وصرامتها المنهجية لدرجة يُخيّل فيها للقارئ أنّ الباحثة بصدد الدفاع عن أطروحة يتمّ فيها التدرّج من العام إلى الخاص فالأخصّ. لذلك يمكن اعتبار تركيز الباحثة على نماذج دون أخرى تحليلاً وتفصيلاً كان مندرجا ضمن تلك الخطّة الرامية إلى "دمقرطة" بقيّة أجزاء العالم والترويج للنظام الليبرالي الذي اعتقد فرانسيس فوكو ياما Francis Fukuyama أنّه نهاية التاريخ[19]. ومهما كان الأمر، فإنّ الاطّلاع على نماذج انتقالية من شأنه أن يُغني التجارب ويُراكمها ممّا يوفّر إمكانية استفادة أكبر والارتقاء بمستوى العمليات الانتقالية الديمقراطية الجارية أو القادمة.
تُعتبر التجربة الألمانية الديمقراطية (الشرقية سابقا) من أكثر الأمثلة التي استرعت انتباه الباحثة فركّزت عليها. وتشير كالهون إلى أنّ هذه التجربة أثبتت مرّة أخرى قدرة الإنسان الألماني على التحدّي ولملمة جراحه، ففي ظرف سنة واحدة من سقوط جدار برلين سنة 1989 تمّ انتخاب مجلس نواب ألماني شرقي في انتخابات نزيهة، ثم تنازل ذلك المجلس عن سلطاته لفائدة تكوين مجلس فيدرالي اتحادي يضم كذلك نواب ألمانيا الغربية. فتمّ في فترة قياسية الانتقال من الحكم الشيوعي إلى حكم ديمقراطي في إطار الوحدة مع الشقيقة الغربية[20]. وإذا كانت الباحثة ذكّرت بحيثيات الانتقال الديمقراطي،[21] فإنّها ركّزت على معضلات العدالة الانتقالية من خلال الإشارة مرّات متتاليةً إلى الصعوبات التي اعترضت مسيرة الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية، وهي ليست صعوبات مقتصرة على العوامل الخارجية أو ممن يُفترض أنّهم يشكّلون خطرًا على الديمقراطية الناشئة، وإنّما كذلك من الضحايا السابقين الذين وصلت منهم نخبة سياسية إلى سدّة الحكم أو إلى أنّ ثمن العدالة غالبا ما يكون باهظا سواء من الناحية المادية أو النفسية إلى الحدّ الذي يهدّد بانخرام الموازنات العامة للدولة أحياناً. وفي الحالة الألمانية قدّمت نويل كالهون الأرقام التالية:
- طالب تسعمائة وخمسون ألف (950) مواطن بالاطّلاع على ملفاتهم. –أظهر 95% من الذين قرأوا ملفاتهم اقتناعهم بصواب ما فعلوا. –عبّر 27% فقط من هؤلاء عن كراهية تجاه الذين تجسّسوا عليهم. –عمل في الهيئة المكلفة بمعالجة ملفات الماضي والعدالة الانتقالية ثلاثة آلاف (3000) موظّف. – قدّر متوسّط ميزانيتها السنوية بين عامي 1993 و1995 بمعدّل مائتين وستة وخمسين (256) مليون فرنك في فترة شهدت تزايد الضغط على الموازنة الفيدرالية[22].
لئن لم تفض سياسات الحق والعدالة بألمانيا الديمقراطية إلى تكريس تصوّر مثالي للعدالة الانتقالية، فإنّها أنتجت نموذجاً يمكن الاستئناس به، باعتباره جنّب البلاد مخاطر العنف والانتقام الذي توقّعه بعض المراقبين، بل إنّها شجّعت على تكريس نسبي للعدالة الانتقالية، على الرغم من ضعف تأثير الأحزاب والمنظّمات الشرقية وتراخي المجلس الفيدرالي والحكومة الممثّلة له بقيادة كول Helmut Kohl. يتجلّى ذلك النجاح في القيام بمحاكمات لبعض الزعماء السابقين في مقدّمتهم ايريش هونيكر Erich Honecher الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم سابقا وكذلك إيريش ميلكه Erich Milke الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية (شتازي) وعديد الحراس الذين أطلقوا النار على كلّ من حاول عبور جدار برلين[23]. ولئن كانت تلك الأحكام مخفّفة، فإنّ فائدتها الرمزية مضمونة باعتبار أنّها أكّدت أنّه لا أحد مهما تجبّر يمكنه الانفلات من العدالة. كما تمّت بعض عمليات التطهير النوعية المنظمة في إطار القانون في بعض الأسلاك مثل الأمن والاتصالات والتعليم[24]. إلى جانب عملية إعادة تأهيل خمسة وأربعين ألف شخص من الضحايا المفترضين وإقرار تعويضات مالية مقدّرة بثلاثمائة مارك ألماني عن كلّ شهر قضاه الضحيّة في السجن مع زيادة مائة وخمسين ماركا لكلّ من بقي في ألمانيا الديمقراطية إلى تاريخ سقوط جدار برلين.[25]
أمّا بالنسبة إلى التجربة البولندية،[26] فهي أيضا تتميّز ببعض المميّزات الفريدة من أهمّها طول مدّة ترسيخ العدالة الانتقالية التي استغرقت زهاء عشر سنوات بداية من سنة 1989[27]، واعتماد استراتيجية التدرّج سواء في عملية ترسيخ العدالة الانتقالية أو في عملية انتقال السلطة خشية الانزلاق في متاهات الفوضى والعنف، وتبنّي سياسات التساهل مع أعوان النظام القديم ونسيان الماضي وبشكل مبدئي وعلني صادر من أعلى مستوى سياسي. فقد أعلن ماروفيتسكي T.Mazowiecki، وهو أحد قادة حركة "تضامن" التي تعدّ أكبر فصيل سياسي بولندي وأحد المحاورين السابقين للنظام الشيوعي في أوت 1989 ما بات يعرف بسياسة "الخطّ العريض" التي تعني تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد لتعبئة جميع الجهود في كسب الرهان الاقتصادي وضمان علوية سيادة القانون.[28]
إذا كان مجلس السيم (الشيوخ) البولندي قد اقترح منذ شهر ديسمبر 1989 سنّ تشريع يقضي بإعادة تأهيل الأشخاص الذين أدينوا بجرائم سياسية في الحقبة الشيوعية وتطهير بعض أجهزة الدولة الحيوية، مثل جهازي القضاء والأمن تزامنا مع موجة الانتقال الديمقراطي بأوروبا الشرقية ودول حلف وارسو[29]، فإنّ الجهود الفعلية في هذا الملف لم تنطلق إلاّ في سنة 1992 إثر وصول الشيوعيين السابقين لسدّة الحكم عن طريق الانتخابات في شكل أحزاب يسارية وليبرالية بعد إتقانهم للأساليب الديمقراطية الليبرالية وتحالفهم حتّى مع الليبراليين في معسكر "تضامن". وهو التحالف الذي وقف حائلا دون الشروع المبكر في عملية التطهير. وقد كانت أوّل عملية تطهير بمبادرة من حكومة يان أول شفسكي Olszouski سنة 1992.[30]
لقد ألهم الالتزام الصارم الذي أبدته الفصائل السياسية البولندية بمنظومة العقيدة الديمقراطية الليبرالية المحتكمة إلى ضمان سيادة القانون واجتناب العنف ونزوات الانتقام والقصاص من حكّام الأيام الخوالي البولنديين إطلاق تسمية "ثورة التقييد الذاتي"[31] على ثورتهم. وقد كان موقف الباحثة الأمريكية نويل كالهون التي عكفت على دراسة مسيرة العدالة الانتقالية البولندية متّفقا مع انطباع البولنديين المذكور آنفا، بل إنّها ذهبت إلى حدّ وجود شكل من أشكال الاتفاق المريب بين الفاعلين السياسيين البارزين على وأد العدالة الانتقالية كأنّهم يعتبرونها خرقًا للمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي الوليد التي يجب أن تشمل بعنايتها الجميع ضحايا وجلاّدين.[32]
بيد أنّ ذلك لا يعني انعدام تطبيق سياسات الحق والعدالة في نطاق محدّد، إذ لوحظ تطبيق سياسات التطهير على قطاع الادعاء العام فتمّ فصل ثلاثمائة وأحد عشر (311) من بين ثمان وسبعين ومائتين وثلاثة آلاف مدّع عام بولندي[33]. وقد شمل التطهير وزارة الدولة للشؤون الداخلية وبعض الأجهزة الأخرى خاصة بعد أن صدر قانون في عام 1997 عن الهيئة التشريعية يقضي بتطهير الوظائف الحسّاسة من المسؤولين الشيوعيين السابقين[34]. كما تمّ في عام 1999 بإيعاز من حركة تضامن سنّ تشريع من قبل مجلس الشيوخ يبيح فتح ملفات جهاز الأمن أمام الضحايا السابقين لتدارك الأداء الباهت للجنة بوكينا التي كلفت بالكشف عن الحقيقة[35]. إضافة إلى إقرار تعويضات مالية وإعادة تأهيل الضحايا بعد تجاوز صعوبات جمّة في الوصول إلى تعويض متّفق عليه للضحايا الجديرين بالتعويض والتأهيل"[36].
إذا كان قد تمّ تخصيص فصل كامل للتجربة الروسية على أساس كونها تعكس بوضوح تام مفارقة الواجب والحاصل[37]، فإنّنا نعتقد أنّه كان من الأفضل الاستعاضة عنها بالتجربة الإسبانية خاصة أنّ الباحثة أشارت إشارة خاطفة إلى مسألة هامة تبدو متناقضة تماما مع فكرة الديمقراطية، تتعلّق تلك المسألة بإمكانية قيام ديمقراطية دون الحاجة إلى عدالة انتقالية بناءً على ما خلصت إليه في قراءتها للتجربة المذكورة آنفا[38]. فقد كان من المهمّ جدا بالنسبة إلى القارئ أن يطّلع على كيفية إرساء نظام ديمقراطي دون مرور بالعدالة الانتقالية لا سيما أنّ الباحثة ما فتئت تؤكّد في أجزاء متعدّدة من بحثها ضرورةَ الاستفادة من الماضي ومخاطر التهرّب من معالجته. بيد أنّ كالهون استدركت الأمر نسبيًّا بإشارتها إلى أنّ إسبانيا أنجزت سياسات الحق والعدالة في شكل إصلاحات مؤسّساتية جوهرية بتمهّل وعلى "نار هادئة" بعد وفاة الجنرال فرانكو دون إثارة القوى الفاعلة في عهده خاصة المؤسّسة العسكرية.[39]
• حدود التطلّع إلى عدالة ديمقراطية: إذا كانت مؤلّفة الكتاب قد أثبتت قدرة بيّنة على الإلمام ببعض التجارب الانتقالية في مجالي تأسيس نظام ديمقراطي وتكريس عدالة انتقالية، فإنّها لم تثبت إمكانية قيام عدالة تامة. ففي جميع التجارب التي تناولتها برزت عديد النقائص سواء في مستوى التصوّر أو في مستوى التطبيق، ممّا جعل تمتيع الضحايا بحقوقهم كاملةً مسألةً غير واردة حتّى لا تقول مستحيلة في ظلّ تراخي الأحزاب الكبرى ومجلس النواب والحكومة الفيدرالية في الحالة الألمانية، وهو ما عمّق فيهم الشعور بالحرمان والقهر إلى حدّ أنّ فيهم من اعتبر الشقيقة الألمانية الغربية بحكومتها الفيدرالية قوّة احتلال جديدةً، وما ذلك إلاّ لأنّهم لم يعرفوا معنى الظلم والحرمان الذي عاناه مواطنوهم الشرقيون طيلة أربعين عامًا. وفي بولندا أطلق الضحايا على ثورتهم تسمية ثورة "التقييد الذاتي" لاستغراق زعماء المرحلة الانتقالية في التقيّد بالقوانين واللوائح ممّا ضيّع الكثير من الوقت ظنّا منهم أنّ النسيان كفيلٌ برتق جروح الماضي. ولكن حتّى بعد عقدين من الزمن (1989- 1990) لم تتحقّق عدالة تامة. أمّا في روسيا فلم يتخلّص المواطنون ولا الناشطون السياسيون والمدنيون من سطوة الأجهزة الأمنية وغطرستها إلى يومنا هذا. هل يعني كلّ ذلك أنّه تُوجد دائما فوارق بين التصوّر والمثال أم أنّ خللاً ما في العقيدة الليبرالية المؤطّرة لتلك العدالة الانتقالية أم هو مجرّد قصور في الآليات الموظفة وفي محدودية الاستلهام؟
تحتاج كلّ هذه الفرضيات إلى جهد تحليلي مفصّل للحسم فيها. وهو أمر لا يندرج ضمن رهاننا في هذه المراجعة الموجزة. لكن ما ينبغي التذكير به أنّ الباحثة نفسها أشارت في أكثر من موضع إلى أنّ العقيدة الديمقراطية الليبرالية لا تتضمّن أجوبةً وحلولاً جاهزةً لجميع الحالات، وإنّما هي تصوّر نسبي دوره لا يتعدّى الاستئناس والمساعدة، إذ لكلّ حالة انتقالية خصوصيتها المستمدّة من مجالها التداولي الخاص والظرفية التاريخية الدائرة في فلكها. وهو أمر هام يجب أن لا يعزب عن ذهن المفكّرين والمشتغلين بملف العدالة الانتقالية بالبلدان العربية المسماة بـ"دول الربيع العربي".
[1]- العنوان الأصلي باللغة الإنجليزية Noel Calhoun: Dilemmas of Justice in Eastern Europe’s Democratic Transitions 2004
[2]- نويل كالهون: معضلات العدالة الانتقالية في التحوّل من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية، ترجمة ضفاف شربا، ط1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2014، ص 14
[3]- م ن، ص 85
[4]- م ن، ص ن.
[5]- م ن، ص 278
[6]- م ن، ص 279
[7]- م ن، ص 107
[8]- سنفصّل هذا الأمر في النقطة التالية من تقديمنا.
[9]- معضلات العدالة الانتقالية، م س، ص 14
[10]- م ن، ص ص 12-22
[11]- م ن، ص ص 12- 39
[12]- انظر مثلا عند حديثها عن تلك السياسات في التجربة الألمانية، م ن، ص 151
[13] - بحثنا في هذا الأمر في دراسة مخطوطة لنا بعنوان "من العدل إلى العدالة الانتقالية" تتبعنا فيها أهم دلالاتها في الفكر العربي الحديث والمعاصر من عصر النهضة إلى اليوم.
[14] -Anu Suidler: culture in action symbols and strategies, Americain Sociological Review, Vol 51. No 2 (App-198-6) P 278
[15] - معضلات العدالة الانتقالية، ص ص 38- 39
[16]- معضلات العدالة الانتقالية، ص 39
[17]- معضلات العدالة الانتقالية، ص 40
[18]- م ن، ص 56
[19]- Francis Fukuyama: The End of History And- The Last Man, Free Press New York, 1992
[20]- معضلات العدالة الانتقالية، ص 91
[21]- مثل الإشارة إلى بعض المنظمات والتشكيلات الحزبية المؤطّرة للحراك الثوري أمثال "حركة المنبر الجديد" و"اليقظة الديمقراطية"...
[22]- معضلات العدالة الانتقالية، ص ص 125-126
[23]- م ن، ص ص 175- 177
[24]- م ن، ص ص 128- 130
[25]- م ن، ص 142
[26]- نقلنا ملخّص التجربة البولندية من دراستنا سابقة الذكر "من العدل إلى العدالة الانتقالية"، ص ص 13- 14
[27]- م ن، ص 153
[28]- م ن، ص 162
[29]- م ن، ص 167
[30]- م ن، ص 155
[31]- م ن، ص 50
[32]- م ن، ص 166
[33]- للتفاصيل راجع ص ص 173- 174
[34]- م ن، ص ص 215- 216
[35]- م ن، ص 216[35]
[36]- م ن، ص ن.
[37]- تقول الباحثة في ذلك: "إنّه يشقّ على الدول التصالح مع ماضيها حينما تكون بأمسّ الحاجة لذلك بسبب فقر التجربة الديمقراطية الروسية في الماضي وتاريخها الزاخر بالاضطهاد السياسي الوحشي"، م س، ص 281
[38]- م ن، ص 282
[39]- م ن، ص 283