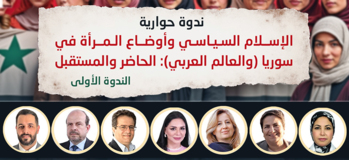ما بعد الإسلام السياسي قراءة في المشهد السياسي والثقافي للعالم العربي محمد محفوظ
فئة : قراءات في كتب
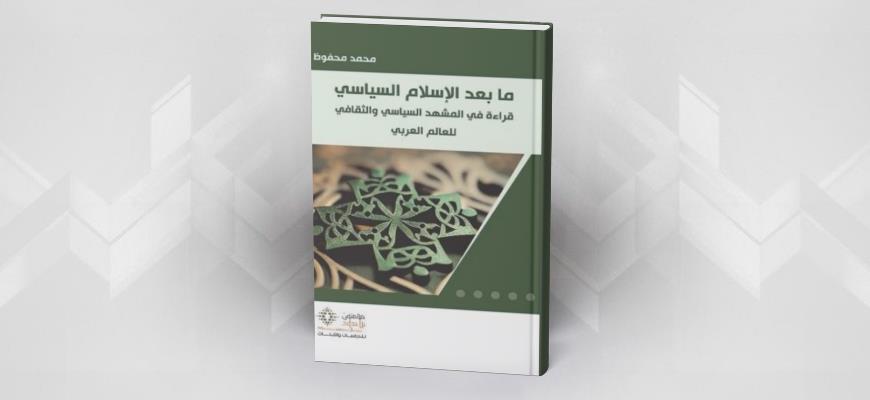
ما بعد الإسلام السياسي
قراءة في المشهد السياسي والثقافي للعالم العربي
محمد محفوظ
كتاب ما بعد الإسلام السياسي لمحمد محفوظ، من إصدار مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2024م، كتاب يتكون من ثلاثة فصول، وهي: الفصل الأول: العرب ودولة الإنسان، الفصل الثاني: الحرّية أولاً ودائماً، الفصل الثالث: الطريق الجديد.
حاول المؤلف من خلال هذه الفصول المحورية أن يقربنا من الإسلام السياسي كخطاب وتصور ودعوة سياسية ما قبل الربيع العربي، وكممارسة في السلطة دفع بها الربيع العربي نحو كرسي تدبير الشأن السياسي في مجموعة من البلدان، ولم يتوقف المؤلف عند هذا الحدّ، بل فكر مليًّا في ما ينبغي أن يكون عليه الإسلام السياسي، بعد تجربته في السلطة، بالعمل على تجاوز فراغات خطاباته السياسية، كما أنه أكد على ضرورة تجاوز مقولة الصراع مع الإسلاميين.
يرى محمد محفوظ، أن بعض جماعات الإسلام السياسي، خسرت سياسيًّا بعد ظاهرة الربيع العربي ما لم تخسره طوال فترة وجودها في النشاط الديني والاجتماعي، وإن بعض الأطراف التي لم تحسم أمرها من مشروع هذه الجماعات، حسمت أمرها بعد ظاهرة الربيع العربي من جرَّاء بروز العيوب السياسية لجماعات الإسلام السياسي. ولهذا، فإن السؤال الأساسي الذي يبحث عن إجابات تحليلية علمية هو: ما هي أهم العيوب السياسية التي وقعت فيها بعض جماعات الإسلام السياسي في حقبة الربيع العربي وبعدها؟
ما يقرب قرن من الزمن على ظهور الإسلام السياسي
يفصلنا قرن من الزمن على حدث سقوط الخلافة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك 1924م، وهي مسألة تفجر النقاش بشأنها، وكانت من بين الأسباب من وراء ظهور الإسلام السياسي 1928م المتمثل في حركة الاخوان المسلمين في مصر، وهي الجماعة الأم التي تحولت مع مرور الزمن إلى ظاهرة ما نُسمِّيه اليوم الإسلام السياسي، وهي ظاهرة كبيرة ومتعدِّدة ومركَّبة، تشمل الكثير من الجماعات والأحزاب والحركات والمؤسسات والشخصيات والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية.
فجلّ المحسوبين على الإسلام السياسي "يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها، فالخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله... ولهذا يجعل الإخوان المسلمين فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لابد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد وأن تسبقها خطوات".[1]
فعلى طول قرن من الزمن، كرست مختلف التنظيمات المحسوبة على الإسلام السياسي كل طاقتها من أجل الوصول الى السلطة في مختلف أقطار العالم العربي، فقد نجحت في ذلك في بعض من الدول عن طريق الانقلاب، وقطع الطريق أمامها في بلدان أخرى، ومن البين أن لحظة الربيع العربي قد جاءت بالإسلاميين إلى السلطة في بعض البلدان. والحقيقة أن الربيع العربي قد أخرج الإسلاميين من دائرة الدعوة والتبشير بمشروعهم السياسي إلى حالة التجربة والممارسة، وهي تجربة لها ما لها وعليها ما عليها.
هناك الكثير من الكتابات والمقاربات على طول القرن العشرين التي اعتنت بظاهرة الإسلام السياسي تحليلا وقراءة ونقدا، وهناك الكثير من المؤلفات التي كتبها الإسلاميين على أنفسهم، وفي نظرتهم الى السلطة والى الدولة وكيف يتصورون الإسلام، ومواقفهم من الديمقراطية ومن العلمانية، وطبيعة تعاطيهم مع التراث الإسلامي ومع الفكر الغربي. ويغلب على كتابات الإسلاميين نوع من الانتقائية وتوظيف كل طاقاتهم وجهدهم في التركيز على إقناع الشارع بأن مشكلة العالم الإسلامي، تعود الى ابتعاد المسلمين عن هويتهم الدينية وابتعادهم وإعراضهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية... وغير ذلك من الشعارات التي مفادها أن الإسلام هو الحل الوحيد لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي... في العالم الإسلامي. صحيح أن مختلف التنظيمات الإسلامية على طول العالم العربي تختلف وتتفاوت في برامجها وتصوراتها. إنها تتفق في فكرة وشعار أن الإسلام هو الحل.
بقي الإسلاميون بمختلف طوائفهم حبيسي تصورات وآراء النصف الأول من القرن العشرين، وقد كرسوا جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلا في مصارعة مختلف الأنظمة السياسية في الحكم في مختلف أقطار العالم العربي، ونتيجة لذلك انخرط الكثير من الشباب في دوامة العنف وتكفير الأنظمة الحاكمة المنخرطة بدورها في الصراع من أجل البقاء على كرسي السلطة، كما أنهم انخرطوا لوقت كبير في معارك ايديولوجية باسم الدفاع على الدين والشريعة، مقابل التيارات الماركسية والشيوعية وغيرها، مع مطلع القرن العشرين وجد الإسلاميين أنفسهم لا يملكون بديلا تصوريًّا وعمليًّا لمختلف المشكلات الحضارية والثقافية للعالم العربي والإسلامي، لحظة مجيء العولة التي ساهمت بشكل كبير في تعرية مختلف الأيديولوجيات.
تحوُّلات الربيع العربي، كان تحولا مفاجئًا للجميع بما فيهم الإسلاميين، فلا أحد توقع وصول التيارات الإسلامية إلى الحكم والسلطة؛ إذ بدأت مهمَّة تقديم المشروع الإسلامي، بوصفه مشروعاً للتطبيق، وليس مشروعاً للدعوة. ولا شك في أن هذه المسألة تتطلَّب من الإسلاميين -بكل تياراتهم وفئاتهم- لياقة سياسية وتدبيرية جديدة، حتى يتمكَّنوا من اجتياز المسافة بين الوعد والإنجاز بشكل صحيح ومناسب. فإذا كان الخطاب والممارسة الدعوية -في بعض جوانبها- تستطيع أن تتجاوز زمنها ومعطياته المتعدِّدة، فإن الخطاب والممارسة السياسية لا تستطيع أن تتجاوز زمنها ومعطياته؛ لأنها ممارسة تستهدف التعامل المباشر مع معطيات الواقع والزمن وحقائقها المتعدِّدة.[2]
ما بعد الإسلام السياسي
يرى محمد محفوظ، أن نجاح التيارات الإسلامية في تجربتها في الحكم والسلطة من الأولى أن يكون مرهون إلى حدٍّ بعيد على قدرة هذه التيارات على نقد تجربتها السياسية السابقة، وتفكيك بعض عناصرها، وصياغة رؤية أو مشروع سياسي جديد، يأخذ بعين الاعتبار الكثير من التحوُّلات والمتغيِّرات على الصعد السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية. وما ينبغي أن يقال في هذا السياق: إن تصدُّر التيارات الإسلامية المشهد السياسي في دول الربيع العربي، لا يعود إلى عمل هذه التيارات على الصعيد السياسي، وإنما يعود إلى العاطفة الدينية المتجذِّرة في نفوس وعقول المجتمعات العربية، وإلى الأنشطة الاجتماعية والخدمية والثقافية التي كانت تقوم بها هذه التيارات، ممَّا وفَّر لها علاقة طبيعية مع الناس، وأدَّى إلى تراجع تأثير الوجودات الأيديولوجية والفكرية والسياسية الأخرى المنافسة للإسلاميين.[3]
مرّ على الربيع العربي أكثر من عقد من الزمن، وقد تغيرت على ضوئه الكثير من التصورات، والمفاهيم، واتضح للجميع بما فيهم الإسلاميين أنهم متكئين على خطاب أيديولوجي خاوي من الداخل، ومن مفارقات الربيع العربي، أنه جاء من دون معادل معرفي أو فكري، فهو عبارة عن ثورة شارع لا توازيها ثورة فكر وعقل ونظر، وربما أن الذي جعل الإسلاميين يقطفون ثمرته بسهولة هي قوتهم التنظيمية والاستقطابية للجماهير، وتمثيل دور الضحية الذي حرم من فرصته في السلطة وفي تدبير الشأن السياسي... ولكن هي قوة تنظيمية لا تستند على تصور وبرنامج سياسي واضح المعالم في التعاطي مع المحيط الإقليمي والدولي، وفي خلق تالفات داخلية في تدبير الشأن المحلي، وهو الأمر الذي أسقطهم بشكل معلن أو غير معلن بأن يبقوا أوفياء لتصوراتهم القديمة القريبة من طروحات السيد قطب وحسن البنا بشكل معلن أو غير معلن، وهي تصورات تستعدي المجتمع وترى فيه بأنه يعيش حالة من الجاهلية، وتستعدي الغرب وترى فيه موضوع للصراع، صحيح أن الإسلاميين لم يصرحوا بهكذا تصورات، ولكنهم لم يقدموا أفكارا وطروحات يظهر من خلالها أنهم تخلّوا عن تصوراتهم القديمة، ومن الواضح أنهم لم يتخذوا مواقف جريئة واضحة تعبر عن القطيعة بينهم كتيار حركي وبين التيارات السلفية المتشددة المتطرفة؛ لأنهم يرون فيها قاعدة انتخابية تدفع بهم الى السلطة.
السؤال هنا ما هو مصير الإسلام السياسي بعد تجربة في السلطة، وبعد أكثر من عقد من الزمن على الربيع العربي؟ هنا تأتي أهمية إعادة قراءة ودراسة الإسلام السياسي، وهو الآن في حالة من أزمة الخطاب وأزمنة التصور. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب الذي نحن بصدده ما بعد الإسلام السياسي، وهو دراسة مرت من ثلاث مراحل، وهي:
1- أفكار نظرية تُوضِّح طبيعة العلاقة بين التشكل الأيديولوجي والفكري وطبيعة الخطاب على ضوء تجربة التيارات الإسلامية المعاصرة.
2- طبيعة الخطاب الإسلامي، والمراحل التي مرَّ بها قبل الربيع العربي.
3- مآلات الخطاب الإسلامي بعد الربيع العربي والتحوُّلات السياسية المتلاحقة.
ففي سياق الدراسة والبحث والتحليل يؤكد محمد محفوظ، أن الظاهرة الإسلامية الحديثة (جماعات وتيارات، شخصيات ومؤسسات) أضحت من الحقائق الثابتة في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في المنطقة العربية، حيث من الصعوبة تجاوز هذه الحقيقة أو التغافل عن مقتضياتها ومتطلَّباتها، بل إننا نستطيع القول: إن المنطقة العربية دخلت في الكثير من المآزق والتوتُّرات بفعل عملية الإقصاء والنبذ الذي تعرَّضت له هذه التيارات، ممَّا وسَّع الفجوة بين المؤسسة الرسمية والمجتمع وفعالياته السياسية والمدنية. وفي تقديرنا، إن انفتاح السلطات السياسية على التيارات الإسلامية، وفسح المجال لها للنشاط العلني، سيسهم في الآتي:
1- استقرار الحياة السياسية والاجتماعية؛ لأنه لا يمكن أن يتحقَّق الاستقرار العميق في ظل سياسات وممارسات إقصائية لبعض الوجودات السياسية والاجتماعية.
2- تهذيب نزعات التيارات الإسلامية وخلق مسافة كبيرة بينها وبين التوجُّهات العنفية التي سادت في بعض المناطق العربية والإسلامية من جرَّاء سياسات التغييب والإقصاء.
3- بناء الأوضاع السياسية على أسس الحرية والديمقراطية وصيانة حقوق الجميع في العمل والتنافس في المجال العام؛ وذلك عبر إرساء آليات وأطر ومؤسسات للتداول والتنافس السياسي بين مختلف التيارات والوجودات السياسية.[4]
[1] حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد، الإسكندرية، دار الدعوة، 1992م، ص144. (رسالة المؤتمر الخامس للجماعة (1938م))
[2] محمد محفوظ، ما بعد الإسلام السياسي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود بيروت، لبنان، 2024م (فقرة، ملاحظات تأسيسية حول الخطاب الإسلامي في ظل التحولات الجديدة)
[3] نفسه،
[4] نفسه.