من دولة الطوبى إلى دولة الاستبداد: "دولة الفقهاء" لنبيل فازيو
فئة : قراءات في كتب
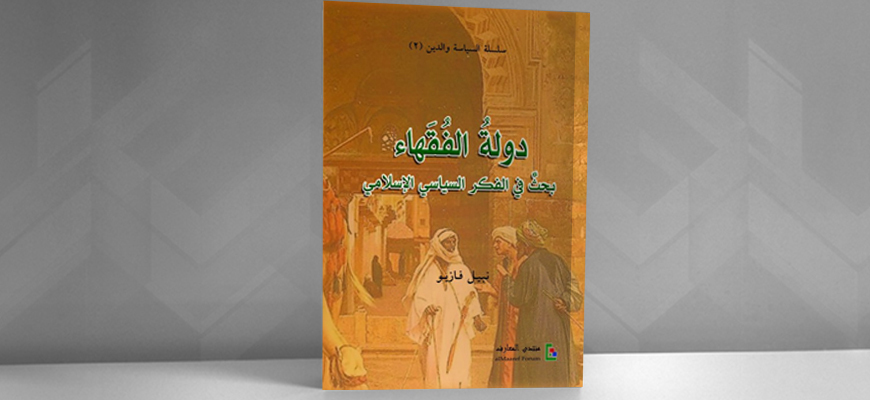
من دولة الطوبى إلى دولة الاستبداد
قراءة في كتاب "دولة الفقهاء"* لنبيل فازيو
تقديم:
سعى الكاتب في "دولة الفقهاء" إلى الخروج عن نمطين من الكتابة هَمَّا فقه السياسة الشرعية: الأول ما وصفه بالقراءة الأورثوذوكسية لتراث فقه السياسة الشرعية، والتي غالبًا ما اكتفت بعرض مضمون نصوص الفقهاء. أمّا النمط الثاني من الكتابة فتمثل في القراءة الاستشراقية لتراث الفقه السياسي، ولئن كان لهذه القراءة دور في التعريف، دراسةً ونقدًا، بذلك التراث فإنّ ما يعتور هذه الدراسة حسب صاحب الكتاب: "تمثل في إعراضها عن استثمار مكتسبات الفلسفة السياسية المعاصرة والدراسات الاجتماعية والثقافية في فهم تشكل ترسانة المفاهيم الفقهية في مجال السياسة"[1]. أما المنهج الذي اعتمده فهو منهج «تفكيكي تاريخي» عاملاً، بذلك، على تجاوز السلطة التي قد يمارسها النص على القارئ، خاصة إذا كان النص يمسّ المقدّس من تراث أمّة ما، محلّلاً البنى الداخلية الناظمة لتلك النصوص، مبيّنًا الحدود التي تقف عندها مثلها في ذلك مثل كل النصوص التي أبدعها الإنسان، رافعًا، بذلك هالة القداسة عليها. هذه العوامل كلها شكلت، في اعتقادنا، الهاجس الأساس، الذي دفع بالباحث نبيل فازيو إلى الحفر في فقه السياسة الشرعية. وعليه، إنّ البحث في "دولة الفقهاء" لم يظل حبيس المنظومة التي أنتج فيها وسجينها، إذ رام الباحث استثمار مجموعة من المفاهيم الفلسفية في دراسته من قبيل: "الشرعية والمشروعية والحق، والخطاب، ونظام القول، والصلاحية، والتبرير، والرأسمال المادي والرأسمال الرمزي، والحقل السياسي، والسلطة العقابية"[2]. بهذا المعنى، إنّ توسل الباحث بالمفاهيم الحديثة والمعاصرة ليس عيبًا اعتور بحثه في "دولة الفقهاء"، إنّما توسله ذاك يظل أساسيًّا بالنسبة إلى الباحث المعاصر. وعلى الباحث اليوم الذي يخوض في التراث عمومًا، وتراث فقه السياسة الشرعية أن ينهل من المناهج السائدة في مجال العلوم الإنسانية: التحليل النفسي، الأنثربولوجيا، علم الاجتماع، علم الاجتماع السياسي... وقد سبق للمفكر محمد أركون أن نبه لهذا النقص الحاصل في دراسة التراث العربي الإسلامي، سواء على مستوى ثقافة المركز أو ثقافة الهامش. بناءً عليه نفهم عملية انتقاله - محمد أركون - من الإسلاميات الكلاسيكية إلى الإسلاميات التطبيقية.
لا مرية أنّ العنوان الذي اختاره الدكتور نبيل فازيو: "دولة الفقهاء" يستفز القارئ المنتمي إلى حقل الفلسفة السياسية، وذلك على أكثر من صعيد، خاصة إذا كان البحّاثة لا يعتبر "بحثه في الفقه السياسي... بل هو، بالأحرى، مساهمة في تحليل رؤية الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي من خلال الوقوف، بقدر من التحليل والتفكيك على تصور خطاب فقه السياسة الشرعية للمسألة السياسية عامة، ولما تعلق منها بالدولة والمشروعية على وجه التحديد."[3] الأوّل؛ هل بحث فقهاء السياسة الشرعية في الدولة سنده ما هو بشري نسبي أم أنّ تصورهم "للدولة" وتمثلهم لها لا يخرج عن حيز الدين وقيود الشرع؟ بعبارة أدقّ، هل هو بحث لا يمكن له تجاوز قواطع الشرع كما حدّدها الجويني: القرآن والسنة والإجماع والقياس الفقهي. الثاني؛ إذا كان صاحب "دولة الفقهاء" يعتقد أنّ بحثه ينهل من الفكر السياسي الحديث والمعاصر وجملة المفاهيم الناظمة لهما، ألا يظنّ أنّ الجمع بين مفهوم الدولة من جهة، والفقهاء من جهة أخرى هو من باب الجمع بين المتناقضات؟ ذلك أنّ مفهوم الدولة المتعارف عليها في الفلسفة السياسية الحديثة والمعاصرة هي دولة من إبداع البشر، حيث تعرف هذه الدولة فصلاً بين المجالين السياسي والديني، ونحن نعرف المجهود الجبّار الذي قام به فلاسفة العقد الاجتماعي قصد القطع مع دولة القرون الوسطى التي أثقلت كاهل العقل الأوربي. أما الحديث عن "دولة الفقهاء" فلا يستقيم، في اعتقادنا، إلا من خلال أنموذج سلف وعبره، الأنموذج الذي مثله بدءًا النبي محمد والخلفاء الراشدون ثانيًا، خاصة الفترة التي حكم فيها كل من أبي بكر وعمر بن الخطاب. ما الذي قام به، على سبيل المثال، الماوردي في "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" أو فقيه معاصر له هو أبو يعلى الفراء في "الأحكام السلطانية" الذي يعد نسخة شبه مطابقة لكتاب الماوردي. ما الذي قد يميز فقيهًا ثالثًا هو إمام الحرمين الجويني في مؤلفه: "الغياثي"، أو فقيهًا آخر هو ابن تيمية في "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" غير تشييد "دولة" وفق مقتضيات الشرع. ذلك أنّ نظام الحكم الذي طالما دغدغ مخيلة الفقهاء هو نظام الحكم كما تجلى في الإسلام المبكر. مُبرر دفاع الباحث نبيل فازيو عن فقهاء السياسة الشرعية يتمثل في أخذهم للواقع بعين الاعتبار بدلاً من التحليق، عاليًا، في سماء الطوبى، وقد تبدى ذلك من خلال قول الفقهاء بإمارة الاستيلاء، وتنازلهم عن النسب القرشي شرطًا من شروط نصب الإمام أو الخليفة، وتجويزهم إمامة الفاسق إن كان هو يذبّ عن الأمة، وترجيحهم كفّة الإمام القوي وإن لم يكن مجتهدًا... إلى غير ذلك من المسائل التي قد يعتقد منها أنّ تمثّل فقهاء السياسة الشرعية "للدولة" هو تمثل يخرج من مجال المطلق إلى دائرة النسبي ومن مجال اللاهوت إلى حيز الناسوت. غير أنّ النظر في المقدمات المشكلة لمنطلقات فقهاء السياسة الشرعية سيتبين صعوبة الإقرار بتأكيدهم على أولوية الواقع على حساب المثال أو الفكر على حساب النص. الثالث، أليس الدفاع عن "دولة الفقهاء" باعتبارها دولة الواقع، يقول نبيل فازيو: "سنّ الماوردي سُنّة سار عليها اللاحقون من فقهاء السنة، وكان من حسناتها أن قادته واقعيته إلى فتح العقل الفقهي على مجال الممكن والنسبي بعيدًا عن لغة المطلق والضرورة، فكان قبوله بسلطة المتغلب الدليل الفارق عل تعامله الواقعي مع أزمة المشروعية."[4] يُمَثِلُ، على عكس ما يعتقد صاحب دولة الفقهاء، عائقًا أمام تكوين الدولة الحديثة والمعاصرة، إذ إصرار فقهاء السياسة الشرعية على "الأمر الواقع" ليس مردّه واقعيتهم في التفكير النزاعة إلى أخذ النسبي والممكن والمحتمل بعين الاعتبار، بقدر أنّ اشتغالهم على الواقع السياسي يتم من خلال "النص المقدس" وعبره: القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس الفقهي. إنّ قولهم بإمارة الاستيلاء، على سبيل المثال، يجد مرجعيّته في نصوص تفرض على العقل الفقهي القول باجتناب الفتن وصون الجماعة والذب عن الدين؟
انطلاقًا من هذه الملاحظات ذات الطابع الإشكالي، سنحاول رفقة الباحث نبيل فازيو التفكير في دولة الفقهاء من خلال التوقف، في نظره، على الأحكام المسبقة التي نُسجت حول خطاب نظرية الخلافة من جهة، وخطاب الآداب السلطانية من جهة ثانية، أما الحكم المسبق الأول فهو: أنّ تفكير فقهاء الأحكام السلطانية هو تفكير طوباوي ضارب في المثالية، بينما يقول الدكتور نبيل فازيو عن الحكم المسبق الثاني ما يلي: "أليست بأحكام مسبقة ولا مفتعلة تلك التي تقول إنّ خطاب الآداب السلطانية حمل في تضاعيفه علامة على الاستبداد والتسلط ورفع السلطان إلى مقام الإله على شاكلة الدولة الثيوقراطية في العالم الغربي"[5]
أولاً: "الخلافة: جدلية الفكر والمثال"
لا مرية أنّ نظرية الخلافة شُيدت بكيفية نسقية صارمة، من خلال استنادها على مجموعة من المقدمات التي لا تتعارض مع مجريات الواقع، أضف إلى ذلك أنّ الذين نظروا في الخلافة ابتغوا جرّ الواقع إلى نظرياتهم، بحيث نلمس نوعًا من الحوار يجري بين الفكر والواقع. هذا الحوار الذي قد يُبعد عنهم شُبهة الإغراق في الطوباوية. غير أنّه بالإمكان طرح العديد من الأسئلة في هذا السياق: هل كان اعتماد منظري الخلافة على الواقع والأحداث التاريخية تعاملاً فينومينويلوجيًّا أم أنّه حرص على ليِّ عنق التَّاريخ بتأويل أحداثه حسب مقدمات - مسلمات - لا يمكن الطعن فيها {القرآن والسنة والإجماع والقياس}؟ بعبارة أخرى هل نظرية الخلافة هي نظرية - حسب التعبير الكانطي - قبلية أم بعدية؟ هل قراءة المارودي وإمام الحرمين وبعده ابن تيميّة وصاحب الإمامة العظمى للتاريخ الإسلامي هي قراءة تهدف إلى الكشف عن الحق والحقيقة أم أنّ المسألة تتصل باستنطاق التاريخ لكي يجيب عن أسئلة نعرف الإجابة عنها بشكل مسبق؟ هل بالإمكان الحديث مع أصحاب نظرية الخلافة السنية الأشعرية عن عقل محايث للتاريخ أم العقل عندهم تابع خاضع للعقل المطلق، العقل الإلهي الذي يعتبر النص والإجماع صورة معكوسة له - العقل الإلهي -؟
إنّ أوّل ما يسترعي اهتمام الباحث في الأسس النظرية التي استندت عليها فكرة الخلافة في العالم الإسلامي، القديم منه والحديث، هو انتشار هذه الفكرة في العديد من المؤلفات، حيث نصّب الكثير من الكتاب أنفسهم مدافعين شرعيين عنها، كَحَلّ لكل المعضلات في كل زمان ومكان. يتعلق الأمر بمنظومة أيديولوجية ادَّعت ردم الهوة بين المثال والفعل، الثابت والمتحوّل، الفكر والواقع، المطلق والنسبيّ. استنطقت مجريات الواقع لتشيد من خلاله نسقًا صارمًا أصبح من الممكن، حسب ادعائها، تطبيقه اليوم، ومستقبلاً، كما كان حاصلاً في الأمس البعيد. أما "الواقع" الذي شكّل مرجعًا للأغلب الأعمّ من المنظّرين لفكرة الخلافة فيجد أصله في الفترة النبوية؛ حيث كان الاتصال المباشر بين الله[6] ورسوله عن طريق جبريل. بهذا المعنى يمكن الحديث عن خلافة الشيخين: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب. قد يصح حرص الفقهاء الشديد على عدم الابتعاد التام عن الواقع، إذ تبدو في محاولتهم إرادة لتكييف نظرتهم السياسية مع مجريات الواقع، وذلك من خلال قبولهم، على سبيل المثال، بإمارة الاستيلاء[7]، إلى شرعنة إمكانية قيام إمامين، إلى الاعتراف بأهمية الشوكة[8]، كذلك خضوعهم إلى أمر الواقع في شأن تنصيب الإمام الفاسق[9]، إذ تبقى الغاية واحدة: الذبّ عن الإسلام، حماية الدين، والدفاع عن وحدة الأمّة تجنّبًا للفتن والفرقة.
يتعلق الأمر، إذن، بضرورة تطويع الواقع ليمتثل إلى فكرة الخلافة، بالعمل على إلحاق النسبي بالمطلق، إنّه أسّ العمل الذي تقدّم به كلّ من إمام الحرمين والماوردي؛ إذ غايتهما القصوى ردم الهوة بين الخلافة كمثال، كما تحققت زمن النبي والشيخين، والواقع السياسي الذي يظل بعيدًا عن فكرة الخلافة قريبًا من الملك[10]. إدانة للتمزق والفرقة وتمسّك بوحدة الأمة؛ والنتيجة: ابتعاد عن الواقع، واقع الفتن والفرقة، والمحن، واستئثار "الخلفاء" بالحكم.
قد يصح القول بأنّ المنظّرين لشأن الخلافة راموا ربط الفكرة بالواقع من خلال آلية التبرير المعتمدة من طرفهم، غير أنّ القول باتخاذهم الواقع منطلقًا للتفكير في الإمامة والخلافة لا يعني أنّهم على استعداد للتنازل عن جملة من المبادئ المؤسسة للخلافة؛ إذ الحوار الدَّائر بين الفكر والواقع لا يسمح لهذا الأخير بتجاوز مجموعة من المسلّمات التي يتأسس عليها كيان الخلافة، يقول ناصيف نصار في هذا السياق: "ولكن واقعية الماوردي لا تعني مطلقًا تقديم الواقع على المبدأ أو الانطلاق من الواقع في سبيل تحقيق مثال فلسفي. إنّ واقعية الماوردي هي بالضبط الطريقة التي يتعامل بها مع الواقع انطلاقًا من تسليمه بوجوب وجود إمامة واحدة في دار الإسلام"[11]. الحاصل، إنّ تصور فقهاء السياسة للزَّمن تصور سكوني، ثابت، مطلق، تمثله لحظة السَّلف الصَّالح، زمن النَّبي وأصحابه، حيث إنّ كل حياد عن هذه اللحظة يمثل، من دون شك، مروقًا عن الدين. على التاريخ البشري أن يخضع، بهذا المعنى، لمنطق الزمن الإلهي، وما نعيشه اليوم لابد من أن نجد له صدًى في الماضي. فإمّا الاعتراف بالسلطة المرجعية للماضي الذهبي التي رافع عنها فقهاء السياسة الشرعية باعتبارهم ورثة الأنبياء لتحقيق العدل، وإمّا العيش وفق مقتضيات الزمن البشري المؤدي، من دون شك، إلى الهلاك في الدنيا قبل الآخرة.
من كل ما سبق يمكن القول إنّ نعت النظام الحاكم وفق فقه السياسة الشرعية بالطوباوية هو قول مسبق، على حد تعبير الدكتور نبيل فازيو، ليس بالحكم المسبق، في اعتقادنا، ما دام له ما يبرره. ثم ما الذي حدا بالباحث إلى التشديد على الملاحظة الآتية: "سيكون من الأليق، إذن، وتجنبًا لكل شطط، أن نعترف بالحس الواقعي الذي يحكم تصور مرايا الأمراء للسياسة، وذلك خلافًا للرؤية الطوباوية التي صدر عنها غيرهم من محترفي مجال الفكر السياسي، كالفقيه والفيلسوف"[12].
ثانيًا: فقه السياسة الشرعيّة: تضخيم النصّ، تفقير الواقع.
إنّ الناظر في مؤلفات فقهاء السياسة الشرعية، التراث السُنّي على وجه التخصيص، مثل الماوردي في كتابه: "الأحكام السلطانية والولايات الدينية"، والجويني في مؤلفه: "غياث الأمم في التياث الظلم" وأبي يعلى الفراء المعاصر للماوردي، وابن تيمية في كتابه: "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيّة"، يجدهم يبتدرون، في مطلع مؤلفاتهم، إلى تعريف الإمامة بما هي منصبٌ الغاية منه حفظ الدين والذب عنه. يُعرِّف الماوردي الإمامة قائلاً: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذّ عنهم الأعصم"[13]. ويعرّفها الجويني بما هي: "رياسةٌ تامة وزعامةٌ عامّة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا"[14]... إنّ القاسم المشترك بين التعريفين تشديدهما على الإمامة باعتبارها منصبًا دينيًّا بدليل "إجماع" السلف الصالح؛ إذ يتوجّب على الخليفة أو الإمام "حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحُجّة وبيّن له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسًا من خلل والأمّة ممنوعة من زلل."[15] لا مرية، إذا، أنّ مفتتح الخلافة ومختتمها هو صون الدين من الواقع ومتغيراته الطارئة التي لم يعرف الدين الإسلامي لها نظيرًا. بهذا المعنى، على الخليفة، أو من يحلّ محلّه من الفقهاء[16]، عند الاقتضاء، أن يستعيد لحظة البدء العظيمة كما تجلّت مع النبي والخلفاء الراشدين، مجتهدًا في النوازل وما استحدث من ظواهر، غير أنّ الاجتهاد، هاهنا، لا يخرج عن المنظومة الحاكمة للنصّ؛ أي "القواطع الشرعية الثلاثة: نصّ في كتاب الله تعالى لا يتطرق إليه التأويل، وخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعارض إمكان الزلل روايته، ونقله، ولا تقابل الاحتمالات متنه وأصله، وإجماع منعقد."[17] وإذا كان ذلك كذلك، فالقياس الفقهي: "العقلي": الاجتهاد، لا يعني، كما قد يظن، استعمالاً حرًّا للعقل الإنساني في المستجدات الطارئة في الدولة: اقتصاديًّا، واجتماعيًّا، وسياسيًّا. إنّ الاجتهاد، في شؤون الأمة، لا يمكنه الانفلات من قبضة النص، وإلا كان الاجتهاد بدعةً وزللاً يتطاول فيه الخليفة أو الفقيه على حقوق الله من جهة، وحقوق الآدميين من جهة أخرى. الحاصل إنّ السياسة الشرعية، في مقابل سياسة فاسدة، هي سياسة تستند، كما يرى ابن تيمية، على الآيتين: ﴿إِنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ... يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول إِنْ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأويلاً﴾ وما العدل في الآية إلا تطبيق لشرع أساسه: الكتاب والسُنّة والإجماع والقياس[18].
يتّصل صلاح الرَّاعي والرَّعية، إذا، حسب فقهاء السيَّاسة الشَّرعية، بالعمل وفق مقتضى النَّص، وفسادهما راجع، حتمًا، إلى ابتعاد السياسي، في تدبيره لنظام الحكم، عن الدين. لننظر، على سبيل المثال، إلى مسألة الحدود المتضمنة في مؤلفات فقهاء السياسة الشرعية، والتي تتصل إما بحقوق الله: الصَّلاة، الَّزكاة، الصَّوم... أو بحقوق البشر: السَّرقة، الِّزنا، شرب الخمر...، سنجد الأحكام نفسها وقد نسخت هنا وهناك بدعوى وجود نصٍّ شرعيِّ مقدَّس لا يمكن تجاوزه، نصّ متعالٍ عن زمن تشوبه شوائب التبدُّل والتَّغير. قد يعترض معترض أنّ قاضيًا مثل الماوردي، في تشريعه لأحكام الإمارة والقضاء والأحكام المرتبطة بقانون الأرض، والنظام الاقتصادي والمالي "للدولة"، إنّما كان شديد الاتصال بالواقع الذي عاصره. إنَّ اتِّصال الرَّجل بالواقع يظلُّ عرضيًّا، إذ لا يمكنه، في كل الحالات، الخروج عن مقتضيات النص، و"الدعوة إلى الرجوع إلى كان ما عليه السَّلف الصَّالح، وما كان عليه السلف الصالح، في منظور الفقهاء، هو التَّمسك بالكتاب والسنَّة، وهو الوقوف عند حدود النَّص أو الاجتهاد فيه متى اقتضت النوازل ذلك بمعايير يمتلك الفقهاء وحدهم، دون غيرهم، سلطة تقديرها وحق ممارستها."[19] نحن، ها هنا، أمام سرعتين مختلفتين، واحدة تفوق الأخرى، الأولى مرتبطة بالواقع والثانية متّصلة بالنَّص، إذ يحاول النَّص، متى استجدّ مستجدّ، اللحاق بالواقع قصد شرعنته وتبريره؛ لكأنّ النَّص حوى كل ما كان وما هو كائن وما سيكون، فالحاضر يتصل، وشائجيًّا، بالماضي، والواقع يرتبط بالنص. وعليه، إذا كانت الدولة تزدهر بأسباب وتنهار بأسباب، فتلك الأسباب، مرتبطة في نظر الفقهاء بمدى القرب أو البعد من النَّص المقدَّس، فبهذا الأخير يستقيم الحديث عن نظرية الخلافة، أما العقل فلا مجال له في هذه النظرية إلا باعتباره تابعًا خاضعًا للشرع، "فإنّ الذي لا يقتضيه الشَّرع لا معوَّل عليه"[20] يقول الجويني.
ملاك القول إنّ النص، في اعتقادي، واحد من أبرز العوائق التي تمنع من تكوين نظرية في الدولة وفق مقتضيات العقل البشري.
ثالثًا} جدلية الراعي والرعية: الدعوة إلى الطاعة وتجنب الفتنة.
يشكّل السلطان الراعي، في تراث الآداب السلطانية، قطب رحى الدولة السلطانية؛ هو المبتدأ والمنتهى، علة وجود "الدولة"، تنصيبه أمر مُسَلَّم به وبديهي. من ثم، لا حاجة للأديب أو الفقيه الذي يتقدم بحزمة من النصائح للملك لتبرير ضرورة تنصيبه كما جرت العادة مع منظّري الإمامة أو الخلافة الذين يخصّصون فاتحة مؤلفاتهم للبحث في المبررات الشرعية لهذا التنصيب. غير أنّ اللافت للانتباه هو الكيفية التي يُقدم بها الراعي أو السلطان أو الملك من طرف الأديب السلطاني. لم يعد الأديب السلطاني يتحرج في تذكير الملك بفرادته التي تعلو على العامة والخاصة؛ حيث أحيطت به هالة قدسية مردّها في تصور الأديب إلى اللّه كما نجد ذلك في التراث الإسلامي من جهة ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ﴾[21]، ﴿لَو كَانَ فِيهِمَا آلهةٌ إلاَّ الله لَفَسَدَتَا﴾[22]، والأفكار التي تناقلوها من خلال معرفتهم بالعهود (عهد أردشير)، ونمط الحكم في الشرق الذي يجعل من الحاكم أبًا راعياً لرعية في حاجة إلى من يسوس أمرها ويعتني بها؛ إذ الرعية كائنات ناقصة غير راشدة. بهذا المعنى، فهم فقيه مثل الماوردي السياسة؛ حيث يقول: "ولهذا المعنى سماهم الحكماء ساسة، إذ محلهم من يسوسهم محل السائس مما يسوسه من البهائم والدواب الناقصة الحال من القيام بأمور أنفسها، والعلم بمصالحها ومفاسدها"[23]. هذا الفهم الذي يتقدم به صاحب "نصيحة الملوك" و"تسهيل النظر وتعجيل الظفر" لأمور السياسة ولعلاقة الحاكم بالمحكومين تجده عند من سبقه مثل الجاحظ[24] في التاج في أخلاق الملوك (المنسوب إليه)، وعند ابن الربيع في سلوك المالك في تدبير الممالك، كما نجده في مؤلفات اللاحقين على الماوردي مثل الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن طباطبا أو الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن الرضوان أو بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق. وعليه، تكون الرعية مِلكيةً تحت تصرف الراعي، "فمن جلالة شأن الملوك، يقول الجاحظ، وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس أنّ كل من تحت يدي الملك من رعاياه [...] فإنّ محلهم منه في كثير من الجهات محل المملوكين"[25]. وحده السلطان-الراعي، إذن، من يتمتع بالصفات الإنسانية الكاملة التي تقرّبه من الله، إذ يشترك الاثنان في صفات: العدل، الرحمة، الملك، القهر.... أضف إلى ذلك، فإنّ كل مخلوقات الله في أرضه، وكل ما يرتبط بالحياة الدنيا والآخرة غير ذي معنى من دون وجود السلطان[26]؛ إذ هو حجة الله على خلقه، يقول الغزالي[27]: "يسمع في الأخبار: السلطان ظل الله في أرضه، فينبغي أن يعلم أنّ من أعطاه الله درجة الملوك، وجعله ظله في الأرض، فإنّه يجب على الخلق محبته ويلزمهم متابعته وطاعته، ولا يجوز لهم معصيته ومنازعته". بهذا المعنى، يشكّل السلطان الأصل بينما تشكّل الرعية الفرع، وما على الرعية، جلباً لمصالحها المتمثلة في الأمن والعدل وتطبيق الشرع، إلاّ الخضوع التام والمطلق للراعي. فَصْمٌ تام بين الراعي والرعية، بين أخلاقه وأخلاقها؛ أخلاق الأول تجعل منه كائناً حراً، وإن لم يكن كذلك، بينما أخلاق الثانية هي أخلاق الطاعة والامتثال والإذعان. وعليه، لا مجال لافتراض إمكانية الخروج على السلطان بالدعوة إلى الثورة أو العصيان، ففي ذلك خروج عن قوانين الشرع ونواميس الكون، ألم يقل الله في القرآن الكريم: ﴿وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ﴾[28]. فإمّا الطاعة الملازمة للخير والنفع، وإما المعصية التي تجرّ معها ويلات التشتت، والتمزق والفتن. في هذا السياق، نورد نصًّا لعبد الحميد الكاتب يشدّد فيه على ضرورة الطاعة درءاً للفتن، يقول: "ففي طاعة الأئمة في الإسلام، ومناصَحَتِهِمْ على أمورهم، والتسليم لما أَمروا به، مهم كل نعمة فاضلة، وكرامة باقية، وعافية متخللة، وسلامة ظاهرة وباطنة، وقوة بإذن الله مانعة، وفي الخلاف عليهم والمعصية لهم ذهاب كل نعمة، وتفرق كل كرامة ومحق كل غنية، وهلاك كل سلامة وألفة، وموت كل عزة وقوة، والدعاء لكل بلية، ومقارفة كل ضلالة، واتباع كل جهالة، وإحياء كل بدعة، وإماتة كل سنة، واجتلاب كل ضرر على الأمة، وإدبار كل منفعة، والعمل بكل جور باطل، وفناء كل حق"[29]. الحاصل إنّ الواقع العربي الإسلامي، بعد أفول نجم الخلافة، إنّما كان واقع فتن وتمزق وتشتت وصراع طاحن بين أبناء الأمة الواحدة، لهذا تجد كتّاب الآداب السلطانية، بنظرتهم الواقعية، يتشبثون، في خطابهم، بما بقي من الدولة السلطانية على الرغم من اقتناعهم ببعدها عن الأنموذج الذي مثله سلطان النبي والخلفاء الراشدين من بعده.
يمكن القول، تأسيسًا على ما سبق، إنّ واقع الدولة السلطانية وتفكير كتّاب الآداب السلطانية في هذه الدولة شدد على السلطان والملك في مقابل الدولة المؤسساتية؛ إذ ترتبط دولة السلطنة بالسلطان، ويحضر تاريخ الدولة السلطانية من خلال أسماء ملوكها. هذا الملك يتمتع بحرية مطلقة في مقابل العبودية التي تسم العامة من الرعية، الغوغاء، القطيع الذي يرتبط، أنطولوجيّاً، بالراعي. أضف إلى ذلك الغياب التامّ للفرد في هذه الدولة. رُبّ معترض يقول إنّنا نسقط جملة من المفاهيم التي تنتمي إلى المجال الحديث والمعاصر على الدولة السلطانية، في حين أنّ الأصوب هو النَّظر إلى خطاب الآداب السلطانية من خلال المفاهيم الناظمة له، والمبررات الواقعية التي أدت إلى إنتاج مثل هذا الخطاب؛ بعبارة أخرى لا بدّ لنا من التماس المبرّرات والمسوّغات التي أفرزت خطاب الآداب السلطانية. قد لا نجانب الصواب إن قلنا إنّ خطاب الآداب السلطانية الذي يمتد، زمنيًّا، من القرن الثامن الميلادي وإلى حدود القرن العشرين إنّما ظل يكرّر معطياته نفسها، وينطلق من المرجعيات ذاتها الناظمة له، كما لو أنّنا أمام خطاب سلطاني يعيش خارج منطق التاريخ الفعلي؛ تاريخ الوقائع والأحداث المتبدلة والمتغيرة. للنظر إلى واقع "الإصلاحات" و"التنظيمات" التي عرفتها الدولة السلطانية، إبان الضغوطات التي مارستها الدول الأجنبية، سيتبين لنا أنّ الأمر يهم الجانب الخارجي للدولة السلطانية، أمّا روح {بالمعنى الهيجلي} الدولة السلطانية فهي روح مستبدة، متسلّطة، تعمل على احتكار السلطة السياسية والدينية. يتعلق الأمر بنص واحد يُكتب مع كل دولة سلطانية عرفتها هذه الرقعة الجغرافية التي تسم نفسها بأنّها إسلامية؛ تجد الفقيه والمؤرخ والأديب يمجّدون ذاتَ الراعي مع تقديمهم له طرائق التصرف والسلوك الواجب انتهاجها إزاء الأغيار من الخاصة والعامة، إذ مبرر ذلك هو ضرورة الحفاظ على وحدة الأمّة درءًا للفتنة التي مزقت جسم الأمة الإسلامية غبّ مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان.
* فازيو نبيل. دولة الفقهاء: بحث في الفكر السياسي الإسلامي. بيروت، منتدى المعارف. 2015. عدد الصفحات 544
[1] المصدر نفسه. ص 32
[2] المصدر نفسه. ص 32
[3] المصدر نفسه. ص 17
[4] نبيل فازيو. دولة الفقهاء. ص 22. مصدر سابق.
[5] المصدر نفسه. ص 117
[6] "الله في القرآن متعال جدًّا، لا يمكن تصوره، لكنه خلافًا لـ: البراهما الكسول أو الإله الغنوصي، هو إله نشط في شؤون العالم والإنسان. إنّه بعيد جدًّا وقريب جدًّا"، هشام جعيط: الوحي والقرآن والنبوة. مصدر سابق. ص 52
[7] "واما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار، فهي: أن يستولي الأمير بالقوّة على بلاد يقلّده الخليفةُ إمارتَها، ويفوّض إليه تدبيرها وسياستها، فيكون الأمير باستيلائه مستبدًّا بالسياسة والتدبير، والخليفة بإذنه منفّذًا لأحكام الدين" الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص 66
[8] "فأمّا لو فرض رجل عظيم القدر، رفيع المنصب، ثم صدرت منه بيعة لصالح لها سرًّا، وتأكدت الإمامة لهذا السبب بالشوكة العظمى-فلست أرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعًا" الإمام الجويني، غياث الأمم، ص 41
[9] "ولو فرض فاسق بشرب الخمر أو غيره من الموبقات، وكنا نراه حريصًا، مع ما يخامره من الزلات وضروب المخالفات، على الذب عن حوزة الإسلام، مشمرًا في الدين لانتصاب أسباب الصلاح العام العائد إلى الإسلام، وكان ذا كفاية، ولم نجد غيره، فالظاهر عندي نصبه مع القيام بتقويم أوده على أقصى الإمكان" الجويني، غياث الأمم، ص 142
[10] "إنّ الخلافة بعد منقرض الأربعة الراشدين شابتها شوائب الاستيلاء وأضحى الحق المحض في الإمامة مرفوضًا، وصارت الإمامة ملكًا عضوضًا" الجويني، غياث الأمم، ص 66
[11] ناصيف نصار، مفهوم الأمّة بين الدين والتاريخ. دار الطليعة، بيروت. الطبعة الخامسة. 2003. ص 85
[12] نبيل فازيو. دولة الفقهاء. ص 116
[13] الماوردي. الأحكام السلطانية. تحقيق عماد زكي البارودي. القاهرة. المكتبة التوفيقية، ص 15
[14] إمام الحرمين الجويني. الغياثي: غياث الأمم في التياث الظلم. بيروت. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية، 2003. ص 15
[15] الماوردي. الأحكام السلطانية. ص ص 38-39
[16] "فأما إذا كان سلطان الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبعون العلماء، والسلطان نجدتهم وشوكتهم" الجويني. غياث الأمم في التياث الظلم. ص 169
[17] الجويني. غياث الأمم وفي التياث الظلم. ص 34
[18] انظر الدائرة المغلقة التي حدد فيها الشافعي مصادر التشريع، إذ لا يمكن، في كل الأحوال الاجتهاد إلا بالقياس على ما سبق. "-...فهل تجيز أنت أن يقول الرجل: أَسْتَحْسِنُ، بغير قياس؟
- فقلت: لا يجوز هذا عندي - والله أعلم - لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دونَ غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتّباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر.
- ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان.
- ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من علم مضى قبله، وجهة العلمِ بعدُ الكتاب السنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها.
- ولا يقيس إلاَّ من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضِه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده." الشافعي. الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة. مكتبة دار التراث. الطبعة الثالثة 2005. ص ص 415-536
[19] سعيد بنسعيد العلوي. نظرية الخلافة: دراسة في التفكير السياسي عند أبي الحسن الماوري. القاهرة. رؤية للنشر والتوزيع. 2010. ص 84
[20] الجويني، الغياثي. ص 48
[21] سورة الشورى، الآية: 11
[22] سورة الأنبياء، الآية: 22
[23] الماوردي، نصيحة الملوك. تحقيق الشيخ خضر محمد خضر. الكويت. مكتبة الفلاح.1983. ص 51
[24] يقول الجاحظ: "وأولى الأمور بأخلاق الملك، إن أمكنه التفرد بالماء والهواء ألا يشارك فيهما أحد؛ فإنّ البهاء والعز في التفرد". التاج في أخلاق الملوك. ص 14
[25] المصدر نفسه، ص 53
[26] "قال بعض القدماء: لو رفع السلطان من الأرض ما كان لله في أهل الأرض من حاجة. ومن الحكم التي في إقامة السلطان: إنّه من حجج الله تعالى، ومن علاماته على توحيده، لأنّه كما لا يمكن استقامة أمر العالم واعتداله بغير مدبّر ينفرد بتدبيره، كذلك لا يتوهم وجوده وتدبيره وما فيه من الحكمة ودقائق الصنعة بغير خالق خلقه وعالم أتقنه، وحكيم دبره، وكما لا يستقيم سلطانان في بلد واحد لا يستقيم إلهان للعالم، والعالم بأسره في سلطان الله تعالى كالبلد الواحد في يد سلطان الأرض". الطرطوشي. سراج الملوك. ص 59
[27] أبو حامد الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، عربه عن الفارسية إلى العربية أحد تلامذته، ضبطه وصححه أحمد شمس الدين. بيروت. دار الكتب العلمية.. 1988. ص 43
[28] سورة البقرة، الآية: 191
[29] إحسان عباس، عبد الحميد الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العلاء. الأردن. دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان. 1988. ص 209






