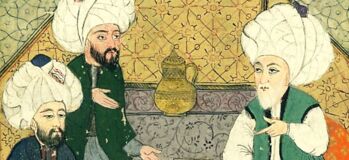ميراث الأقليّات المسلمة: الخُنثى والمجنون والهدمى والغرقى أنموذجا
فئة : مقالات

ميراث الأقليّات المسلمة:
الخُنثى والمجنون والهدمى والغرقى أنموذجا
ملخّص:
يهدف هذا المقال إلى النّظر في قضّية الأقليّات المسلمة كفئة اجتماعيّة لها الحقّ في التّعايش ضمن مجموعتها. فبيّنا فيما سيأتي كيف أنّ الإسلام - من خلال القرآن والسّنة واجتهادات علماء الأمّة - ضمن حقوق هذه الأقليّات معنويّا وماديّا، مُتّخذين من فقه المواريث أنموذجا عن ذلك. فهذا الإسلام الّذي لطالما تّهم بالعنصريّة والتّخلّف والعدم احترام حقوق الإنسان في كلّ مُناسبة حاولت فيه المجتمعات الغربيّة التّرويج لمفاهيم وأنماط حياتيّة دخيلة عنه كالشّذوذ الجنسيّ والمساواة في الميراث والإساءة إلى الرّسول "ص" بدعوى حريّة التّعبير. كلّ هذه الاتّهامات وغيرها فنّدها الاعتناء بهذه الفئات المهمّشة والأقليّات الاجتماعيّة وكانت أحسن ردّ على أقوال هؤلاء المضلّلين..
مقدّمة البحث:
يقول الله عزّ وجلّ في الآية 89 من سورة النّحل: "وَنَزَّلْنَا عَلْيكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لكلّ شيء وهُدًى ورحمةً وبُشرى للمُسلمِينَ."، ويقول أيضَا تبارك وتعالى في الآية 38 من سورة الأنعام: "مَّا فَرَّطنَا فِي الكِتَابِ منْ شيء ثُمَّ إلى ربّهمْ يُحشَرُونَ." ... هذا وغيره من الآيات الأخرى جاءت للتّأكيد أنّ القرآن شاملُ الأحكام، وأنّه صالح لكلّ زمان ومكان، وأنّه أتى على جميع الأمور حتّى تلك الّتي تعلّقت بالأقليّات والحالات الشّاذة، والّتي قد يعتبرها الكثيرون من الفئات مهمّشة لا أحكام فقهيّة خاصّة بها من ذلك: الخُنثى، والمجنون، والغرقى، والهدمى.... على عكس الموقف السّابق، فإنّ الإسلام قد أولاها عنايته ولم يبخسها حقّها. ويظهر ذلك خاصّة في قضايا الميراث[1]، نظرا لما يحتلّه هذا العلم من حيز متميّز عن باقي أبواب الفقه الأخرى، فلا عجب أن عدّه بعض العلماء والباحثين علما مستقلا بذاته له قواعده وأصوله وأحكامه وتفاصيله. فقد اعتبر أنّه ثلث العلم أو نصفه. وقد عُدّ علم المواريث من أعظم العلوم وأجلها وانفعها، ألم يقلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية مُحكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة". وقال أيضا عليه الصّلاة والسلام: "تعلّموا الفرائض وعلّموها، فإنّه نصف العلم، وهو يُنسى وهو أوّل شيء ينزع من أمتي".
1. ميراث الخُنثى
قبل النّظر في أحكام ميراث الخُنثى، علينا ضبط تعريف لهذه الفئة.
الخُنثى لغة هو: الّذي لا يخلص لذكر ولا أُنثى الّذي له ما للرّجال والنّساء جميعا.[2] أمّا اصطلاحا، فهو: شخص له آلتا الرّجال والنّساء، أو ليس له شيء منها أصلا.[3] وعرّفه الكسائي بأنّه: منْ لهُ آلةُ الرّجال والنّساء والشّخص الواحد لا يكون ذكرا وأنثى حقيقة. فإمّا أن يكون ذكرا وإمّا أن يكون أنثى.[4] فإذا كان للمولود فرج وذكر فهو خُنثى.[5] ويعرّفه ابن قدامه بأنّه: "الذّي له ذكر وفرج امرأة أو ثبت في مكان الفرج يخرج منه البول، وينقسم - أي الخُنثى - إلى مشكل وغير مشكل، فالّذي يتبيّن فيه علامات الذّكوريّة أو الأنوثة فيعلم أنّه رجل أو امرأة فليس بمشكل، وإنّما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خِلقة زائدة."[6]
أمّا الطّب، فيُعرّفُ الخُنثى بأنّه؛ نتاج حادث جينيّ طارئ غير معتاد، فمن المتعارف عليه أنّ الأب يحمل الصبغ (y) و(x). أمّا الأم، فتحمل صبغا واحدا وهو الصبغ (x). فإذا ما لقّحت البويضة بالنطفة (y) كان الجنين ذكرا. وإذا لقحت البويضة بالنّطفة (x) كان المولود أنثى. لكن هذا الأمر قد يكون مختلفا في حالات نادرة. قد يحدث خلل في انقسام النّطف فيضم بعضها صبغتين جنسيتين (xx) بدل صبغي واحد، بينما يبقى الآخر خاليا من أي صبغيّ جنسيّ. فيكون النّاتج أربعة أصناف من النّطف عند الر ّجل (o.xx.yx.x) وتكون هناك فرصة لإنجاب أربع تركيبات من الأولاد من هذا الرّجل بعضها خُنثى على التّفصيل التّالي:
ـــ الأوّل: (yo) وهذا لا يعيش كما هو متعارف عليه.
ــــــ الثّاني: (xo) يسمى طبيا متلازمة تورنز tumer syndrime، وهو مخلوق ظاهره أنثى، ولكنّه بلا مبيضين ويكون مصابا عادة بعدد من التّشوهات البدنية، وهو لا ينجب ولا يحيض.
ـــــــ الثّالث: (xxo) يسمى طبيا متلازمة كلا ينفلتر klein filter syndrome وهو رجل شاذ الطّباع عديم الرّجولة تقريبا، وهو عقيم ولا ينجب.
ــــــــ الرّابع: (xxx) وهي طبعا أنثى، ولكن بإفراط في هذا الصّبغيّ الأنثويّ الزّائد لا يورثها زيادة في الرّقة والجمال والجاذبية كما هو حال النّساء غالبا، بل على النّقيض من هذا نجد أنّ بعض الحالات متخلفة عقليا أو مصابة بندرة الطّمث أو انقطاع الطّمث، وقد تكون بعض المصابات بهذه المتلازمة طبيعيات تماما.[7]
أحكام ميراث الخُنثى: اتّفق العلماء على أنّ الخُنثى يرث من حيث يبول؛ فإنْ بال من حيث يبول الرّجل ورث ميراث الرّجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة[8]، وإذا بال من العضويين معا فحكمه حكم أسبقهما في التّبول. فإنّ سبق ببوله من العضو الذّكري، فهو خُنثى ذكر، وإلاّ فهو خُنثى أنثى وفي الأوّل أحكامه أحكام الذّكور وفي الثّاني أحكامه أحكام النّساء.[9]
وينقسم الخُنثى إلى نوعين: خُنثى مشكل وخُنثى غير مشكل. أمّا الخُنثى المشكل: هو ذلك الّذي تختلط فيه علامات الأنوثة والذّكورة في آن واحد، وهو على نوعين الأوّل: أن توجد في المولود آلتان آلة الذّكورة والأنوثة. فيقع عندها الاشتباه حتّى تترجّح إحداهما بخروج البول منه. أمّا الثّاني: أن تنعدم آلة التّمييز أصلا بأن لا يكون للمولد آلة الرّجال ولا آلة النّساء وهذا أبلغ جهات الاشتباه.[10]
أمّا الخُنثى غير المشكل: هو الّذي يتبينُ فيه علامات الذّكوريّة أو الأنوثة، فيعلم أنّه رجلٌ أو امرأة. فليس بمشكل، وإنّما هو رجل فيه خِلقة زائدة أو امرأة فيها خِلقة زائدة.[11]
يُقال إن تبيّنَ لنا أنه ذكر ورث ميراث الذكر، وإن تبيّن لنا أنّه أنثى ورث ميراثها. وتتبين الذّكورة والأنوثة بظهور علامات كلّ منهما، وهي قبل البلوغ تعرف بالبول. فإن بال بالعضو المخصوص بالذّكر فهو ذكر، وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النّساء أو احتلم كما يحتلم الرّجال فهو ذكر، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو دُرَّ له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى، وهو في هاتين الحالتين يقال له: خنثي غير مشكل.
اختلف الفقهاء في مقدار ما يُعطى للخُنثى في الميراث على أقوال مختلفة منها:
الرّأي الأوّل: يكون له شرّ الحالتين وأقلّ النّصيبيْن وهذا مذهب الحنيفة، واستدلّ هذا الرأي بأن الأقلّ ثابت بيقين وفي الأكثر شكّ؛ لأنّه إن كان ذكرا فله الأكثر، وإن كان أنثى فلها الأقلّ فكان استحقاق الأقلّ ثابتا بيقين وفي استحقاق الأكثر شكّ. فلا يثبت الاستحقاق مع الشّكّ على الأصل المعهود في غير الثّابت بيقين أنّه لا يثبت بالشّكّ.[12]
الرأي الثّاني: أعطيَ نصف نصيب أنثى ونصف نصيب ذكر وهذا رأي المالكيّة.[13] واستدل أصحاب هذا الرّأي بأنّ أسوأ أحواله أن يكون أنثى وما زاد عليها فتنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزية على صاحبه؛ لأنّ الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتّداعي.[14]
الرأي الثّالث: يعامل كلّ من الورثة والخُنثى بأقلّ النّصيبين؛ لأنّه المتبقي إلى كلّ منهما واستدلوا بأن ميراث الأنثى هو اليقين وما عداه مشكوك فيه، فيوقف حتّى يتبين حاله وقالت به الشّافعيّة.
الرأي الرّابع: قالت به الحنابلة، ورأى أبو يوسف من الحنفية إن كان يرجى ظهور حاله، يعامل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي. وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ المتوسّط بين نصيبي الذّكر والأنثى. فيقول ابن قدامة: "ولأنّ حالتيْه تساوتا فوجبت التّسوية بين حُكميها كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما ولا بيّنة لهما وليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بهذا يحكّم لا دليل عليه ولا سبيل إلى الوقف؛ لأنّه لا غاية له تنتظر وفيه تضييعُ المال مع يقين استحقاقهم له".[15] والرأي الرّابع هو الأرجح عندنا والله أعلم.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشّرع كلّ بلد يأخذ برأي المذهب الرّسمي له. فالقانون مثلا في القاهرة يأخذ برأي أبي حنيفة ففي المادّة 46 منه للخُنثى المشكل، وهو الّذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أخذ بأقلّ النّصيبين وما بقي من التّركة يعطى لباقي الورثة.[16] وهذا ما ذهب إليه أيضا المشرّع الكويتي والمشرع القطري في المادة رقم "298". هذا فيما يخصّ ميراث الخنثى. فماذا قال علم المواريث في ميراث الغرقى والهدمى؟
2. ميراث الغرقى والهدمى
تعريف ميراث الغرقى والهدمى: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عامّ كهدم وغرق ونحوهما.[17] وينطبق هذا على كلّ من عُمي موتهم، وجهل المتقدّم من المتأخّر في الموت فلم يعرف اللاّحق. فيورث السّابق وينطبق عليها حوادث السّيارات والطّائرات والانفجارات والأمراض العامّة والمعارك.
حصر العلماء حالات الغرقى والهدمى، فقالوا: بأنّها لا تخرج عن الحالات الخمس التّالية:
1: أن يعلم موت المتأخّر من المتقدّم، فيورّث من تأخّر موته ممن سبق من أقاربه.
2: أن يعلم موت بيقين موتهم جميعا في وقت واحد بينهم؛ فقد اتّفق الفقهاء أنّه إن تيقّن أنّهما ماتا معا أنّهما لا يتوارثان.[18]
3: أن يعلم أن منهم متأخّر لا بعينه، فيعلم التّأخّر دون المتأخِّر.
4: أن يعلم أن أحدهم أسبق موتا من الآخر ثمّ ينسى، فلا يذكر أو يلبس تحديده.
5: أن يجهل موتهم فلا يعرف هل ماتوا جميعا في وقت واحد أم تأخّر موت بعضهم عن بعض.
من الواضح أنّ في الحالة الأولى يتمّ التّوارث. أمّا في الحالة الثّانية، فلا يتمّ ذلك، إلاّ أنّ الحالات الثّلاث الأخيرة، فقد اختلف فيها الفقهاء في حكم التّوارث فيها على قولين.
القول الأوّل: يتمّ التّوارث بين الغرقى والهدمى ومن في صفتهم وقالت به الحنابلة في رواية عمر بن الخطاب وعليّ _رضي الله عنه _ وقد استبدلوا ببعض الأدلّة منها:
عن إياس بن عبد الله المرنيّ أنّه سُئل عن أناس سقط عليهم بيت فماتوا جميعا فورث بعضهم من بعض.[19]
وروى أنّ عُمر وعليّا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيّهم يموت قبل: أنّ بعضهم يرث بعضا.[20]
القول الثّاني: أنّ الغرقى والهدمى لا يرث بعضهم بعضا، وهو قول الجمهور من الحنفيّة[21] والمالكيّة[22] والشّافعيّة[23] ورواية عند الحنابلة. فالعمل في كلّ متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيّهما مات قبل صاحبه، فإذا لم يعلم أيّهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا. وكان ميراثهما لمن بقيَ من ورثتهما يرث كلّ واحد ورثته من الأحياء.[24]
من الأدلّة الّتي استدلّوا عليها كحجج نذكر:
أخبرنا عبد الرّزاق عن عبّاد بن كثير عن أبي الزّناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: "أنّه يُورث الأحياء من الأموات ولا يورّث الموتى بعضهم من بعض."[25]
عمل الصّحابة حيث إنّهم يورثون من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرّة.[26] وقد وضع ابن قدامة بعض الأدّلّة العقليّة التي تثبت عدم توارث الغرقى والهدمى، وهي:
أ: أنّ شرط التّوريث حياة الوارث بعد موت الموروث، وهو غير معلوم ولا يثبت التّوريث مع الشّكّ.
ب: أنّه لم تُعلم حياته حين موت موروثه، فلم يرثه كالحمل إذا وضعته ميّتا.
ج: أنّ توريث كلّ واحد منهما خطّا يقينا؛ لأنّه لا يخلو من أن يكون موتهما معا أو سبق أحدهما به، وتوريث السّابق بالموت والميّت معه خطّا يقينا مخالف للإجماع فكيف يُعمل به.[27] قال ابن تيمية: منْ عميَ موتهم فلم يُعرف أيّهم مات أوّلا، فالنّزاع مشهور فيهم والأشبه بأصول الشّريعة أنّه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرثُ كلّ واحد ورثته الأحياء وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب أحمد؛ لكن خلاف المشهور في مذهبه؛ وذلك لأنّ المجهول كالمعدوم في الأصول.[28] هذا فيما تعلّق بميراث الغرقى والهدمى. فماذا قال علم المواريث في ميراث المجنون؟
3. ميراث المجنون
كرّم الله الإنسان حتّى في أضعف حالاته؛ من ذلك تكريمه للمجنون، فلم يبخسه حقّه من الميراث. فمن أصيب بالجنون لا تزول ملكيته عن أمواله قائمة، فإن استحقاقه لا يسقط بسبب جنونه، فإذا ثبت له إرث أو هدية أو نفقة؛ فهذا المال يكون ملكا له، ولسائل أن يسأل كيف له أن يتصرّف فيما ورث؟ فكّر الشّرع في هذا. فحالة الوارث تحول بينه وبين التّصرّف السّليم لما اكتسب. فالمال لا يسلّم له، وإنّما يعطى لوليه (وهو من يقوم بمصالحه) حتّى ينفق عليه منه. وهذا أيضا تكريم مرة أخرى حفظا لماله من التّلف والمفسدة. قال الله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا النساء/5.
شرح ابن كثير رحمه الله هذه الآية فقال: "ينهى تعالى عن تَمْكين السّفهاء من التّصرّف في الأموال الّتي جعلها الله للنّاس قياما، أي: تقوم بها معايشهم من التّجارات وغيرها. ومن هاهنا يُؤْخَذُ الحجر على السّفهاء، وهم أقسام:
فتارة يكون الحَجْرُ للصّغر؛ فإن الصّغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرُ للجنون. وتارة لسوء التّصرف لنقص العقل أو الدّين. وتارة يكون الحجر للفَلَس، وهو ما إذا أحاطت الدّيون برجل وضاقَ ماله عن وفائها، فإذا سأل الغُرَماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجَرَ عليه"[29]
اجتهد من بعد أهل العلم وتشعّبوا في أمر هذا الوليّ الّذي يتولّى التّصرف في ميراث المجنون فقالوا: إذا كان في بلدكم محاكم شرعيّة، فإنّه يرجع إلى القاضي الشّرعي ليعين وليا عليها، يكون مسؤولا عن أموالها. وإن لم يكن عندكم محاكم شرعيّة، فإنّ أولادها إذا كانوا بالغين راشدين يتفقون على أحدهم يكون هو الولي عليها. فإن حصل نزاع بينهم، فإنّهم يُحَكِّمون أحدا من أهل العلم في مدينتهم، فيختار الأصلح من أولادها ويجعله وليا على أموالها. وقال في ذلك أبو الحسن العدوي في حاشيته: "وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذّر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل".[30]
يمكن أن نذهب أبعد من ذلك بكثير في تكريم الإسلام للمجنون وضمان حقّه. فلو فرضنا جدلا أنّ المجنون كان قاتلا لصاحب الميراث هل يرث من قتل؟ ينبني على الرّاجح من أقوال الفقهاء في ميراث القاتل المجنون، ومذهب الشّافعية والحنابلة أنّه لا يرث، فالشّافعية منعوا من ميراث القاتل مطلقا، والحنابلة منعوا من ميراث القتل المضمون بقود أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كقتل المجنون. وأما الحنفية، فلا يرون قتل المجنون مانعا من الميراث، وكذا المالكية يورثون القاتل المجنون من المال ولا يورثونه من الدّية.
والذي نراه راجحا هو ما ذهب إليه الحنابلة والشّافعية في منع القاتل المجنون من الميراث مطلقا من المال ومن الدّية، لأنّه أقرب إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داوود وصحّحه الألباني.
خاتمة البحث:
إذا كانت المواريث مسألة متعلقة بالحقوق والأنصبة بات الأمر مع ذلك أكثر صعوبة وفي حاجة ماسة إلى الحيطة والحذر في التّعامل مع حقوق هذه الأقليّات. إنّ السّؤال الأكثر إحراجا مع هذه الحالات هو: هل الأحكام الفقهية في الميراث مع هذه الفئات، ستجد رواجا وتطبيقا أم إنّها ستكون في محلّ تنازع مع القوانين الوضعيّة والنّصوص التّشريعيّة المدنيّة؟
نحن نعتقد أن الكثير من القوانين منها القانون المصريّ على سبيل المثال إلى الآن، لم يوافق على تغيير النّوع البشريّ في بطاقة الرّقم القوميّ للمتحوّلين جنسيا؛ أي بعد إجراء عمليات على الخنثى، وصدر بذلك بعض الأحكام القانونيّة المؤيّدة لموقف وزارة الدّاخلية في رفضها لتغيير النّوع في بطاقة الرّقم القوميّ، وبذلك فحكم العابرين جنسيا ومن ثمّ الخُنثى عند ميراثهم سيكون باعتبار ما كانوا عليه، وليس بما صاروا إليه، إلاّ إذا تراضى بقية الورثة بتوريثهم باعتبار ما صاروا إليه بالتّراضي فيما بينهم، فهذا شأنهم.
[1] الفرق بين التّركة والميراث أنّ التركة هي المال والحقوق المتعلقة به، كالدين على الميت. والميراث هو المال الخالص من التركة الذي لم تتعلق به حقوق قط.
[2] ابن منظور، لسان العرب، ط3، ج2، دار صادر، بيروت، ص145
[3] الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، ط3، المجلد1، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، مصر، ص101
[4] علاء الدين بن مسعود الكسائي، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع، ط3، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، ص327
[5] أبو محمد محمود بن أحمد موسى بن أحمد بن حسين الغيتاني الحنفي بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ط1، ج13، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص528
[6] محمد ابن قدامة، المغني لابن قدامة، ط1، ج1، مكتبة القاهرة، ص336
[7] أحمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ط3، دار النّفائس، سنة 200.ص438، 439
[8] علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ط1، الفاروق الحديثة للطّباعة والنّشر، القاهرة، ج3، ص104
[9] محمد نعيم، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ط2، دار السلام للطّباعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة، مصر، ج2، ص236.
[10] محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السّرخسي، ط1، دار المعرفة بيروت، ج30، ص92
[11] محمد ابن قدامة، المغني لابن قدامة، ط1، ج2، مكتبة القاهرة، ص336
[12] علاء الدين بن مسعود الكسائي، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع، ط3، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، ج7، ص328
[13] أبو القاسم، محمد بن أحمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطيّ، القوانين الفقهية، ط1، الشرق للنشر والتوزيع، قطر، ص260
[14] القاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، ط2، المكتبة التجارية مصطفى احمد الباز مكة المكرّمة، ج3، ص1657
[15] محمد ابن قدامة، المغني لابن قدامة، ط1، ج2، مكتبة القاهرة، ج6، ص337
[16] السيد سابق، فقه الأمّة، ط3، دار الفتح للإعلام العربيّ، القاهرة، المجلد 4، ص351
[17] محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تسهيل الفرائض، ط1، دار ابن الجوزي، ص132
[18] ابن قطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ط2، ج2، دار المعرفة، مصر، سنة 2002، ص 113
[19] أبو بكر عبد الرزاق، المصنّف في الأحاديث والآثار، ط2، الجزء2، دار التأصيل، فاس المغرب، 2013م، ص274
[20] أبو بكر عبد الرزاق، المصنّف في الأحاديث والآثار، ط2، الجزء10، دار التأصيل، فاس المغرب، 2013م، ص 294
[21] علاء الدين بن مسعود الكسائي، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع، ط3، مطبعة شركة المطبوعات العلمية، مصر، ج4، ص166
[22] أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيّ، الاستذكار، ط1، ج5، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000.، ص376
[23] أبو الحسن البغدادي المشهور بالماوردي، الحاوي الكبير، ط1، ج8، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1999م، ص745
[24] مالك بن أنس بن مالك، الموطأ، ج3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1985م، ص745
[25] أبو بكر عبد الرزاق، المصنّف في الأحاديث والآثار، ط2، الجزء10، دار التأصيل، فاس المغرب، 2013م، ص 298
[26] مالك بن أنس بن مالك، الموطأ، ج3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1985م، ص745
[27] محمد ابن قدامة، المغني لابن قدامة، ط1، ج6، مكتبة القاهرة، ص 379
[28] ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج31، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة السعودية، 2004م، ص356
[29] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ج2، ص214
[30] أبو الحسن العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرّباني، دار الفكر بيروت، ج2، ص133