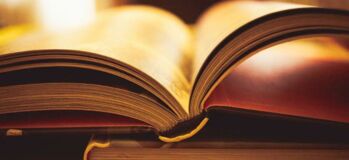نظرية العقل في القرآن الكريم
فئة : مقالات

نظرية العقل في القرآن الكريم
ملخص
يعيد هذا المقال النظر في السؤال أو الإشكالية القديمة الحديثة المتجددة عن تعارض العقل مع القرآن، أو عن تغييب القرآن للعقل، فيتبع جذور مدى صحة هذه الدعوى، محللا ومنتهيا إلى حتمية التكامل بين القرآن والعقل، العقل والقرآن. فيبدأ بإبراز إشكالية مفهوم العقل في التداول الإسلامي، مرورا بتحليل ووصف مكانة العقل قرآنا وسنة وأثرا؛ وذلك بإيراد نماذج وأمثلة نظرية، ثم يقدم نماذج تطبيقية لذلك. كما يعتمد البحث إضافة إلى الوصف والتحليل، منهج النقد؛ وذلك من خلال جمع المادة المتعلقة بالموضوع، ودراستها حسب المطالب والرد عن المخالفين.
يوصي المقال بأن تجرى المزيد من الدراسات المتجددة، تنظر نظرة تكاملية لكل من العقل والقرآن (الوحي)؛ وذلك بالنظر إلى مجال عمل كل منهما واختصاصاته، كما تقتضيه المنهجية المعرفية القرآنية، وعدم الخلط بين مجالات العقل ومجالات الوحي.
تمهيد
إصلاح العقل ليس غاية تراد لذاتها، وإنما هي قنطرة لابد من عبورها لتعقيل الممارسة الدينية، تلك الممارسة التي تستحضر القيم والمعاني الأخلاقية، ولا تقف عند ظاهر الممارسات الدينية بما يحولها إلى طقوس مفرغة من أي معنى روحي.
هناك أزمة عقل حقيقية اليوم، وممتدة منذ قرون، ومصاحبة للبشرية، ولا خلاص لها فيما اهتدت إليه البشرية في العلوم على كثرتها وأهميتها في تناول العقل من جوانب متعددة، وإنما خلاصها في كتاب الله عز وجل.
إننا في حاجة ماسة لجعل العقل مجاور للوحي، وليس مجاوزا له؛ لأنه دون أن نستنبت العقل في تربة القرآن الكريم، فسيبقى عقلا مهمشا أو عقلا مؤلها، وهذه هي التجربة التي عرفتها البشرية، إذا أردنا اختصار المسارات الحضارية والثقافية والفكرية، فالعقل إما مهمش أو مؤلّه.
ومنه، فإننا في هذه الدراسة سنحاول أن نعرف إن كان القرآن يعتبر العقل سندا، أو كما يقول علماء الفقه والأصول، هل العقل حجة؟ أي إذا كان المكتشف حقا من مكتشفات العقل الصحيحة، فهل ينبغي على البشر أن يحترموه وأن يعملوا بموجبه أم لا؟ فإذا عملوا به وارتكبوا في ذلك أحيانا خطأ ما، فهل سيعذرهم الله على ذلك أم سيعاقبهم؟ وإذا لم يعملوا به، فهل سيعاقبهم الله على عدم العمل به مع أن عقولهم قد حكمت بذلك، أم لا؟
أولا: تقريب مفهوم العقل
يصعب تحديد العقل بمفهوم جامع وشامل وشافي، نظرا لأن هذا التعريف نسبي جدًّا، نسبيةَ إدراك العقل لنفسه، الآتيةِ من نسبية العقل نفسه. وفي محاولة لتقريب مفهومه انطلقت من التعاريف الثلاثة الآتية:
ـ العقل هو: الموهبة الطبيعية والقوة الفطرية التي زود بها الإنسان وهي غير مادية ولا محسوسة، والتي بها يميز بين صحيح الفكر وسقيمه. وهذا المعنى هو الغالب في التراث الإسلامي. وإليه أشار الحارث المحاسبي (ت 243هـ) بقوله في تعريف بديع للعقل: "غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه، لم يطَّلع عليها العباد بعضُهم من بعض، ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برويّة، ولا بحس، ولا ذوق، ولا طعم".[1]
ـ العقل هو: آلية منهجية لممارسات عمليات الفهم والإدراك والتحليل والاستنباط وتعميم القواعد. وهذا التعريف يستعمل في الغالب عند المناطقة والفلاسفة، وخصوصا الفلسفة المعاصرة. فمن رواد هذا المذهب الباحث عمرو شريف.[2]
ـ العقل هو: الذي يماهي العقل بنتاجه، وهو تعريف جهده لا ينصب في التمييز بين العقل كآلية، وبين ما أنتجه من معرفة وفلسفة ومنطق وتحليل، وهذا التعريف هو الغالب على المدرسة العربية المعاصرة خصوصا. ولعل المفكر عابد الجابري أبرز رواد هذا الاتجاه، فتصوره لمفهوم العقل، هو تلك الأداة المفكرة التي تتخذ شكلها من ثقافتها الخاصة. إنه أداة لأنه لا يدل على مجموع التصورات التي ينتجها، بل هو تلك الميكانيزمات والنظم المعرفية التي توجه عقل ما نحو تصورات ضرورية حول عالمه الخاص.[3]
وقد قدم الفيلسوف طه عبد الرحمن مفهوما منحوتا واضحا عن العقل، أعلن فيه رفضه التام للنزعة التجزيئية التي سادت الفلسفة الغربية كما عهدناه، وبين فيه صفاته الجوهرية المتكوثرة[4]، ودرجاته العقلانية المتفاضلة، معتمدا في كل ذلك على نقبه وحفره الخاص واشتقاقاته اللغوية المبدعة.
فالعقل عنده يعتبر مجرد فاعلية، وليس ذاتا قائمة بنفسها، أو جوهرا مستقلا، يقول: "والمقصود بذلك أن العقل لا يقيم على حال، وإنما يتجدد على الدوام ويتقلب بغير انقطاع، فعلى خلاف ما ساد ويسود به الاعتقاد الموروث عن اليونان، ليس العقل جوهرا مستقلا قائما بنفس الإنسان، وإنما هو أصلا فاعلية، وحق الفاعلية أن تتغير على الدوام، نظرا لأن مقتضى الفعل أن يفعل، وكل ما يفعل يوجد بوجود أثره وينتفي بانتفائه، وليس العقل فاعلية فحسب، بل هو أسمى الفاعليات الإنسانية وأقواها، وحق الفاعلية الأسمى والأقوى أن تتغير على مقتضى الزيادة وأن تبقى على هذه الزيادة ما بقي العاقل"[5].
ثانيا: منزلة العقل قرآنا وسنة وأثرا [6]
استعمل القرآن الكريم لفظة "العقل" في صيغها ومتصرفاتها المختلفة 49 مرة[7]، هذا عدا مرادفاتها ومشابهاتها، مما يبرز الحضور الواسع والعريض لاستعمال العقل في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: {أفلا يعقلون} [يس/68]، وقوله: {لعلكم تعقلون} [البقرة/272]، وقوله: {وما يعقلها إلا العالمون} [العنكبوت/43].
إن الله أراد للإنسان أن يفكر في كل ما تعرضه عليه الرسالات، ويقدمه إليه الرسل من آيات الله ودلائل قدرته ومواقع عظمته ونعمته، مما يمثل الحجة عليه في خط الشريعة لأن الله يتعامل مع الإنسان من خلال عقله الذي أعده ليرشده إلى الحق، وليقوده إلى المعرفة الواعية المنفتحة على حقائق الحياة في دلالاتها ونتائجها، وهذا هو المنهج القرآني الذي أراده الله للإنسان عقلا وإرادة وحركة ومسؤولية في الحاضر والمستقبل.[8]
إن القرآن يقدم العقل في «صورة بسيطة» ليس فيها تعقيد ولا إبهام، يقدمه عقلا متأملا في الطبيعة، دارسا لظواهرها، مفكرا فيما هي عليه من دقة ونظام وإحكام، مقارنا في النتيجة بين الحقائق البديهية والأوهام المصطنعة، ليصل إلى يقين ثابت بوجود الخالق المبدع، الذي أوجد الكون على هذه الصورة الرائعة.
والقرآن الكريم إذا ما ادّعى دعوة إلا وكان له فيها من نفسه دليل بتعبير المفكر محمد عمراني حنشي. لذلك، فإن من أبرز مظاهر أزمة العقل المسلم المعاصر، سوء الظن بالعقل، على اعتبار أن جرأة العقل وانطلاقه وإفساح المجال له سيؤدي للتشكيك في الإيمان، والإضرار به، وبالعكس فإن الذي يتضرر من العقل، هي العقيدة الخرافية غير المؤسسة على الدليل، وغير المبنية على العلم الشرعي وعلى الوحي الصحيح بالنصوص المضبوطة. أما العقل، فهو خير سند للإيمان، إذا كان إيمانا صحيحا. والقرآن الكريم خير مثال على هذا التساند، وهذا التكاثف بين العقل والإيمان، ويبرز ذلك جليا في آيات القرآن، وفي سير الأنبياء ومواقفهم[9]. وهذه ليست دعوى إلى العودة لتأليه العقل كما عبرت بذلك فلسفة الحداثة، فإن هذا الأمر مُتجاوز، فنحن نسلم بأن العقل ما هو إلا جزء بسيط من كينونة النفس البشرية ولا يشكل إلا جزءا من عشرة بتعبير فرويد، وإنما هي دعوى لإعطاء العقل حقه ومكانته في السؤال والنقد[10] والتعبير عما يدور في خوالجه، باتزان وضبط، دون المبالغة في الثقة المطلقة فيه وحده، لأنها عملية متعبة جدا بتعبير أبو حامد الغزالي (ت 505هـ).[11]
والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيق، إنما يتحرك في مجال واسع جدا.. يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله، الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب أيضا; كما يحتوي أغوار النفس ومجالي الأحداث، ومجالات الحياة جميعا.. فالوحي لا يكف العقل عن شيء إلا عن انحراف المنهج، وسوء الرؤية والتواء الأهواء والشهوات! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعا. فهذه الأداة العظيمة التي وهبها الله للإنسان.. العقل.. إنما وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى الرباني.. فلا تضل إذن ولا تطغى[12].
إن إيمان العقل المسلم بالغيب وتصديقه لأموره العظيمة، لا يتم في صراع مع عقله؛ لأن هذا العقل يميز بين ثلاث دوائر: دائرة العقل ودائرة الوحي ودائرة الخرافة. وليس كل ما هو خارج العقل بالضرورة وحيا، ولا بالمقابل خرافة، وإن كانا يتطابقان عند الملحد، بمسمى أن كل ما هو خارج العقل خرافة، حتى ما كان غيبا أو وحيا أو عقيدة.[13] يقول الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله: "هناك ما يمكن أن نطلق عليه «العقلية العامة» أو «العقلية الخرافية»، وهي التي تصدق كل ما يقال لها أو يُعرض عليها، ولا تضعه موضع امتحان، بل تأخذه قضية مسلمة، ولا سيما إذا جاء من قِبل من تعظمه مثل الأجداد والآباء، أو السادة والكبراء. وفي مقابل هذه العقلية المتّبِعة، توجد عقلية أخرى مخالفة، لها مواصفاتها وخصائصها، وهي التي عمل القرآن بآياته الشرعية والموجهة على إنشائها وصياغتها، وإبرازها لتقوم بدورها في الحياة"[14].
إذن نستنتج مما تقدم، أن معجزة الرسول ﷺ هي القرآن الكريم، ومن ثَم فهي معجزة عقلية وعقلانية؛ إذ إن سائر معجزات الأنبياء السابقين انتهت بانتهاء زمانها، وكانت من جنس ما تفوق فيه أهل زمان كل نبي حتى تلائم تلك المعجزة طبيعة تلقي المخاطب لتلك الكتب وتلقي معاصري ذاك النبي. والرسول ﷺ باعتبار معجزته خاتمةً، كان لابد أن تكون معجزة عقلانية تتعدى الأزمنة وتعبُر الأحقبة وتخاطب الإنسان مهما تطورت معارفه ومهما تطورت إمكاناته ومهما تطورت قدراته العقلية. لذلك نعتقد أن المعجزة الرئيسة القرآنية في تثمين العقل وفي التحفيز على إعمال العقل، وفي استنهاض كل الطاقات الإنسان التي زودها الحق سبحانه من تدبر وتذكر وتبصر ونظر واعتبار... من أجل أن يمتلك هذا الإنسان القدرة على أن يدبر كل شؤونه من خلال الاستناد إلى هذه المَلكة النورانية التي زوده الحق بها. هذا على مستوى القرآن الكريم.
وعلى مستوى السنة، فكثيرة هي الأحاديث التي وصلتنا عن طريق كتب الصحاح عبرت وبشكل كبير عن احترام الرسول ﷺ العقل، أشهرها موقفه من اقتران وفاة ابنه إبراهيم بحادثة الكسوف. فوفاة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله تأثر لها النبي ﷺ أيما تأثر، وتأثر معه صحابته رضوان الله عليهم، وكان الموقف يتفجر بعواطف جياشة إثر فقدان ابن رسول الله. ولما تزامن ذلك مع هذه الظاهرة (الكسوف)، اعتقد الصحابة أن الشمس والقمر انكسَفتا لمشاركة الرسول والصحابة حزن موت سيدنا إبراهيم، فرد عليهم ﷺ بقوله: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا»[15]، انظروا إلى هذا الجواب العلمي الدقيق وسط جلجلة من العواطف التي كانت يمكن أن تغلب العقل، كيف احترم سيدنا رسول الله ﷺ العقل، وقدم الجواب والإقناع الكافي في هذه الظاهرة. فهذا موقف وحيد ينبئ عن الاحترام الكبير لسيد البشر للعقل دون التأثر بأية عاطفة مهما كانت. وكيف يتأثر هذا العقل النبوي وقد أعده الله أحسن استعداد في غراء حراء؟
ولا ضير أن نجد هذا المنهج النبوي قد تشرب الصحابة منه أيضا، وسأقدم نموذجين لصحابيين جليلين وقفا عند إمكانية العقل وقواعده في جو لو حدثت به أحدا لقال إنهم يسيئون الأدب في الحضرة النبوية ويبالغون في الاعتداد بعقولهم.
الأول: هو موقف سيدنا عمر بن الخطاب[16] من الحجر الأسود، فبعدما كان الرسول عليه السلام وصحابته في جو إيماني عالي في الحج، جاء رجل يجاهر بموقفه من الحجر الأسود بعد أن رأى رسول الله يقبله، ووقف هو عنده هنيهة واصفا له بأسلوب عقلي متميز: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك»[17]. فهو رضي الله عنه في هذا الموقف استصحب الموقف الأصلي، وهو أن الإسلام يحارب الوثنية، وأول مظاهر الوثنية تقبيل الحجارة، استصحب هذا الأصل، وبنى نفسه على هذا الموقف، فعبر عن موقفه العقلي، إنها قوة العقل في لحظة الإيمان، ثم ما لبث رضي الله عنه حتى استجاب لداعيه الإيماني «ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبّلتك أبدا»، وهذا التزام بقمة الإيمان والتسليم والطاعة، حيث سجد رضي الله عنه بين يدي الوحي بفعله.
قد يقول قائل: إنك تتحدث عن العبقرية العمرية بتعبير العقاد، وإن الرجل _أي عمر_ يمثل استثناء، فهو أحد المبشرين بالجنة، وأكثر من وافقه الوحي في آراء متعددة[18]، وبه أعز الله الإسلام[19]...غير أن هذا القياس ليس صحيحا، ولنعرض صحابيا آخر غير مشهور عند الكثير، وله موقف في غاية الأهمية من العقل لا يقل عن موقف سيدنا عمر، وأوردناه متعمدين حتى يتبين أن هذا الاختيار العقلي حالة ثقافية عامة، شائعة عند عموم الصحابة والأجيال الأولى، وليس حالات استثنائية مرتبطة بشخصيات "عبقرية".
الثاني: قال الإمام أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليهما إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس، وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، فقال يا رسول اللهِ أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال، بل نسيت يا رسول اللهِ فأقبل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على القوم، فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، فرجع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى مقامه، فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو، فقال لم أحفظه عن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم.
الشاهد لدينا من الحديث، قول ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فأجابه رسوله الله: «لم تقصر ولم أنسَ»، ليرد ذو اليدين بقوله: بل نسيت يا رسول اللهِ. انظروا إلى هذه القِسمة العقلية، وإلى استحالة عقل ذو اليدين قول النبي عليه السلام: «لم تقصر ولم أنسَ»، فقد فهم ذو اليدين من فعل رسول الله باستخدامه للميزان العقلي، أن الصلاة إما قصُرت أي حدث فيها وحي فشرَع تقصيرها، أو نسي النبي عليه السلام، ولا يمكن أن يُتصور شيء ثالث. فعبر بقوله: «بل نسيت يا رسول اللهِ».
ثالثا: وقفة مع رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام
قد يعتبر أحدا عقل رحلة سيدنا إبراهيم إلى الله عز وجل، على سبيل المثال، عبر الكواكب والأفلاك حيرة وتيها وضلالا. هكذا يقولون الذين يظنون بالعقل ظن السوء، مُضحين في سبيل ذلك بسياقات النصوص القرآنية. إنهم يقتحمون عليها منطقها الخاص، ويدخلون فيها ما ليس منها، محدثين زيادات تفسد الروح العامة للنص، من حيث لا يدرون. والحاصل أن رحلة سيدنا إبراهيم عليه السلام دليل على اعتداده بعقله. فهو العقل الذي رَقي به في مقامات الاقتراب من الله عز وجل، فكان بذلك عقل هداية ورشاد[20].
إن إبراهيم كان يعيش حركة الفكر الذي يريد أن ينمي من خلاله أفكاره وإيمانه، بكل الأشياء التي تركز للفكرة قوتها وفاعليتها وثباتها وحركتها أمام التحديات التي تواجهها، حتى في ما يشبه الأوهام، ليواجه الصراع الذي يعيشه، بانفتاح وقناعة وقوة لا تعرف الضعف ولا التراجع في كل المجالات.
إن الرؤية التي يتحدث عنها في قوله تعالى ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 75] هي الرؤية الواعية الفاحصة المدققة التي تثير في النفس المزيد من التأمل والحوار والاستنتاج بدليل قوله ﴿ولِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75] مما يوحي بأنها الرؤية التي تبعث على القناعة واليقين.
ولنقف مع الآيات بتمامها وكمالها لبيان هذا الجهد العقلي الإبراهيمي الذي خلده لنا القرآن الكريم. يقول الله تعالى:
﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 79].
توضح الآيات صفاء فطرة سيدنا إبراهيم في إيمانه، حيث تنعطف هذه الآيات انعطافا متميزا في حديثها عن العقيدة، "متجهة إلى الفطرة الصافية، التي تنساب منها الأفكار بعفوية وبساطةٍ، قادرة على مواجهة الانحرافات الفكرية دون تعقيد فلسفي تحليلي، لا لأن الفكر الإيماني لا يتحرك في اتجاه العمق في عملية الحوار، بل لأنه يواجه قضايا الصراع من منطق الواقع في مفردات التصور وأدوات الساحة، فلا يعمل على أساس الحالة الذاتية للمفكر، بل على أساس الحالة الواقعية الإنسانية للآخرين؛ لأنهم يطمحون أن يعيشوا الإيمان في تجربتهم لتكون حركة الإيمان لديهم، قضية محاكاة لا قضية معاناة"[21].
في صرخة الإنسان الطيب الذي خُيل إليه أنه اكتشف السر الكبير الذي يبحث عنه كل الناس، كما لو لم يكتشفه أحد غيره، وكأنه أقبل إليه في خشوع العابد، وفي لهفة المسحور، وفي اندفاعة الإيمان، وربما ردد هذه الكلمة ﴿هَٰذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 78]، ليوحي لنفسه بالحقيقة التي اكتشفها بعيدا عن كل حالات الشك والريب .. ثم بدأت تغيب وتأفل وتترك الكون في حيرة عجيبة، وضجت علامات الاستفهام في روحه تتساءل من هو الإله؟ وأين هو؟ وعاش في التصور الضبابي المبهم الغارق في الغموض يتوسل بالرب الذي لا يعرف كنهه، أن يهديه سواء السبيل لئلا يضل ويضيع ﴿لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: 77] وما زال ينتظر وضوح الحقيقة.[22]
إن العقل لا يصل إلى اليقين وإن كان يقطع في يقينه، إن شرف الحس على العقل هو أيضا أن ننظر إلى العقل بعين البصيرة وليس العكس، حيث يتبين حينذاك ما يأخذه العقل من الحس، يقول ابن عربي: "وانظر بعين بصيرتك إلى العقل، فإنك تجد براهينه واعتماداته في اقتناء علومه التي يقطع بها مبنية على ما يأخذ من الحس"[23].
وما دام العقل بطبيعته قلقا، مشاغبا، جريئا، يطرح أسئلة أكبر منه، وهو لا يستطيع أن ينفك عنها، واصل سيدنا إبراهيم طريقة استنكافه عن التساؤل والشك[24]، رغم اقتحامه درجة النبوة وصار كليم الله، فاختار عليه السلام التساؤل عن لغز إحياء الله الموتى! قال تعالى:
﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 258].
وقد أبدع الأستاذ المقرئ أبو زيد في تفسير هذا الجهد العقلي الإبراهيمي، في رصد هذه الرغبة الشديدة في المعرفة من إبراهيم عليه السلام، واجملها في الآتي:
- جرأة سيدنا إبراهيم على ترجمة هذه الرغبة الداخلية إلى طلب يوجه إلى الله. وهذه جرأة عقلية كبيرة تدل على اعتداد سيدنا إبراهيم بعقله، وإيمانه بحق هذا العقل في أن يطمئن.
- الثبات على هذا الطلب؛ لأن مراجعة (أولم تؤمن) على رقتها، يمكن أن تذيب الجبال؛ لأنها من رب العزة. وكان يمكن لسيدنا إبراهيم عليه السلام مباشرة بعدها أن يتراجع ويقول يا رب اغفر لي، لقد شككت وإني أتوب إليك. لكنه بالعكس قالى (بلى) و(لكن). إنها (لكن) الاستدراكية التي لا تناقض (بلى): إن القلب مطمئن، أما العقل فله قوانينه الخاصة، ويريد استجابة لهذه القوانين، على أساس أن منطق الاستدلال العقلي مختلف عن منطق الاستدلال القلبي.
رابعا: في حاجة للاستفادة من تجربة المسلمين الغربيين
كتب الباحث "جيفري لانغ"[25] كتابه "الصراع من أجل الإيمان" حيث اتكأ على عقله، وبدأ يقرأ ترجمة القرآن، داخلا في معركة حادة مع القرآن وفي مبارزة عقلية معه، بل إن معظم كتبه تتسم بهذه الخاصية، حيث كان الرجل يكثر من طرح الأسئلة الفضولية الحارقة[26]. فما إن يعدد الأسئلة التي قد تطرحها عليها الآية الواحدة إلا ويجيئه الجواب مباشرة في الصفحة الموالية من القرآن، فيظن الرجل أنه أمسك بخناق القرآن، فإذا به مرة أخرى يصرعه بأسئلة أخرى منطلقا في بيان إشراقات العقل في القرآن الكريم إلى أن انتهى إلى التسليم بتعبير علي عزت بيغوڤيتش[27].
إن هذا التصارع العقلي بتعبير جيڤري لانغ هو ما نحتاجه اليوم، فإطلاق عنان العقل داخل النص القرآني مع احترام قواعده اللغوية والأصولية والعامة التي هي من صميم العقل، ومن صميم الفطرة ايضا، لا يشكل أي حرج البتة؛ لأن الارتماء في أحضان العقيدة الصحيحة المدعومة بالعقل وقواعده، لا يتصور منه إلا نتيجة إيجابية متماسكة، ولنقرأ ما كتبه جيڨري: "إذا كنا لا نستطيع إبراز الإسلام على أنه متوافق تماما مع التفكير العقلاني، فإن الإيمان بالنسبة إلى المسلم الغربي لن يغدو أكثر من مجرد مسألة تجربة شخصية وروحية، شأنه في ذلك شأن الكثير من أتباع الديانات الأخرى في الغرب. إن الإيمان في هذه الحالة سوف يفقد الكثير من قدرته على الإقناع. إن التفكير العقلي يمكن الإفصاح عنه ومناقشته بشكل فعال تماما مع الآخرين، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على التجارب الروحية"[28].
خامسا: التسليم البيغوفيتشي
أشرنا سابقا إلى أن اقتحامنا لهذا المدخل العقلي لا يعد رجوعا إلى عصر الحداثة، _عصر تأليه العقل _، فإن ذلك متجاوز[29]، ولا أن نقدم مثالا لكمال الثقة المطلقة في العقل[30] بل نريد إعادة بوصلة العقل المفكر المتأمل وفقا للقواعد التي ينتظم بها هو نفسه والقواعد التي ينتظم بها النص المراد دراسته، والخروج من عطالة الإبداع بتعبير الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي.[31]
وما أجمل ذلك المصطلح الدقيق الذي استعمله "علي عزت بيغوفيتش" رحمه الله في كتابه الرائع "الإسلام بين الشرق والغرب"، استعمل مصطلح "التسليم" كآخر فصل في الكتاب تنبيها منه إلى الحذر كل الحذر من الثقة المبالغ فيها تجاه العقل، وأنه يمكن التوصل عن طريقه إلى كل المعارف، فلو سلّمنا بذلك لسقط احترام العقل البشري بتعبير سيد قطب رحمه الله؛ لأن "العقل البشري ليسقط احترامه حين يدّعي أنه يعلم كل شيء، وهو لا يعلم نفسه، ولا يدري كيف يدرك المدركات، وليس في هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته، ولكن فيه احتراما لهذا الفكر بمعرفة قدره ومجالاته"[32].
وإن رحلة علي عزت في هذا الكتاب من التعرض للعلوم والفنون والفلسفات وصلتها بالأديان أدت به لعقد هذا الفصل المتميز بالتسليم بدل ادعاء الإحاطة بكل شيء، يقول رحمه الله: "للطبيعة حتمية تحكمُها، وللإنسان قَدَرُه. والتسليم بهذا القدر هو الفكرة النهائية العليا للإسلام"[33].
إن الإسلام لم يأخذ اسمه من قوانينه ولا نظامه ولا محرماته ولا من جهود النفس والبدن التي تطالب الإنسان بها، وإنما من شيء يشمل هذا كله ويسمو عليه: من لحظة فارقة تنقدح فيها شرارة وعي باطني.. من قوة النفس في مواجهة محن الزمان.. من التهيؤ لاحتمال كل ما يأتي به الوجود.. من حقيقة التسليم لله. إنه استسلام لله. والاسم إسلام[34]!
[1]الحارث المحاسبي، ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه، تحقيق: حسين القوتلي، دار الكندي/دار الفكر. 1982م، ط3، ص201
[2] انظر على سبيل المثال كتابه: "ثم صار العقل مخا"، د. عمرو شريف، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط1، 2012م.
[3] ولتعميق هذا المعنى أدعوا للنظر إلى رباعية الجابري عن العقل: ـ تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي، العقل السياسي العربي، العقل الأخلاقي العربي.
[4] المتكوثرة مصطلح صاغه الدكتور طه عبد الرحمن، وهو من التكوثر ويقابلها العديد من النظائر المشتقة منه، مثل: التكاثر، التكثر، الإكثار...وكلها تفيد النفع والضر في الوقت نفسه، بينما التكوثر لا يكون إلا في ما يفيد، ولا تكوثر فيما =يضر. يقول : "الأصل في العقل هو الكثرة وليس الوحدة كما يعتقد عامة الناس وخاصتهم، فالتكوثر يجلب للعاقل ما فيه ظهور إنسانيته وارتقاؤها في مراتب متفاوتة، حتى تشرف على أفق الكمال العقلي. فالعقل إذن يتكوثر من أجل جلب المنفعة لصاحبه آجلا أم عاجلا، أما العقل الذي يجلب المضرة له فهو العقل المتقلب؛ أي الواحد الذي لا يتغير". طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص21
[5] طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، بيروت، المركز الثقافي العربي، بيروت- لبنان، ط2، 2012م، ص22
[6] لقد أبدع فيلسوف المرابطة طه عبد الرحمن لما جعل محل العقل في الشرع نفسه، وليس متجاوزا له كما يعبر البعض، فقال: "لا يمكن أن ننكر أن هناك تأثيرا يونانيا على المسلمين فرضا، إما عن طريق الفلاسفة أو عن طريق غيرهم، حتى غدونا نسمع في الخطاب الفقهي مثلا عبارة (هذا لا يصح عقلا وشرعا) وكأن الشرع لا عقل فيه، وكأن العقل لا شرع فيه، وكأننا حينما نقول: (الشرع) نكون أمام تقريرات غير معللة، حتى اعتقد أن العقل ليست فيه إلا التقريرات المدللة، وأن الشرع يخلوا من التعليلات والأدلة". أنظر: طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2013م، ص41
[7]يوسف القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكريم، مكتبة وهبة، ط1، القاهرة، 1996م، ص13
[8]محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن، دار الملاك للطباعة والنشر، لبنان، 2018م، ط3، ج7، ص32
[9]المقرئ أبوزيد الإدربسي، القرآن والعقل، مؤسسة الإدريسي الفكرية للأبحاث والدراسات، الدار البيضاء، ط5، ص12
[10] النقد بمعناه اللغوي، أي بيان القيمة.
[11] للإشارة، فإن أبا حامد رحمه الله لم يلغ إعمال العقل في تجربته أو أنكر فائدته كما ادعى ذلك بعض أبناء جلدتنا، ودليلنا على ذلك أنه يخصص في كتاب الإحياء بابا يتحدث فيه عن شرف العقل وقيمته. فالرجل رحمه الله يلمس حدود العقل، لكنه لا يقف عند هذا العجز ولا عند معطيات الابستمولوجيا، بل إنه يفرض درجة أرقى من المعرفة تتجاوز المعرفة العقلانية، وهو ما سماه: "إدراك النبوة" الذي يستطيع أن ينفذ إلى عالم الغيب. يقول: "...بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة والعقل معزول عنها كعزل السمع عن إدراك الألوان، والبصر عن إدراك الأصوات". انظر: الإحياء، ج1، ص65
[12] سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشرق، القاهرة، ط2، 1968م، ج2، ص690
[13]المقرئ أبوزيد، القرآن والعقل، ص127
[14]يوسف القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكريم، ص249
* لتبسيط الفكرة: الوحي خارج العقل والخرافة خارجة العقل، لكن الوحي فوق العقل، أما الخرافة فتحت العقل؛ بمعنى أن الخرافة ضد العقل، وإذا كان العقل لا يستوعب مقتضيات الغيب، فهو يقبل من حيث المبدأ بإمكان وجودها، بخلاف الخرافة فإنها تكسر قواعد العقل، ومنه فإن قبول الدين يحتاج إلى إعمال العقل لا إلغائه.
[15] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس.
[16]شخصية سيدنا عمر بن الخطاب ملفتة للانتباه حقيقة؛ لأن لها القدرة على التحليل والنقد دون التسليم من بادئ الأمر
[17]أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود.
[18] قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه». أنظر: سنن الترمذي، ج6، ص57، رقم3682، كتاب المناقب، باب17، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
[19] روى أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرّي في كتاب الشريعة بإسناده، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر رضي الله عنه فأصبح فأسلم». أنظر: الآجري في الشريعة، ج3، ص87
[20] المقرئ أبوزيد، القرآن والعقل، ص172
[21] محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن، ج7، ص176
[22]المرجع السابق، ج7، ص ص179-180
[23] محيي الدين بن عربي، اليقين من رسائل محيي الدين بن عربي، تحقيق سعيد عبد الفتاح، مؤسسة الانتشار العربي، (د.ت)، ص ص19-20
[24] كلمة الشك مثيرة للخوف عند بعض الناس، إلا أن الذي نريد إيصاله منها ليس الشك المريب ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ [فصلت: 45]، وإنما نقصد الشك الذي يخلق حالة من التساؤل بتعبير الفلاسفة.
[25] جيفري لانغ، أستاذ الرياضيات بجامعة شيكاغو، ألحد وهو في سن السادسة عشرة، واعتنق الإسلام في سن السادسة والعشرين من عمره، ألف كتبا متميزة ترجمت إلى اللغة العربية وغير العربية منها: "حتى الملائكة تسأل"، "الصراع من أجل الإيمان"، "ضياع ديني"
[26] أنظر على سبيل المثال قوله: "لم نكد نمضي في قراءة سبع وثلاثين آية من القرآن إلا وقد أثير قلقنا واستياؤنا إلى الحد الأقصى. ونسأل: لم (يا رب) تخضع الجنس البشري إلى ألم دنيوي؟ لم لا تنقلنا إلى الجنة أو لم تضعنا هناك منذ البداية؟ لماذا كتبت علينا، معشر البشر، الصراع من أجل البقاء؟ لم خلقتنا ضعفاء وأعداء لأنفسنا مدمرين لها؟ لماذا كتبت علينا أن نحيى بقلوب منكسرة وأحلام محطمة، بحب ضائع، وشباب زائل، وأزمات ومحن لا تحصى؟" انظر: جيفري لانغ، حتى الملائكة تسأل، ترجمة منذر العبسي، دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان، ص47.
[27] لنا عودة مع هذا المصطلح البيغوڤيتشي إن شاء الله.
[28] جيڤري لانع، حتى الملائكة تسأل، ص27
[29] القطيعة الابستمولوجيا بتعبير علماء الاجتماع
[30] هنا أستخدم قول فرويد: "كان الاعتقاد سابقا هو أن العقل البشري هو منتج الحقيقة، وهو أداة الإرادة ومنتج المعنى، فكشفت أن العقل ما هو إلا جزء بسيط من كينونة النفس البشرية لا يُشكل إلا جزءا من عشرة، وتسعة الأعشار الأخرى هي اللاشعور هي اللاوعي، بل اللاوعي يتحكم في العقل ويقوده ويوجهه، فصار العقل عبدا للاعقل"، وقول ديكارت "إن العملية التي سأُقدم عليها عملية هدم من الجذور (يقصد عملية الثقة المطلقة في العقل خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل الاعتقاد) لمختلف البنية المعرفية التي احملها ولا أنصح بها كل الناس".
[31] انظر كتابه: النخب العربية وعطالة الإبداع في منظور الفلسفة القرآنية.
[32] سيد قطب، التصور الإسلامي في القرآن، دار الشرق، بدون تاريخ، ص257
[33] علي عزت بيغوڤيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، مؤسسة العلم الحديث- بيروت، ط1، 1994م، ص396
[34] المرجع السابق، نفس الصفحة.