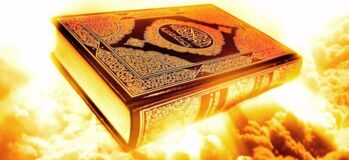نَظْمُ القُرْآنِ قراءةٌ جديدةٌ فِي تَجَانُسِ إيقاعِهِ وَتَلَاحُمِ بِنَائِهِ جوهر محمد داوود
فئة : قراءات في كتب
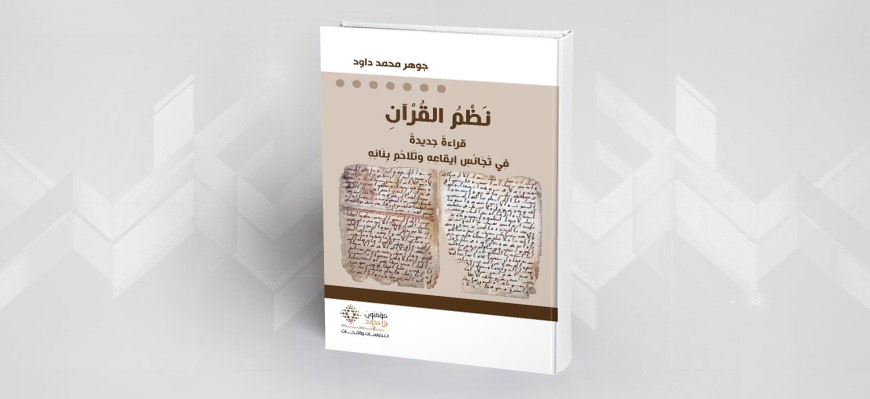
نَظْمُ القُرْآنِ قراءةٌ جديدةٌ فِي تَجَانُسِ إيقاعِهِ وَتَلَاحُمِ بِنَائِهِ
جوهر محمد داوود
نَظْمُ القُرْآنِ قراءةٌ جديدةٌ فِي تَجَانُسِ إيقاعِهِ وَتَلَاحُمِ بِنَائِهِ، لجوهر محمد داود، صدر عن دار مؤمنون بلا حدود، الشارقة، بيروت، 2022م.
هناك العديد من الكتابات والمؤلفات والدراسات والأبحاث، التي اعتنت بنظم القرآن من زوايا مختلفة، وبرؤى ومناهج مختلفة، وجلّها خلص إلى نتائج متقاربة أو متباينة فيما بينها، وهذا دليل وتأكيد أن القرآن يتفرد بنظمه الفريد، وهو نظم يتكشف ويتجدد اكتشافه، بتجدد نظم المعرفة في مجال اللغة وعلوم الإنسان والكون، أهمية الدراسة التي قدمها محمد داود، أنها اختارت أن تنطلق من القرآن وتعود إليه، في استحضار ومراعات جل ما كتب حول موضوع نظم القرآن، سواء ما كتبه الأقدمون أو ما كتبه المعاصرون، سواء منهم المستشرقون أو المسلمون العرب وغير العرب، وهو أمر جعل محمد داود يتفرد يكشف الغطاء على وجه محجوب في نظم القرآن، ويتعلق الأمر بموضوع الإيقاع والوزن والفصاحة، وقد كان مقنعا، عندما وقف عند المساحة الفاصلة بين الشعر وبين فصاحة الكلام؛ إذ اتضح بأن نظم القرآن لا ينضبط ولا يستجيب لمختلف القواعد التي تصدق على الشعر وفصاحة الكلام، كما اتضح أن فصاحة القرآن وإيقاعه مستمدان من نظمه الداخلي وليس من خارجه.
يرى جوهر محمد داود، أن كتابه "نَظْمُ القُرْآنِ قراءةٌ جديدةٌ فِي تَجَانُسِ إيقاعِهِ وَتَلَاحُمِ بِنَائِهِ" يَقْتَرحُ نظريةً جديدةً عن الأساسِ الذي يقوم عليه بناء السورة. فمن المعلوم أنَّ السورة القرآنية لا تتناول موضوعًا واحدًا، وإنما تتناول موضوعات متعددة، كإثبات الوحي، والحِجَاج مع المشركين، وقصص المرسلين، ومشاهد القيامة، والآيات الكونية، والأحكام التشريعية، وغيرها. وعلى مدار القرون، لم يستطع علم المناسبة أن يَعْثُرَ على خيطٍ فريدٍ يجمع بين هذه الموضوعات المتعددة من خلال المعاني المشتركة بينها"[1] ويؤكد أن هذا العمل يصب في "مشروعٌ يحاول أن يَدْرُسَ القرآن في صورتِه الخامةِ في المصحف قبل أَنْ تُسَلَّطَ عليه قوانينُ النحوِ، وقواعدُ البلاغةِ، ومذاهبُ التفسيرِ، وأدواتُ التأويل، وهو في الأصل أطروحة نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة باللغة الإنجليزية.[2]
أما عن مفردة نظم الواردة في عنوان الكتاب، فمصطلح "النظم" واسع المدلول، متعدد المعاني؛ إذ يعني التركيب، أيْ دخولَ الكلمة في علاقات نحوية مع غيرها من الكلمات لتكوين الجملة، ثم النص. ويعني كذلك الترتيب؛ أيْ تنسيقَ الكلمات والجمل والفقرات على نحو معيَّن يُخْرِجها من حيِّز الفوضى إلى حيِّز النظام، فيَجمعها بعد تفرُّق، ثم يكسوها الجلال والجمال. ويعني كذلك الأسلوب؛ أي الطريقةَ التي يسلكها كل نص للتعبير عن أغراضه، ويتميز بها عن غيره من النصوص سواء في إيقاعه في السمع أو تأثيره في النفس. ويعني كذلك تنظيم الأفكار والمعاني في أجزاء النص الواحد، حيث يرتبط بعضها ببعض، ويتصل السابق منها باللاحق، والمقدمة بالنتيجة. ونظم القرآن –على النحو الذي استُعمل به في سياق هذا الكتاب– يتضمّن كل هذه المعاني، وهو أوسع في مدلوله مما عنى به الأقدمون عند إطلاقه. وأهم ما يميز معنى النظم في سياق هذا الكتاب تركيزُه بصورةٍ حصريةٍ على دراسةِ النصِّ القرآني، لا على دراسة العلوم والمعارف والنظريات التي دارت حوله، وبهذا يفترق منهج هذا الكتاب عن المناهج التي اتبعها السابقون لدراسة القرآن."[3]
مصادر الإيقاع في القرآن وفي الشعر
الإيقاع لغة مأخوذ من الجذر الثلاثي (و. ق. ع) والوقْعُ: وَقْعةُ الضَّربِ بالشيءِ ومنه وقعُ المطر، ووقْعُ حوافر الدابة، وهو الصوت الذي يُسمع منهما، الإيقاع إذن له علاقة بما يسمح، فالشعر المزون يطرب النفس والمستمع، والإيقاع في الموسيقى ينتج عنه تناسب الأصوات، فاللحن يتكون من درجات في تناسب الأصوات.
وقد توقف المؤلف عند موضوع الإيقاع في الشعر العربي، في سياق الحديث عن الشعر يذكرنا محمد داود بأبرز الخصائص التي يتميز بها الشعر، وهي الوزن والقافية، ولكن بالنسبة إلى القرآن إذا نظرنا له في "مجمل لخصائص النظم في الشعر، لم نجد في آياتِه مقاطعَ متساويةً تتردد بانتظام؛ ذلك لأنّ القرآن ليس موزونًا ولا مقفًّى، وإن كانت فيه الفاصلة التي تشبه القافية ولكن لا تماثلها. فآيات القرآن تتفاوت في طولها تفاوتًا شديدًا. فبعضها يتكون من كلمةٍ واحدة، وبعضها من بضع كلمات، وبعضها من عدد من الجمل"[4] والسؤال هنا من أين ينبعث الإيقاع في القرآن وسوره؟ يجيبنا محمد داود "إنّ الإيقاع في القرآن ينبعث من حروفه وكلماته وفواصله جميعًا. إنه ينبعث من تردد الحروف والتنوين والضمائر وأدوات النحو والفواصل في أنساقٍ متنوعةٍ ومتجددةٍ لا تكاد تُحْصَى".[5]
توقف محمد داوود عند الكثير من أقوال المتقدمين، الذين يؤكدون أن فصاحة الكلام لا تقبل التكرار، والمفارقة هنا أن القرآن يحضر فيه التكرار بشكل طبعي وغير مخل للفصاحة والأمثلة في القرآن كثيرة من بينها في هذه الآيات الثلاث من سورة غافر: ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ * تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ * لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: 41-43].
نفهم من طرح محمد داود أن القرآن مخالف للشعر من جهة إيقاعه، فهو لا يخضع للوزن ولا للقافية، ومخالف لفصاحة الكلام التي لا تقبل التكرار؛ فالقرآن لا مشكلة لديه مع التكرار، وهذا الفهم نجده عند طه حسين، فهو يرى أن "نظم القرآن أي أسلوبه في أداء المعاني التي أراد لله أن تُؤدَّى إلى الناس. لم يؤدِّ إليهم هذه المعاني شعرًا ... ولم يؤدِّها إليهم نثرًا أيضًا، وإنما أدَّاها على مذهب مقصور عليه وفي أسلوب خاصٍّ به لم يُسبق إليه ولم يُلحق فيه. ليس شعرًا لأنه لا يتقيد بأوزان الشعر وقوافيه، وليس نثرًا لأنه لا يُطلق إطلاق النثر ولا يُقَيَّدُ بهذه القيود التي عرفها الكُتَّاب في الإسلام، وإنما هو آيات مفصلة لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصال وفي الطول والقِصَر".[6] ففي رأي طه حسين "القرآن كان أساسا للنحو العربي قبل أي شعر أو نثر."[7]
وهذا يعني ان فصاحة القرآن وإيقاعه متصلان بنظمه وأحرفه؛ أي بمحتواه الداخلي. وهذا ما استطاع أن يبينه جوهر داود من خلال دراسته وتتبعه للأحرف بكونها موضع الإيقاع في القرآن، كما أنه توقف عند مصادر أخرى للإيقاع في القرآن من بينها التنوين والضمائر والتكرار والفاصلة...
طبيعة الحروف، لها إحساس بوقع إيقاعها في الأذن يعتمد على فهمنا لطبيعة كل حرف ونسبة شيوعه في القرآن وفي اللغة، "هناك وظيفتان أساسيتان للحروف في النظام اللغوي؛ فالوظيفة الأولى هي أنّ الحروف تشارك في بناء الكلمات، وهذه الوظيفة تؤديها جميع الحروف الثمانية والعشرين التي في النظام الهجائي بوصفها المواد الأولية لبناء الكلام، ويمكن أن نسميها وظيفة هجائية. والوظيفة الثانية هي أنها تشارك في بناء النظام النحوي للغة، وهذه الوظيفة تؤديها فقط بعض الحروف، ويمكن أن نسميها وظيفة نحوية. فالحروف التي تؤدي كلًّا من الوظيفتين الهجائية والنحوية هي الأكثر شيوعًا في اللغة، في حين أنّ الحروف التي تؤدي الوظيفة الهجائية وحدها هي الأقل شيوعًا. وفي علم اللغة الحديث يسمى كل حرف يؤدي الوظيفة الهجائية بالفونيم (phoneme)، والذي يؤدي الوظيفة النحوية بالمورفيم (morpheme). والفونيم هو أصغر وحدة كلامية تفترق بها كلمة عن أخرى، نحو التاء والسين في «كَتَبَ» و«كَسَبَ». أما المورفيم، فهو أصغر وحدة دلالية في اللغة كالكاف الأولى في قوله تعالى: ﴿وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾ [طه: 34]؛ لأن هذه الكاف ليست جزءًا من بنية الكلمة نفسها، وإنما جيء بها لتفيد الخطاب، أي لتؤدي وظيفة نحويةً هي وقوع الفعل عليها."[8]
توقف الكاتب عند دراسة مجموعة من الحروف ودورها في إيقاع القرآن، كما توقف عند التكرار والضمائر والفاصلة وواو الجماعة... من خلال سرد الكثير من الأمثلة من آيات القرآن الكريم، وهناك أمر في غاية الأهمية نبّه إليه محمد داود، ويتعلق بأهمية التركيز على التلقي بالسمع للقرآن؛ لأن الأُذُنَ هي مَنْفَذُ القرآنِ الأولُ إلى القلب والنفس والعقل، وأن شطراً من تأثيره يكمن في الجهر بقراءته. ولا شك في أن للبناء اللفظي للقرآن دخلًا في تأثيره الصوتي مما يعني أن القالب اللفظي الذي يحمل رسالة القرآن لا يقل أهمية عن رسالته، وأن جمال صوته يوازي جلال معناه. ولا يزال القرآن يتلى بعد مُضِيِّ أربعة عشر قرنًا من نزوله، لا يَخْلَقُ على كثرة الرد، تتجدد عذوبته في السمع في كل مرة يتلى فيها في مشارق الأرض ومغاربها، ويتلذذ بالاستماع إليه من يعرف العربية ومن لا يعرفها.[9]
التلاحم اللغوي في القرآن
الكتاب يضم دراسة لجانب الالتحام اللغوي لمجموعة من السور (الأنعام والكهف ويوسف...) فالمقصود بتلاحمِ البناءِ اللُّغَوِيِّ في القرآن هو أنْ يَعْمِدَ النَّظْمُ القرآنيُّ إلى عنصرٍ لغويٍّ معين، فَيُكَرِّرَه في مَقَاطِعَ مختلفةٍ من السورة، لِيَدُلَّ ذلك التَّكرارُ على تلاحم تلك المقاطع، ثم لا يُكَرِّرَ ذلك العنصرَ اللغويَّ في أيِّ سورةٍ أخرى في القرآن. مع العلم أن "القرآن كتاب متشابه مكرر كما جاء في قوله تعالى: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ﴾ [الزُّمَر: 23]. والمثاني المكرر. فالقرآن تتكرر قصصه ومواعظه وتوجيهاته وأمثاله. ومن هذا التكرار ينشأ التشابه بين آياته وسوره مما يجعلها تحمل ملامح متقاربة يصعب التمييز بينها. فالقصة الواحدة مثلًا تتكرر حلقاتٌ منها في سور مختلفة بمفردات متقاربة تكاد تكون متطابقة في كثير من الأحيان"[10] والسؤال هنا كيف نفهم السورة كوحدة ولبنة من داخل نظم القرآن؟ مع العلم أنّ أساس التقسيم في القرآن هو السور، لا الموضوعات. فليس في القرآن بابٌ للصلاة، وبابٌ للزكاة، وبابٌ للصيام، وبابٌ للحج، يجيبنا محمد داود، أن هناك طرائق عديدة لمعرفة أن السورة القرآنية تشكل وحدة نصية متماسكة الأجزاء. الطريقة الأولى هي البحث عن الهدف أو المحور العام الذي تدور حوله موضوعات السورة. الطريقة الثانية هي النظر إلى النسق الذي تُعْرَضُ به موضوعاتُ السورة المختلفة المختلفة. الطريقة الثالثة هي أن ندرس معجم السورة دراسةً فاحصةً تستهدف الكشف عن الخصائص اللغوية الدقيقة التي تنفرد بها السورة عن غيرها من السور كوحدة نصية متماسكة.
ويتحقق تلاحم البناء اللغوي في القرآن على الأقل في ثلاثةِ أنواعٍ مختلفة: النوع الأول: أن تتكرر في السورة كلمة لا نظير لها في سورة أخرى. النوع الثاني: أن تتكرر في السورة عبارة أو تركيب لغوي لا نظير له في القرآن. النوع الثالث: إنشاء آياتٍ جديدةٍ باستعمال كلماتٍ وردت في نصٍّ سابق.
حديث الأحرف السبعة
روى البخاري ومسلم في صحيحيها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أقرأني جبريل على حرف فراجعتُه، فلم أزل أستزيده ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف" يرى محمد داوود أنّ العلماء يختلفون في فهم حديث الأحرف السبعة على أكثر من خمسة وثلاثين رأيا، وقد أثبت "أنّ القرآن لم يكن متعدّد الألفاظ في يوم من الأيام، وأنّ القرآن الذي بين أيدينا في المصحف اليوم هو عين القرآن الذي كان يتلوه النبي ﷺ، وهو عينه الذي تلقاه منه الصحابة رضوان الله عليهم، لم يتغير ولم يتبدل، وأنه لم يكن ثمة نسخ متباينة منه بألفاظ متعددة في أي وقت من الأوقات، وأن تفرّد السبك القرآني يأبى هذا التفسير لحديث الأحرف السبعة ولا يقبله".[11]
جمع القرآن
يرى محمد داود بعد أن ناقش قصة جمع القرآن زمن أبي بكر وعثمان أن " الذي تطمئن إليه النفس، ويتفق مع طبيعة الأشياء، ويتسق مع الدقة المعجزة التي قام عليها بناء النظم القرآني هو أنّ القرآن دُوِّن وجُمع ورتِّب في حياة النبي ﷺ، وأنه كان لدى النبي منذ اللحظة الأولى للوحي مصحفٌ إمامٌ يأمر كتبَةَ الوحي أن ينقلوا إليه كلَّ ما كان ينزل عليه من القرآن لحظة بلحظة فور تنزله بلا تأخير ولا تراخ."[12]
[1] مقدمة الكتاب.
[2] نفسه.
[3] نفسه.
[4] الفصل الأول من الكتاب.
[5] نفسه، فقرة (الحروف مصادر الإيقاع في القرآن).
[6] طه حسين، مرآة الإسلام، مؤسسة هنداوي، 2017م، ص. 75
[7] طه حسين، من الشاطئ الآخر، محاضرات طه حسين بالفرنسية، عبد الرشيد الصادق محمودي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2008م، ص.132
[8] نفسه.
[9] نفسه (مصادر الإيقاع في القرآن).
[10] الفصل الثاني من الكتاب.
[11] خاتمة الكتاب.
[12] نفسه.