وحدة الخطاب الرشدي بين الفقه والفلسفة: قراءةٌ في كتاب الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي
فئة : قراءات في كتب
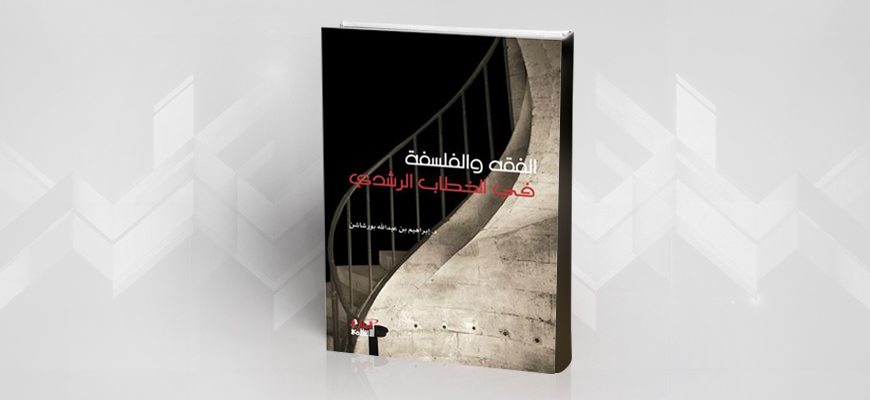
على الرغم من أن عنوان الكتاب يوحي، بأن مدار حديثه على العلاقة القلقة التي ما انفكت تجمع القول الفقهي بالقول الفلسفي في الخطاب الرشدي، ورغم ما توحي به مقدمته من رغبة في الخوض في سجال، بات كلاسيكيًا بين الرشديين، حول طبيعة العلاقة التي تربط الفقه بالفلسفة في الخطاب الرشدي، فإن الناظر في تضاعيف هذا المصنف يُدرك أن الهم الرئيس الحاكم له تجلى في وضع اليد على الوحدة الحاكمة لخطاب أبي الوليد، إن على المستوى اللا إشكالي أو التكويني أو الدلالي. ولعله ليس تزيدًا في القول، إن الذي حمل المؤلف على خوض مجازفة قراءته التركيبية للمتن الرشدي، رغبة ٌتتجاوز الحدود الضيقة للعمل الأكاديمي المحض إلى رهانات أبعد، تتمثل، على حد تعبيره، في "الرغبة في امتلاك ابن رشد العربي المسلم، وفي إعادته إنسانيا إلى جسم الثقافة العربية الإسلامية، التي نشأ فيها فقيهًا، وترعرع فيها فيلسوفًا". من هنا وجب القول إن هذا الكتاب، بقدر ما يقدم لقارئه فهمًا رصينا للخطاب الرشدي، فإنه يرسم معالم قراءة جديدة ومغايرة لتراث أبي الوليد، تنكب الأحكام المسبقة التي تناسلت على هامش التفكير فيه، عند الباحثين عربًا ومستشرقين، منذ أعمال رينان ومونك. أما جوازه إلى ذلك، فتمثل في بيان الوحدة التي يتسم بها فكر ابن رشد، ولعله من الغني عن البيان القول،إن بورشاشن يصطف بموقفه هذا إلى جانب المدافعين عن وحدة المتن الرشدي، كإرنالديز والمرحوم جمال الدين العلوي، بل إننا نجد في عمله نوعًا من الاستمرارية لكتاب المتن الرشدي، مع وعيه بضرورة البحث عن وحدة أشسع، تشمل المؤلفات التي اعتبرها المرحوم جمال الدين أدخل في باب مرحلة الضروري في الكمال الإنساني، حتى يصبح المتن الرشدي قادرًا على الاندراج في وحدةٍ شاملة ممكنةٍ.
هكذا، صار من الصعب أن نتحدث، بعد عقد هذا المصنف، عن فلسفة أبي الوليد بمعزلٍ عن رؤيته الفقهية والأصولية. كما أنه لم يعد من المقبول، أن يقرأ المرء كتبه الفقهية من دون استحضار المقدمات الفلسفية التي صدر عنها الموقف الرشدي برمته، بل إن المؤلف يذهب في بيان مظاهر وحدة الخطاب الرشدي إلى حدودٍ بعيدةٍ، يقر فيها بإمكانية تفهم المنطلقات الصوفية لفكر أبي الوليد، وما كان لها من عظيم الأثر في ترسيم قواعد ممارسته، لفعل التأمل في مختلف مستوياته؛ الأمر الذي يجعلنا أمام قراءةٍ، بقدر ما تريد لنفسها أن تكون قولًا مُفصلًا في العقلين الفقهي والفلسفي، بقدر ما إنها لا تقيم فصلًا قاطعًا بينهما وبين الرؤية الصوفية، التي نهل منها أبو الوليد قواعد ممارسته العلمية. هكذا، يضعنا الكتاب أمام أفقٍ منفتحٍ لفهم منابع الفكر الرشدي وتفاعل مكوناته، تتكامل فيه صورة ابن رشد القاضي مع صورته كفقيه وكفيلسوف وكشارحٍ لمتن المعلم الأول، وكناقد لمناهج المتكلمين ومساجلٍ لأطروحاتهم. كان على المؤلف أن يسوق أمثلةً، من مجالات معرفية متعددة، امتد فكر ابن رشد للتفكير في قضاياها، يقيم بها الدليل على وجود تلك الوحدة الناظمة للخطاب الرشدي. ولعل الذي حمله على ذلك، ما يمكن أن نلاحظه من حضورٍ فريد للدعوة إلى التأمل العقلي في فكر هذا الفيلسوف، إذ نجدها دعوةً تحضر في متنه الفقهي كبداية المجتهد، كما في كتبه الفلسفية والنقدية. لم يدع الباحث إمكانية رد هذه الدعوة إلى التكوين الفقهي لابن رشد فقط، رغم أنه بذل جهدًا كبيرًا في بيان الجو الثقافي والعلمي الذي تفتق عليه وعي أبي الوليد، مركزًا على رصد نزوعٍ إلى الاجتهاد، ونبذ التقليد كسمةٍ جوهريةٍ اتسم بها ذلك الجو؛ فمنطق وحدة الخطاب الرشدي استلزم التنقيب عن تجليات النَفَس الاجتهادي في مختلف مكونات المتن. لذلك يشعر القارئ في كتاب بورشاشن، أن صاحبه يتحرك في جبهات فكرية متعددة؛ بين الفقه والفلسفة والكلام والسياسة، يتنقل بينها جيئة ًوذُهوبًا، دون أن يشعرك بوجود اختلافٍ بينها، من حيث هي مجالاتٌ للتأمل والتدبر؛ فكان من نتائج ذلك، أن المؤلف انصرف إلى تصحيح الكثير من الأحكام المتداعية عن ابن رشد ومتنه، وقد أسعفته فكرة الوحدة بما يكفيه من العدة المنهجية والمفاهيمية التي أعاد بواسطتها ترتيب أوضاع الخطاب الرشدي.
*- المقدمات الفقهية للقول الفلسفي عند ابن رشد:
خصص بورشاشن حيّزًا كبيرًا من كتابه للنظر في ما يمكن وصفه بالأصول الفقهية لفكر ابن رشد؛ وقد كانت غايته من ذلك، إثبات الدور الكبير الذي لعبه التكوين الفقهي والأصولي في تشكل الفكر الرشدي، إنْ على مستوى مواقفه الفلسفية أو الكلامية أو الفقهية، الداعية إلى الاجتهاد، والرافضة لكل مظاهر التقليد والتكرارية. وقد كان جوازه إلى ذلك، الوقوفُ عند مظاهر التجديد الذي قعد له أبو الوليد على مستوى أصول الفقه، من خلال تحليلٍ دقيقٍ ورصينٍ لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابتدأه برصد المفارقات التي يطرحها عنوان الكتاب ودلالاته التاريخية والسياسية، وختمه برصد تجليات النفَس التجديدي في العدة المنطقية التي اعتد بها ابن رشد، في نظره، في القضايا الفقهية التي ضمنها كتابه البداية، انطلاقا من تحليل للنشأة المنطقية للفقه. وفي هذا المضمار تحديدًا، نحت المؤلف صورة واضحة المعالم عن غنى التكوين الفقهي الذي تلقاه فيلسوف قرطبة. لذلك، كان عليه أن يتحدث عن جسورٍ فقهيةٍ، عَبَر منها هذا الفيلسوف إلى الفلسفة، بدءًا بالتربية الفقهية والعلمية التي تلقاها في بيته الذي كان يعج بالأسفار الفقهية، وتتلمذه لفكر جده الذي كان من المتحمسين إلى الخروج من شرنقة التكرار والحفظ التي تخندق فيها الوعي الفقهي، ومرورًا بتفاعله مع الفكر الفقهي للغزالي الذي حضر في شكل كتابة مختصر لكتاب المستصفى، وكذا مع فكر إمام الحرمين الجويني من خلال كتابه الغياثي الذي قدم، في نظر بورشاشن، الخطاطة العامة لكتاب بداية المجتهد. ووصولًا إلى رصد تجليات الهاجس الاجتهادي لدى بعض ممثلي المدرسة الفقهية التي تأثر بها أبو الوليد؛ وهي مدرسة علمية تجمع بين الفقه والحديث، مدرسة تحتفي بالاجتهاد وتروم تأسيسه تأسيسًا علميًا، من خلال انفتاحها على مدرسة "الخلاف العالي". لا يعني الحديث عن هذه الجسور الفقهية إلى الفلسفة، أن الباحث سقط في ترتيبٍ كرونولوجي لأعمال ابن رشد، تكون فيه مؤلفاته الفقهية ذات سبقٍ زمنيٍ، قياسًا بما عقده من مصنفات فلسفية، إذ يدرك المؤلف مدى التداخل بين الفضاءين في عملية تكون المتن الرشدي، بل إن ما ترمي إليه عبارة الجسور صوب الفلسفة، هو تنبيه القارئ إلى دور التربية الفقهية في تشكل وعي ابن رشد، إذ منها نهل مبادئ الاجتهاد ونبْذ التقليد، وفي رحمها أينعت قناعته بالحاجة إلى مجتهدٍ يُخرج العقل الفقهي من دائرة الحفظ والتكرار، وقد أتى كتاب بداية المجتهد يعبر عن هذا الطموح، إذ أراده صاحبه، في نظر المؤلف، كتابًا للتأمل وإعمال الفكر؛ وهذا الأمر هو ما يفسر لنا ما ذهب إليه بورشاشن من القول، إن مجرد مطالبة ابن رشد الفقهاء بالدليل للحسم في المسائل، يعتبر محاولة لتجاوز العقلية الفقهية السائدة في ذلك الإبان. على هذا النحو من النظر، يقارب المؤلف علاقة ابن رشد بكل من جده والغزالي، وإذا كان من نافلة القول إنه غنم من قراءة فكر جده غُنمًا أحْفظ خصومه وأثار إعجاب كثيرين، فإن الحديث عن إفادته من الغزالي يبقى أمرًا يحتاج إلى كثير من البيان والتبرير. ولعلي لا أجانب الصواب، إن زعمت بأن أهمية كتاب بورشاشن تكمن في نجاحه في إعادة النظر في علاقة ابن رشد بالغزالي، في ما يخص القول الفلسفي. إذ يسجل، بذكاءٍ، كيف أن الغزالي كان منطلقًا لأبي الوليد في تكوينه الفقهي، كما في مشروعه الفلسفي؛ لذلك، كان خليقا بنا أن ننتبه إلى أثر التأليف الفلسفي الغزالي في تشكل الموقف الرشدي. وقد اقتضى ذلك من المؤلف إعادة ترتيب أوضاع موقف الغزالي من الفلسفة، وتفهمه في ضوء سياق نصوصه التي كان لها وقعها الكبير على وعي أبي الوليد. وبيان ذلك أن بورشاشن كان حريصًا على تفهم موقف ابن رشد من نقد الغزالي للفلاسفة، من خلال إشارته إلى بعض المسائل التي وافقه فيها الرأي، من قبيل موقفه من نظرية الفيض، كما روج لها الفارابي وابن سينا، وكذا من خلال رصده للعبارات التي أعملها أبو الوليد في مرافعته الشهيرة ضد تهافت الفلاسفة، وهي عباراتٌ تنم في نظر المؤلف عن تقديرٍ كبيرٍ واعترافٍ بالسلطة العلمية والمعرفية للغزالي. من هذا المنطلق، يبحث المؤلف عن دوافع أخرى تثوي وراء موقف ابن رشد النقدي من صاحب مشكاة الأنوار، ويرى أن "أذية الغزالي للفلسفة هي نتيجة ممارسته للأيديولوجيا في الحقل الفلسفي، وما نجم عنه من تصريح بالحقائق التي سكت عنها الشرع.
هكذا، يمكن القول إن الذي دفع المؤلف إلى الوقوف عند التكوين الفقهي لابن رشد، هي رغبته في إظهار سهمه في تشكل خطابه عامة، والفلسفي منه على وجه التحديد. ويبقى الدليل الأوقع على ذلك ما عرف عند صاحب بداية المجتهد بالفقه الجاري على المعاني؛ أي فقه التعليل والمقاصد، فقه المعاني الثاوية وراء المسائل الفقهية، والتي تخلع عليها المعقولية على حد تعبير بورشاشن؛ فارتياد درب هذا الفقه قاد أبا الوليد إلى إضفاء قدرٍ من المعقولية على الأفعال الشرعية، كما مكنه ذلك من الكشف عن البعد الأخلاقي للشرع. يمكن أن نفهم، انطلاقاً من هذا التصور العقلي لمهمة الفقه، الأسباب التي حملتْ أبا الوليد على خوض مغامرة التجديد الفقهي من داخل دائرة الفقه المالكي. ولعلنا لا نجازف بالقول، إن جزءًا كبيرًا من أهمية عمل بورشاشن يكمن في وقوفه على العلاقة القلقة، التي ربطت ابن رشد بالمالكية فكرًا ومذهبًا، فهو لا يتردد في سَوق نماذج دالة من نقد ابن رشد للمذهب المالكي، كما ينبه قارئه إلى انفتاح الرجل على المذاهب الأخرى، واعتماده عليها كلما اضطر إلى ذلك، دون أن يرى في فعله هذا أي خطرٍ على المذهب ووحدته. والمؤلف يرصد هذا الموقف من المذهب المالكي، وهو على بينةٍ من أمر الرهانات السياسية التي كانت تشرطه، إذ يرفض أن يرى في موقف ابن رشد، الداعي إلى التأمل والاجتهاد، مجرد ترجمةٍ فقهيةٍ وفلسفيةٍ لسياسة الموحدين الثقافية التي قامت على أنقاض فقه الفروع المالكي. ويرى، ضدًا على ذلك، أن ابن رشد أعلن عن مشروعٍ علميٍ يريد إحياء الاجتهاد داخل المذهب المالكي، وهو ما يمثل أمارةً على موقف أبي الوليد من تلك السياسة، إذ لم يقرأ في نفورها من التقليد الفقهي السابق إلا إعلانًا عن الحاجة التاريخية إلى ميلاد المجتهد الذي يخلو منه الزمان، على حد تعبير إمام الحرمين.
لم تكن ممارسة ابن رشد للنظر الفقهي مجرد محاولةٍ لشرح المذاهب الفقهية وبسط القول في فروعها، إذ كان الرجل على وعيٍ بأهمية تلك الممارسة وعلاقتها المتينة برهانات إصلاح العقل التي كان يرنو إلى إنجازها على مستوى نظام المعرفة في ذلك الإبان. وقد بين بورشاشن أن ابن رشد "قصد بكتابة بداية المجتهد تصحيحًا عميقًا لوضعية الفقه في الغرب الإسلامي، وليس فقط نقله من تقليد إلى تقليد" وهو ما يعني أن الوقوف عند دلالات عملية الإصلاح تلك، هو ما يأذن لنا بفهم صلة الوصل بين الحس الاجتهادي الحاكم لتصور أبي الوليد لمجال الفقه وأصوله، والمشروع الفلسفي الذي بلوره، سواء في مضمار شروحه على أرسطو، أو من خلال مساجلته للمتكلمين. على أن الحديث عن هذا التعالق بين القولين الفقهي والفلسفي، لا يعني أبدا أن أبا الوليد لم يكن يميز بين المنطق الحاكم لكل واحد منهما، ومدى تمايزه عن منطق غيره، وهو ما سعى بورشاشن إلى بيانه من خلال إفراد حيز من كتابه، للوقوف عند ما سماه بتفاضل التصديقات بين الفقه والفلسفة، مظهرًا إلى أي حدٍ كان فيلسوفُنا على وعيٍ بالدلالات الإشكالية التي يتخذها مفهوم اليقين والتصديق كلما تنقل بين الفقه والفلسفة. وسيكون علينا أن نعترف بأن المؤلف استطاع أن يُظهر الفرق بين المنطقين، من خلال الوقوف عند الطابع الإشكالي لمفهوم الحق الذي تتعدد دلالاته، كلما انتقلنا من مجال القول الفلسفي إلى مجال القول الفقهي الاعتقادي، حيث التعدد الدلالي لليقين يفرض نفسه، وحيث نكون غلبة الظن قاعدة يمكن أن يقام عليها الاجتهاد العقلي الذي دافع عنه ابن رشد على مستوى الأصول، صادرًا في ذلك عن اعتقاده بأن الأحكام الشرعية معقولة المعنى، مما يشي بأننا أمام محاولة تروم إضفاء المعقولية على مجال الفقه وأصوله.
*- ابن رشد والالتزام بقضايا المجتمع:
رفض بورشاشن، منذ مقدمة كتابه، الصورة النمطية التي تداولها بعض الباحثين عن ابن رشد، باعتباره مثقفًا عاش حالةً من الانفصام بين ممارسته فعل التفلسف وشخصيته كفقيه وقاضٍ. ومن المعلوم أن الأستاذ علي أمليل كان في جملة الذين روجوا لهذه الصورة في كتابه السلطة الثقافية والسلطة السياسية. بدت أولى معالم هذا الرفض، عندما طفق المؤلف يبحث عن أثر مزاولة مهمة القضاء في تشكل الوعي الرشدي بالحاجة إلى الاجتهاد وإعمال العقل، إذ في رحمها أينع كتاب بداية المجتهد الذي كان ثمرة نظره الفقهي، مما يشي بأن أبا الوليد لم يكن بعيدًا عن هموم مجتمعه ومدينته، وهو ما سيتبدى بوضوحٍ أكثر عند تحليل منطق السياسة عند ابن رشد، حيث بين بورشاشن مقدار الصلة التي جمعت ابن رشد بهموم مدينته، فبدا خطابه مهجوسًا بها وبالرغبة في إصلاحها. إن قوة عمل الأستاذ إبراهيم تتجلى، في هذه اللحظة، من خلال مقارنة مقاربته للفكر السياسي الرشدي بغيرها من المقاربات، التي غالبا ما اكتفت بالوقوف عند ذكر المواقف السياسية لفيلسوف قرطبة، من خلال ما ذكره في شرح كتاب الجمهورية لأفلاطون أو بعض مواقف أرسطو، كما يمكن اشتقاقها من الأخلاق والجدل والخطابة؛ إذ فضل، ضدًا على ذلك، الانطلاق من الهواجس الفقهية في فهم تصور ابن رشد للمدينة الإسلامية.
في هذا السياق، تحديدًا، تندرجُ محاولة صاحب فصل المقال الرامية إلى تصحيح وضعية الفقه داخل تلك المدينة، من خلال النقد الذي خلخل به موقع المتفقهة، وكذا في أعقاب نقده لموقع علم الكلام، ورصده للخطر الذي يمثله بالنسبة إلى وحدة المدينة واستقرارها، من حيث تجرُّئِه على فضح ما سكت عنه الشرع. لذلك يخلص الباحث إلى القول، "إن ابن رشد أراد أن يحرر العقل الإسلامي من سلطتي الفقهاء المقلدين والمتكلمين المشاغبين، ولم يكن يقصد إلى تحرير العقل الإنساني من الإيمان، كما زعم بعض المستشرقين الذين تصوروا العقلانية الرشدية على غرار عقلانية عصر الأنوار".
يتعقب بورشاشن تمظهرات التصور الرشدي للسياسة، من خلال وصله بمقدماته ورهاناته كمثقفٍ مسلم ملتزمٍ بقضايا مدينته التي في ضوئها قرأ ما قرأه من كتب أفلاطون وأرسطو في السياسة والأخلاق، راصدًا بذلك الحس الواقعي الذي وسم انشغال أبي الوليد الذي لا يسير، في نظر المؤلف، في اتجاه انتظار غدٍ خيالي أفلاطوني، بل إنه يقدم تفكيرًا أكثر واقعية مؤسسًا على تجربة المدينة الإسلامية. ويتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اختيار الشارح الأكبر لنص أفلاطوني في السياسة، وعن مدى وفائه لروح ذلك النص، وعن دلالات المجاوزة التي حققها شرحه له، وعلاقة ذلك بمركزية فكرة الجمع عند هذا الفيلسوف، ليخلص إلى بيان أصالة ابن رشد في تسخير المنظومة الفقهية والتراث الفلسفي في تشييد تصوره للمدينة والسياسة.
خاتمة: ملامح صورة جديدة عن ابن رشد من داخل خطابه
يمكن القول، في أعقاب المعطيات السابقة، إن أهمية كتاب بورشاشن ليست تنحصر في كونه طرق مجالا غالبا ما أُهمل من طرف الباحثين في مجال الرشديات، مجالُ الفكر الفقهي وعلاقته بالمشروع الفلسفي الرشدي، رهاناته السياسية المرتبطة بالمدينة الإسلامية، بل إنها تتجسد في هذه الوحدة التي اعتبرها منطقًا حاكمًا للمتن الرشدي برمته، إذ انطلاقًا منها بات من الممكن أن تتجاور صورة ابن رشد الفقيه مع صورة ابن رشد الناقد والفيلسوف. لذلك يمكن القول، دون كبير مجازفةٍ، إن بورشاشن أسعفنا بفهمٍ للمتن الرشدي، من شأنه أن يضيء الكثير من القضايا التي ما تزال تطرح على المهتمين بفلسفته، كما أنه يدفعنا إلى إعادة التفكير في موقع الفلسفة الإسلامية ومكانتها بالنسبة إلى وجودنا التاريخي، في الماضي كما في الحاضر، انطلاقا من علاقتها التاريخية بالفقه والمدينة.






