يوسف الصّدّيق: في مساءلة القرآن
فئة : حوارات
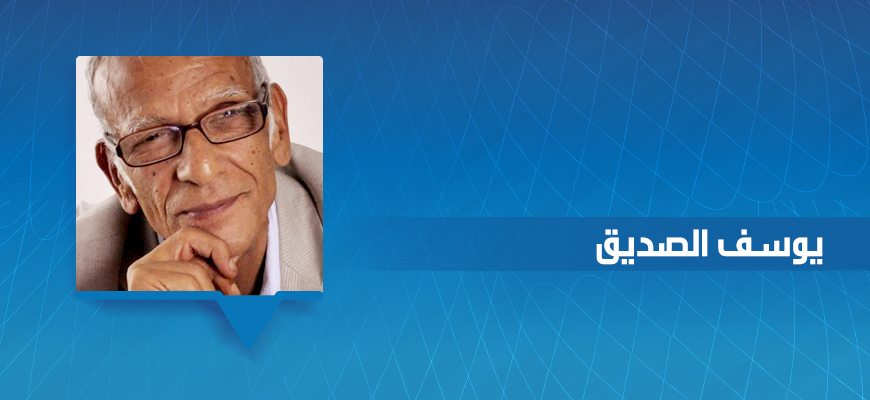
الجزء الأوّل: ملامح في مسيرة الحياة والفكر
د. نادر الحمامي: تغمرنا سعادة كبيرة ونحن نستقبل اليوم المفكّر التّونسيّ يوسف الصّدّيق، لا لنتائج البحوث الّتي قدّمها فحسب، وإنّما، بالخصوص، لأنّه يمثّل إضافة معرفيّة وعلميّة في المستوى المنهجي في السّاحة التّونسيّة والعربيّة والدّوليّة أيضا، ويأتي هذا الحوار والنّقاش مع الأستاذ يوسف الصّدّيق في إطار سلسلة الحوارات الّتي تجريها مؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدّراسات والأبحاث مع جملة من الباحثين والمفكّرين والأساتذة الّذين نعتز دائما باللّقاء معهم، والتفكير معهم وبهم والإفادة منهم في هذه الحوارات الممتعة في حقيقة الأمر.
استضافتنا اليوم للمفكّر يوسف الصّدّيق لا تأتي من فراغ، بل بعد الاطلاع على ما كتبه منذ سنوات طويلة. والحقيقة أنّني فكّرت كثيرا عن مداخل لهذا الحوار وهذا النّقاش؛ ومن بين ما اطّلعت عليه في سيرته الفكريّة والحياتيّة أنّه بالخصوص قد تكوّن في جامعة السوربون، حيث درس على أساتذة كبار مثل ملفاين، كانجيام، قيرو، قيفال وإنكلوفيتش وغيرهم. لكن ما أثار انتباهي بالخصوص، أنّ المدخل إلى فكر يوسف الصّدّيق قد يكون ذاتيّا، شخصيّا، ولذلك فإنّي أعتبر، أنّ المدخل الأساسيّ لفكر يوسف الصّدّيق ربّما قبل هؤلاء المعلّمين الكبار، هو شخص آخر أهدى إليه أحد أهمّ كتبه "هل قرأنا القرآن؟ أمْ على قلوبٍ أقفالها" وأقصد محمّد حفناوي الصّدّيق والده في مدينة توزر بالجريد التّونسيّ، لا أدري إن كان الأستاذ يوسف الصّدّيق يوافقني على أنّ معلّمه الأوّل كان والده؟
د. يوسف الصدّيق: أهلا وسهلا بك وبالجميع وشكرا جزيلا على هذه الفرصة الّتي تسمح لي بأن أقابل وأن أناقش، وأن أتحدّث إلى قارئي هذا الحوار، فعلا أعتقد أنّني حين أقارن في حياتي الخاصّة بين المرحلة الأولى التي عشناها كلّنا منذ ثلاثين سنة وهذه المرحلة التي أعيشها الآن، أرى أنّنا توغّلنا مسافة كبيرة في الارتداد وفي الرّجعيّة؛ فقد كان هذا الوالد يملك مكتبة شرقيّة، مكتبة عربيّة بحت، تأتي سلعها من لبنان ومصر، خاصّة، مرّتين في السّنة وكنّا نشاركه في إفراغ الصّناديق الّتي تأتينا من دار المعارف ومن دار العودة ومن دار الجيل ومن الدّور المصريّة، كنّا نشاركه في تنظيم الكتب وفي فرزها وفي ترتيبها على الرّفوف في هذه المكتبة، وكنا نستفيد من تلك العناوين، وكنت أبقى حوالي سبع أو ثماني سنوات لا أعرف من هذا الكاتب أو ذاك، سوى العناوين التي كان والدي يتلقّى منها بعض النسخ وأقوم بتسجيلها. إذن، كان هذا الرّجل، الذي يصدمني بالمقارنة بالحالة الّتي نعيشها الآن، أباً لثمانية أولاد منهم ثلاث بنات كبريات وأصغرهن لم تكن تصلّي قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين، ولم يكن أبدا ليجبرها على شيء، وكنت أتذكّر عندما يغضب على بناته أو على أولاده الكبار الاثنين؛ محمّد أخي الأكبر وأنا، كان يكتفي بــالقول "اللّه يهديك" مع الابتسامة، وكان يفرح ويحتفل إذا بدأ أحدنا يصلّي، ولم يكن يجبر أحدا على أيّ شيء. لقد كان المؤمن بذاته، وهذا عشته وأنا في صباي الأوّل، وأتذكّر أنّه كان يعتزم أن يدخلني جامع الزّيتونة الذي كان على بعد أمتار من مكتبته وعلى بعد عشرات الأمتار من بيتنا بجانب نهج العطّارين، النّهج العظيم، لكن قبل الاستقلال جاءه أحد الشّعراء الكبار الذي كنّا نسمّيه أمير الشّعراء "الشاذلي خزندار" وسأله عن مشروعه فيّ، فقال بطبيعة الحال أنا أعلّمه الآن سيدي خالد والمعاشر والأجرومية والقرآن الكريم، بالطّبع، والأحاديث وبعض الشّعر القديم وسأزّفه إلى جامع الزّيتونة، (وهذه كانت كلمته)، أي إلى السّنة الأولى من جامع الزّيتونة الّتي كانت تعادل السّنة الأولى من الإعدادي الآن في المنظومات العصريّة، وأذكر بالحرف ما قال له الشّاذلي خزندار الذي كان يرتاد بيوت البايات آنذاك، بيوت عهد تونس في ذلك الوقت، وكان يرنو هو أيضا إلى استقلال البلاد، قال له: "لا، أنا أقترح أن يدخل إلى مدرسة تكون فيها الفرنسيّة على قدر المساواة مع العربيّة"، أي تلك المدرسة التي كنّا نسمّيها "الفرنكو-عربيّة"، وقال له كلمة ذكرها الكاتب الجزائريّ كاتب ياسين، بعد سنوات، "يا سي الحفناوي إنّ الفرنسيّة ستصبح سلاحنا عندما نفوز بالاستقلال"، وقد اقتنع الوالد بذلك وسجّلني في المدرسة الفرنكو-عربيّة آنذاك، حيث أتممت دراستي فيها، ثمّ انتقلت إلى مدرسة ثانويّة تشبهها، وهي "المدرسة الصّادقيّة" الّتي أخرجت كبار الصّفوات العلميّة والسيّاسيّة. إذن هذه هي المرحلة الأولى الّتي أعتقد، فعلا، أنّني كنت من المحظوظين، عندما قرّر الوالد أن يقحمني في منظومة عصريّة يكون فيها المتنبّي وفكتور هوجو بابين للتكوين الشّخصي.
د. نادر الحمامي: لكن كان هناك أيضا أثر لأعلام آخرين تونسيّين، مثل: البشير خريّف والفاضل ابن عاشور وأبيه الطّاهر ابن عاشور.
د. يوسف الصدّيق: الفاضل والطّاهر كانا يرتادان المكتبة ثلاث أو أربع مرّات في الأسبوع، على الأقل، وكانا قبيل صلاة الجمعة يأتيان إلى المكتبة، ثمّ يغلق الوالد الباب وينزع الصّناديق البلّوريّة الّتي كانت تزيّنه، ويذهب معهما إلى الجمعة ويرجعون إلى المكتبة، فيتحدّثون عن الخطبة وعن أخطاء الخطبة وأخطاء الإمام إلخ... وكنت أتمتّع كثيرا بهذا الجوّ الذي كان جوّا روائيّا مسرحيّا بامتياز. أذكر وعمري ثمان سنوات أو أقل من ذلك، جبّة الشّيخ الطّاهر ابن عاشور ذات اللّون الخمريّ، وكان متواضعا جدّا بالمقارنة مع ابنه الّذي كان أنيقا، كانت له عمامة خاصّة تشبه عمامة الشّيوخ المصريين، ذات لفاف واحد، وكانت له جُبّات خاصّة يفصّلها لنفسه، بينما كان الشّيخ الطّاهر ابن عاشور يلبس أشياء تونسيّة بغاية من البساطة وفي غاية من الشّعبيّة، وكانت له نظّارات ذهبيّة صغيرة بالكاد تتّسع لعينه، وكان كثيرا ما يسألني عن آية أو عن معنى آية فأعجز أكثر الأحيان على أن أفسّرها وعلى أن أدلي بالبعد المعجميّ للكلمة، فكان يفسّر لي بعض الآيات والكلمات، وأنا أتذكّر تفاسيره مثلا في "غاسق إذا وقب" الّتي كنت على بعد مسافة كبيرة من أن أفهمها وهي من السُّوَرِ الأولى، وقد فسّر لي "من شرّ النّفّاثات في العقد" ولم أكن أفهمها أبدا، ولا أفهم أية كلمة من القرآن أو من السّور التي يفسّرها لي، وكنت أستعين لفهمها، إمّا بوالدي أو بالبشير خريّف الّذي كان يعتني بنا كثيرا؛ أخي محمّد وأنا. وكنّا نحاول أن نطالع كتب التّفسير أو كتب ابن حزم ولكن ذلك كان يتم بتدرّج كبير. كانت المكتبة العربيّة تزخر بالمختصرات للأعمال العالميّة، وقد قرأت "الملك لير" و"دونكيشوت" بالعربيّة في نسخة مختصرة، كانت تزخر بها النّشرات العربيّة الّتي تأتينا من مصر أو من لبنان، وتلك المكتبة العظيمة لكامل الكيلاني الّتي كنّا نستقي منها أوائل معرفتنا بسيرفانتيس أو بفكتور هوجو إلخ...
د. نادر الحمامي: ولكن دائما بالعربيّة؟
د. يوسف الصدّيق: دائما بالعربيّة، لحدّ الآن هناك عناوين لم أقرأها بعد بلغتها الأصليّة الفرنسيّة أو بلغتها الإنجليزية؛ مثلا، شكسبير قرأت له ثلاثة أو أربعة أعمال بالإنجليزية ومنها ''هاملت''، لكن لحدّ الآن أعرف شكسبير بالعربيّة أكثر؛ فقد قرأت "الملك لير"، "العاصفة"، "عطيل" وغيرها، باللغة العربية.
د. نادر الحمامي: هذا مدخل مهمّ، لأنّه يثير لديّ سؤالين، على الأقل، السّؤال الأوّل هو ما الّذي جعل يوسف الصديق يتجه إلى الفلسفة وإلى باريس وإلى السّوربون تحديدا، بعد أن تلقّى هذا التكوين من خلال تلك القراءات بالعربية وذلك الجوّ التّونسي التّقليدي الأقرب إلى الشّرق؟ أما السؤال الثاني الذي سنتحدّث عنه بعد ذلك، فهو: ما سرّ الموقف الذي عُرف عنك ضدّ تعريب الفلسفة في تونس؟
د. يوسف الصدّيق: هذه المرحلة الثّانية الّتي كنت سأحدّثك عنها، المرحلة الثّانية هي الصّدمة، وفيها كثير من المآسي التي انتابتني ، عندما قامت الدّولة وأحد الوزراء التّونسيّين الّذي كان وزيرا للدّاخليّة، فأصبح وزيرا للتّعليم (أقصد إدريس قيقة) بتعريب الفلسفة، وكنّا آنذاك أساتذة شبّان ندرّس الفلسفة باللّغة الفرنسيّة، ولم يكن ذلك الوزير يمتّ إلى حبّ العربيّة بصلة، ولا من النّاس المنغمسين في اللّغة العربيّة أو ممن يتذوّقونها، مثل محمّد مزالي أو فرج الشّاذلي أو البشير بن سلامة، بل إنّه قالها بصريح العبارة، ''أنا أعرّب الفلسفة حتّى أوصد الباب على الماركسيّة''، أي يغلق الباب على الماركسيين وعلى اليساريين، وكنت أرتاد جريدة La Presse آنذاك وفي كثير من المقالات نبّهته إلى أنّه سيفتح الباب للظّلاميين بالمقابل، وهذا ما كان.
د. نادر الحمامي: أي أنك تعتبر أنّ تعريب الفلسفة كان سببا من أسباب تسرّب الكثير من الظّلاميين إلى هذا المجال.
د. يوسف الصدّيق: بطبيعة الحال، ولكن من النّاحية المنظوميّة فقط، لا لأنّ العربيّة عاجزة؛ فالعربيّة أعطت الكندي (805 – 873م)، وابن ثابت(564-565م)، وأبي معشر البلخي (787– 886م)، أعطت كبار العلماء الذين مازالوا مؤثّرين في العلوم الصّحيحة الّتي نتعاطاها اليوم، لذلك فأنا أعتقد أنّ اللّغة العربيّة هي لغة حاملة للعلم والأدب منذ بدايتها. لكن المفارقة الكبيرة الّتي صدمتني، والّتي حاولت أن أجاهدها أو أن أكتب ضدّها في الصّحف هي أن المكتبة المدرسيّة آنذاك، كانت تفتقر للمراجع عن الفلسفة باللغة العربية، وأتذكّر أنّي في ندوة صحفيّة لهذا الوزير السيّد إدريس قيقة، كنت حضرتها، قلت له أراهنك أنني أستطيع أن أقتني مئتي نسخة من ''خطاب المنهج لديكارت'' باللغة الفرنسيّة، من شارع الحبيب بورقيبة، حيث أكشاك الصّحف، بدون أدنى مشكل، في حين أنني لن أستطيع أن آتي بـعشر نسخ من ''المدينة الفاضلة'' باللغة العربية، في كامل أنحاء البلاد.
د. نادر الحمامي: هل تراه قرارا مسقطا إذن؟
د. يوسف الصدّيق: المكتبة العربيّة بصفة عامّة، تفتقر لترجمات أمّهات الكتب من ليفي شتراوس (1908-2009) إلى التّحليل النّفسي إلخ... لذلك، لا نستطيع أن ندرّس الفلسفة من دون مراجع.
د. نادر الحمامي: هل هذا ما دعاك في أواسط السّبعينيات إلى كتابة ''المفاهيم والألفاظ في الفلسفة الحديثة''؟ هل كان ذلك تعاملا مع أمر واقع؟
د. يوسف الصدّيق: ذلك لأنّ أحد الوزراء أيضا، الوزير الأوّل محمّد مزالي رحمه اللّه، قال إنّ هؤلاء، وذكرني بالاسم، يتصدّون إلى تعريب الفلسفة؛ لأنّهم لا يعرفون العربيّة، وقد حزّ ذلك في نفسي واستغرق الأمر ستة أشهر لأكتب هذا الكتاب الّذي أعطيته لدار نشر ليبية تونسيّة شهيرة وهي الدّار العربيّة للكتاب، ونشرته في الحال. وكان الطّلبة قد استفادوا منه استفادة كبيرة، فقد طبع أربع عشرة مرّة، وكان يُستعمل في كلّ سنة دراسيّة، ولا أزال إلى حدّ الآن أتلقّى اعترافات من أناس أصبحوا أساتذة أو موظّفين كبارا ويعتقدون أنّه أعانهم دون المراجع على أن يتلقّوا الفلسفة بالعربيّة، وقد نجح أكثرهم في أن يتلقّاها بالعربيّة والحمد للّه.
د. نادر الحمامي: ولكن هذا لم يمنع من فتح الباب أمام نوع من ''المحافظة'' في دراسة الفلسفة وتدريسها، وربّما كان سببا في توجّه أعلام معروفين، اليوم، نحو دراسة الفلسفة في المشرق عوض دراستها في الجامعات الأوروبيّة.
د. يوسف الصدّيق: وتوجّهوا كذلك إلى المغرب الأقصى، في تلك الفترة، حيث كانت الفلسفة تدرّس بطريقة أعمق بكثير مما كانت تدرّس في تونس. على الرغم من أن في تونس كفاءات عالية جدّا من الأساتذة؛ أناس قد درسوا في أوروبا ودرسوا في تونس، أنا مثلا كنت قد درست في تونس إلى حدّ الماجستير، فأنا خرّيج تونس، قبل أن أواصل شهادة التّبريز في "أميان" في ناسيونال فرنسا، وأحصل على الدّكتوراه في المعهد الأعلى للدّراسات الاجتماعية (Ecole nationale des hautes études en sciences sociales) في باريس، لذلك أنا أعتقد أنّني خرّيج تونس 100% من الثّانويّة إلى التّعليم العالي؛ ففيها كفاءات كبيرة جدّا من أوّل الاستقلال في مادّة الفلسفة بصفة خاصّة.
د. نادر الحمامي: إذن، كان خروجك إلى فرنسا بعد هذه التّجارب في تونس بالأساس، فهل كان الخروج من تونس في ذلك الوقت نوعا من ردّة الفعل على هذا التّعريب أو طرق التّغيير أو الوضع العامّ في البلاد آنذاك، أم أنّه كان اختيارا علميا ومعرفيا بالأساس؟
د. يوسف الصدّيق: لا، إن خروجي من الفلسفة كان إلى الصّحافة، وإلى المراسلة الحربيّة قبل كلّ شيء، وكان بمثابة نوع من انتحار المثقّف، فقد رأيت أنّه لا يمكن لي أن أكون صحافيّا محليّا، لأنّي ممنوع من التّدبّر في مسائل التّنمية في تونس وفي السّياسة الدّاخليّة والسّياسة الخارجيّة أو حتّى في متابعة سياسة مرتبطة بالسّياسة الخارجيّة التّونسيّة، مثل أن أتحدّث عن ليبيا أو الجزائر أو المغرب، وعن علاقتنا أو عدم علاقتنا مع جبهة البوليساريو إلخ... فلم أجد إلاّ أن أطلب، من صاحب المؤسّسة آنذاك، وهي يوميّة تونسيّة عريقة جدّا، وأقدم جريدة يوميّة في إفريقيا، وهي جريدة La Presse التي مازالت تعيش إلى الآن. طلبت منه أن أذهب إلى بؤر الخطر والموت، فأرسلني إلى التّشاد وإلى لبنان وإلى ظفار (الإقليم الجنوبي لسلطنة عمان) وإلى السّودان آنذاك، فقد كنت أوّل من جال في جوبا وتوقّع أنّه ربّما في يوم من الأيّام سيحدث انفصال في السّودان، وكتبتها بالحرف الواحد، كما كنت أوّل من ذهب إلى أريتريا وواكبت الحركة الوطنيّة فيها، وكنت في لبنان أتمنّى بصفة لا شعوريّة ألاّ أعود، أو أنّ أعود شهيد الخبر، ولو مارست التحليل النفسي الذاتي، يمكن أن أرجع ذلك إلى أنني كنت أخاطر كثيرا بحياتي حتّى أنّ ياسر عرفات كان يلومني وكان يزجرني حتى لا أتنقّل من مكان إلى مكان لغاية أن أسوّي معه حديثا، كان يقول لي إنّ حياتك أغلى من حديث، بإمكاننا أن نؤخّره ليوم آخر إلخ... بعد سنة 1982 لمّا خرج الفلسطينيون من بيروت وخرجت بعدهم بشهرين، بعد أن جلت في جنوب لبنان؛ في صيدا، النبطيّة، الناقورة... وكنت قد أُجبرت على الدّخول إلى الضّفّة الغربيّة وإلى إسرائيل عبر القدس، فأحسست أن رسالتي قد انتهت، وانتهى دوري في الإعلام الموجّه إلى تونس، وإلى القارئ التّونسي، فشعرت وقد بدأ المدّ الرّجعيّ، المدّ الدّيني السّلفي يتغلغل في البلاد سنة 1982، 1983، 1984 شعرت فعلا بصفة بيولوجيّة ''تنفّسيّة''، شعرت أنّه لم يعد يمكن لي، أنا كمفكّر، أن أتنفّس في تونس. كنت صاحب وظيفة وكنت من أحد الكواكب في الصّحافة، وكنت عندما أمرّ في الشّارع حتّى التّاكسي لا يأخذ منّي ثمن المسافة، لأنّه رآني في التّلفزة عائدا من بيروت أو عائدا من صيدا... كانت زوجتي تشتغل وكانت لها وظيفة مهمّة، ورغم ذلك فقد قرّرنا معا أن نرحل من هذا البلد الذي لم يعد بإمكان المثقّف فيه أن يفكّر وحتّى أن يتنفّس.
د. نادر الحمامي: هل هي استقالة أستاذ يوسف؟
د. يوسف الصدّيق : لأنّه لم يكن لي حول ولا قوّة في أن أغيّر شيئا، إلاّ عندما أتمكّن من التّنفّس؛ أي من التّفكير. ولذلك هاجرت إلى باريس، وعندما أقول إنّني كتبت كتابين باللغة العربيّة في تونس منذ الفترة الّتي تخرّجت فيها إلى حدود سنة 1982 بينما كتبت أكثر من خمسة وعشرين كتابا في بلد الغربة، فأعتقد أنّ هروبي لم يكن هروبا من ذاتي أو هروبا من حضارتي، وإنّما كان انغماسا فيها عن بعد. وعندما حلّت ثورة 14 جانفييه/ يناير في نفس اليوم عدت إلى تونس وإلى حدّ الآن أنا أعيش في تونس.
د. نادر الحمامي: يمكن في الحقيقة أن نصف هذا بالابتعاد القسري، وأنت تتحدّث فتقول إنّها غربة في نهاية المطاف. لكن تلك الغربة أدّت إلى نتيجة أحسبها سلبيّة، فلتعذرني، فرغم ذلك الاعتراف الذي نلته في البلد الّذي تسمّيه بلد الغربة، فإنّك بقيت طيلة هذه السّنوات من الثّمانينيات إلى سنة 2011 مجهولا أو شبه مجهول في تونس، فهل يعود ذلك إلى تقصير منّا نحن أم إلى أسباب أخرى؟
د. يوسف الصدّيق: ليعذرني إخواني المثقفون التّونسيون، فلي تحليل آخر، وإن اقتنعوا به، فليتجاوزوا، وإن لم يقتنعوا فليناقشوني؛ أنا أعتقد أنّنا نحن البلد الوحيد مقارنة بلبنان أو بمصر أو بالمغرب الأقصى، الذي يغار فيه المثقّف على توطينه في بلده، يعتقد أنّه إذا اغترب أحدنا فليبق هناك وليكن مبجّلا من طرف التّلفزة الفرنسيّة أو دور النّشر الفرنسيّة وحتّى الحكم الفرنسي أو حتّى النّظام، وقد كنت أذهب إلى الحفلات وإلى الاستقبالات في ماتينيون وفي الإليزيه وكنت أرتاد الأماكن الرّسميّة في فرنسا. فالتّونسي المقيم في بلده هنا عندما يعود إليه المغترب لا يعترف به بسهولة. وكأنّه يقول له: ''اِبق مغتربا، لا تأت إلى هنا لتنافسنا بتجربتك التي أعطتك زخما كبيرا في الخارج. لا تنافسنا في وطننا هذا، وفي أرضنا هذه وفي محلّيتنا هذه، ولذلك أرجوك لا تمسّ محلّيتنا...'' هذا هو المشكل الذي جعل كثيرا من الرّوائيّين مثل حبيب السّالمي ومصطفى التليلي مثلا، وغيرهما من المقيمين، سواء في جنيف أو في فرنسا أو في إسبانيا لا يعرفهم أحد والحال أنّهم ذوو أبعاد عالميّة ولكن القارئ التّونسي لا يعرفهم ولا تعرفهم السّلطة التّونسية ولا تتم دعوتهم إلى ندوات عن القصّة القصيرة أو القصّة الطّويلة أو الرّواية، ولا يمنحون الفرصة لإثراء المشهد التّونسي في الأدب. نحن نُترك بعيدين وأنا أتعذّب من هذا، أن تُعقد ندوات في اختصاصي وينظّمها أصدقاء حميمون ولا يتذكرون أنّ هناك إنسانا كانوا يشربون القهوة معه البارحة، أنّ هناك إنسانا يوسف الصديق يمكن أن يفيدهم في هذه النّدوة، فيقومون بدعوته. هذا الأمر أتشكّى منه وأتأسّف له كثيرا.
د. نادر الحمامي: نحن بصدد محاولات الاستدراك الآن، ولكنّي في نهاية هذا الجزء الذّاتي شيئا ما، الذي أردته أن يكون بمثابة المدخل لفكرك، أشير إلى أن هذا الجوّ الّذي عشت فيه في أوروبا وفي الجامعات الغربيّة، وهذا الاغتراب لم يمنع من شيء مهمّ، قلّما ينتبه إليه الكثيرون، وهو أنّك قمت بنقل المتون القديمة إلى الفرنسيّة. هل هذا النّقل لموطّأ مالك مثلا ولأقوال علي وتفسير الأحلام الكبير لابن سيرين خاصّة، بمثابة الكسر لتلك الغربة، أم هو تقريب لمغترب في بلاد يحسّ أنّها لا تعترف به؟
الجزء الثاني: في مساءلة القرآن
د. نادر الحمامي: نجدّد التّرحاب والشكر للأستاذ يوسف الصدّيق على قبوله دعوتنا لمناقشته ومحاورته وما أريد استئناف الحوار به في الحقيقة هو تذكّري لترجمته العجيبة البديعة لقصيد بارمينيدس "إلى ينابيع الفلسفة" الّذي نشرت ترجمته العربيّة بدار الجنوب بتونس في أوائل التّسعينيات، تحديدا في سنة 1994 إلى جانب ترجماته العديدة لمتون صعبة إلى الفرنسيّة؛ مثل "كتاب البيوع" من "موطّأ مالك" وكتاب ''الإشارة إلى محاسن التجارة'' لأبي الفضل الدّمشقي. وترجمته لأقوال علي بن أبي طالب، وأقوال النبيّ محمّد أيضا، وغير ذلك... أودّ سؤال الأستاذ يوسف الصديق، هل كان فعلا يريد نقل هذه النّصوص إلى الفرنسيّة لمجرّد تعريف الأوروبّيين بها، أم أن ذلك كان من أجل كسر ما سمّاه في الجزء الأوّل من الحوار غربة أو اغترابا؟
د. يوسف الصدّيق: لا، لقد كان بإمكاني أن أفعل أعمق من هذا لو كنت أريد أن أكسر الغربة، لم أكن غريبا في فرنسا، كانت أسرتي معي، وكنت أتمتّع بمحيط من الأصحاب التّونسيّين والعرب الذين نزعوا عنّي مرارة الغربة، وكنت أعود إلى تونس سنويّا مع أولادي الذين علّمتهم اللّغة العربيّة، وهم يتحدّثون العربيّة، رغم أنّهم ولدوا هناك؛ ثلاثة منهم على أربعة ولدوا في فرنسا. إذن، فمسألة الغربة كنت أداويها بالعودة وبالمحيط العربي الأصيل المتنوّع الّذي كنت أتمتّع به. فالسّبب غير هذا الّذي ذكرت، غير مسألة الغربة.
لقد كنت من المعجبين بفيلسوف ومفكّر كبير جاءنا إلى تونس، ولم أحضر دروسه حينها، وهو ميشال فوكو (Michel Foucault) (1926-1984). عندما جاء ليدرّس في كليّة الآداب 9 أبريل بتونس، كنت قد غادرت إلى فرنسا. ولكنّني التقيت به عندما كنت أنا أدرّس في شمال فرنسا، وكنت أحضر دروسه كمراقب أو كمشاهد حرّ. هذا الرّجل له خاصيّة كبيرة جدّا في منظومة الفكر الأوروبي؛ فهو لم يدل باكتشافاته الشّخصيّة المحض في الفكر وبأفكاره في الفلسفيّة، إلاّ عندما تشبّع بأناس لا يعرفهم الكثيرون؛ أي بعلماء الاقتصاد والبيولوجيا والكيمياء مثل "لافوازييه"... وهذا يتراءى كثيرا في كتابه الأوّل "الكلمات والأشياء" الّذي استنكره عن نفسه بعض الشّيء، وهو مترجم ترجمة عربية غير موفّقة قام بها كل من سالم يفوت وبدر الدّين عرودكي، وكانا أبعد النّاس عن التّواصل مع هذا النصّ بطريقة فلسفيّة، وإنّما تواصلا معه بطريقة معجميّة فحسب، لذلك لم تكن الترجمة للكتاب ترجمة فلسفيّة صائبة في رأيي.
إذن، بدأ فوكو باستيعاب النّصوص غير المعروفة على الأقل في محيطه الآنيّ، وقد كان مشروعي الذي بدأته منذ سنة 1967، متأثرا بتلك الخاصية لدى فوكو، وهو أن أتصارع مع نصّ أُهْمِلَ من طرف الفلاسفة، لا لأنّهم لم يستسيغوا الإقبال عليه، وإنّما لأنّه مخيف. فلو سألت الفارابي في زمانه عن موقفه من النصّ القرآني لتهرّب وقال هذا ليس من مشمولاتي، كما أنك لو سألت نجّارا عن رأيه في الحدادة أو عن رأيه في الطبّ سيقول لك أنا مجرّد نجّار "اتركني في حالي"، والفارابي كان سيقول أيضا: "اتركني في حالي" فلا يتحدّث عن القرآن، وكان ابن رشد أيضا لا يتحدّث عن القرآن ومع أنه تحدّث في "فصل المقال" عن آية النّحل "ادع إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ..." فقد كان يتفادى الاقتراب من القرآن؛ وهذا صدمني جدّا.
كان مشروعي أن أواجه هذا النصّ (القرآن) بالفلسفة، بطريقة صريحة ومختصرة ودون تلاعب، مثلما واجه لوفيناس (Emmanuel Levinas) (1906-1995) التّوراة بالفلسفة، ومثلما واجه دو شاردان (Teilhard de Chardin) (1881-1955) المسيحيّة بالفلسفة، وغيره كثيرون الذين واجهوا المسيحيّة بالفلسفة مثل الوجودي المتديّن كارل ياسبرس (Karl Jaspers) (1883-1969). وكان لا بد قبل أن أبدأ في هذا المشروع أن أقدّم له أوراق اعتماد، فلا يمكن لي أن أتناول هذا النصّ الكبير، النصّ العظيم، النصّ المؤسّس، دون أن ألمّ بما أحاط به من نصوص حواف، لذلك واجهت أوّل ما واجهت نصّ ''تفسير الأحلام لابن سيرين'' وهذا ما أعانني على أن أجازف بالتّفسير في تصديق الرّؤيا عند إبراهيم وعبور الرّؤيا أو تعبير الرّؤيا عند يوسف مثلا، وكنت أوّل من صرّح أن إبراهيم في الصّافات كان يلام من اللّه، عزّ وجلّ، على أنّه كان صدّق الرّؤيا، فالرّؤيا لا تصدّق، وإنّما تعبر كما عند يوسف، ولذلك كان يوسف يشكر المولى على أنّه علّمه تأويل الأحاديث إلخ... ويوسف، بمثابة ريكور (Paul Ricœur) (1913-2005) وفرويد (Sigmund Freud) (1856-1939)، يعبر الرّؤيا كما تعبر بين ضفّتي نهر، بينما إبراهيم كان بدائيا، وقد لامه الله وفداه بذبح عظيم، يعني أنه صدّق الرّؤيا في حين لم يكن عليه تصديقها. لقد تبيّنت هذا من معاشرتي لنصّ لم أقم بترجمته حرفيّا أو معجميّا أو ترجمته مجرّد ترجمة فقط، وإنّما تفاعلت مع هذه القضيّة الكبيرة الّتي يمثّلها كتاب ابن سيرين الذي كان نواة تاريخيّة.
د. نادر الحمامي: تقصد بذلك الحواشي التي كتبتها على ترجمتك لابن سيرين؟
د. يوسف الصدّيق: وفي مسألة الكتاب في اللّغة والحضارة العربيّة، التي ينفرد بها القرآن، نجد الكتاب الأوّل الذي تصدّى لكلمة ''كتاب'' هو كتاب سيبويه، و"الكتاب" اسمه كذلك إذن فله مؤلّف، وكذلك كتاب ألف ليلة وليلة الذي نطلق عليه اسم ''كتاب'' دون أن يكون له مؤلّف معروف، لأنّ المؤلّف الوحيد هو اللّه في الحضارة العربيّة الإسلاميّة، وانطلاقا من ذلك ترجمت لابن مالك المؤسّس لتقاليد في ممارسة النصّ الديني. وعندما ترجمت رسائل ابن سينا التي لم أعثر على أصلها اليوناني، وإنما كان يوجد النص العربي فقط، كنت أريد أن أظهر للقارئ الفرنسي الذي أتوجّه إليه أنّنا ذوو منطوق آخر للفكر، منطوق متميّز، وليس المنطوق الّذي يتلقّاه الأوروبيّ عنّا بأنّنا أهل نقل وبأنّنا أهل تراكم للمعرفة فقط، كما تتراكم الكتب فوق بعضها في رفّ معيّن أو في صندوق معيّن. وقد وجدت استجابة كبيرة لهذا، لأنّني أعتقد من خلال المراسلات ومن خلال المقالات التي كُتبت عن ترجماتي ومن خلال الدّعوات في وسائل الإعلام، أعتقد أنّي نفذت إلى ما كان يمكّنني من أن أقول: ''لم نقرأ القرآن بعد'' للفرنسيّين.
د. نادر الحمامي: قبل "لم نقرأ القرآن بعد" هناك مرحلة سابقة، أو هي بمثابة "البرزخ" بين ترجمتك لجزء من "الموطّأ"، ولابن سيرين، ولأقوال النبيّ، ولأقوال علي إلخ... قبل كتاب "لم نقرأ القرآن بعد" هنالك القرآن ترجمة أخرى، قراءة أخرى، وربّما ما مهّدت به من ترجمة تلك المتون أوصلك إلى هذه التّرجمة الأخرى والقراءات الأخرى. أليس كذلك؟
د. يوسف الصدّيق: هذا الكتاب الأوّل ''قراءة أخرى ترجمة أخرى'' كان بمثابة المقدّمة، بكلّ تواضع طبعا، لابن خلدون، لأنّني كنت أجهّز القارئ لأن يتلقّى شيئين خطيرين، وأعتقد أنّ المنظومة الذّهنيّة العربيّة الإسلاميّة لم تستوعبهما إلى حدّ الآن؛ الأولى أن النصّ القرآني ليس المصحف، أردت أن آخذ آيات وأن أفكّكها على سبعة، أن أفكّكها على هرم قمّته اللّه وجانباه المعرفة والأخلاق إلخ... وأن أضمّن في كلّ مرحلة بنائيّة أو بنيويّة الآيات الّتي نتحدّث عنها، ولكن الأهمّ من هذا هو الحواشي في هذا الكتاب، يعني مثلا من هو ذو القرنين؟ كيف يمكن إلى حدّ الآن أن نقرأ لمفسّرين في القرن العشرين يقولون إن هذا الرّجل جاء قبل الطّوفان، وليس بتلميذ أرسطو، وأن تلميذ أرسطو وثني، فكيف يمجّده اللّه؟ وكيف يقول اللّه مخاطبا له ''قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا''؟ كيف يمكن أن يقال هذا لنبيّ أو لرسول؟ كيف يمكن أن يقال لتلميذ أرسطو، وهو إمبراطور ولا يمتّ للرّسالة ولا يمتّ للوحي بصلة؟ لكنني أظهرت في الحواشي وفي "نحن لم نقرأ القرآن بعد" بأنّه هو بعينه في كلّ مراحله، وقد سمّي من خلال الآثار اليونانيّة التي رجعت إليها ''قرنَا الكبش'' سمّاه الإله آمون، إلخ... وقد أظهرت أنّه هناك أنثروبولوجيا للرّهبنة في زمن أمون إلخ... عندما يقول يسمع الرّاهب الرّياح في المعبد بطريقة معيّنة يترجمها للزّائر، سواء كان زائرا عاديّا أو إمبراطورا أو مرشّحا للإمبراطوريّة كالإسكندر ذي القرنين، وممّا قال له؛ لقد قبلك ابنه على أن تكون "قرني الكبش"، ومن الواضح أن انتهاء الأمر في تفسير شخصيّة ذي القرنين أنّه هو الإسكندر. لكن لماذا اصطفاه اللّه، في الحكم على الأقل؟ لأن هناك أفلاطونيّة عميقة في القرآن أظهرتها ولو باحتشام فقد سحبت من الكتاب أشياء "فجعتني أنا"، أي أنني صُدمت، وخفت على القارئ لو وضعتها أن يُصدم. "فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ'' نجدها حرفيّا في الكتاب العاشر لأفلاطون من الجمهوريّة، حتّى كلمة صُوَر التي أعطت كلمة (corps) بالفرنسية، "وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ" هي نفسها في نص أفلاطون... إذن هناك أفلاطونيّة عميقة جدّا في القرآن، وهذا لا يمنعه من أن يكون وحيا. يعني أنني لمّا أقول أنّك مثلا كتبت كتابا وفتحت ظفرين ثمّ جئت بقول من هايدجر أو غيره فلا يعني ذلك أنّك سرقت أو أنّ كتابك مسروق.
ولقد أجبت عبد الفتّاح مورو الشّخصيّة الثّانية في النّهضة هكذا لمّا سألني، وفسّرت له أنّ هناك "وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ" في إنجيل حنّا حرفيّا، وكذلك "حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ" توجد حرفيّا في إنجيل متّى، عندما كان المسيح يتصارع مع تجّار المعبد قال لهم لن تدخلوا ملكوت اللّه "حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط". إذن فالنصّ ليس في إعجازه الحرفيّ، فدعنا نتخلّص من الإعجاز الحرفي، وإنما إعجازه في استيعاب شخص واحد اسمه محمّد لمعلومات العالم، هذا هو الإعجاز وهذه هي رفعة الإسلام. فالكلمات غير مهمّة، أي ليست أهم من أنّه استوعب حمّورابي (1792-1750 ق. م) وفيثاغورس (570-495 ق.م) وكل الكتب الّتي نعلمها أو التي لا نعلمها. ما تعلمون وما لا تعلمون موجود "في القرآن" وكذلك الذرّة والمعارف الكبيرة ومستقرّ الشّمس و "كلّ في فلك يسبحون" كلّ هذا هو الإعجاز، لذلك فأنا لا أستحي أن أقول يوجد هذا في "إنجيل متى" وغيره، فاعترافنا بالتّوراة وبالإنجيل اللذين فيهما هدى ونور، وبنصّ القرآن، يجعلنا نعتقد بوجوب أن نراجع قضيّة التّحريف، فصحيح أن التوراة والإنجيل حرّفا تاريخيا من طرف اليهود والمسيحيين، لكن عندما تقول لي إنّ هذه الرّسالة محرّفة فلا بدّ لي أن أعرفها حتّى أعرف المحرّف منها وغير المحرّف، حتّى أعيد النّظر فيما حرّف وفيما لم يحرّف، هذا هو الشّيء الأعمق الّذي لم نقم به إلى حدّ الآن ترفيعا لمنظومة دينيّة نحن نعتزّ بها ونعترف أنّها من ضمن معارفنا ومن ضمن إبستيميّتنا.
د. نادر الحمامي: لكنك تقول أيضا "لنقرأ القرآن كأنّ شيئا لم يكن"، هذه جملتك. وأنت تقصد في هذا الفصل تحديدا المعارف المتعلّقة بما أنتجته المؤسّسة الدّينيّة والتيولوجية عبر هذا التّاريخ وهذا التّراث الطّويل الّذي امتد أكثر من 1400 سنة من التّفسير بداية من مقاتل بن سليمان الذي تعتبره النّقطة الأولى في عمليّة التّفسير. أفهم جيّدا أن نتخلّى عمّا أنتجته المؤسّسة الدّينيّة، ولكن من ناحية أخرى هل يمكن التّخلّي عن المعارف الأخرى السابقة عن نشأة المصحف وعن تشكّل النصّ القرآني في القرن السّابع الميلادي لفهم هذا النصّ؟ هل يمكن في النهاية أن نتخلّى عن معارفنا لنفهم هذا النص؟
د. يوسف الصدّيق: أنا أرجو الانتباه هنا، لأنّ هذا أهمّ شيء أشتغل عليه الآن، أشتغل على كتاب جديد وأخشى من سوء الفهم، فأن تأتي لإنسان يحادثك فتقول له أنت تريد أن تسرق منّي بيتي وتضيف إليه نيّة ليست منه. أنا بالنّسبة إليّ لا تقويض الإيمان ولا تقويض المنظومة الّتي نعيش عليها الآن اجتماعيا واقتصاديا وحضاريّا وذوقيّا هذا أبعد شيء عندي، والشيء الوحيد هو أنّي أمام تهجّم كبير على هذه المنظومة الّتي أنتمي إليها، أي على هذا الوطن الرّوحي الّذي أنتمي إليه، تهجّم كبير من خلال المنظومة الأوروبيّة والمنظومة الغربيّة الّتي أصبحت تطالبنا بأن ندلي بإثباتات لما نقول. أنا أعتقد أنّه هناك حدثا ما يسمّيه باديو (Alain Badiou) (1937) بـ Evénement، حدث اسمه محمّد بن عبد اللّه، لا أناقش في بعد الإيمان فيه أو في بعد غير الإيمان، لقد كان حدثا كبيرا وكان منعطفا في تاريخ الإنسانيّة، عندما يتهكّم الأوروبي على المسلم فيقول كيف يمكن أن نقبل الآن قضيّة الرّق مثلا التي يتناولها القرآن ويتصرّف فيها، قضيّة فكّ رقبته إلخ ... والكفّارتين... وفكّ الرّقاب... والصّدقات لليتامى وللفقراء... وكيف يمكن أنّ نقبل أن مجرّد الخوف من أن تخون امرأة زوجها يجعله يحبسها في البيت "وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً''... كل هذا لا بدّ من تحييده ولا بدّ من القول إنّه كان ابن زمانه، ولا يمكن أن يربطني الخالق بثلاثة آلاف عام من قوانين القرن السّابع. هذا لا بدّ أن نأخذ فيه موقفا نهائيا.
لكن هناك زخم فكري عظيم جدّا إلى حدّ الآن، يتناوله كبار الفلاسفة في القرآن عندما تكون أمام آية "خلق الإنسان من عجل" يعني لا بدّ للفيلسوف أن يتذكّر أنّه إلى حد الآن يشتغل عليه فلاسفة كبار. "ما غرّك بربّك الكريم الّذي خلقك فسوّاك..." أيأنّ قضيّة الإنسان في القرآن كانت حدثا، ألم يكن معاصرو محمّد ومعاصرو الوحي يستوعبونه، ولا يمكن أن نطالبهم باستيعابه لكن الآن وقد توسّعت المعرفة وقد بقيت هذه الآيات تدلّ على عمق فلسفي كبير معترفا به؛ أذكر أنني لمّا حدثت جاك رانسيار(Jacques Rancière) (1940)، وجيل دولوز (Gilles Deleuze) (1925-1995)عن هذه الآية من القرآن في هذه الجملة "خلق الإنسان من عجل" احتارا وأريتهما إياها في كثير من التّرجمات وقد تحدّث جيل دولوز عن محادثتنا تلك في كتابه ''Mille Plateaux'' تحدّث عن قضيّة الأعراب، تحدّث عنها من خلال محادثة بيننا، راجَع القرآن وراجع ما كنت أقول له، فتبيّن له أنّ هذا الشّق في الوحي شقّ فلسفيّ عميق وقد بقي إلى حدّ الآن قابلا للتّفلسف، هذا جيل دولوز من أكبر فلاسفة العصر.
د. نادر الحمامي: ولكن الغريب أنّ هذا البعد الفلسفي أهمل في الأكاديميات أو الجامعات أو البحث العربي والإسلامي، أذكر أنني كنت وإياك في حديث الأسبوع الماضي، وكانت هنالك جملة أنت قلتها هكذا، لكنّها بقيت في ذهني وهي أنّ العرب والمسلمين بصورة عامّة بقوا يقرؤون القرآن ويرتّلونه دون نفاذ معرفيّ.
د. يوسف الصدّيق: هي مسألة القراءة، إلى حدّ الآن أغلبيّة المسلمين حتّى المتعمّقين منهم، مثل مشايخ الأزهر ومشايخ الزّيتونة الذين أحترمهم، وقد عاشرتهم، كما كنت أقول، صبيّا وعاشرتهم حتى في كهولتي، أعتقد أنّهم أناس قابلون للتّخاطب وقابلون لأن نتعامل مع بعضنا ونتفاهم، وكنت أتحدّث مع الأستاذ عبد الفتّاح مورو، الّذي كان منفتحا، وسألني عن قضيّة بارمينيدس كيف تقول إنّه قال: ''قل هو اللّه أحد''؟ قلت له طبعا، أوّلا السورة تشير إلى أنّها شاهد بين ظفرين، لأنّه من جملة السور المئة والأربعة عشر الموجودة، السّورة الوحيدة الّتي عنوانها أو اسمها لا يوجد في النصّ هي سورة الإخلاص، ونحن نعرف أنّ بارمينيدس قد قالها حرفيّا قبل ميلاد المسيح بستّة قرون، وقد ترجمتها عام 1994، وقرأها التّونسيّون قرأ ما سأقوله الآن: "الآن قف وقل إنّه أحدٌ صمد''، و"صمد" باليونانيّة "صمت" وهي الكلمة نفسها، ونجد في لسان العرب "مُصْمَت" و"المصمت إذا ضربته لا يحدث صدى". إذن، "الصمد لم يلد ولم يولد" (Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré) لا شيء يشبهه وليس له كفؤا أحدٌ.
لمّا قلت هذا وجدت أن شيخا من الشّيوخ المتحزّبين سياسيّا، وهو عبد الفتّاح مورو، قد تنهّد ونظر إليّ طويلا وتعجّب، ثمّ قال لي: ''أنا أعتقد أنّ محمّد بن عبد اللّه أوحي إليه ببارمينيدس''، قلتُ له: طبعا هذا هو المشكل، أن نعترف بأنّه أوحي إليه بكلّ المعارف، وهذا هو الإعجاز، أترى هل يمكن أن يكون لشخص قد عاش حياتا عادية ستين سنة أو ثلاث وستين سنة، أن يستوعب كلّ المعارف، أنا أعتقد أنه عليّ أن أشير إلى هذا الجانب من الإعجاز عوض أن أكتفي بالقول إن هذه الكلمة، كما قال النظّام، لا يستطيع إنسان أن يعادلها أو أن يأتي بها، إلخ... الإعجاز اللفظي من وقت المعتزلة كان إعجازا ثانويّا بطبيعة الحال لا يمكن لأيّ إنسان (وأنا قلتها مرّة وهوجمت بسبب ذلك) وإن درّسته الإنجليزية ألف سنة أن يأتي ببيت من شكسبير، ولو درس الإنجليزية وتعمّق فيها إلخ... ولو درس الرّوسيّة لا يأتي بقصّة من قصص دوستوفسكي، وهذا ليس بالحجّة على إعجاز القرآن، الحجّة على إعجاز القرآن هو استيعاب لآماد طويلة من المعرفة فيها حمّورابي وفيها فيثاغورس، "وأحصينا كلّ شيء عددا" فكلّ شيء مبني على العدد.
د. نادر الحمامي: هل كان ينبغي تغيير مفهوم الوحي أساسا؟
د. يوسف الصدّيق: طبعا، الإعجاز والوحي هو هذا، اللّه أشار لنا بأنّ الوحي هو في الزّلزال "بأنّ ربّك أوحى لها"، أشار إلى أنّ الوحي ليس مسألة إملاء من المولى، حاشاه، إلى فرد معيّن حتّى وإن كان سيّدنا محمّد...''ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا''. وعندما عجّزه النّاس...قال لهم ما أنا إلا بشر، وهذه قالها وحده؛ فالوحي مشترك فيه النّحل ومشترك فيه أمّ موسى ومشترك فيه النّاس وهذا ليس مشكلا، أمّا ما هو محتوى الوحي، فهو أنّ محمّدا له فيه معارف كبرى يحتويها القرآن الذي أتى به، وهو موحى إليه عن طريق إمام أي ملاك أو جبريل إلخ... على فكرة كان جبريل متأخّرا، فقد كان ثمّة شيء اسمه الرّوح الأمين أو الرّوح القدس. جاء جبريل متأخّرا عندما عاشر النبيّ، وهذا من أسباب النّزول، عندما عاشر النبي فئة من اليهود كانوا يجادلونه... وكانوا يسبّون جبريل ويعتقدون أنّ "ميكائيل" أفضل منه إلخ... فناقشهم ومن كان عدوّا لجبريل أو لميكائيل في أواخر التّنزيل.
د. نادر الحمامي: إذن دخلنا الآن في مسائل دقيقة شيئا ما في دراسة القرآن ومقارباته وإعادة النّظر إلى مفاهيم كبرى، مثل الوحي والإعجاز. ربّما سنعمّق النّظر في هذه المسائل وغيرها بالمقارنة مع بحوث أخرى تنتمي إلى المجال نفسه ولا تتطابق معه، في حقيقة الأمر، ويقع فيها مقارنات.
الجزء الثالث: القرآن من التلاوة إلى القراءة
د. نادر الحمامي: نستأنف حوارنا في الجزء الثالث مع الأستاذ يوسف الصديق، مجدّدين له الشّكر على قبوله الحوار معنا. وكنّا تطرّقنا في الجزء الثّاني إلى مسألة اهتمامه بالنصّ القرآني، وأريد مواصلة الحديث في هذا الشّأن، تحديدا، لعدّة أسباب من أهمّها تلك المقارنات الّتي توضع بين يوسف الصديق من جهة ومقاربات أخرى للنصّ القرآني ولغته وظروفه التّاريخيّة ومحيطه التّاريخي، وكثيرا ما تدرج أعمال يوسف الصديق ضمن هذه المباحث الفيلولوجيّة واللّغويّة وأصول اللّغة القرآنيّة، في حين أعتقد أنّ الأمر يتجاوز ذلك إلى إطار أنثروبولوجيا أوسع؛ فهو بهذه اللّغة ليس هدفه مجرّد تبيّن هذه الأصول اللّغويّة الفيلولوجيّة وإنّما البحث الأنثروبولوجي العميق في هذا النصّ؛ لا أدري إن كان الأستاذ يوسف الصديق يشاطرني الرأي في هذا التّقييم؟
د. يوسف الصدّيق: انظر، لقد سحبت منظومة بناء مؤسّسات الإسلام من النصّ طاقته، أوّلا بتوخّي التّلاوة والتّرتيل دون القراءة، نُسيت القراءة تماما، ونحن نتذكّر لمّا كنّا نُسأل ونحن صِبية في تونس، عن السّورة الّتي وصلنا إليها في الحفظ، نقول كلاما ليس له معنى، من قبيل أنا وصلت "سبّح اسم"، وهي ليست جملة (سبّح اسم ربّك الأعلى)، أو أنا وصلت "لم يَكُ"، أو "قد أوحي"، أو "جزء عم"... المثقّف عندما يذكر هذه السّورة يقول عمّا يتساءلون. أو أشياء صغيرة لأنّ التّلاوة الشّكليّة اللفظية هي الّتي غلبت بصفة عامّة على مواجهة النصّ ومواجهة طاقة النصّ الكبرى الّتي كانت سواء في المأثور يقولون أنّها تُبكي، وأنّها تجعل في لحظة واحدة عمر يؤمن عندما سمع سورة طه، وفي القرآن نفسه "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربّهم"... إذن، هذه الطّاقة سُحبت بتوخّي التّلاوة فقط، ثمّ سحبت أيضا ببناء عكسي أي أن محيط النص هو الذي أصبح يفسّر هذه الطاقة، والأحاديث... مثلا لم ينتبه فقهاؤنا والقائمون على ما أصبح شبه كنيسة ورهبنة في الإسلام، إلى أنّ كلمة سنّة لم تأت أبدا في القرآن، هناك معنيان للسّنة: السّنة المغلوطة أي سنّة الأوّلين، وقد انتهت سنّة الأوّلين. والسّنة الثّانية الّتي هي فلسفيّة بامتياز سنّة اللّه ''ولن تجد لسنّة اللّه تبديلا'' يعني القانون؛ قانون العالم وقانون الآفاق وقانون المجرّات... واللّه نفسه مربوط بهذه السّنة الّتي اعتمدها لنفسه أن تكون في العالم، هذا نسيناه... فكلمة سنّة وحتّى كلمة شيعة تعني معجميّا مجرّد الطّريق، وأن سنّة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قد فرضت بطريقة سفسطائيّة في سورة الحشر يقول: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" هذا لا يعني السنّة أبدا، وإنما يعني العطاء وإيتاء الرجل أجره، وإيتاء المرأة مهرها، ويعني الغنيمة؛ ''فما أعطاكم الرّسول خمسة إبل... فارضوا به وما منعكم أن تأخذوه فلا تأخذوه''...فلماذا يذهب كل الفقهاء في تونس أو في إندونيسيا أو في القاهرة أو في غيرها، إلى القول بأنّ السّنة مبنيّة على هذه الآية؟ وذلك بصفة مغلوطة، فهذه الآية لا تعني شيئا في بناء السّنة. السّنة بنيت أوّلا على خيانة الدّولة الأمويّة للذِّكْرِ أي للطّاقة الكبرى الّتي في النصّ؛ نقرأ أنّ يزيد بن معاوية قال: "لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل". وهذه الخيانة دعّمت أحاديث عند ناس مشكوك فيهم. أظنّ أنّك اشتغلت أنت على شخصيّة أبي هريرة وشخصيّات من هذا النوع، الأقرب أن يكونوا أشخاصا خياليّين لم يوجدوا أبدا؛ لأنّنا لا نعلم عنهم شيئا تاريخيّا، كما نعلم عن عمر أو عن أبي بكر أو عن عثمان بن عفّان، ولا نعلم شيئا عن هذا الرّجل الّذي نجد 68 % من الأحاديث قد اعتمدها هو أو رواها في مسلم، فعل ذلك مع أنّه لم يعرف النّبيّ إلاّ سنتين أو ثلاثا قبل وفاته. وقد نعلم من التّراث أنّه جلد أو أنّه عوقب من طرف عمر عن فساد، فكيف يمكن أن تبنى هذه السّنة وهذا الهيكل الكبير على رجل كهذا؟ ولذلك لا بدّ لشبابنا أو لا بدّ لمؤمنينا أن يراجعوا هذه المسألة. من هم أهل الحديث وكيف يمكن أن نقرأ السنّة، وأُعطي مثلا من آلاف الأمثلة أو على الأقل مئات الأمثلة في هذا البناء الّذي نسمّيه السّنة ونسمّيه الحديث، عندما يقول أبو هريرة عن عائشة إنّها كانت تغتسل بإناء واحد مع رسول الّله صلّى اللّه عليه وسلّم فاغتسلت بمئزره وباشرها وهي حائض، بينما القرآن يقول: "وذلك إثم عظيم" فكيف يمكن أن نوفّق في هذا الحديث لأبي هريرة، وهو الاسم الأكثر ذكرا في العالم الإسلامي إلى حدّ الآن. لا بدّ من مراجعة هذا، كيف يمكن أن يغالط. محمّد بن عبد اللّه، صاحب الوحي، القرآن وفي سورة الأحزاب نجد الآية واضحة لا تُأتى النّساء في المحيض، ومن أتى ذلك فقد أتى إثما عظيما.
د. نادر الحمامي: إذن، ربّما هذه الملاحظات والمقاربات ومقابلة النّصوص الحوافّ بالنصّ المؤسّس هي ما يميّزك عن مقارنات أراها في الحقيقة مغلوطة بين باحثين آخرين فيما يسمّى بالدّراسات القرآنيّة الّتي تبحث فينومينولوجيا في أصل النصّ مثلما فعل لوكسمبورغ (Christoph Luxenberg). وكثيرا ما توجد مثل هذه المقارنات. إلاّ أنّه يحاول تأكيد الأصل السّرياني والأرامي للنص القرآني، بينما أنت تعود إلى النصّ اليوناني في هذه المسائل، وبحثه لغويّ في الأساس في حين أنّك تميل إلى البحث الأنثروبولوجي.
د. يوسف الصدّيق: شكرا جزيلا على هذا السّؤال، أنا لا أهتمّ بما جاء به لوكسمبورغ أبدا. أوّلا اعتبرته من الناحية العلميّة بديهي بطبيعة الحال إنّ اللّغات السّيرو_كلدانيّة إلى حدّ العربيّة تتناسل من بعضها، وهي أمّهات بعضها أو بنات بعضها. فلم يأت بشيء جديد من هذه النّاحية، وحتّى عندما يتحدّث عن حور العين، ويقول إنّها عناقيد العنب مثلا، والّتي ضحك منها الجمهور الأوروبي في صحيفة لومنوند (Le Monde) وقالوا إنّ الّذين يلتمسون الشّهادة سيجدون أعنابا بينما هو لم يقرأ "لم يطمثهن إنس ولا جان" يعني أن ذلك كان مجازا وأن "البنات" الّلاتي وعد اللّه بهن الرجال تشبهن العنب الصّافي.
د. نادر الحمامي: شتيفان فيلد أحد أعلام الاستشراق في ألمانيا يفنّد هذا أيضا؛ فهو كتب مقالا كاملا حول قضيّة حور العين كما قدّمها لوكسمبورغ.
د. يوسف الصدّيق: نعم، هو ضحل، لكن الذي يهمني هو الانسلاخ عن المعجم إلى الأبعاد الأنثروبولوجية، عندما ننظر في كلمة (تَضِلَّ) مثلا، في قوله: ''أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا'' في الشّهادة، لماذا اختار المفسّرون "الضّلال" بمعنى نقص العقل؟ بينما الكلمة، إلى حدّ الآن، تعني ضلّت أي أنّنا لم نعد نجدها، بحثنا عنها ولم نجدها، وهذا مرتبط بالزواج العربي في ذلك الوقت، وكان زواجا خارجيّا، أي خارج القبيلة، فالمرأة يمكن أن تضل بعد أن يتزوج بها إنسان من مكة (مثلا) ويذهب بها إلى اليمن أو يذهب بها إلى البحرين أو إلى العراق عند بني إيّاد (على سبيل المثال) ... وعندما نلتمس رجوعها للشّهادة مرّة ثانيّة فلا نجدها، فنقول بأنها قد ضلّت. وأنا يهمّني معنى الكلمة والرّجوع به إلى الواقع الأنثروبولوجي وعادة ما أطبّق ذلك على كلمة "الطّاغوت" مثلا، وأنا أحارب من أجل بيان ذلك في كلّ مناسبة، وهذه مناسبة جديدة تُتاح لي من أجل توضيح أنّ كلمة طاغوت اسم علم لإله (أو آلهة) مصريّ هو "هرمس"، حتّى أنّ القرآن الكريم يشير إلى ذلك بطريقة واضحة عندما يؤنّثه "يعبدوها"، ويرد ذلك في القرآن خمس مرّات، لأن "هرمس" كان له وجهان: وجه أنثوي ووجه ذكوري، والقرآن يقول ذلك عندما يتحدّث عن الطّاغوت مقترنا بـ"الجبت"، وهو (جاب الإله) الّذي أعطى كلمة "إيجيبت" (Egypte)، وهو ربّ الأرباب في المنظومة الوثنيّة المصريّة. والطّاغوت كان من حاشيته، وكان يؤمّن له المراسلات ويخطف له البنات الإنسيّات اللاتي يعجبنه... كما كان يفعل الإله "زوس" في الثّقافة اليونانيّة تقريبا. إذن لا بدّ أن نهتم بالمفاهيم والألفاظ في القرآن الكريم، وأن نعيدها إلى نصّيّتها الأنثروبولوجيّة. كيف كان يتزوّج النّاس؟ كيف كانوا يطبخون؟ كيف كان يلبسون؟ ... الكلمة هنا يصبح لها إشعاع معنوي يساعدك على فهم الجملة، ويساعدك حتّى على استخراج قاعدة للوضوء أو قاعدة للباس أو قاعد للحية، وذلك انطلاقا من التساؤل دائما ''لماذا قال هذا؟'' من الناحية الأنثروبولوجية.
د. نادر الحمامي: كلّ هذاهو نوع من الأنثروبولوجيا التاريخية التي تقوم على معرفة ذلك النصّ في محيطه التّاريخي الأنثروبولوجي، والمجتمع الذي ظهر فيه، ونحن قد ذكرنا تمييز ما تبحث فيه أنت، واختلاف وجهة نظرك المنهجيّة والمعرفيّة، عمّا يبحث فيه لوكسومبوغ، ولكن هل ما تبحث فيه أنت يلتقي أو يتواصل مع ما بحث فيه شخص آخر مهمّ، وهو نصر حامد أبو زيد، الذي يحدّثنا في كتابه الشّهير ''مفهوم النصّ'' عن ضرورة ربط النصّ بما يسمّيه هو "مجتمع المتلقّي"، هل هذا هو الاتّجاه الّذي يمكن أن ندخل منه إلى النصّ؟
د. يوسف الصدّيق: لقد تعرّفت على المرحوم "نصر حامد أبو زيد" عام 1990، عندما اشتريت كتابه من اللّجنة المصريّة للكتاب، في نفس اليوم كان قد انتزع من الرّفوف، وحُرّم، وبدأت محنة الرّجل مع الأزهر ومع المحاكمة. لم أكن أعرفه أبدا قبل أن أشتري هذا الكتاب الّذي سمعت عنه وأنا في مصر سنوات التّسعين، والتقيت معه في مقولة كنت أقولها عندما كنت أجهّز لكتاب "نحن لم نقرأ القرآن بعد"، وهي أنّه أُريد لنا أن نقرأ هذا الكتاب، لا فقط، كأنّه نزل على النّاس الآن بشكل معاصر، وإنّما أيضا، كأنّه نزل على ذلك "الأسكيمو" الّذي وجد كتابا، وهو خالي الذّهن، لا يعرف لا أبا هريرة ولا البيهقي ولا القرطبي ولا غيرهم، أي لقد أُريد لنا أن نهتم بهذا الكتاب وأن نتعامل معه، باعتباره نصّا يحتوي على قصص وأحكام. فقد كنت أقول هذا (أنا أيضا) وأكتبه في الصّحف، فلا يمكن أن أكتفي بهذه المنظومة الّتي تحجب عنّي القرآن أكثر ممّا توضّحه لي. وعندما قرأت كتاب نصر حامد أبو زيد أعجبت به وأعجبت بالشّخص، وأعتقد أنّه من الذين قدّموا لهذا الفتح الذي نحن على عتباته الأولى. ولقد تعرّض هو، كما تعرّضتُ أنا، لاتّهام بأنّنا نريد أن نخفّض من قيمة الإسلام، ومن قيمة القرآن، ونحن (أنا وأبو زيد وأكثر الذين يقومون بهذا العمل)، نريد أن نرفّع من هذا الدّين الذي ينتمي إليه أكثر من مليار ونصف من الناس، ولا يمكن أن نتهكّم عليه، أو أن نعبث به، أو أن نتنكر له. لقد مرّت أربعة عشر قرنا من المغالطة، وأنا أعتقد أنّ تاريخ الإسلام كان دائما ضدّ النصّ المؤسّس، وهو ضدّ القرآن منذ بدأت المعتزلة تسوّق لتفلسف النصّ مع أفلوطين ومع بذرات الفلسفة الإسلامية وقضيّة الفيض وغير ذلك... ثمّ نسينا أنّه لا يمكن أن يكون الوحي باللّفظ، (وقد رجع إلى هذه المسألة طه حسين وأمين الخولي) فاللّه منزّه أن يكون وحيه باللّفظ، وقد قال المعتزلة ذلك في قضيّة خلق القرآن، قالوا إن المعنى يأتي وحيًا، ويتلفّظ به محمّد بن عبد اللّه بلغتنا، وأنه كلام لا يُنطق عن الهوى. والإشكال ليس في ذلك، وإنما هو، بكل بساطة، في ما يمكن أن يمسّ من تنزيه الله حين نعتبر ''كُن'' التي ننطق بها نحن البشر، هي ذاتها ''كُن'' التي يخلق بها الله.
كان فهم المعتزلة ضدّ حرفيّة النصّ، لكنّ ذلك قُبِر منذ زمن المتوكّل، أي بعد انتصار ما يسمّيه محمد أركون "الأرثوذكسيّة الإسلاميّة"، وانتصار أهل الحديث. منذ ذلك الوقت أغلق باب الاجتهاد على محمد وأربعة مذاهب، دون أمل في فتحه أو في الإبقاء عليه مفتوحا، ولعلّ المشكل الأعمق يتعلّق بغلق باب القراءة الذي لم يفتح إلى حدّ الآن. باب القراءة الّتي هي أهمّ شيء، وثمّة آيات في القرآن ماتزال غير مقروءة إلى حدّ الآن، وهي ماتزال فلسفيّا وفكريّا وذهنيّا غير مفهومة؛ "وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا". فمسألة القراءة مهمّة جدّا، وكلمة "قراءة" هي من أقدم الكلمات في اللّغات السّاميّة (وأنا لا أعتقد في التّقسيم إلى سامي وغير سامي في اللّغات، بل أعتقد أن ثمّة تقسيم أعمق من هذا)، وهي من قرّ، يقرّ، قرية... والقرآن ينبّهنا إلى أن ''القراءة'' هي أن تُلصق الشّيء في بطنك كأنّك امرأة ستحمل، وأن تلفظه من جديد ميلادا جديدا، يقولها عمرو ابن كلثوم حين يصف ناقة ضامرة جميلة، ويقول إنّها لم تقرأ فصيلة، أيّ أنّها لم تلد ولم تحبل؛ لأنّ القراءة هي ولادة من جديد. لذلك نجد كلمة قُرُوء (جمع قُرء) مستعملة في القرآن في ذكر شهور العِدّة، والقرآن يقول في زمن العدّة قروء ولا يستعمل كلمة شهور، لأنّ القروء، والقراءة فيها معنى الولادة. فيجب أن ننتبه إلى ذلك السبب وراء استعمال كلمة ''قروء'' عوض ''شهور'' المستعملة في موضع آخر من القرآن (عدّة من شهور أخر). وكلمة قروء وقراءة مهمّة جدّا؛ لأنّها تحيل على معنى الولادة من جديد أي أن نستقبل البذرة، وأن نلفظها ميلادا جديدا؛ وهذا ما لم نقم به إلى حدّ الآن.
د. نادر الحمامي: هذا ما لم نقم به، ولكن يوجد سوء تفاهم كبير بين الشّق الإسلامي في مجتمعاتنا الإسلاميّة (التي لم تقرأ هذا النصّ الـتّأسيسي بعد) وشقّ آخر متمثّل في الغرب، وأنت كتبت في هذه المسألة وقلت بأن سوء التّفاهم كبير. إذن فالإشكاليّة مزدوجة، إشكاليّة المسلمين أمام النصّ المؤسّس وإشكاليّة الغرب أمام هذا القرآن، فكيف ترى الإشكال من الجهة الثانية؟
د. يوسف الصدّيق: من هذا الجانب، في الحقيقة، هذا ما أسمّيه نضالا مع المثقّف الفرنسي، فأنا درست على فطاحل الأساتذة في فرنسا، وقد صادفت في تكويني كوكبة مهمّة من العلماء الأفذاذ، فدرست على ألتوسير (Louis Althusser) (1918-1990)، وآلكيي (Ferdinand Alquié) (1906-1985)، ولوفيناس، وجاك لاكان (Jacques Lacan) (1901-1981)، وحتى جون بول سارتر (Jean-Paul Sartre) (1905-1980) الذي لم يكن يدرّس ولكنني كنت ألتقيه، وفوكو ودولوز، وليوتار (Jean-François Lyotard) (1924-1998)، وكل أولئك العظماء الذين اجتمعوا في جيل واحد أكثر من خمسين اسما في نفس المساحة في باريس، في السّربون، في الحيّ اللّاتيني وفي بوردو وفي مرسيليا، ولكنهم ماتوا، والآن لا يوجد في فرنسا كلّها سوى أربعة أو خمسة أسماء معروفين يشبهونهم، مثل جاك رانسيير، وباليبار (Étienne Balibar) (1942). لقد كنت أحارب كل أولئك العظماء، لأنّهم تلقّوا تعريفا لهذا النصّ من تراثنا نحن، وكانوا يضحكون منه، ويعتبرونه نصّا بدائيا ولا يستحق الاعتناء حتّى كما اعتنى غابريال مارسال (Gabriel Marcel) (1889-1973) الفيلسوف الوجودي المسيحي بالإنجيل، فهو في نظرهم "كلام فاضي" لأنّهم تلقّوا التّراث والمأثور العربي وترجموه واهتمّوا به وتكوّنت لديهم قناعة بأن هذا النص لا يستحق التفكير فيه.
وكما قلت لك لقد كنت أتحدث مع دولوز، ومع مجموعة من أصحاب الدراسات الفلسفية المعمقة في ذلك، وقد أقحم دولوز في كتابه ''الرّأسماليّة والانفصام: أوديب المضاد'' (Capitalism et schizophrénie: L'anti-Œdipe. Livre de Félix Guattari et Gilles Deleuze) وهو في جزئين، أقحم قضيّة إنّما الأعراب أشدّ كفرا ونفاقا، وقضيّة الأعراب لا يعلمون حدود ما أنزل الله...وجعل من ذلك آلية لحرب البدو، وكان لي معه حديث في احدى الندوات التي كنا نقوم بها في باريس الثّامنة. لقد كانت مرحلة صعبة لم أساهم فيها وحدي في باريس، بل كان التّونسيون والمغاربة وكلنا ساهمنا، فالحقيقة إذا كان ثمة نص يستحق أكثر من التوراة والإنجيل بكتبه الأربعة استقباله في المنظومة الفلسفية فهو القرآن. لم أكن وحدي، بل كنا مجموعة حاولنا منذ سنة 1967 أن نقول للغرب إن هذا النص هو نص يستطيع أن يقبل النقاش من كبار أئمّة الفلسفة من أفلاطون إلى اليوم ولكن وجب فبل ذلك أن يتم تنظيفه مما بسّطه التّراث إلى حدّ الضّحالة.
د. نادر الحمامي: طيّب لا يمكنني أن أختم الحوار معك دون استخلاص للعديد من النّتائج أهمّها ما يجب علينا فعله، باعتبارنا مثقّفين أو إلى غير ذلك أو دور المثقّف اليوم، وأذكر أنّك ضمّنت كتابك "لم نقرأ القرآن بعد" مقولة الفارابي إلى سيف الدّولة الحمداني "أجلس حيث أنا أم حيث أنت"، نعم باعتباره موسيقيّا أبو نصر الفارابي قبل أن يكون فيلسوفا حين أجاب سيف الدّولة. بودّي وفي نوع ما من العجالة أن تلحّ شيئا ما على دور هذا المثقّف في علاقته بالسّلطة.
د. يوسف الصدّيق: نحن لم نأت بعد إلى هذه اللّحظة الفاصلة كتلك التي حدثت في فرنسا، عام 1968؛ فقد قال رئيس الوزراء ميشال دوبري (Michel Debré) (1912-1996) لشارل ديغول (Charles de Gaulle) (1890-1970): ''لو سجنّا جون بول سارتر لخفّت المظاهرات وهدأت الفتنة في شوارع باريس وفي غيرها''، فقال له ديغول السّياسي: ''يا ميشال لا يمكن أن نضع فولتير في السّجن، (On ne met pas Voltaire en prison)'' وأُثِرت تلك الكلمة عن هذا الجنرال، فلا يجبأن يكون المثقّف، الذي لا سلاح له والذي هو عارٍ تماما في مواجهة السّلطة، أن يكون مهدّدا، مثلما هي الحال بالنسبة إلينا نحن الآن، فنحن مهدّدون الآن في كلّ مكان، وفي كلّ لحظة، مهدّدون بأن نسجن أو أن نعذّب أو أن نصلّب وتقطع أيدينا من خلاف.
د. نادر الحمامي: شكرا أستاذ يوسف الصدّيق على ما تفّضلت به. و بهذه الدّعوة نختم حوارنا، وأجدّد شكري العميق والحقيقي، دون مجاملة، لتفضّلك بهذا الحوار، وسنعتبره نقطة انطلاق للتّعامل معك لا حقا في محاضرات وندوات.






