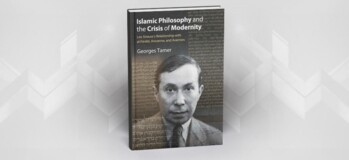«يوسف» و«الكهف» وقدرنا التأويلي
فئة : مقالات

«يوسف» و«الكهف» وقدرنا التأويلي
محمد محجوب
تتراوح هذه الورقة بين بنيتين تأويليتين؛ اخترنا أن نعبّر عن أولاهما من خلال نموذجيّة قصّة يوسف، وعن ثانيتهما من خلال نموذجيّة قصة الكهف؛ فسورة يوسف وسورة الكهف لا تؤخذان هنا بوصفهما سورتين، وإنّما بوصفهما أنموذجين ضمن البرادايم التأويلي:
- فأمّا الأنموذج الأول، فيعطيه تدرّج صورة (figure) يوسف اقتفاءً لأثر هو معنى معطى؛ فكأنّما تريد القصة أن تكون تجربة التقاء بمعنى مقدّر من البداية، وهو المعنى الذي تشير إليه رمزياً صيغة الرّؤيا: "إني رأيت أحد عشر كوكباً والشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين" (الآية).
- وأما الأنموذج الثاني، فتعطيه لا نهائيّة المعنى، التي تعبّر عنها صياغة خبر الكهف نسقاً من الإمكانات نكاد لا نقر إحداها حتى تعوّضها إمكانية أخرى ترجئ الحسم في حقيقتها. ولعلّ صيغة الإرجاء تتحول، في الوقت نفسه، إلى نوعٍ من صيغة الرجاء، الذي يجد عبارته في هذا الاستدراك المزامن لكلّ إقرار: "قلّ ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ..." (الآية).
وتنتهي الورقة إلى طرح مفهوم «القدر التأويلي» (destin herméneutique) من خلال التّساؤل عن معوّقات «الإصلاح» في تراثنا: أليس هو أنّنا أخذناه دوماً على جهة الرؤيا التي نؤوّلها إلى معنى سابق، متعالٍ، على كلّ إنسان (تأويليات «المجاز»، والدّلالة «الحقيقية»...)؟ ألا يمكننا تعويض ذلك بنموذج الخبر «عبرةً» يعتبرها كلّ إنسان بحسب إنسانيّته المحايثة (تأويليات التحرر)؟
في نصّ من ألفت نصوص نظرية التّأويل تأريخاً لهذه النّظرية منذ سنة (1978)، وتنزيلاً لها في سياق التوسّط لجدل بين الأدبيّات الأنطولوجية لهايدغر وغادامر، من جهة، وبين الاستشكالات الإبستمولوجية لهابرماس وآبل من جهة أخرى، يكتب ريكور محيلاً على غادامر (Gadamer):
«فعند [غادامر]... ينبغي فهم الانضواء الوجداني في التقليد «كتطبيق»، [يجري توسطاً] بين معيار الماضي والوضعية الحالية. فبفضل التّطبيق يُعاد تصوير فاعليّة التاريخ في قوّتها الأصليّة، على الرغم من المسافة الزّمنية. وساعتها يُنشَدُ أنموذج التّأويل في ما يقوم به القاضي من تحيين المعيار».
ودون أن ينكر آبل وهابرماس أن يكون غادامر على أتمّ الوعي بأنّ التّأويلية لا يكون لها ما تقوله إلا متى فَقد التّقليدُ قوّته؛ أي متى كان في وضعيّة أزمةٍ يوشك فيها تواصل حركة النّقل الثّقافي أن ينقطع، فإنّهما يريان في «التّطبيق» حدّاً (limitation) من المشروع الهرمينوطيقي أكثر ممّا هو تحقيقٌ له. فإنّ المرء لا يتحدّث عن التّطبيق إلا في ما تعلّق بالنّصوص الدّينية، التي لا تزال سلطتُها قائمةً حتى وإن ضعفت، أو بالنّصوص الأدبية «الكلاسيكية»؛ أي التي تحتمل تحييناً في كلّ وضعية ثقافية، أو بالنّصوص القانونية، التي تظلّ قيمتها المعيارية فوق كلّ جدل. ولكنّ هذه العلاقة بالتقليد ليست هي العلاقة الحديثة به. ومن هذا المنظار، إنّ المشكل الذي تطرحه الثّقافات اللاأوروبية أو اللاأمريكية أوضحُ وأشدُّ جذريةً من مشكلنا نحن؛ ذلك أنّ إعادة تملّك الماضي لم تعد تقبل تصوُّرها كتطبيق، وإنما كعبور (يشُقُّ من خلال) شكٍّ جذريٍّ يضاهي مماسفةً (distanciation) شاقَّة أحياناً. وفي الوقت نفسه لم يعد ممكناً أن نُرجعَ كلّ مماسفة إلى الاغتراب المنهجيّ (المعروف). وإنّما المماسفةُ جزءٌ لا يتجزّأ من الأسلوب الحديث بحقٍّ في العلاقة بالتّقليد. وفي هذا المعنى، إنّ عين المماسفة هي التي تجعل إعادةَ التملكِ والتجريدَ المنهجيَّ ممكنين. ويسلّم آبل، بغير مشاحّة، أنّه قد أصبح من العسير اليوم أن نقول بالمقالتين معاً: فمن ناحيةٍ، لا بدّ لنا، حتى لا نقع من جديد في مضائق النزعة التاريخية (historicisme)، من أن نقول إنّه ليس ثمّة موقف محايد نستطيع منه أن ننظر عن بعد إلى كلّ التقاليد: وبهذا المعنى، إنّ نقل التّقليد يظلّ شرط إدراك أيّ موضوع ثقافي؛ فتشتغل الهرمينوطيقا إزاء الوهم المنهجيّ بمثابة كاشف للسذاجة. ولكنّه ينبغي علينا، من ناحية أخرى، أن نعترف بأنّ هذا التقليد أو ذاك لم يعد يخاطبنا، وأن إعادة تملّكه المباشرة ممنوعة علينا. فيبقى لنا أن نستفيد من المماسفة نفسها، وأن نمارس بفضلها شبْهَ موضعةٍ للمضامين المنقُولة، حتى ندرك تملُّكاً أكثر توسُّطاً، وأشدَّ تعقيداً، ليس لنا بعد، في كثير من الأحوال، مفتاحه.
ولكنّ منطق «التّطبيق» (Anwendung) لا يعني مجرّد الإخضاع، الذي نتولّى فيه قراءة المعطى الجديد وفق أنموذج يقدّمه لنا التراث والتّقليد، وإنّما هو كذلك، وخاصّة الوضع الذي نعتبر فيه روح التقليد الموروث اعتباراً: لا لاستحضار إيقاع مكرور وجاهز، وإنّما لتمثّل معنى لنا: هو ليس استحضاراً للمقصد يفرض علينا الوجهة نفسها، ويلزمنا بالحركات نفسها، وإنّما معاودة للإيماءة (une répétition du geste)، بعد أن غادرنا التُّربة الأصلية، والموطن الأصلي، ولم يعد يصاحبنا غير الحنين. ذلك هو التّفلسف: حنينٌ يجد منه المرء نفسه في بيته، في وطنه، في موطنه حيثما كان. وليس ثمّة تعريف أوفق للتأويل من هذا الحنين الذي نستحضر به التقليد، ولكن لا لإنشابه في الحاضر موضوعاً له طيّعاً.
إن هذين الأنموذجين هما ما خلتُ أنه يمكنني استنطاقهما ضمن قصصيتي «يوسف» و«الكهف»: فرؤيا يوسف منوال الرؤيا المفتوحة على دلالتها لا يكون استحضارها إلا لحاقاً بتلك الدلالة. إنّ صورة يوسف «آية للسائلين»، وجواب يقدّمه النص عن كلّ استفهام للمعنى. هي أكثر من العجيب الذي تصفه قصة الشغف الذي طوح بامرأة العزيز: إنّها جواب كلّ من يسأل عن المعنى.
يوسف جواب. ويعني ذلك أنّ رؤياه تحتوي من قبل على حقيقتها؛ بل على مصداقها لما يعقب الرؤيا من الأحداث: جاء في تفسير؟ (التّحرير والتنوير) أنّ القصة تنبيه ليوسف «بعلوّ شأنه ليتذكّرها كلّما حلّت به ضائقة، فتطمئنّ بها نفسه أنّ عاقبته طيبة». ولكن اللافت في قصة يوسف أنّها مع ذلك تسرد الأحداث دون اطمئنان.
إنّ سورة يوسف تفترض نهايتها واطمئنان نهايتها، وتصرّح بأنّ يعقوب كان على أتمّ العلم بمفتاح الرؤيا، ولكنها مع ذلك تعرض مشاهد يعقوب ضمن تتالي صور المأساة، التي كأنّما تنسى لبرهة من الزمن ما كانت قدمته، واطمأنّت إليه من مفاتيح المأساة: صورة يوسف ليست صورة الفاجعة التي يكتنفها هلع اللايقين، ولكنّها صورة الحزن (حزن يعقوب النموذجي خاصة) هذا الحزن الذي يعيش نفسه، ويخبر زمانيته، حزن لا يأتي من عدم الاطمئنان وإنما هو حزن في عين الاطمئنان إلى أن مصيره معروف: يعقوب مطمئنّ إلى مصير يوسف، ولكنّه، مع ذلك، خائف حزين: "قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون"، بل تبلغ القصة قمّتها حين تعرض مشهد الحزن المطمئنّ؛ بل حتى «العالم بما لا يعلمون»: "قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزْنيَ إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون".
إنّ أنموذج يوسف هو أنموذج جريان الحياة ووقوع الحكاية كتحقيق ملتزم لقدر تأويليّ لا مبدّل له. في البدء كانت الرؤيا. ولدى النهاية كانت الرؤيا "قد جعلها ربي حقا" (الآية). ولم يجعلها في الأثناء إلا تطبيقاً لا يحيد عن الرؤيا. ليست قصّة يوسف، في حد ذاتها، هي التي تعنينا هاهنا. وإنّما يعنينا المنوال الذي تقدّمه لعلاقتنا بالتقليد: أننا لا نحيّن هذه العلاقة إلا كتطبيق لها، تماماً كما أنّ يوسف لا يعيش حكايته، ولا يخبر حياته، ولا حياة أبيه يعقوب، ولا حياة عالمه بأكمله إلا كتطبيق للرؤيا. ما هو التّأويل إذاً؟ إنّه تطبيق معيار الرؤيا الأولى على مسار الأحداث التي تجري.
وعلى العكس من ذلك، تبدو قصّة الكهف محرّرة للفعل وللحدث وجريان الحدث؛ فحكاية الكهف نبأ وخبر. ومن هذه الناحية لا فرق بينها، بوصفها قصة وبنية قصة، وبين قصة يوسف. ولكنّنا مع الكهف لدى خبر لا يتعلّق الأمر بأن ندركه ونعايشه كتحقق لصيغته الرمزية الأولى؛ بل الخبر معطى للاعتبار، وهو إلى ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، معطى مصحوب، تلازمه بنية التخفّف التي تجعل الاعتبار بالحكاية متاحاً لكلّ قارئ ولكلّ سياق، من جهة كون الإحداثيّات الواقعية للحكاية ليست ملزمة ولا ضاغطة. إننا، هاهنا، لا نبذل الحياة تحقيقاً لرؤيا، وإنّما نعيشها في أفق الرحمة التي لا تسلّط البدء على القارئ مآلاً محتوماً: "سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل" [الآية 21].
ليس على الفعل من شرط، وليس عليه من قدر يضاف إلى مشيئة الرحمن. لذلك مباشرة تعقب رمزية الكهف إطلاقيّة حرية الفعل، التي لا حدّ لها خارج المشيئة التي لعلّ جوهرها أنّها غير معلومة. ليس الأمر، هاهنا، محكوماً بضرورة تحقيق الرؤيا تطبيقاً لإرادة معلومة وسابقة، وإنّما هو الفِعل، بل ربما «الفَعل» (Agir)، الذي يخبر حريّته الأصلية كقصد لا علم له بنتيجته، رغم أنّه يظل تحت سماء المشيئة الإلهية غير المعلومة "قل الله أعلم ..." (الآية).
ما أعنيه بالقدر التأويلي، إذاً، هو هذا التأرجح بين بنية التأويل تطبيقاً، ولكنّه تطبيق معرض إلى ضرب من هزال التقليد عن إعطاء المعيار، هزال بتنا نرى العناد اليومي (acharnement) في التمسّك به صارخاً، في دموية التعامل مع الحاضر، لكأنّه اعتراض على تمنّع هذا الحاضر من الإذعان للمعيار، وبين بنيته عبرةً تتخفف من مادية التقليد، ومن ثقل ارتباطه بإحداثياته لتقبل على الحاضر بإيماءة الرمز، إيماءته فقط، وتفعل فيه وفق منطق الحرية: ألا إنّ أول شروط الحرية هو الرجاء.
منطق الحرية، هاهنا، هو منطق العبرة بما هي العبرة من الخبر، من «النبأ» في عبارة القرآن الكريم. ما هي العبرة؟ وهل كلّما تمثّلنا وقائع ماضٍ ما، أو تقليد ما، حصل لنا من تمثّلنا ذاك إدراك معنى؟ إنّ تمثّل الوقائع ضمن حدث ماضٍ ما يعني إدراك بنيتها الدلاليّة من جهة ما هي عناصر محيلٌ بعضها على بعض ضمن ترتيب من إنشائها؛ لأنّه ترتيب لا يسابقها إلى بنية يضعها لها من قبل، حيث يؤدّي تلاؤمها مع تلك البنية إلى شهادتها عليها. إنّ ترتّب الوقائع ضمن بنية ذاتيّة قد يفيدنا بمدلول، ولكنّه لا يستطيع أن يفيدنا بمعنى. ويقتضي الحديث عن المعنى، على العكس من ذلك، تمدّد الإحالة التي لكلّ عنصر من عناصر بنية ما إلى خارج تلك البنية. إنّ ذلك التمدّد هو الانتشار الزّماني، الذي يسمح بالمعاودة على نحو غير تكراري، فكأنّما ترتسم لدى كلّ اطّلاع «على أحوال الماضين من الأمم» مضارعة لتلك الأحوال تعيد، بشكل ما، تولّد آنات تلك الأحوال على دياغرام هوسرل المعروف، بضرب من تشاكل (تآلف؟ تضامن؟) المصير؛ أي من تشاكل إيقاع الذهاب والإدبار، وذلك هو الذي نسميه درساً. ما الذي يسمح بتمثّل ذلك التشاكل؟ لا شك في أنّ الذي يسمح به ليس أياً من العناصر، إذا ما أخذناها في ذاتية ملامحها؛ أي في تضاريس فرادتها المخصوصة. إنّ خروج عنصر «الأحوال الماضية» من فردانيّة صورته (l’individualité de sa forme) ذات المدلول، إلى كثرته الافتراضية (sa pluralité hypothétique) هو الذي يسمح بتمثّل المعنى لدى الاطّلاع على «أحوال الماضي»، وهو الذي يسمح خاصّة بالانتقال من حديث يتمثّل الماضي إلى حديث يتمثّل التّاريخ بوصفه حدث المعنى.