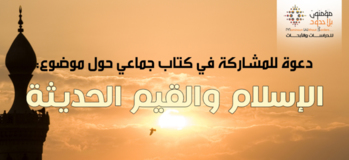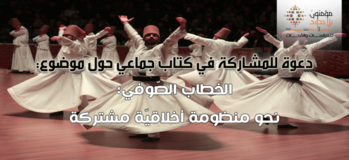دعوة للمشاركة في مشروع بحثي بعنوان: "من قضايا الإسلام السياسي"
فئة: المشاريع البحثية القادمة
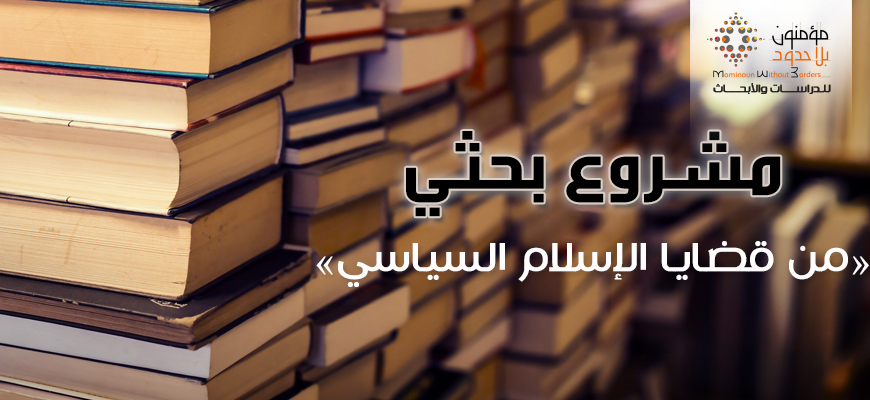
مشروع بحثي:
من قضايا الإسلام السياسي
مدخل تمهيدي:
بقطع النظر عن جدّة المفهوم أو قدمه وقبوله أو رفضه، فإنّ موضوع الإسلام السياسي لم يعد مشغلا ضيقا موكولا لفئات مخصوصة تتناوله بالبحث والمتابعة في المجال السياسي أو الأكاديمي، بعد أن أضحى له من الانتشار والرواج والتأثير في المجال المحلّي بل والدوليّ، ما جعله حديث القاصي والداني بفعل نشاط أتباعه في الكتابة وكثافة حضورهم في مختلف المجالات (وخاصة في الإعلام ووسائل الاتصال)، وباتت أطروحاتهم متداولة مشهورة بعد أن كانت مقصورة على جماعات محدّدة اختارت الاشتغال في كنف السرّيّة والتكتّم على هامش الدولة. وقد يكون من أبرز أسباب الانتشار التحوّلات التي طرأت اليوم في العالم العربي والإسلامي بفعل ما سمّي بـ"الربيع العربي"، وهو الذي ساهم في إتاحة الفرصة لأنصار الإسلام السياسي، كي يمارسوا السلطة ويخوضوا تجربة الحكم بعد أن نجحوا في توجيه الرأي العام واستقطابه وأعلنوا قبولهم الانخراط في العمليّة السياسيّة من داخل الدولة وعبر قنواتها الرسميّة والمؤسّساتيّة والقانونيّة في جزء كبير منهم. ولم يُخْفِ هذا حذر بعضهم من مثل هذا الانخراط وتذبذبهم في قبوله والالتزام به، وهو ما جعل المواقف من الإسلام السياسي متباينة (من داخله ومن خارجه) بين من يدافع ومن يعارض أو يحترز، ومن ثمّ اختلفت القراءات والمواقف حول طبيعته ونجاعته ومستقبله؛ فثمّة من سلّم بفشله واستشرف زواله واندثاره، وثمّة أيضا من أكّد استمراريّته وبارك المراجعات التي أعلنها أتباعه من داخل المنظومة نفسها، وهو ما جعلنا أمام صنفين من الخطاب: خطاب الإسلام السياسي ذاته، وخطاب على خطاب الإسلام السياسي.
وقد أضحت المسألة متشعّبة نتيجة تنامي الإسلام السياسي وسعة انتشاره إلى درجة حوّلته إلى ظاهرة مركّبة متحوّلة عرفت توظيفات شتّى ولم تبرز في شكل واحد، بل كانت لها أشكال عدّة تصل أحيانا حدّ التضاد والتناقض (إسلام أصولي، دعوي، جهادي، راديكالي..). ومثل هذا الوضع يطرح إشكاليات كثيرة منها ما يتعلّق بالجهاز المفهومي الذي يقوم عليه الإسلام السياسي، ومنها ما له صلة بالتصوّرات والخلفيّات النظريّة والمرجعيّات وطرائق العمل والانتظام داخله، ومنها ما يهمّ مستقبله أو أفقه وغائيّاته.
ولفهم هذه الظاهرة وتفكيك خطاباتها والوقوف على مكوّناتها وآليّات اشتغالها وتداعياتها وآثارها وآفاقها نقترح الاشتغال على المحاور الكبرى التالية:
- فلسفة الإسلام السياسي
- الإسلام السياسي: المراجعات والتحوّلات
- الإسلام السياسي والدولة الوطنيّة
- الدين والدولة في الإسلام المبكّر.. أيّة علاقة؟
- الظاهرة الجهاديّة في الإسلام السياسي: منابعها، تطوّراتها
- مواقف الإسلام السياسي من المفاهيم الحديثة والقيم الحديثة
- الإسلام السياسي والإسلام الصوفي
- الإسلام السياسي في عيون ناقديه
1) فلسفة الإسلام السياسي:
بما أنّ الإسلام السياسيّ تصوّر دينيّ، فهو يقوم على مصادرات أنطولوجيّة تمثّل قوام تفسيره للكون، لأنّ كلّ دين هو تصوّر معيّن للكون، وهو تصوّر يقوم على ثالوث: اللّه، الوجود، الإنسان. والانطلاق من تفكيك هذه المصادرات قد يكون أساسا لا محيد عنه لفهم القاع الدينيّ الميتافيزيقي الذي يسند خطابهم وتوجهاتهم؛ فضلا عن تبيّن خلفيّتهم النظريّة التي انطلقوا منها في بناء منظومتهم الأيديولوجيّة الجامعة بين التنظير والممارسة، وهو تصوّر عبّرت عنه كتابات أبرز أعلامهم المؤسّسين منذ حسن البنا (في "رسالة العقائد" مثلا)، وأبي الأعلى المودودي (في "المصطلحات الأربعة في القرآن")، وسيّد قطب (في "في ظلال القرآن")..، واستمرّ يتداول بالمعاني نفسها عند ممثّليه الحاليّين، ولاسيما في كتابات يوسف القرضاوي الشاهد على كلّ أجيال الإسلام السياسيّ تقريبا. ويطرح النظر في هذه المصادرات الأنطولوجيّة الأسئلة الكبرى التالية:
- ما تصوّر الإسلام السياسي للوجود عامة (الله، الكون، الإنسان)؟
- كيف تبدو علاقة الإيمان بالعمل من منظور الإسلام السياسي؟
- ما منزلة الإنسان في الوجود (مقالة الاستخلاف ودلالاتها: الممارسة السياسيّة، العهد مقابلا للعقد الاجتماعي، الولاء والبراء..)؟
- هل يؤسّس التنظير الأنطولوجي لدى دعاة الإسلام السياسي فلسفة ما للوجود؟ وبأيّ معنى؟
2) الإسلام السياسي: المراجعات والتحوّلات
مرّ الإسلام السياسي منذ تأسيسه (فترة ما بين الحربين العالميّتين) إلى اليوم بأطوار ومنعرجات كبرى؛ فقد انتقل من طور مهادنة الدولة (مع حسن البنّا مثلا) إلى طور مواجهتها، بل تكفيرها والدعوة إلى محاربتها (سيّد قطب مثلا في مواجهة نظام جمال عبد الناصر بداية من فترته القطبيّة)، فطَوْر التحالف الظرفي الضمني معها (مع السادات) وصولا إلى طور ممارسة الحكم وتسيير دواليب الدولة (حزب العدالة والتنمية في تركيا/حزب النهضة في تونس/جماعة الإخوان في مصر..). ولم تكن الطريق ممهّدة في جميع الأطوار، بل لقي الإسلام السياسي معارضة ورفضا دفعاه إلى إعلان القيام بمراجعات، وهي مراجعات وجّهت في الفترة الراهنة نحو التفاعل إيجابا مع منطق الدولة ومؤسّساتها ومقتضيات الديمقراطيّة وأسبابها... ولم تكن هذه المراجعات من جهة واحدة، بل تعدّدت الجهات التي صدرت منها، فبعضها جرى من داخل تسلسل منظّريه أو دعاته الذين بقوا أوفياء لأطروحته الرئيسيّة ومن أبرزهم في الوقت الحالي: عبد الله النعيم، عبد الله النفيسي، سعد الدين العثماني..، وبعضها الآخر جرى من جهات خرجت عن تلك الأطروحة، ومن أولئك الذين فكّوا ارتباطهم به وخرجوا عنه: محمّد اللويزي، عبد الجواد ياسين، كمال حبيب....
وكذلك الشأن مع السلفيّة التي انتقلت من طور الحركة الدينيّة الإحيائيّة الصرف إلى مرحلة المعارضة السياسيّة، وأدّى تسيّسها التدريجي إلى أن قبلت بالحزبيّة، بل وصلت إلى المشاركة في ممارسة الحكم في إطار الدولة منذ عام 2005 في الكويت مثلا، وبعد ثورة الربيع العربيّ مع حزب النّور السلفي في مصر، بل ظهرت منها سلفيّة ترقّت في معارضة الدولة، وحقّقت نوعا من التوافق مع الاتّجاه الحركي القطبيّ، كان منها ما هو معروف راهنا بالسلفيّة الجهاديّة. وبالإمكان تدبّر أهمّ القضايا سالفة الذكر في المحاور التالية:
- استرجاع الأطوار الكبرى للإسلام السياسي بفرعيه الحركي الإخواني والسلفي من زاوية مقارنة.
- هل مسّت مراجعات الإسلام السياسي الثوابت الفكريّة التي قام عليها أم اقتصرت على مسائل هامشيّة اقتضاها الظرف المتغيّر؟
- هل كانت هذه المراجعات استجابة لضغوط الواقع التاريخي بمختلف تطوّراته، أم أنّها حصيلة تطوّر نظري ذاتي تلقائي؟
- ماهي تداعيات هذه المراجعات والتحوّلات على واقع الإسلام السياسي اليوم وعلى مستقبله؟
3) الإسلام السياسي والدولة الوطنيّة:
يطرح هذا المستوى أكثر من إشكال، فالإسلام السياسي لا يقرّ إلاّ بالدولة الإسلاميّة؛ ومن ثمّ فهو لا يعترف بالدولة الوطنيّة في ذاتها، وإن أعلن انصياعه لمتطلباتها وانتظم وفق نواميسها وشروطها وقبل ممارسة الحكم بواسطتها. ولهذا، يتّهم الإسلام السياسيّ بأنّه يعمل على اختراق الدولة وتوظيف أجهزتها ومؤسّساتها لتحقيق مشروعه السياسيّ الإسلاميّ، لأنّ الهويّة الدينيّة في عرفه أهمّ من الهويّة المدنيّة أو الوطنيّة؛ لذلك نجده يتحرّك في مستويين اثنين:
- مستوى نظري: يتمّ فيه تغليب الديني على السياسي، باعتبار الدولة مجرّد أداة لتنفيذ المشروع الديني ورعايته؛ فالديني يحتوي السياسي ويتحكّم فيه، ومن هنا قد نفهم دواعي رفض العلمانيّة ومحاربتها.
- مستوى عملي حركي: يقوم على مهادنة الدولة، والخضوع لمنطق عملها حينا والمواجهة والاختراق والتحوير لخصائصها من الداخل حينا آخر.
واستنادا إلى المستويين المذكورين أعلاه، بالإمكان تبرّر إشكاليّة العلاقة بين الإسلام السياسي والدولة الوطنيّة في المحاور الرئيسيّة التالية:
- ماهي مقوّمات الدولة الإسلاميّة التي تفارق بها الدولة الوطنيّة؟
- الدولة الوطنيّة في غربال الإسلام السياسي (الأجهزة والمؤسّسات، مرجعيّة التشريع، التسميات، المواطنة، العلمانيّة، الديمقراطيّة...).
- الإسلام السياسي في اختبار ممارسة السلطة السياسيّة داخل الدولة الوطنيّة.
4) الدين والدولة في الإسلام المبكّر.. أيّة علاقة؟
لعلّ من أبرز حجج الإسلامويّين ومرجعيّاتهم العلاقة بين الدين والدولة في الفترة الأولى للإسلام؛ فالدولة بالنسبة إليهم هدف للدين وأداة له منذ تجربة النبيّ في المدينة، وليس مشروعهم إلاّ سيرا على منهاج النبيّ القدوة. يتطلّب هذا التأكيد الذي ينطلقون منه التثبّت في مدى صدق الدعوى، أو وجاهتها وصلاحيّتها، ويقتضي العودة بالنظر والتقييم إلى مجمل الدراسات التي تعلّقت بالفكر السياسي الإسلاميّ المبكّر، وهي دراسات قلّبت النظر في ما اصطلح عليه باسم "الإسلام المبكّر" أو "صدر الإسلام"، وهي الفترة التي تمتدّ على القرنين الأوّلين بعد ظهور الإسلام. وعلى الرغم من تعدّد الكتابات والتوجّهات والاختصاصات المعرفيّة، فإنّه يمكن حصر المشاغل في محاور كبرى نظر فيها الباحثون ولكن يمكن الإقرار أنّها تبقى دائما في حاجة إلى مزيد البحث بمناهج ومقاربات مختلفة. ولعلّ من أهمّ المحاور التي يمكن الانتباه إليها:
- محددات "العقل السياسي" الإسلامي إذا ما استعرنا عبارة الجابري، وهي مقاربة تمزج بين الفلسفة السياسية والتاريخ، أو لنقل قراءة التاريخ السياسي الإسلامي في ضوء النظريات الفلسفية في السياسة.
- أمّا المحور الثاني المهمّ، فيتعلق بالبحث في التداخل بين المستويات الفكريّة والحضاريّة والعقائدية والأخلاقيّة والاقتصادية وأثر ذلك التداخل في تشكّل الفكر السياسي وتطوّره.
- ويرتبط المحور الثالث الكبير بالحفر في المفاهيم السياسية الكبرى وفي آليات الحكم في الإسلام المبكّر ومدى أصالة تلك المفاهيم أو وفودها على المسلمين في تلك الفترة، والمقصود بذلك النظر في مفاهيم من قبيل السلطة، والنفوذ، والشرعيّة، وما يترتب على هذه المفاهيم من جهاز اصطلاحي له دلالته السياسية والحضارية من قبيل ألقاب الخلفاء، ومفاهيم الشرف الديني أو العرقي، أو المرتبط بالقبيلة، والشورى، والإجماع، والطاعة، والعصيان، والخروج.
- ومناط المحور الرابع هو تجاوز القراءات التاريخية والتاريخانية والوضعيّة القائمة على مقارنة الأخبار الكثيرة، والمتضاربة في كثير من الأحيان، ذات العلاقة بالتجربة السياسية الإسلامية المبكرة، نظرا إلى ما شاب تلك الأخبار من أبعاد ملحميّة وتراجيدية، وما داخلها من اعتبارات عقائدية ومذهبية، وهو ما يفتح الباب شارعا أمام المقاربات الأنثروبولوجية والرمزية للنظر في المتخيل السياسي الذي أحاط بالتجربة السياسية الإسلامية في عهدها الخليفي وفي زمن الأمويين والعباسيين الأوائل بالخصوص.
5) الظاهرة الجهاديّة في الإسلام السياسي: منابعها، تطوّراتها
تعدّ الظاهرة الجهاديّة من أكثر الظواهر حساسيّة وخطورة في الإسلام السياسي، فهي محلّ تنازع واختلاف بين جميع تشكيلاته، وخاصة الإخواني القطبي والسلفي الحركي (مع السلفيّة السروريّة مثلا). فكلّ له تأويل أو فهم للجهاد يصرّفه وفق ما يستجيب لأهدافه وغاياته، وينسجم مع طرحه الأيديولوجي الذي يريد تكريسه ليكون المتحكّم في حياة الفرد والجماعة، وبه يضرب كلّ أساس للغَيْرِيّة والاختلاف والتنوّع... وهذا من شأنه أن يزرع الفرقة في الوقت الذي ينشد فيه الوحدة، ولعلّ تطوّرات توظيف هذا المفهوم مع الإسلام السياسي تكفل وحدها إبراز ذلك، انطلاقا من الجهاد الأفغاني؛ فتنظيم القاعدة وصولا إلى تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام، وهو ما يدفع إلى تتبّع مسارَيْ "التأويل السِلْميّ" و"التأويل الحربي" لهذا المفهوم، والمفاهيم المترتّبة عليهما، وتداعياتها في ظلّ التوظيفات السياسيّة المختلفة لها، لفهم كيفيّة تحوّله من تجربة أخلاقيّة تقَوِيّة، إلى عمليّة قتاليّة سياسيّة، وتصنيفة قانونيّة فقهيّة للأفراد والمجتمعات والدول، بل اعتباره نظاما معرفيّا شاملا برؤيته للعالم وأبعاده المدنيّة والاجتماعيّة، ومنهجا للتغيير، يستمدّ مشروعيّته من أصول قرآنيّة وتأويلات فقهيّة وتجربة تاريخيّة لا تخلو من قداسة.
ومن ثمّ نقدّر أنّ التصدّي لهذه المسائل يستدعي النظر في القضايا التالية:
- مرجعيّات الجهاد من منظور الإسلام السياسي.
- ما هي المنعرجات الكبرى لمسار تطوّر فكرة الجهاد وممارسته لدى دعاة الإسلام السياسي (من فكرة مجاهدة العدوّ الخارجي إلى ممارسة الجهاد داخل المجال الإسلامي وخارجه دون استثناء من جهة، ومن فكرة دفع العدوان إلى الحرب الكونيّة الشاملة لتطهير العالم من جهة أخرى)؟
- التعبئة للجهاد: مسالكها وأدواتها من الدعوة والتبليغ إلى الاستقطاب والتوجيه (توظيف مكتسبات التواصل الشبكي).
6) مواقف الإسلام السياسي من المفاهيم الحديثة والقيم الكونيّة:
تتّسم مواقف الإسلام السياسي من المفاهيم الحديثة والقيم الكونيّة بالارتباك والتذبذب، إذ لم يخف رفضه لها ولم يتردّد في مهاجمة مرجعيّاتها وحتّى تكفير رموزها والمؤمنين بها من جهة، ولكنّه في سياق ما أعلنه من مراجعات يبدي مرونة نسبيّة في التعاطي معها من جهة أخرى؛ فهو قد لا ينكر الحرّيّة والتعدّديّة وقد لا يعترض على حرّيّة المعتقد والضمير والعلمانيّة والقوانين الوضعيّة، وقد يبرّرها ويشرّع لها من خلال النصوص ذاتها التي عارضها بها بداية، بل قد يعلن أنّه متبنّ لها وأنّ الإسلام الذي يقدّم، مرجع في الإيمان بها وأصل في فهمها وبيان الحكمة منها وطرائق إجرائها وتفعيلها. ولكنّه عمليّا قد يمارس خلاف ذلك، وخاصة إذا تعلّق الأمر بالمسألة الإبداعيّة رسما ونحتا ومسرحا وسينما وأدبا.. وهو ما يفرض البحث في طبيعة هذه المواقف ومرجعيّاتها وأسباب تذبذبها وارتباكها، وذلك من خلال المحاور التالية:
- ما موقف الإسلام السياسي من القيم الكبرى للحداثة (الحرّيّة، الحقّ، العدالة، المساواة..) والمبادئ الأساسيّة التي قامت عليها (الإنسيّة، مركزيّة الإنسان في الكون، حقوق الإنسان..)؟
- جدل الكونيّة والخصوصيّة من منظور الإسلام السياسي
- موقف الإسلام السياسي من المسألة الإبداعيّة
7) الإسلام السياسي والإسلام الصوفي:
لم يخف التوظيف السياسي للإسلام الصوفي، على الرغم من كون أدبيّاته تعلن نأيها عن مثل هذا المجال وتجنّبها له، لذا كثيرا ما عيب عليه ههنا دوره السلبي المكتفي أساسا بمسايرة الأنظمة الحاكمة وتأييدها، وانصرافه نحو تعميق البعد الروحي في الإنسان والدعوة إلى المحبّة والانفتاح على الآخر، ونبذ الكراهية والعنف والتطرّف، وهذا ما جعل أصواتا كثيرة تنادي اليوم به بديلا عن الإسلام السياسي، وترى أنّ قوّة حضوره وانغراسه في المجتمعات العربيّة والإسلاميّة وأثره فيها قد يمكّن من الحدّ من تنامي عدد أتباع الإسلام السياسي واحتوائهم وتقديم صورة عن إسلام منفتح معتدل طهري تلغي الصورة العنيفة المنغلقة والمتشدّدة التي أفرزها الإسلام السياسي في بعض تشكيلاته.
وهذا قد يعني أنّ محاولة بعض أعلام الإسلام السياسي استقطاب التصوّف بإعلان اعترافهم به، وانخراطهم في سلكه لا يعدو أن يكون دارجا ضمن مشروعهم الرئيس الذي يقدّم نفسه على أنّه الممثّل الأوّل للإسلام بمختلف أطيافه والناطق من ثمّ باسمه، يقول عمر الشوبكي مثلا في حديثه عن جماعة الإخوان المسلمين: "امتلكت الجماعة مرجعيّة فكريّة وسياسيّة مرنة سمحت لها أن تمتلك تصوّرا شاملا وعامّا للإسلام يسمح للإخوان أن يكونوا سياسيّين إذا أرادوا، وأن يكونوا دعاة فقط للأخلاق الحميدة إذا أحبّوا، وأن يكونوا شيوخا على منابر المساجد أو نوّابا تحت قبّة البرلمان، وأن يكونوا صوفيّين، وأن يكونوا أحيانا ثوّارا، وأن يكون بين قادتهم القاضي المحافظ كحسن الهضيبي، والمناضل الرّاديكالي كسيّد قطب". وقد يكون ذلك سياسة مرحليّة لا يمكن أن تلغي ما سبق من نظرة تبديعيّة تكفيريّة تبنّتها تيّارات الإسلام السياسي تجاه التجارب الصوفيّة، فضلا عن اختلاف المنطلقات الفكريّة لكليهما في تأويل النص الديني وتمثّل العلاقة بين الإنسان والله وأبعادها الوجوديّة.
وبناء على ما سبق، نقدّر أنّ العلاقة بين الإسلام السياسي والإسلام الصوفي تطرح الإشكاليّات التالية:
- التجربة الدينيّة بين الإسلام السياسي والإسلام الصوفي (مظاهر التوظيف وحدوده).
- السلطة السياسيّة بين الإسلام السياسي والإسلام الصوفي
- الإسلام السياسي والإسلام الصوفي: صراع مواقع أم اختلاف مواقف؟
- إلى أيّ حدّ يمكن أن يوفّر الإسلام الصوفي إمكانا للحدّ من العنف الذي ارتبط بتجارب الإسلام السياسي؟
8) الإسلام السياسي في عيون ناقديه:
حظي الإسلام السياسي باهتمام كثير من المفكّرين الذين تناولوه من زوايا عدّة ومقاربات مختلفة، بعضهم نظر في المرجعيّات والأسس النظريّة والأيديولوجيّة، وبعضهم استشرف مستقبله ووضعه على محكّ التجربة التاريخيّة، وبعضهم تتبّع أهمّ خصائصه وآليّات تحرّكه وانتشاره.. وجميعهم بحث عن فهم هذه الظاهرة وتداعياتها وآثارها وعيا بموقعها في خارطة السياسة العربيّة والإسلاميّة وحتّى العالميّة، وأيضا بوقعها وقدرتها على توجيه الرأي العام وتغيير أنماط التفكير والأنظمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة.. والأمثلة على ذلك كثيرة مشرقا ومغربا (محمّد سعيد العشماوي، رفعت السعيد، حسام تمّام، محمّد الشريف الفرجاني، عبد المجيد الشرفي، جيل كيبال، فرج فودة، أوليفييه روا...). ويمكن تتبّع العمليّة النقديّة للإسلام السياسي استنادا إلى المحاور التالية:
- ماهي التوجّهات النقديّة الكبرى للإسلام السياسي؟
- ما هي أبرز المنظورات التي تمّ في ضوئها نقد تجربة الإسلام السياسي (منظور ديني، منظور اجتماعي، منظور سياسي، منظور تاريخي، منظور علمي، منظور إيديولوجي..)
- الإسلام السياسي بين محاولات التفهّم والنقد والتقويم والتقويض.
- نقديّة هدّامة أم تصحيحيّة بنائيّة؟
- ردود الإسلام السياسيّ على ناقديه.
مواعيد مهمة:
- آخر أجل للتوصّل بالملخّصات: 31 ـ 08 ـ 2018.
- آخر أجل للردّ على أصحاب الملخّصات المقبولة فقط: 30 ـ 09 ـ 2018.
- آخر أجل للتوصّل بالمقالات والبحوث التامّة: 31 ـ 12 ـ 2018.
- آخر أجل للإعلان عن نتائج التحكيم 01 ـ 04 ـ 2019
- بالنسبة إلى المشاركين عن طريق الاستكتاب فإن آخر أجل للإعلان عن نتائج التحكيم هو 30-06-2019